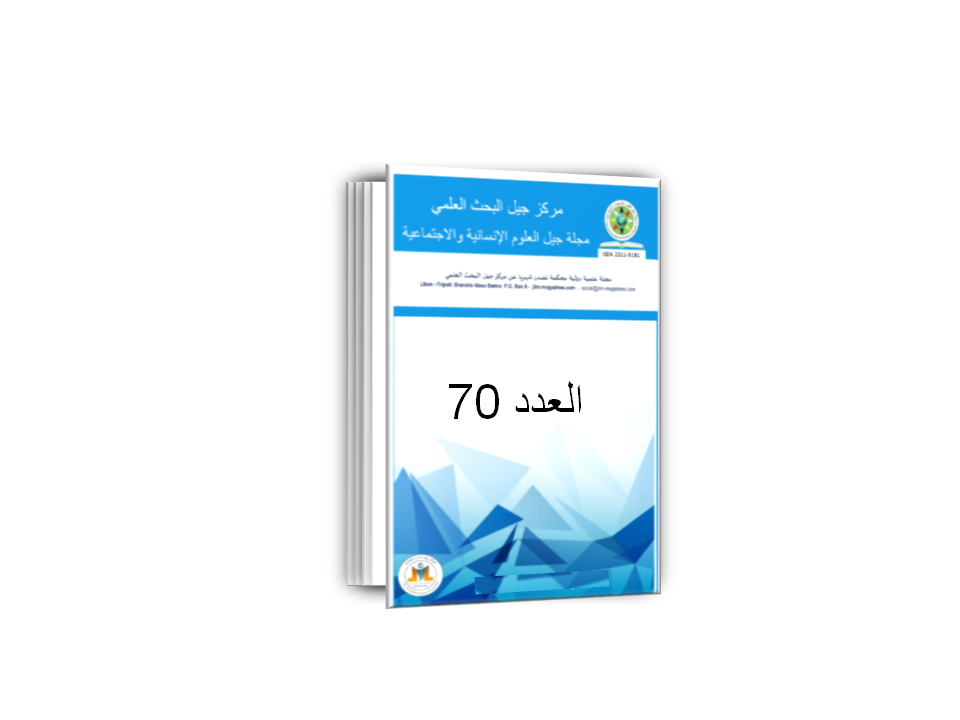
أضواء على مدينة مازونة الجزائرية ومدرستها خلال العهد العثماني في الجزائر
Highlights of The Algerian of Mazouna and Her school during the Ottoman era in Algeria
د.جلول دواجي عبد القادر/ أستاذ محاضر بجامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف- ، الجزائر
Ben Bouali University- Chlef- Algeria /Djelloul Daouadji Abdelkader
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 70 الصفحة 39.
Abstract:
The Mazouna School is a cultural symbol and cultural landmark for Algeria for several centuries, which has been extensively addressed by literary sources, and then by contemporary historians with many productions, and it is among the educational schools from which many scholars and jurists graduated during the Ottoman era, for its characteristics based on the teaching of Maliki Fikh and a set of different religious and worldly sciences, which were compared by some of them with the higher institutes in Fes, Egypt, Tunisia, Cham and Hijaz the Orient in general, because of what they had with teachers and scholars who had come out of the ottoman era. The scientific movement in the Algerian West for its fame, was the destination of many students.
Mazouna experienced a distinct cultural renaissance during the Ottoman period, thanks to the many cultural and religious institutions scattered there, such as mosques, schools and Zawia, where these institutions were one of the most important centers of cultural radiation at the time and a crucial turning point in the life of students who worked hard to seek science and progress to the degree of scholars and jurists, among the most important of these institutions the school of jurisprudence, which played a major role in this field.
The Mazouna School of Jurisprudence was very important in the western aspects of the Algerian eyala for acquiring a well-established system and strong traditions derived from its connection to education in Tlemcen, Andalusia, Morocco and the Orient as well, and also in the Cham, which continued to radiate knowledge even after the western Baylik capital moved from Mazouna to Camp and Then Oran, and was the destination of western students, particularly from Nedroma, Mostaganem, Tennis, Tlemcen, Oran and even from outside the homeland.
Keywords: Mazouna- Ottoman Era – Mazouna School of Fikh – Education- Method – History.
ملخص:
تعتبر مدرسة مازونة رمزا حضاريا ومعلما ثقافيا للجزائر طيلة قرون عدة من الزمن، تناولتها المصادر الأدبية بإسهاب، ثم المؤرخون المعاصرون بإنتاجات جمة، وهي من بين المدارس التربوية التي تخرج منها العديد من العلماء والفقهاء خلال العهد العثماني، لخاصيتها القائمة على تدريس الفقه المالكي ومجموعة من العلوم الدينية والدنيوية المختلفة فكانت تقارن حسب بعضهم بالمعاهد العليا في فاس وتونس ومصر والشام والحجاز والمشرق بصفة عامة، لما كانت تتوفر عليه من أساتذة وعلماء ذاع صيتهم في المغرب والمشرق، كما ساهمت في بعث الحركة العلمية في الغرب الجزائري لشهرتها التي بلغت عنان السماء، فكانت مقصد العديد من الطلاب.
عرفت مدينة مازونة خلال الفترة العثمانية نهضة ثقافية متميزة، ويعود الفضل في ذلك إلى كثرة المؤسسات الثقافية والدينية المنتشرة بها مثل المساجد والجوامع والمدارس والزوايا، حيث كانت هذه المؤسسات من أهم مراكز الإشعاع الثقافي آنذاك ونقطة تحول حاسمة في حياة الطلبة الذين اجتهدوا في طلب العلم والرقي إلى درجة العلماء والفقهاء، ومن بين أهم هذه المؤسسات المدرسة الفقهية التي لعبت دورا كبيرا في هذا المجال.
إن مدرسة مازونة الفقهية قد كانت على درجة كبيرة من الأهمية في النواحي الغربية للإيالة الجزائرية لاكتسابها لنظام راسخ وتقاليد متينة استمدتها من صلتها بالتعليم في تلمسان والأندلس والمغرب الأقصى ومن المشرق أيضا، فاستمرت تشع بالمعرفة حتى بعد انتقال عاصمة البايلك الغربي من مازونة إلى معسكر ثم وهران، فكانت مقصد طلاب النواحي الغربية لا سيما من ندرومة ومستغانم وتنس وتلمسان ووهران وحتى من خارج الوطن.
الكلمات المفتاحية: مازونة- العهد العثماني-مدرسة مازونة الفقهية-التعليم-المنهج-التاريخ. تمهيد:يقول الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس الجزائري ـ رحمه الله ـ يرهن صلاح المسلمين وصلاح علمائهم بصلاح التعليم، فيقول: “لن يصلح المسلمون حتى يصلح ﻋﻠﻤﺎﺅﻫﻡ، فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلَح صلحَ الجسد كله وإذا فسَد فسدَ الجسد كله…، ﻭلن يصلح العلماء ﺇﻻ ﺇﺫﺍ صلح تعليمهم، فالتعليم ﻫﻭ الذي يصبغ المتعلم بالطابع الذي يكون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ مستقبل حياته وما يستقبل من ﻋﻤﻠﻪ لنفسه ﻭﻏﻴﺭﻩ”.
تتناول هذه الدراسة التعريف بمازونة وبمدرستها وعلمائها وشيوخها وتلامذتها والطرق والمناهج التعليمية والدور العلمي والتعليمي الذي عرفته المدينة ومدرستها المشهورة والتي كان يضرب بها المثل في العلم ومنهج الأخذ والتعليم وكانت أنموذجا يحتذى به في الشق الآخر من العالم العربي ـ أقصد المشرق ـ إلى درجة أن أي شخص كان يسافر لطلب العلم في الشام أو مصر أو العراق يقال له: “هل درست بمازونة؟، فإجازة الطلبة بمازونة كانت تمثل تأشيرة عبور لمواصلة تلقي العلم بالشام والحجاز والعراق ومصر” وهذا ما جعلها تتبوأ مكانا عليا في العلم وتستحق فعلا لقبَ بلدة العلم والعلماء بامتياز، ولقب أم الأحكام المكنونة كذلك.
ومما يبرهن عن أهمية مدرسة مازونة الفقهية ما جاء على لسان أبي راس الناصري المعسكري الجزائري، قال: سألني الشيخ محمد بن لبنة عن وجهتي، فقلت له ذاهب إلى مازونة، قال لم؟ قلت: لقراءة الفقه، فقال: والقرآن؟ فقلت له: نعرفه بأحكامه وأنصاصه وما يتعلق به، فحفظت في مازونة مختصر خليل وفهمته معنى ولفظًا في عامي الأول، ثم قرأت للطلبة الفرائض”.
أولا-التعليم في العهد العثماني:
المطلع لتاريخ الجزائر العثماني يتبدى له أن الجزائر وبالضبط في النصف الثاني من القرن السادس عشر كانت مقسمة إلى أربعة أقاليم إدارية أو بايلكات وهي على التوالي:1- دار السلطان: وتمتد من دلس شرقا إلى شرشال غربا ومن ساحل البحر شمالا إلى سفوح الأطلس البليدي جنوبا.2- بايلك الشرق: كان مركزه قسنطينة.3- بايلك الغرب: و قد استقر مركزه بوهران بعد انتقاله من مازونة ثم معسكر.4- بايلك التيطري: ومركزه المدية ويعتبر أصغر البايلكات وأفقرها وأكثرها ارتباطا بالسلطة المركزية[1].
إن بايلك الغرب لم تكن عاصمته مستقرة بمكان واحد، مقارنة مع البايلكات الأخرى، فقد كانت منطقة مازونة في البداية عاصمة له عام 1563م إلى غاية 1700م ثم تحولت العاصمة إلى معسكر سنة 1701م ثم إلى وهران في الفتح الأول سنة 1708م، ثم مستغانم سنة 1732م بعد ذلك عاد المقر إلى معسكر ثانية سنة 1737م، و أخيرا انتقل إلى وهران بعد الفتح الثاني سنة 1792م، وإذا كانت البايلكات الأربعة محدودة بحدودها الجغرافية ، فإنه كان على رأس كل بايلك بايا يعينه السلطان ” لقد كان الباي صاحب السلطة السياسية الأولى على المنطقة و هو المسؤول الأول أمام الحكم المركزي ، حيث إن هذا الأخير هو الذي يقوم بتعيين البايات وتنصيبهم”[2].
لقد شجع العثمانيون انتشار حركة التعليم وتركوا الميدان مفتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات دينية أو تعليمية. لأن الجزائريين والعثمانيين أصبحوا تحت راية الإسلام، واستنجاد الجزائريين بإخوانهم العثمانيين كان عن قصد، فكان لهم “ذلك الدور البطولي الذي قاموا به – أي العثمانيون – خلال عصر الانحلال والتدهور والغزو المسيحي في قيادة الشعب، وشد أزره ضد العدو المهاجم، وما اضطلعوا به تحقيقا لرغبة الشعب من تأسيس الدولة، ومقاومة المهاجم إلى أن أبعد نهائيا عن أرض الوطن، وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية الإسلامية ضمن دولة واحدة وحول عاصمة واحدة وتحت راية واحدة رغم أنف الإقطاعية الطاغية … و إذا ما ذكرنا الدولة الجزائرية، والوطن الجزائري، فقد ذكرنا الأتراك العثمانيين سواء أكنا من المعترفين أو من الجاحدين”[3].
ولكن ما يميز هذا العهد هو أن بعض الحكام العثمانيين كانت لهم إسهامات في تشجيع بناء المدارس، وتكريم العلماء وتقريبهم بسبب مساهماتهم المختلفة، ومن بين الذين شجعوا ازدهار التعليم الداي محمد عثمان باشا (1766م-1791م)، وصالح باي، باي قسنطينة (1725-1795)، ومحمد الكبير باي إقليم الغرب (1779-1796)، حيث أنشأ صالح باي مدرسة الكتانية، وألحق بالجامع الأخضر مدرسة، وأمر محمد الكبير بتوسيع رقعة التعليم ومنح جوائز للبعض من أهل الفكر[4].
وإذا كانت الأقلية التركية تتكلم اللغة التركية فإن ذلك لم يفقد من أهمية اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية ولا ذهبت العادات والتقاليد وبقي المجتمع محافظا على ثقافته ونسيجه الاجتماعي “فبالرغم من كون الأتراك كانوا يتكلمون لغة تركية ولهم ثقافتهم الخاصة، فإن الثقافة العربية لم تفقد وظيفتها في الإدارة التركية سواء في المحاكم الشرعية أو التعليم و غيرها من المرافق التي لها صلة بحياة المواطنين وخلال ثلاثة قرون لم يحاول الأتراك فرض اللغة التركية على الأهالي كما أنهم لم يكونوا مدارس خاصة بأبناء الأتراك لتعليم اللغة التركية، بل إن أحمد باي كاتَب السلطانَ باللغة العربية”[5].
ومن هنا فإن العهد العثماني امتاز بازدهار ورقي الحركة العلمية والتعليمية والتي ارتبطت بالتعليم الديني أساسا، لأن العثمانيين لما جاءوا وجدوا حواضر علمية مزدهرة ببجاية وتلمسان وقسنطينة ومازونة والجزائر وغيرها، إلا أنه نظرا لظروف سياسية ومخاوف عسكرية نقلت كثير من هذه المراكز من المدن إلى الأرياف.
يقول البوعبدلي: (إن العصر العثماني امتاز في الجزائر بانتقال المراكز الثقافية من المدن إلى القرى، واشتهرت عدة معاهد إذ ذاك في كامل القطر، كمعاهد بني يعلى العجيسي، عبد الرحمن اليالولي … وبني خليل، والمدية ومعاهد الراشدية ومازونة …)[6].
وبتعدد هذه المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية على اختلافها وتنوعها في المدن والأرياف نقصت الأمية من أوساط المجتمع إلى نسبة قليلة، وساهمت في تكوين أجيال مثقفة، ويشير المؤرخ أحمد توفيق المدني إلى أن “الأمية كانت في القطر الجزائري أثناء تلك الفترة (الفترة العثمانية) أقل مما هي عليه الآن، فهم يقولون إن الأمة الجزائرية لم يكن عددها يومئذ إلا نحو ثلاثة ملايين من الأنفس، ويقولون إن القطر الجزائري كان يشمل نحوا من ثلاثة آلاف كتّاب ومسجد ومدرسة وزاوية لتعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة، فلو فرضنا أن كل كتّاب ومدرسة وزاوية لم يكن يشمل إلا عشرين فقط من الطلاب، وجدنا عدد الطلبة يومئذ ستين ألفا…”[7].
و في هذه الظروف و التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر خلال القرون الثلاثة من الحكم العثماني لم تخمد حركة التأليف والكتابة والتدوين، رغم انعدام وسائل الطبع ودور النشر وآلات الكتابة والنسخ، ولقد خلد علماء وكتاب ومعاصرو الفترة العثمانية كتبا ومخطوطات ومحفوظات ضاع جزء منها، وظهر الجزء الآخر الذي كان مغمورا في خزائن المهتمين، ولا يزال الجزء الكبير في حقائب وخزائن الكثيرين من محتكري العلم، وهو يتدهور يوما بعد يوم بسبب مفسدات الإنسان والطبيعة والزمن.
ومن جملة ما وصلنا من المؤلفات العلمية والثقافية والدينية في الجزائر العثمانية نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: “لقد ألف بن ميمون للفتح الأول كتابه (التحفة المرضية في الدولة البكطاشية)…، وكتب محمد المصطفى بن عبد المعروف بابن زرقة مؤلفه (الرحلة القمرية في السيرة المحمدية)…، وكتب ابن سحنون الراشدي مؤلفه الجماني (في ابتسام الثغر الوهراني )، وكتب بن هطال التلمساني مؤلفه (رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الوهراني”[8]، كما كتب “عبد القادر بن عبد الله المشرفي الغريسي (بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر”[9]، وكتب أبو عمران موسى أبو عيسى المغيلي مؤلفات عديدة أشهرها “ديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار” و(الرائق في تدريب النشء من القضاة وأهل الوثائق) و(حلية المسافر) “[10]، وكتب أبو زكريا بن يحي بن أبي عمران المغيلي “الدرر المكنونة في نوازل مازونة “[11]، وكتب أبو العباس الونشريسي “المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس و المغرب”[12]، دون أن ننسى ما كتبه محمد أبو راس الناصري.
وقد قسّم الدكتور سعد الله العلماء خلال العهد العثماني إلى ثلاثة أصناف: “العلماء الموظفون (كتّاب الإنشاء أو الخوجات)، والفقهاء المستقلون( المثقفون الأحرار) الذين لا صلة لهم بالتصوف ولا بالسلطة، ثم العلماء المتصوفة، أو المتصوفة دعاة العلم والولاية (المرابطون)[13].
ثانيا: مدينة مازونة: تاريخها وأعلامها[14]: مدينة مازونة مدينة عريقة تعتبر قاعدة تاريخية هامة في قلب جبال الظهرة، كانت ملتقى لعناصر مختلفة وحضارات متعددة، وصفت منذ القدم بمدينة العلم والثقافة، وسميت بأم الأحكام المكنونة، لقد امتدت بتاريخها إلى جذور الحضارات القديمة فكانت منارة العلم ومنهل الحضارة.[15]
إن الباحث في تاريخ المدينة يصطدم بشح المادة التاريخية والمصادر حولها، فكل الذين كتبوا في هذا الموضوع ما هو سوى إعادة وتكرار لما جاء في كتابات مولاي بلحميسي ويوسف لوكيل، وهما ابني المدينة ومختصين في التاريخ الإسلامي، فالأول كتب باللغتين الفرنسية والعربية، وهو مؤرخ حصيف، تخرج على يديه علماء كثر في المجال، وأثرى المكتبة بمادة تاريخية ثرية حول الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر، خصوصا كتابه المعنون بـ: (مازونة مدينة صغيرة وتاريخ كبير)، وأما يوسف لوكيل فكتب بالفرنسية كتابا قيما مجبر كل من يتحدث عن تاريخ المدينة العودة إليه، رغم صغر حجمه سماه: (مازونة عاصمة الظهرة القديمة)، أما من كتب عن المدينة من كتب ومقالات وأبحاث ورسائل أكاديمية فما هو في الحقيقة سوى اجترار لما كتبه الرجلان.
هناك عدة روايات حول تسميتها وهذه أهمها:
مازونة تعني أرض الرجال الأقوياء[16]، ومازونة اسم قبيلة من زناتة لأن اسم أبيهم مازون[17]، وقيل مشتقة من كلمة “ماسونة” بلدة رومانية فتحول الاسم اللاتيني ماسونة إلى البربري مازونة.[18]
ويروى أن مازونة كانت تحكمها ملكة لها كنز من قطع نقدية من الذهب تسمى “موزونة”، وأنه كان راع يدعى “ماتع” يرعى بغنمه في المكان الذي تأسست فيه المدينة؛ فرجع إلى أهله يصف. مزايا المرعى، ويقارنه بتلك القطع النقدية التي تسمى موزونة فلقب المكان بمازونة[19]، ويروى أن ملكا حط رحاله بجبال المنطقة وكانت ترافقه ابنته “زونة”؛ فطلب من رجاله أن يحضروا لها الماء، وعندما وجدوا المنبع حرموه على الغير وجعلوه لها، وقالوا هذا ماء زونة، ومنه أخذ اسم المنطقة مازونة[20]، وكلها تبقى مجرد روايات وآراء تحتاج إلى الدليل اليقيني القاطع.
تقع مازونة في قلب جبال الظهرة، فنالت إعجاب كثير من الرحالة والجغرافيين القدماء حيث يصفها الشريف الإدريسي بقوله: “هي مدينة بين جبل في أسفل، ولها أنهار ومزارع وبساتين وأسواق عامرة ومساكن موفقة ولسوقها يوم معلوم وهي من أحسن البلاد صفة وأكثرها فواكه وخصب”[21]، وأما الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف في الدراسات اللاتينية بليون الأفريقي فيقول عن مازونة في رحلته ومعجمه وصف إفريقيا: “مدينة أزلية بناها الأفارقة -حسب قول بعضهم- على بعد نحو أربعين ميلاً من البحر، تمتد على مساحة شاسعة وتحيط بها أسوار متينة، …، وفيها جامع وبعض مساجد أخرى، لقد كانت مدينة متحضرة جدًّا في القديم ….، حتى أصبحت اليوم (القرن السادس عشر) قليلة السكان، والأراضي المزروعة جيدة تعطي غلة حسنة”[22].
أما ابن بطوطة فذكرها من دون وصف حيث قال: “فوصلنا…إلى مدينة تنس ثم إلى مازونة ثم إلى مستغانم ثم إلى تلمسان[23]“، كما ذكرها العبدري في رحلته قائلا: “ثم رحلنا على طريقنا الأول إلى مليانة فتيمنا منها على طريق مازونة، مثوى خطوب الزمان ومناخ ركاب الحدثان، وهي بليدة مجموعة مقطوعة من بعض جهاتها بجرف واد منقطع شبه قلعة، وواهية حسا ومعنى”[24] .
أما تاريخ هذه المدينة عند الرحال الإسباني Mormol فيرجعه إلى عهد الروماني، عندما قام بجولته عبر الغرب العربي خلال القرن السادس عشر، .ويذكر أن مازونة مدينة قديمة أسسّها الرومان مستدلا ببعض الآثار الموجودة [25]، أما ابن خلدون فيرجع تأسيسها إلى القرن الثاني عشر ميلادي (565هـ) على يد عبد الرحمن أبو منديل زعيم قبيلة مغراوة [26]، ويشير محمد بن يوسف الزياني إلى أنّ مازونة تعرضت للتدمير عام ( 665هـ) حسبما ذكره ابن المدينة (مازونة) مولاي بلحميسي في قوله:
«D’autre part, l’histirien Oranais, mohammad ibn youcef al-ziyani, dansson dalil al-hayran »affirme que mazoun afut détrute en 665 de l’hégiré ».[27]
ويذكر “شاو shaw الرحالة الإنجليزي عن مازونة أنّها أسست من طرف الأهالي باعتبار أنّ بناياتها تشبه القلعة، هو يعارض مارمول (Marmol-Carvjal) الذي يرجعها إلى العهد الروماني، حيث يذكر أنّه ينبغي أنّه بالضرورة وجود آثار وبنايات تعود إلى هذا العهد، غير أنّ الإدريسي يحدد بعض التفاصيل حول المدينة، ويذكر أنّها كانت موجودة منذ القدم قبل الإسلام بحوالي بضعة قرون. [28]
وخلدت مدينة مازونة في الشعر العربي من قبل من زارها وأعجب بها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر هذه النماذج:
مدح الشيخ جلول البدوي مازونة وساكنتها وبعض ألقاب العوائل التي كانت ولا تزال إلى اليوم فقال:
اذكرْ مازونةَ واعرف قدر ما اشتملت عليه من خير ينويه مرتادُ
مدينةٌ جال فيها العلمُ جولتهُ إذ عاش فيها من الأعلام أطوادُ
آل الحميسي فيها امتاز فضلهم وما أثنوا منه ما جاروا وما حادوُا
مضَوا مصابيح هدى في القضاء مدىً يسوسهم في مجال العدل ميعادُ
فعالم يتولى شرحَ غامضةٍ من الشواردِ فواحها لهم زادُ
وعالم همهُ للفقهِ منبعثٌ وفكره فيه بالإدراك وقّادُ
تناولوه فلم يبرح بهم لهجًا كأنّما احتكروه الدهرَ أو كادوُا
وقد وعى لهم التاريخ ما صنعوا به احتفل فهو هيمان وغراد[29]
ومدح عبدُ الله المشرفي ( قاضي معسكر) الصادقَ الحميسي المازوني وهو تلميذه وقد زاره بمازونة:
مازونة خير القرى وأهلها خير أناس
لم تلق فيهم جنينا إلا كريما أو مواس
العلم صار طبعه والمجد خير لا يقاس
أكرم به من عالم سما بفكر ودرس
ضاهي بفقه مالكا ولغة أبا نواس[30]
ويقول الرحالة ابن الفقون الحسن بن علي القسنطيني أثناء رحلته من قسنطينة إلى مراكش، ملتحقا بالخليفة الموحدي محمد الناصر (1199م/1214م)[31]:
وفي مازونة مازلت صبّا وهمت بكل ذي وجه وضي[32]
ويقول الرحالة المصري صديق أحمد سنة ( 1332هـ- 1919م): (قيلت هذه القصيدة في شأن محمد أبي راس بن أبي طالب المتوفى 1917م):
ألماّ على مازونة وانظرا العلى فمازونةُ بيتُ الهدى وسلامُ
وهل بعد بيتِ العلمِ بيتٌ لقـاصدٍ دعائمهُ فوق السما ومقــامُ
لها شهرةٌ قدما ببث علومهــا ونشر التقِّى بين الورى وأنامُ
حماهـا منيع والمقـام مشدٍ وذكرٌ لها يسرى كبدر تمامُ
أبى الله إلاّ أن تكون ككعـة ملاذًا لمن قد ضلّ بين ظلام
رحلتُ بلادًا في الزمان كثيرةً لأنظرَ حال العلم بين خيامِ
فشاهدتُ كلاً بين مثن وشكر لهـا خير صنع في أجلِّ نظام
ولا عجب فالله أيد أزرهــا بهـذا الذي بين الملا كإمام
غنيت به بدر الأئمة مالكًا فقيه الثرى بل رأس كل همام
محمد أبوراس لذا سار نهجـه وسوى سبيل الفقه خير إمام
وقال له بين الرجال يخدمه وعزم متين فوق حد حسام
فأظهر مكنونا وأبدى دقائقا وأخرج آيات بخير قـوام
وبرز بـل عزّ النظيرُ وفاتهُ وفاقَ فكلٌ قد رمى بزمام
وأثنى عليه الفقه والدين والهدى بقول بديع في جميل كـلام
ومن يخدم العليـا فالله عـونُهُ ويجزيه خيرًا وفق صنع سلام
فدم يا إمام القومٍ درة تاجِهـمْ وبدرًا منيرًا فيكَ مسكُ ختامِ[33] [34]
ثالثا-مدرسة مازونة:1- النشأة والتأسيس: الداخل للمدرسة تصادفه لوحة[35] تؤكد صحة ما ورد في الوثائق التي اطلعنا عليها والروايات التي استمعنا إليها أي أن تأسيس المدرسة كان خلال القرن الحادي عشر الهجري نحو سنة 1029هـ القرن السادس عشر الميلادي على يد الشيخ محمد بن الشارف وقد أسسها وأقامها من ماله الخاص ودرّس بها حوالي 64 سنة وقبره موجود بها عليه قبة تسمى باسمه.
تقول الرواية الشفوية لأفراد عائلة المؤسس[36] بأنه كان في ملك محمد بن الشارف قطعة أرض باعها لأنها غير صالحة للبناء واشترى بالمقابل قطعة أرض أخرى، وقد اشتراها من ثلاث نساء اللواتي رفضن أخذ ثمنها بعد علمهن بنيته في تأسيس زاوية للتعليم غير أنه أصر على دفع الثمن.
اكتسبت مدرسة مازونة شهرة علمية منذ تأسيسها ولعبت دورا رئيسيا في المحافظة على الثقافة العربية الإسلامية ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على نطاق واسع من القطاع الوهراني وأحوازه حيث إنها استقطبت لمدة طويلة عددا كبيرا من الطلبة الذين جاؤوا من مختلف قرى ومدن الغرب الجزائري وحتى من المغرب الأقصى طلبا للعلم وهو ما كان معروفا عن هؤلاء الطلبة أنهم كانوا يأخذون العلم حيث ما وجدوه وقد كان بعضهم في حركة مستمرة لطلب العلم.
يقول محمد أبو راس الجزائري: “لما ذكر لي الطلبة مازونة وكثرة مجالسها ونجابة طلبتها وقريحة أشياخها… سافرت إليها فلقيت في المشي على صغري مشقة لكن ذلك شأن السفر للعلم[37]، وكل ذلك أكسب مدينة مازونة ومدرستها العلمية رمزية فكرية وثقافية إذ اعتبرت حاضرة العلم ولقبت بمدينة العلم والعلماء.
وأسس الفقيه العارف محمد بن علي الشارف المازوني مدرسة تربوية بمازونة في بداية القرن الحادي عشر الهجري، وقام بالتدريس فيها إلى أن لقي ربه، ثم تجدد ازدهار المدرسة على يد الشيخ أبو طالب محمد بن علي، في بداية القرن الثاني عشر الهجري، وخلفه على المدرسة أخوان من أبرز تلامذة المدرسة هما: الشيخ محمد بن هني وشقيقه الشيخ عبد الرحمن بن هني[38].
2- علماء مازونة[39]: كثر هم الذين تخرجوا من مدرسة مازونة، لا تكفي هذه الصفحات للإحاطة بهم والإلمام بسيرتهم جميعا، ولكن سأقتصر على التعريف بأبرزهم وأشهرهم، أولئك الذين ملأت شهرتهم الآفاق، وخلّدوا أسماءهم بمصنّفاتهم وكتبهم وأسفارهم، وكوّنوا من التلاميذ من حمل علمهم ونشر ذكرهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- عبد الرحمن بن محمد بن الشارف: هو مؤسّس المدرسة الفقهية بمازونة، توفي بمدينة مازونة، وبالضبط لا نعرف تاريخ وفاته.
- الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ابن الشارف: وهو ابن الشيخ عبد الرحمن مؤسس المدرسة، وتوفي سنة 1189هـ بمدينة مازونة[40].
- الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الشارف: المعروف بأبي طالب المازوني، وهو حفيد الشيخ المؤسس للمدرسة، توفي الشيخ أبو طالب سنة 1233هـ/ 1818م، بمدينة مازونة عن عمر يناهز مائة وثلاثين (130) سنة، ودامت مدة تدريسه أربعا وأربعين 44 سنة[41].
- 4. الشيخ أبو العباس أحمد بن هني بن محمد بن علي: وهو حفيد الشيخ أبي طالب المازوني السابق ذكره.
- 5. الشيخ محمد الصادق بن فغول: ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺟﻼء، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪيث ﻋﻠﻰ أﻗﺮانه، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن خبيرا ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺸريعة يجمع بين اﻟﻌﻠﻢ والدين.
- 6. يحيى بن موسى أبو عمران ابن عيسى بن يحي، أبو زكريا المغيلي المازوني: وهو فقيه مالكي من أهل مازونة من أعمال وهران، ولي قضاء بلده، توفي بتلمسان سنة 883هـ/ 1478م، له ( الدرر المكنونة في نوازل مازونة)،
قال عنه أحمد بن يحي الونشريسي صاحب المعيار تلميذ المازوني: “الصدر الأوحد العلامة العلم الفضال ذي الخلال السنية، سني الخصال شيخنا ومفيدنا وملاذنا وسيدنا، ومولانا وبركة بلادنا أبي زكريا سيدي يحيى، وهو من العلماء الكبار الذين تناولوا الفتوى، وأصبحوا مرجعية فقهية، ولم يتوظف بعلمه عند السلطة، وكانت فتاوى المعيار والمازوني دائرة على فقه مالك بن أنس، لأنه المذهب الذي كان يتّبعه جميع السكان باستثناء أتباع المذهب الإباضي”[42].
- 7. أبو عمران موسى بن عيسى المازوني: اشتغل قاضيا بمازونة[43]، ويصفه الحفناوي “بالفقيه الأجل المدرس المحقق، القاضي الأكمل، وهو والد صاحب النوازل، ولصاحب الترجمة تأليف في الوثائق سماه: “الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق”[44].
- 8. الحسن بن محمد بن محمد بن مصطفى المازوني: ويعرف بابن منزول آغا، من كبار علماء مازونة في وقته، ولم يعرف تاريخ مولده ولا وفاته[45].
- 9. الصادق بن علي المغيلي المازوني: عالم من فقهاء المالكية، من أهل مازونة التي تعلم بها ثم رحل إلى معسكر، وبعدها رحل إلى المشرق فتعلم بالأزهر الشريف، وبعد عودته تولى القضاء بمازونة، ثم بوهران، لم يعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته، غير أنه كان حيا سنة 1247هـ/ 1838م.
3- العلماء الذين درسوا في مازونة: ومن العلماء الذين درسوا بمازونة، نذكر ما يلي:
- الشيخ مصطفى الرمّاصي (ت 1136ه/ 1724م): نسبة إلى قرية قرب مدينة مازونة، عالم من فقهاء المالكية، تعلم بالمدرسة الفقهية بمازونة، على يد شيوخها وخاصة مؤسسها محمد بن الشارف المازوني، الذي أخذ عنه علم الحديث والفقه المالكي، وأجازه الشيخ في ذلك، ثم رحل إلى القاهرة، حيث أخذ عن علمائها.
وصفه عبد الرحمن الجامعي الفاسي بقوله: “حامل راية الفقه المالكي في عصره ومصره[46]، من آثاره: ترك لنا الشيخ الرماصي مجموعة من المؤلفات في جميع فنون العلم[47].
- 2. الشيخ محمد السنوسي ( 1202هـ/1276م): هو أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسيني الإدريسي مؤسس الطريقة السنوسية، ولد في مستغانم، درس علوما مختلفة بالمدرسة الفقهية بمازونة على يد شيخه أبي طالب المازوني، وحفيده الشيخ أبي العباس أحمد بن هني[48].
- 3. الشيخ محمد بن القندوز (ت 1222هـ): درس في المدرسة الفقهية بمازونة سنين عديدة، ثم رحل إلى مصر، توفي عن سن عالية سنة 1222هـ[49].
- 4. والشيخ عدة بن غلام الله ( 1208- 1283ه /1747-1866م): هو عدة بن محمد الميسوم بن غلام الله بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن محمد الخياطي، درس على يد الشيخ أبي طالب محمد المازوني الفقه بالمدرسة الفقهية بمازونة، تولى القضاء في عهد الأمير عبد القادر[50].
- 5. والشيخ محمد أبو راس: هو الشيخ الفقيه الحافظ المؤرخ، محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد الناصر ابن علي ابن عبد العظيم بن معروف بن عبد الله بن عبد الجليل، الراشدي المعسكري الجزائري.
صاحب المؤلفات الكثيرة المختلفة، منها: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، والحلل السندسية، والخبر المعرب وغيرها، أخذ الفقه المالكي وأصوله عن الشيخ أبي طالب المازوني[51].
- 6. والشيخ العلامة الفقيه عبد القادر بن المختار الخطابي المجاهري: خريج المدرسة الفقهية بمازونة، صاحب كتاب: (الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب)، قرأ بمازونة على عالمها الشيخ أبي راس المازوني، ولعل وفاته كانت سنة 1336هـ بمصر[52].
- 7. السيد محمد بن عبد الله الخالدي المالكي الجزائري: توجه إلى مازونة سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين، واشتغل بالعلوم الشرعية، وحفظ متن الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك، وقرأ بعض شروحه، وبعدها توجّه إلى قسنطينة سنة ألف ومائتين واثنتين وأربعين[53].
1- الجهود التعليمية للمدرسة: اعتنى أهل مازونة كغيرهم في ناحية المغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة بالعلوم الدينية بمختلف فروعها، إذ كان الفقه الإسلامي أساس هذه العلوم المعتنى بها، فقد جرى الاعتناء به والعمل على الإفتاء في المسائل اليومية، كما زاد الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والبحث في مسائل الأصول، كما اهتم علماء حاضرة مازونة بتفسير القرآن الكريم، وبعض علوم القرآن وفي مقدمتها القراءات، وبرزت التآليف المتعددة حول مناقب أولياء الصالحين، وكتب التدريب على القضاء وآداب المسافر منذ القرن الخامس عشر[55].
رغم خطورة هذه الحوادث التي عصفت بالمنطقة فهزت استقرارها وأضنت سكانها، بقيت الجزائر تحت راية الحكم العثماني قبلة للعلم، ومقصد العلماء والطلبة وقطبا لكل راغب في التعلم والتضلع في العلوم الدينية على اختلاف أجناسها من فقـه وتفسير و نحو وعقيدة وشعر. فلقد كانت الجزائر بمدارسها ومساجدها وكتاتيبها وزواياها رائدة في تنشيط الحركة العلمية والثقافية والدينية تضاهي نشاط كل من جامع الزيتونة وجامع الأزهر جامع القرويين.
لقد عرف التعليم بصفة عامة في الجزائر العثمانية مستويين “المستوى الأول وهو ما يعادل الابتدائي، وكان يتم عبر المدارس الصغيرة أي ما يسمى بالكتاتيب، والمستوى الثاني تشرف عليه المدارس على المستوى الحضري و الزوايا في الأوساط الريفية”[56]، وكان تعليما ذا طابع ديني بحت مرتبط بالحركة الدينية هذه الأخيرة كانت عاملا أساسيا في ثقافة العصر العثماني إذ كان يتخرج من المدارس والزوايا الأئمة والقضاة، والعدول والموثقون إضافة إلى العلماء والشيوخ والفقهاء، فاشتهرت مدرستي المسجد الكبير و ابني الإمام بتلمسان، ومدرسة مازونة شرق مستغانم ، وعرفت معسكر التعليم من خلال مدارسها و مساجدها خاصة في عهد الباي محمد الكبير الذي شيد المدرسة المحمدية فأصبحت من أهم المدارس الكبرى، أما مدينتي ندرومة ومستغانم فلم تكن بهما مدارس مشهورة، لكن لعبت المساجد وملاحقها دورا هاما في الحياة الثقافية على المستوى المحلي.
واشتهرت مدينة مازونة بمدرستها العريقة والمتجذرة عبر العصور التي أسسها أحد النازحين من الأندلس وهو “الشيخ محمد بن شارف الأندلسي في نهاية القرن السادس عشر”[57]، وتعدت شهرتها المستوى المحلي إلى المستوى المغاربي، فشدت إليها الرحال وقصدها الطلبة من كل حدب وصوب، لا سيما من مستغانم وتلمسان وندرومة وتنس ومعسكر، وحتى من المغرب الأقصى ودول المغرب العربي والإسلامي وتخرج منها علماء وفقهاء ومفتون مشهورون وبارزون أبرزهم أبوراس الناصري والمغيليان” الأول: أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني صاحب مؤلفات عديدة أشهرها، ديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار و الرائق في تدريب النشء من القضاة و أهل الوثائق وحلية المسافر، أما الثان==ي فهو أبو زكريا يحيا بن أبي عمران المغيلي (ت 1478 م) صاحب كتاب (الدرر المكنونة في نوازل مازونة)، وفي الدرر نجد تلك الحكمة الخالدة الصالحة لكل زمان و مكان : فساد الملوك بفساد العلماء، وفساد الرعية بفساد الملوك “[58].
ولقد أثنى أبوراس الناصري على الدور العلمي و الثقافي للمدرسة، في كتابه ( فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته)، وهو سيرة تفصيلية لحياته الذاتية و العلمية إذ يقول في هذا الصدد ” ثم سافرت أول صومي لـ( مازونة ) مدينة مغراوة، بناها منديل بن عبد الرحمن منهم أول القرن السادس، فلقيت – على صغري- مشقة المشي لكن ذلك شأن أهل السفر للعلم … فحفظت المختصر حفظا، وفهمته معنى ولفظا …وقد طار صيتي بمعرفتي المصنف و تحقيقه ، في المشارق و المغارب ، ووعدني كل طالب إلى الفقه راغب ، ثم انصرفت من (مازونة ) وقدمت إلى ( أم عسكر) من مال ولا غيره سوى معرفة الفقه وحده”[59].
كما ساهمت مازونة أيضا مثل تلمسان في تكوين جيل مثقف و نخبة مثقفة و تجدر الإشارة ” إلى أن مدرسة مازونة كانت منطلق الحركة السنوسية “[60]، واشتهرت المدرسة بتدريس الفقه و الحديث وعلم الكلام، وقد كانت المدرسة ملتقى العلماء و الطلبة ، ومقر مبادرات فكرية وسياسية ولا سيما عندما كانت عاصمة ومقرا لبايلك الغرب للمرة الأولى (1563 م -1700م) ، ثم “جدد الأتراك بناءها أكثر من مرة – يعني المدرسة – تكريما لشيوخها الذين ساهموا في الجهاد ضد الإسبان، وكان الرباط أمام وهران متواصلا لمضايقة العدو الذي احتل المرسى الكبير 1505 م ووهران 1509 م، و شارك فيه عدد من المازونيين من طلبة ومشايخ … لقد كانت المدرسة كالزهرة بين الشوك دائمة العطر و الحيوية يستنشقها محبو العلم و المعرفة … عاصرت مدرسة مازونة ملوكا وأمراء وبايات ودايات وباشوات، وقدموا لها لحسن الحظ الدعم على مختلف الأشكال”[61].
إن منطقة مازونة كانت في العهد العثماني قبلة للملوك و الأمراء والرحالين والعلماء والطلبة باعتبارها كانت عاصمة قرابة قرن وخمسين سنة إضافة إلى أن الكثير من العلماء والقضاة والمفتين والأئمة تخرجوا من مدرستها التي كانت تضاهي الأزهر والزيتونة والقرويين في المكانة والأهمية، حتى إنهم إذا أرادوا أن يفتخروا بطالب علم، عظموه ورفعوا من قدره وشأنه بقولهم: “لقد درس بمازونة”[62].
عرفت المدرسة منذ تأسيسها ازدهارا حيث قامت بتأدية دورها التعليمي على أكمل وجه من خلال ما كانت تقدمه من مضمون علمي وأيضا من خلال ما توافد عليها وما تخرج منها من طلبة ينتمون إلى جهات مختلفة من الوطن وخارجه.
تعتبر مدرسة مازونة الفقهية من بين المدارس التي تخرج منها العديد من العلماء والفقهاء خلال العهد العثماني، لخاصيتها القائمة على تدريس الفقه المالكي ومجموعة من العلوم الدينية والدنيوية المختلفة، حيث أشار مولاي بلحميسي في حديثه عن شعار الطالب بمدرسة مازونة على وجود تسلسل هرمي للموظفين والطلبة والعلماء بها، كان قائما على شروط العلم الأربعة وهي:
شروط العلم أربعة فأوّلهـا التفرّغ له
وثانيها وجود جدّ تبلغ للفتى أمله
وثالثها فعن شيخ يمد للهدى سبله
ورابعها مذاكرة مع الإخوان والفضلاء[63]
وعليه فلقد كان الالتحاق بمدرسة مازونة الفقهية، يقتضي من العالم أو الطالب الانصياع لمجموعة من الضوابط والشروط هي كالآتي:
- ضرورة حفظ القرآن الكريم لأنه واجب ديني لاسيما فيما يخص الطلبة المسافرين والمقيمين بالمدرسة، وفي هذا المقام يقول أبوراس الناصري: “سألني الشيخ محمد بن لبنة عن وجهتي، فقلت له ذاهب إلى مازونة، قال: لم؟ قلت: لقراءة الفقه فقال: والقرآن، فقلت له: نعرفه بأحكامه وأنصاصه وما يتعلق به “[64]
- الانضباط الذاتي وضبط النفس والالتزام الخلقي بالنسبة للطلبة المقيمين بالمدرسة.
- أن يقبل الطلبة المقيمين الحضور الفعلي في المدرسة ليلا ونهارا.
- لا يتمتع طالب العلم بالخدمات الاجتماعية والتغطيات المالية لشح الموارد وقلة الإمكانيات، وفي هذا المقام يقول مولاي بلحميسي: “ولم يكن الطلبة آنذاك يحلمون بالمنح والخدمات الاجتماعية، ولا بالتغطية الطبية ولا بمؤسسات الترفيه شأن إخوانهم اليوم ولعل في الحرمان حافزا للدراسة”[65]
- عدم السماح لأي أحد من الطلبة القاطنين بمازونة، ولا رجال إدارة العلم بها للنوم في المدرسة ما عدا المسافرين من العلماء والطلبة.
- ضرورة تكفل المجتمع المازوني بالإنفاق على المدرسة الفقهية وطلبتها باعتبارها صدقة جارية، بدليل ما ذكره مولاي بلحميسي: “ولا يقتصر العون على ما ذكرنا بل تكفلت العائلات بغسل ثياب الطلبة، كما بادر أهل الإحسان بدفع تكاليف الكراء والتدفئة وشراء الشموع للإنارة”[66]
- احترام مواقيت التدريس (التفرغ للعلم) والمراجعة (المذاكرة).
- احترام الشيخ المشرف على التدريس وجميع المشايخ الآخرين، والانصياع لأوامر الشيخ واستشارته في الغايات العلمية وغيرها.
- ضرورة الحفاظ على النظام الداخلي والالتزام به كاللباس الخاص أو الحصول على الطعام والماء والحطب وباقي الاحتياجات، وهذا فيما يتعلق بالطلبة المسافرين المقيمين بالمدرسة.[67]
- ضرورة التخفيف من مستلزمات العلماء والطلبة، بدليل ما ذكره مولاي بلحميسي: “ورغم عدد الطلبة فقد وجد هؤلاء بمازونة من فرج كربهم فلقوا في المجتمع – مهما كانت الظروف- العون الكافي، وكان إحسان المحسنين العامل الأساسي لنجاح التمدرس، لم يكن في وقتهم داخلية تضمن لهم الأكل فتكفل بتلك المهمة السكان والأعيان”[68]
- عدم السماح للمقيم من الطلبة بالخروج من المدرسة إلا عند الضرورة.
- لا يشترط أن يكون المقيم من المدينة أو البادية.
- ضرورة فصل الطالب المقيم من المدرسة إذا لم يظهر نبوغه في العلم، فيبعد عنها ويقع اختيار مجاور آخر في مكانه، أو إذا أساء مجاورة صحبة أقرانه أو قام بأعمال أو أقوال غير لائقة.[69]
2- مواد التدريس وطرقه:
الزائر لمدرسة مازونة من الباحثين والمطلع على خزانة كتب مدرسة مازونة، يجد في ثناياها أسماء عدة كتب اعتمدت في التدريس لسنين طويلة بالمدرسة، وبقيت تدرس حتى عهد أبي راس المازوني[70]، وكذلك طريقة التدريس قائمة على العلوم الدينية حيث كانت المادة الأساسية فيها هي الفقه المالكي، بدليل ما قاله أبو راس الناصري: “ثم انصرفت من مازونة وقدمت إلى أم عسكر ما معي شيء من المال ولا غير سوى معرفة الفقه وحده، قال: هذه عادة طلبة مازونة”[71]، ضف إلى ذلك ما ذكره الشيخ مصطفى الرماصي رحمه الله تعالى قائلا: “لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب الله وسنة رسول الله إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال من الحرام، وقد صنف فيه الأئمة الأعلام دواوين لا تحصى”[72]
وعلى ما يبدو أن الكتاب هو العمدة في الفقه بالمدرسة قد كان مختصر خليل ـ مصنف- في الفقه المالكي، وتبعا لذلك لقب مشايخ المدرسة وطلبتها “بالخليليين”، بدليل ما ذكره مولاي بلحميسي: “والكتاب العمدة في الفقه بالمدرسة هو مختصر خليل، الذي غطى مختلف التصانيف في المشرق وفي المغرب، كرسالة أبي زيد القيرواني وكتاب لباب الألباب وتحفة بن عاصم وموطإ مالك ومدونة سحنون، فاقتصر برنامج التدريس على هذا المصنف دون سواه، وقد أجمع أهل المذهب على عظيم فائدته”[73]
وكان التعليم بالمدرسة يركز على الجزء الأول من المختصر، بدليل إشارة مولاي بلحميسي قائلا: “وفي مازونة اشتهر المختصر، ومن مازونة نبغ عنصر أسرار خليل وعم نوره الأقطار، وبقي هذا الكتاب أكثر المتن الفقهية تداولا في الجزائر، على الرغم من إيجازه الذي يصل إلى الإبهام، وما من شك أن دعاء الشيخ خليل في مقدمة كتابه كانت من الدواعي التي فتحت أعين العلماء والمتعلمين، إذ قال: ( نسأل الله أن ينفع به من كتبه او قرأه، أو حصله أو سعى في شيء منه)، ويلقبه الناس لشهرته بالكتاب وتسميه العوام سيدي خليل، والكتاب الأصلي في أربعة أجزاء: كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وكتاب البيوع وكتاب الإيجار”[74]
إن علماء وطلبة مدرسة مازونة اقتصروا في تكوينهم الفقهي على المذهب المالكي بمختصر الشيخ خليل، لاسيما الجزء الأول من الشرح المعنون بـ: “منح الجليل على مختصر العلامة خليل”، والذي احتوى على عدة أبواب، فكان بذلك مرجعية فقهية لعلماء وطلبة مازونة خلال العهد العثماني.[75]
وتيسيرا لعملية تدريس المختصر، استند مشايخ وعلماء مازونة على بعض الشروح الموضوعة حوله ومنها شرح “محمد الخرشي” ورسالة “محمد أبي زيد القيرواني”، ومجموعة من التآليف هي لعلماء من المدرسة.
وإلى جانب مختصر الشيخ خليل درس مشايخ وعلماء المدرسة الفقهية مجموعة أخرى من العلوم، كعلم الحديث اعتمادا على صحيح البخاري ومسلم وموطإ الإمام مالك ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوسي في قوله: “قرأت على أبي العباس احمد بن هني الصف الثاني من المختصر مرارا، وسمعت عليه مجالس من البخاري ومثلها من مسلم والموطإ”[76]، كما عرف المحتوى التعليمي الذي تلقاه الطلبة في المدرسة علم التوحيد بالاعتماد على العقيدة الصغرى للشيخ السنوسي، بدليل ما ذكره محمد بن علي السنوسي: “وقرأت على حفيده من بعده أبي العباس أحمد بن هني، وأخذت عليه علم التوحيد وناولني شرحه الكبير على صغرى الشيخ السنوسي”[77]
هذا وقد وجدت أسماء عدة كتب اعتمدت في التدريس بمازونة لسنين طويلة خلال العهد العثماني، لاسيما فيما يتعلق بالعلوم اللغوية كالنحو العربي بالاعتماد على ألفية ابن مالك والأجرومية، وبعض المصادر اللغوية كالقاموس المحيط للفيروزآبادي، وجوهرة الأخضري وسلمه، بالإضافة إلى كتب ابن الحاجب وابن عرفة ومجموعة أخرى من التآليف الفقهية التي لقيت إقبالا كبيرا في اقتناءها من طرف علماء مدرسة مازونة الفقهية.[78]
لقد كانت طريقة التدريس بمدرسة مازونة قائمة على عدة مناهج، خاصة منها قيام أحد الطلبة بقراءة فقرة من الكتاب المقرر تدريسه، ثم يقوم الشيخ بشرحها حسب ما تجود به قريحته وينتهي إليه حفظه وإتقانه، فيفسح المجال خلال الدرس أو عقبه للطلبة للمناقشة والتعقيب وطرح الأسئلة إثراء للدرس وتعميقا للفائدة.[79]
وهو ما أكده مولاي بلحميسي حين أشار إلى ختم المختصر من طرف طلبة مازونة بقوله: “وكان ختم المختصر يوما مشهودا، يحضره الطلبة والأعيان والأهالي والزوار يأتي الناس راجلين أو راكبين فصار المكان لا يسع هؤلاء، فلا تجد موضعا داخل الجامع أو خارجه أو بجواره… ويطول الحفل لطول البرنامج من تلاوة القرآن وخطب حول المختصر وأشعار بالعامية أو بالفصحى، وأدعية للشيوخ الأحياء منهم والأموات، ويتساءل المرء: كيف استطاع طلبة ذلك الوقت فهم النص وهضمه وحفظه؟ ولعل الجواب في طريق التعليم في تلك المدرسة باللغة المبسطة ليفهم الدرس أو التفسير بسهولة، وكان لهذه المنهجية اكبر الآثار فزادها التعليم تحبيبا وترغيبا، وكانت المحاضرات لا تقتصر على النحاة ورجال الأدب، بل كانت في متناول الجميع، فلا غرابة إذا جاء أهل البلدة – في أوقات فراغهم- إلى الدروس يجنون الفوائد من مشايخ رزقوا العلم الواسع والقدرة وملكة التبسيط والتسيير، وبذلك كان الجو العام لائقا والوسط مواتيا لأغلبية الناس ومن مميزات هذا التدريس أن المشايخ كانوا يسمحون بالمناقشة والسؤال، فيستعدون للرد وللإجابة المقنعة دون انفعال أو جرح للطالب”[80]
كما كانت تدرس شروحات وتقييدات أمهات الفقه المالكي، فيبتدئ الدرس بقراءة الكتاب المراد تدريسه ويقتصر فيه على تقرير المتن وحل المشاكل ويطلبون الدروس مع ذلك، بحيث يجعلون من طلوع الشمس أو قبلها أو بعدها بقليل ليسير إلى قرب الزوال درسا واحدا، ومن بعد صلاة الظهر إلى قبيل المغرب درسا، ولا يستطيع ذلك إلا مهرة ممن لا يحتاج غالبا إلى مراجعة في تقرير المتن وحل أشكاله وسموا ذلك “سردا”، فبذلك تسير إلقاء مثل مختصر الشيخ خليل في أربعين يوما والألفية في عشرة أيام من تجزئة المختصر بأربعين جزءا لكل يوم جزء، نصفه في درس أول النهار ونصفه في درس آخره، ومن تجزئة الألفية بعشرة أجزاء لكل يوم جزء كذلك إلى غاية انتهاء الطريقة التعليمية لمشايخ وعلماء المدرسة الفقهية.[81]
وإلى جانب ذلك وجدت طريقة ثانية للتدريس بالمدرسة والقائمة على طريقة التقليد والرواية وترديد أقوال المتقدمين وحفظها حفظا سطحيا، بدليل ما ذكره الباحث بوكفة يوسف في حديثه عن مدرسة مازونة الفقهية قائلا: “فكل من جلس من المشايخ للتدريس يمكن أن يؤلف لطلبته كراسة أو أكثر شرحا، أو حاشية على علم معين، وكانت تتم بأن يجلس الشيخ في صدر المسجد على الكرسي المرتفع عن الأرضية، حتى يرى جميع الطلبة وينظرونه مرتديا عمامة وجبة وفوقها أحيانا برنس، وكان لباس المشائخ هذا يميزهم عن الآخرين”[82]
وبما أن التعليم كان من المستوى العالي بحاضرة مازونة، فلقد كانت الحلقة العلمية بالمدرسة تبدأ بأن يطلب الشيخ من أحد طلبته بقراءة نص من المصنف والذي يمثل موضوع الدرس، حيث يبدأ الشيخ مباشرة بشرح النص وفي هذا المقام يقول أبو القاسم سعد الله: “يدخل الطالب إذن مكان الدرس فيجد المدرس أو المدرسون وحولهم الطلاب في حلق أو نصف دوائر، وكل مدرس يتناول مسألة أو كتابا معينا، فإذا كان الطالب قد كون فكرة واضحة عن مدرس بعينه قبل مجيئه، فإنه يقصده مباشرة ويجلس إلى حلقته ويتابع دراسته معه في المادة التي يدرسها أو المواد”[83]
وعليه فلقد كان الشيخ بالمدرسة الحرية في وضع البرنامج التعليمي وفي تحديد أوقات التدريس وعقد الحلقات العلمية، والتي يكون التركيز فيها من طرف الشيخ على الفكرة العامة من النص، فيأخذ أولا في شرح المسألة وتوضيحها والاستشهاد لها من محفوظه (المنقول) ومعقوله (الحواشي والتصانيف الفقهية)، بحيث قد لا ينهي الشيخ المسألة في نفس الحلقة، ذلك أن ميزة الشيخ الناجح هي الخوض في الجزئية الواحدة عدة مرات ومن عدة وجوه، فكلما أطال الشيخ في المسألة وأفاض فيها كلما كان ذلك من ميزات نجاحه، وعادة ما كان يختم حلقته العلمية بإملاء خلاصات على الطلاب فينسخونها بحذق وعناية.[84]
أما إذا كان الشيخ بالمدرسة قد تميز بتبحره في العلوم الفقهية وسعة فكره غير متقيد بالمنقول والمسموع من المسائل، فلقد كان من الضروري على الطلبة أثناء الحلقة العلمية تسجيل الدرس كله حريصين في ذلك على ألا تفوتهم شاردة أو واردة من درس شيخهم خلال عملية التلقين، حيث كان بعض المشايخ بالمدرسة الفقهية يحفزون الطلبة على حب الاطلاع والتزويد بالمعرفة، وذلك من خلال اعتمادهم على المعقول من التصانيف والشروح والحواشي الفقهية المحتوية على العديد من المسائل الدينية والدنيوية، ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوسي في قوله: ” فمنهم أبو طالب سيدي محمد بن علي بن الشارف قرأت عليه النصف الأول من المختصر مرارا قراءة تحقيق وتدقيق، مطرزة بجزيل الفروع النقلية والفوائد السنية، وقرأت على حفيده أبي العباس أحمد بن هني النصف الثاني من المختصر، وناولني شرحه الكبير، كما ناولني حاشيته على الخرشي في جزئين ضخمين… آمرا لي بإقراء ما أقرؤوه عليه، وبمراجعة ما يقرؤه ويطالبه لنا حفيده المذكور من شرح الخرشي”[85]
فالحفظ والرواية كانا من بين المميزات الأساسية لشيخ المدرسة، باطلاعه على العديد من العلوم وأسانيدها وحفظ الكتب الكاملة كشرح مختصر الشيخ خليل والرسالة وابن الحاجب وغيرها من الكتب والشروح، كما امتاز بعض مشايخ المدرسة بكثرة التآليف في مختلف العلوم التي درسوها لطلابهم في شكل شروح أو ملخصات أو في شكل كتب ودواوين مستقلة، اعتمد عليها طلاب مدرسة مازونة بدرجة كبيرة في مسيرتهم العلمية وتكوينهم الفكري والديني.[86]
وبالإضافة إلى ذلك عرفت عملية التدريس بالمدرسة الفقهية وجود طريقة أخرى، مثلت بوجودها منهجا تدعيميا واستدراكا معرفيا لدى الطلبة ذوي الفهم البطيء وهي طريقة المراجعة، حيث تضمنت مدرسة مازونة في نظامها التعليمي وجود مشايخ متطوعين يراجعون للطلبة الدرس الذي قرؤوه على مشايخهم في حلقة التدريس، وقد ساهمت هذه الطريقة بوجودها في تيسير الحفظ والفهم وتبسيط المسائل الغامضة على الطلبة.[87]
وأما عن نظام الامتحانات فتذكر الأبحاث بأنه لم يكن معروفا بالمدرسة خلال العهد المدروس، وإنما كان الشائع هو تكليف الشيخ للطالب الذي أخذ بسهم وافر من العلوم بمساعدة الطلاب على تكوين فكرة عن الدرس الجديد قبل أن يشرحه، وبإعادة الدرس الذي سبق أن ألقاه، فيرفع من جهة مستوى بعض العناصر الضعيفة ويتمرس من جهة أخرى على إلقاء الدروس، في محاولة من الشيخ لترسيخ المعارف العلمية بفتحه باب المناقشة بعد نهاية كل حلقة علمية، وعملية التدريس تتضمن وجود طرفين الشيخ والطالب، ومن أجل إنجاحها يجب أن يشترك الطرفان في تيسيرها وتسييرها، فعملية الحوار القائمة على طرح أسئلة واستفسارات حول موضوع الحلقة توصل بالطلبة إلى درجة الاستيعاب والفهم، باستمرار على توسيع قاعدة المعرفة عندهم، وحين يختم أحد الطلبة الدرس يمنحه إجازة خاصة لتدريس علم معين أو عدد من العلوم أو إجازة علمية لتدريس كافة العلوم.[88]
يقول محمد يوسفي: ” تكون نهاية الدروس في تلك المؤسسات عادة بمنح إجازة للمستحقين من طرف الشيخ الذي درسه، وهي شهادة تثبت نوع الدراسة والكتب التي درسها لهذا الطالب، وهي تسمح له مزاولة التدريس إن كان يريد ذلك”.[89]
ومما تجدر الإشارة إليه أن مدرسة مازونة الفقهية قد كانت على درجة كبيرة من التنظيم المحكم لهياكلها التعليمية، فلقد وجدت العطلة الأسبوعية والصيفية لطلبتها، بدليل ما ذكره مولاي بلحميسي قائلا: “وكانت الدروس لا تتوقف سوى مساء الأربعاء ويوم الخميس، فيستريح الطلبة في العطلة الأسبوعية وما أحوجهم إلى ذلك، وكذلك تتوقف الدارسة خريفا وشتاء وربيعا، أما الصيف – فصل الحر والاسترخاء- فيتوقف النشاط إلى أن يحل اعتدال الطقس فتستأنف الدروس”.[90]
3- فنون العلم بالمدرسة: اختصت مدرسة مازونة بتدريس علوم الدين وعلوم اللغة[91].
أ- العلوم الدينية: تتمثل في:
1- الفقه المالكي: اعتمادا على مصنف خليل المختصر لذلك لقب شيوخ مدرسة مازونة بالخليليين[92]، وتيسيرا لعملية التدريس استند شيوخ المدرسة على بعض الشروح الموضوعية حوله، ومنها شرح محمد الخرشي ورسالة ابن زيد القيرواني إضافته إلى تأليف بعض شيوخ المدرسة السابقين[93].
ونشير هنا إلى أن هذا الدرس الوحيد الذي استمر الشيوخ في تدريسه إلى غاية اندثار المدرسة وقد عرفت عملية تلقينه خلال هذه المرحلة خضوعا عمليا أدى إلى حظر التعرض لبعض الدواوين التي يؤثر تدريسها على مصالح الاستعمار والاقتصار على تلقين بعض الدواوين التي تتعلق بالعبادات والمعاملات التي تضمن فكرة الخضوع والاعتقاد الديني في سلطة عليا.
ومن هنا اتخذ مصنف خليل بانتمائه إلى الدين وارتباطه بالجد المؤسس للمدرسة والعائلة طابع القداسة حتى أنه مثل عنصرا هاما من عناصر الرأسمال الثقافي والتعليمي.
وقد قسم مختصر خليل إلى أربعة كتب قسم كل منها إلى أجزاء[94]، وهي:-كتاب الصلاة قسم إلى خمسة أجزاء-كتاب الزكاة قسم إلى أربعة أجزاء-كتاب البيوع قسم إلى تسعة عشر جزءا-كتاب الإجازات قسم إلى اثنتي عشر جزءا.
أما تدريسه فكان كل شيخ يتناول كتابا معينا وقد يتناول شيخ كتابين أو أكثر ومن هنا بدأت ظاهرة التخصص في التدريس تدريجيا ومن شدة اهتمام مشايخ المدرسة الفقهية كان من المهم أن يدرس هذا العلم لوحدة خلال السنتين الأوليتين للطالب، وتتم عملية استيعابه عن طريق الحفظ والاستظهار التي يتبعون فيها القراءة الجماعية بعد كتابة النص على اللوح[95].
ومن أسباب عناية أهل المغرب بالمذهب المالكي وانتشاره في المغرب الأوسط: سببين اثنين: أحدهما: ناتج عن ظاهرة اجتماعية وهي أن إفريقية وبلاد المغرب في هذا العهد كانتا في حاجة ماسة إلى مباحث فقهية دينية تنظم شؤون البلاد الاجتماعية تنظيما محكما، وتربط بين مختلف طبقاتها المتفككة منذ العهد الجاهلي إلى ما بعد الإسلام، فكان مدعاة إلى تعاطي هذه العلوم الدينية أكثر من غيرها.
ثانيهما: الظاهرة النفسية الملحوظة وهي أن الأمازيغ لما اعتنقوا الإسلام ووجدوا فيه ما يكتنف المسلم في مختلف مجالاته منذ صغره إلى كبره، وما يواجهه في سلوكه الأخلاقي ويصحح علاقته بالإله والكون وبالعالم الآخر وما يواجهه في شؤونه المدنية والقضائية والدولية وغيرها آمنوا بأن العكوف على دراسة القرآن والسنة أو ما يندرج تحت مفهوم العلوم الدينية هو الأساس وهو الجدير بالعناية.
وكان لهذا الاتجاه الفقهي النشيط وللحماسة التي تحلى بها الفقهاء نتائج باهرة في كثرة المتفقهين، وفي وفرة التآليف الفقهية وتأثير الفقهاء على المجتمع ومختلف طبقاته حتى كان الفقيه رجل قانون وإماما وواليا يحترمه الخاصة والعامة، ويستفتونه في أحكامهم، ويستعينون به على حل مشاكلهم.
ويقول القاضي عياض: “واختلف الناس في السبب الذي انتقل به أهل المغرب عن مذهب أبي حنيفة وغيره إلى مذهب مالك السلفي. فقال ابن خلكان: إن المعز بن باديس هو الذي حمل أهل المغرب على مذهب مالك وحسم مادة الخلاف في المذاهب، واستمر الحال من ذلك الوقت إلى الآن”.
وبذلك بقي المذهب المالكي صامدا ولم يستطع أحد أن يمحوه من المغرب العربي عامة والمغرب الأوسط خاصة، رغم ما قصده البعض منهم من السعي إلى محوه وإزالته من المغرب مرة واحدة، حتى أنه سئل أحدهم وقد ترك مذهبه وتمذهب بمذهب مالك، فلما قيل له: أنت رجل عالم وفقيه قدير متمكن في الفقه ضليع فيه، لمَ تركت مذهبك، ولجأت إلى فقه مالك مع أن المذاهب كلها من نور النبوة تلتمس؟ فقال: ما قلته صحيح إلا أني أقول لك: إني درست المذاهب كلها فوجدت أقربها إلى الفطرة السليمة، وإلى السنة الصحيحة وروحها هو فقه مالك بن أنس؛ لأنه نشأ في دار الهجرة [96]
لقد كانت لشخصية مالك بن أنس صاحب المذهب المتميز أبلغ تأثير في تحبيب مذهبه إلى الناس عامة والمغاربة خاصة، فبالإضافة إلى كرم أخلاقه ومحبته للناس والتواضع لهم، وتهيبه الشديد من الفتوى وتحريه لما ينقل ويرويه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لعنايته بالطلبة المغاربة أبلغ تأثير على انتشار هذا المذهب بالمغرب الإسلامي، وليس أدل على ذلك من تلك الواقعة التاريخية التي نقلت عنه عندما جاءه كتاب ابن غانم يوصيه بعبد الله بن أبي حسان، فأكرمه حتى قال عبد الله: “فلم أزل عنده مكرما”، وأما الطلبة المغاربة فلم يكن يزدريهم كما فعل زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة الذي كان يزدري عبد الله بن فروخ، بل كان يثني عليهم، ويقول: “إن أهل الأمن والذكاء والعقول من أهل الأمصار الثلاثة: المدينة ثم الكوفة ثم القيروان”؛ فكان لسلوكه هذا الأثر الحسن في نفوس المغاربة[97].
وأيضا التشابه بين بيئتي الحجاز والمغرب من الناحية الاجتماعية، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون عند الكلام عن بداوة أهل الحجاز ونظرائهم من أهل المغرب، حيث قال: “وأيضا فالبداوة التي كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى الحجاز أميل لمناسبة البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب[98][99]
2- علم التوحيد: عمد الاستعمار إلى إلغاء مادة التوحيد من المحتوى التعليمي للمدرسة وكان الهدف من ذلك القضاء على التعليم الإسلامي، وبالتالي ضرب الهوية الدينية إضافة إلى أن التوحيد كعلم ديني يتضمن في محتواه المعرفي وحدة الخالق كما أنه عامل جوهري في الثقافة العربية، ومصدر من مصادر القوة والمقاومة وفي ذلك يقول أرنست رينان” إن الصفة الأساسية التي تميز العرب عن غيرهم هي الإيمان بالتوحيد وكان التوحيد منطلقا للثقافة العربية وإلى الوحدة، وحدة اللغة ووحدة التاريخ[100].
لكن ورغم ذلك الإجراء الإلغائي لعلم التوحيد من حركة التعليم بالمدرسة إلا أن الشيوخ استمروا في تدريسه لكن دون أن تعقد له الحلقات العلمية بل كان يلقى أيام العطل.
3- علم الحديث: باعتماد صحيح البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوسي بقوله :(قرأت على ابن العباس بن أحمد بن هني وسمعت عليه مجالس عن البخاري ومثلها من مسلم والموطأ) [101].
ب- العلوم اللغوية: أهمها النحو العربي وحفظ المنظومات وشرحها: عكف شيوخ المدرسة على تدريس وتحفيظ منظومة ألفية بن مالك والأجرومية على غرار الزوايا الفقهية المنتشرة لما لهما دور في عملية التعلم وعلاقة النحو بالعلوم الدينية الأخرى كالتفسير والبلاغة والفقه والحديث.
ويُعَدُّ ابتداء العلماء والشيوخ في النظم النحوي ارتيادا لطريق نحوَ أسلوبٍ جديد لتعليم النحو كان له آثار بعيدة المدى فيه أهمها تنشيط الحركة العلمية؛ إذ كثر إقبال طلاب العلم على حفظه؛ لأن النظم أسهل حفظا وأيسر استحضارا وأكثر رواجا من النثر؛ لما فيه من الأوزان المستحبة والموسيقى المستعذبة، وهذا يدل على مدى الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء العلماء في سبيل خدمة لغة القرآن، وذلك بتيسير معرفة القواعد النحوية وتسهيل تعلمها للطلبة في مدرسة مازونة الفقهية.
إن حفظ وفهم وتعلم المنظومات التعليمية مهم للطالب المتعلم لأنها وسيلة تُسَهِّل على المتعلم حفظ ما يَتعلَّمه، فتُمكِّنَهُ المنظومةُ من الإلمام بالقواعد، وتُيَسِّر له فهم نصوص الفصحى، وتُعَوِّد لسانه التحدث بها، فالنظم طريقة مثلى لتدريس العلوم وبخاصة علوم العربية وما يتعلق بها، لأن حفظ القاعدة هي الوسيلة الْمُثْلَى للابتعاد عن اللحن والخطإ والتعبير بلغة فصحى سليمة.
ب-طرائق التدريس ووسائلها بالمدرسة:
1- الطريقة الإلقائية: كانت تعقد الحلقة العلمية في قاعة الصلاة بالمسجد التابع للمدرسة حيث يجلس الشيخ على كرسيه الخشبي المرتفع وذلك حتى ينظر جميع الطلبة وينظرون إليه كدلالة رمزية على التحكم في نظام الحلقة، ومراقبة سلوكات جميع الطلبة ولفت انتباههم وكان الطلبة يتحلقون حوله متربعين في جلستهم على الحصير وتبدأ العملية التعليمية بأن يأمر الشيخ أحد طلبته بقراءة نص من الكتاب الذي هم بصدد دراسته، وهذا النص هو ما سيشكل موضوع الحلقة العلمية يسمى الطالب الذي يقرأ النص بالدوان[102]، وكان لكل شيخ دوان خاص به وبعد أن يتم الدوان قراءة النص يبدأ الشيخ في شرحه والإجابة والتفسير معتمدا في تلقينه ذلك على محفوظه من الشروح والحواشي الموضوعية حول النص دون أن يبدي رأيه حول الموضوع[103].
هذه هي الطريقة الإلقائية التقليدية التي يلجأ إليها الشيوخ لإثارة دافعية الطلبة وتشويقهم إلى الدرس، إضافة إلى أنها تكسبهم معلومات ومعارف كثيرة في وقت قصير.
عند انتهاء الشيخ من الشرح يتدخل الطلبة الذين أشكل عليهم الدرس طالبين تفسيرات حول بعض المسائل وتبدأ بذلك الطريقة الجدلية القائمة على النقاش وقد انتهج الشيوخ لإنجاح هذه الطريقة أسلوب الجد والهزل للترويح عن النفس وترسيخ الفهم[104].
ساهمت هذه الطريقة في إيجاد عملية التفاعل بين الشيوخ والطلبة وبين الطلبة فيما بينهم وأصبح بذلك الطالب عنصرا إيجابيا في المشاركة في سير العملية التعليمية.
2- طريقة المراجعة: ترسيخا لموضوع الحلقة العلمية اعتمدت المدرسة على طريقة المراجعة أو المذاكرة الجماعية وذلك بأن يقوم الطلبة المتقدمون في الدراسة بإعادة شرح النص وتدارسه مع الطلبة الجدد الذين هم بصدد قراءة هذا النص[105].
تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق كفاءة خصوصا عندما يتمكن الطلبة من مساعدة بعضهم البعض، وقد وفرت هذه الطريقة أيضا فرصا للطلبة المتفوقين لتدعيم تعلمهم عن طريق مساعدة غيرهم ولذلك أطلق عليها التعليم المتبادل.
ج- وسائل التدريس:
- الأدوات: اعتمدت المدرسة الوسائل التقليدية فقد كان الطلبة يسجلون دروسهم على لوحاتهم الخشبية التي هي وسيلة ضرورية في عملية التعلم يجب توفرها لدى كل متعلم من أجل كتابة النصوص ومراجعتها لحفظها.
- أوقات التدريس: أما فيما يخص أوقات التدريس فقد ارتبطت بالواجبات الدينية أي حسب مواقيت الصلاة اليومية وذلك على النحو الآتي:
- بعد صلاة الصبح قراءة الأوراد للطريقة التيجانية وتبدأ بعد ذلك مباشرة عملية التدريس حتى وقت الضحى ونلمس هنا نوعا من التركيز على الإبكار في العملية التعليمية وذلك لما لها من فاعلية في ترسيخ الأفكار وتهيئة الأذهان لقبولها واستيعابها إضافة إلى قدسيتها الدينية وذلك لخبر بورك لأمتي في بكورها[106].
- الدرس الثاني إلى غاية الظهيرة[107]، بعد صلاة الظهر قراءة الراتب وذلك ترسيخا لحفظ القرآن الكريم.
- الدرس الثالث بعد صلاة العصر.
- بعد صلاة المغرب المذاكرة الجماعية.
3-العطل: لم يكن الموسم الدراسي للمدرسة محددا بزمن معين وإنما كان يتم في العادة في مستهل فصل الشتاء ويستمر حتى بداية فصل الصيف مع إمكانية بقاء الطلبة المسافرون (الداخليون) في بيوتهم بالمدرسة أيام العطل يتدارسون فيما بينهم دروسا في علم التوحيد والنحو العربي وتعليم بعض العائلات في ضواحي مدينة مازونة، وكانت العطل موزعة كالآتي:
-العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة وهذا ما يعني أن أيام التدريس تستغرق خمسة أيام.
– العطل الموسمية خاضعة لتحديات الشيخ المشرف على عملية التدريس[108].
– العطل السنوية تتمثل خاصة في عطلة الصيف التي تستمر إلى الخريف.
– العطل الدينية وهي العطل التي تتعلق بالأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء وأول محرم والمولد النبوي.
د- شروط الالتحاق بالمدرسة: كان للمدرسة نظام داخلي وقانون يحدد شروط القبول في المدرسة، تكاد تكون هي نفسها الشروط المعتمدة في المدرسة النظامية الجزائرية الحديثة، وكذا معاهد التعليم القرآني الجزائري، ومن هذه الشروط:
- أن يكون الطالب قد تمكن من حفظ القرآن الكريم وما يتطلبه من تعلم القرآن والكتابة وقواعد الدين وهو ما يعني أن الطالب الذي يلتحق بالمدرسة يكون قد مر على المرحلة الابتدائية في الكتاتيب وبالتالي كانت مدرسة مازونة تمثل مرحلة للتعليم الثانوي وعليه كانت أعمار الطلبة بين الخامسة عشر والثلاثين.
- أن يهتم الطالب بنظافة جسمه وثوبه فلا يدخل على شيخه إلا بأحسن الهيئات وكامل الطهارات وبهندام موحد ولائق، فمثلا لا يسمح لأي طالب حضور حلقة الدرس دون عمامة.
- ألا يتأخر الطالب عن الدرس ولا يدخل دون استئذان من الشيخ وألا يتكلم في حضرته إلا بإذنه.
- أن يراجع الطلبة بعضهم بعضا تطبيقا لطريقة التعليم المتبادل السالفة الذكر.
- أن يمنح الطالب على اجتهاده في دروسه إجازة بالعلوم التي اجتاز بها مرحلة معينة تؤهله الجلوس للتدريس، وهو ما يعرف في المدارس النظامية اليوم بشهادات النجاح.
هـ- مكتبة المدرسة: شكلت المكتبة في وجودها أحد عوامل نجاح العملية التعليمية بالمدرسة فقد وجدت منذ البدايات الأولى لمباشرة وظيفتها التعليمية.
يقولG.H Bousquet في دراسة الوضعية الفقهية للمدرسة: “إنها (المدرسة) قد احتوت على مكتبة هامة شملت مخطوطات رائعة منها ما هو موقوف وبعضها هبات من البايات أثناء العهد العثماني بالإضافة إلى بعض التآليف الخاصة بالمشايخ”[109]، ومما يذكر أن المدرسة تحتوي على 170 كتابا في مختلف العلوم الدينية واللغوية ومعظمها هبات من بايات الأتراك.
خاتمة: رغم الهزات والحوادث والعوائق التي تعرضت لها المدينة عبر العصور إلا أن المدرسة بقيت تستقطب جموع العلماء والطلبة من أنحاء الوطن وحتى خارجه، فلقد اعتنى أهل مازونة كغيرهم في ناحية المغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة بالعلوم الدينية بمختلف فروعها، إذ كان الفقه الإسلامي أساس هذه العلوم المعتنى لها، فقد جرى الاعتناء به والعمل على الإفتاء في المسائل اليومية، كما زاد الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وفهمه وتدارس أحكامه ومعانيه والأحاديث النبوية الشريفة، والبحث في مسائل الأصول، كما اهتم علماء حاضرة مازونة بتفسير القرآن الكريم، وبعض علوم القرآن وفي مقدمتها القراءات، وبرزت التآليف المتعددة حول مناقب أولياء الله الصالحين وأحوال العارفين وأضحت المدرسة فضاء للتصوف ومنها كان انطلاق ومبتدأ بعض الطرق الصوفية واشتهرت بالفقه المالكي والتأليف في فقه النوازل.
تعتبر حاضرة مازونة من أشهر الحواضر العلمية في القطر الجزائري، وهي ذات شهرة مغاربية باعتبارها من أهم المؤسسات التعليمية في تحصيل المعارف ونيلها، وتخريج أفضل العلماء وحاملي الفكر والأدب في الجزائر والمغرب الأقصى، نالت بذلك مرتبة عالية نظرا لعطائها ودورها في نشر العلوم العقلية والنقلية على اختلاف تخصصاتها.
وقد أعطت هذه الحواضر الثقافية كبجاية وتلمسان مازونة” دفعا جديدا للحركة العلمية والثقافية في المغرب الإسلامي قاطبة، فأصبحت بذلك إشعاعا ثقافيا ومعلما حضاريا ساهم في غرس القيم والأخلاق، وتكوين أجيال من أفراد المجتمع الجزائري، تكوينا روحيا وثقافيا وفكريا، حيث تخرج منها كبار العلماء والفقهاء والأدباء الذين كرسوا حياتهم للعلم تعلما وتعليما حتى بلغت شهرتهم عنان السماء، وذاع صيتهم في مشارق البلاد ومغاربها.
إن مازونة بمدرستها تعتبر من الحواضر العلمية التي كان لها وقعها وأثرها الإيجابي على الحياة الثقافية والعلمية داخليا وإسلاميا وعربيا، حيث شهدت إقبالا طلابيا منقطع النظير من مختلف البقاع، وكان لها الدور الفعال في القضاء على الأمية ونشر العلم والثقافة في كامل أرجاء الوطن، ويشهد لهذا ما قاله الرحالة الألماني “فيلهلم شيمبرا” أثناء زيارته الجزائر في ديسمبر 1831م، يقول: “بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدته في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد المجتمع”[110]، فكانت هذه شهادة من هذا الرحالة الألماني عن رقي وعلو المستوى الثقافي في الجزائر خلال فترة الجزائر العثمانية. تصدقه إحصاءات الفرنسيين أنفسهم عند احتلالهم للجزائر حيث قدروا نسبة الأمية في الجزائر حوالي 5% فقط عام 1830م.
قائمة المراجع:
1-بالعربية:
- سعيدوني ناصر الدين: النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني (1792م-1830م)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر، 1985م.
- لواليش فتيحة: الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن 18، مخطوط ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 1993-1994م.
- المدني أحمد توفيق: حرب الـ 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا (1492م-1792م)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 1976.
- حميدة عميراوي: دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية (1827-1840) ط1، دار البعث ، الجزائر، 1987.
- التلي بن الشيخ: دور الشعر الشعبي في الثورة (1830-1945م) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983م.
- العيد مسعود: حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني ، مجلة سيرتا العدد: 3، قسنطينة، الجزائر، ماي 1980م.
- المدني أحمد توفيق: محمد عثمان باشا داي الجزائر (1766-1791)، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986م.
- بلحميسي مولاي: دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية والثقافية من القرن 15م الى منتصف القرن ال20م، مجلة العصر، عدد 11، السلسلة الرابعة، الجزائر، 1414هـ-1997م.
- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1998م.
- الحسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد الأخضر، القسم الثاني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1983م، ط2.
- جنان الطاهر: مازونة عاصمة الظهرة، ثغر حربي ومركز إشعاع حضاري، منشورات جمعية الظهرة، دت، دط.
- أحمد بحري: حاضرة مازونة دراسة تاريخية وحضارية في العصر الحديث (1500-1900)، مخطوط دكتوراه، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، 2012-2013.
- محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق المهدي البوعبدلي، دار عالم المعرفة، الجزائر، ط1، 2013.
- الإدريسي محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ج1، 2002م.
- ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق مجيد عبد المنعم العريان، مراجعة مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، ط1، 1987م.
- العبدري أبو عبد الله: رحلة العبدري، تحقيق علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط2، 2005م.
- مولاي بلحميسي: مازونة مقصد الدّارسين وقلعة الخليليين، منشورات الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، ط 1، 2005.
- بكير سعيد: المدينة الجزائرية في الشعر العربي الحديث، مازونة أنموذجا، مجلة الحضارة الاسلامية، عدد 18، المجلد14، وهران، الجزائر.
- بوعزيز يحيى، المساجد العتيقة بالغرب الجزائري منشورات ANEP، الجزائر، ط1، 2002م.
- أبو راس الناصري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، حياة أبي راس الذاتية والعلمية، تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري، الجزائر، المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر، 1990.
- بوكفة يوسف، مدرسة مازونة الفقهية، النهضة والسقوط، مخطوط ماجستير، قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، 2002-2003م.
- أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط1، 1989م.
- الحفناوي أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، موفم للنشر، الجزائر، 1991م.
- عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 1980م.
- عادل نويهض، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (1830-1960م)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
- الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1991م.
- عبد القادر بن عيسى المستغانمي: مستغانم وأحوازها عبر العصور، المطبعة العلاوية، مستغانم، ط1، 1996.
- حمدادو بن عمر وبوعمامة العربي: الشيخ سيدي عدة بن غلام الله وآثاره في الفكر والتصوف، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر.
- عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق وتنسيق وتعليق محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، ط2، 1413هـ-1993م.
- سفيان شبيرة: دور علماء مازونة في خدمة المذهب المالكي، مجلة عصور الجديدة، عدد 11-12، 1435هـ/2014م.
- ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1984.
- بوجلال قدور، العلم والعلماء في بايلك الغرب 1711-1830م، معسكر ومازونة نموذجا، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة معسكر، 2008- 2009، الجزائر.
- العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سيرتا، العدد 32، رجب 1400هـ ، ماي 1980.
- محمد يوسفي، نظام التعليم في بلاده زواوة بإيالة الجزائر خلال العهد العثماني، ملتقى الحياة الفكرية في الولاية العثمانية، تقديم عبد الجليل التميمي، منشورات في البحوث العثمانية والموركسية والتوثيق والمعلومات، تونس، 1990.
- مخلوفي جمال: التعليم الحر في حوض الشلف خلال الفترة (1930-1956)، مخطوط ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، 2008م-2009م.
- ابن خلدون: المقدمة، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دت، ط4.
- الجندي أنور، الثقافة العربية الإسلامية أصولها وانتماؤها، الموسوعة العربية الإسلامية، دار الكتاب، ط1، 1982م.
- مرسي محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب، طبعة 1983.
- أبو العيد دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط1، 1975.
22. الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، دار الخليل العلمية، الجزائر، 2012م.
2-المراجع الأجنبية:
- Belhamissi (moulay), Histoire de Mazouna (des origines à nos jours) Alger, SNED.1981.P:25-37.
- Moulay Belhamissi, histoire de Mazouna, société nationale d’édition et de diffusion, Alger.
- Bousquet, Promenade Sociologique : «Une Medersa dechue Mazouna »in : Revue Africaine, 1947.
[1] – سعيدوني ناصر الدين: النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني (1792م-1830م)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985م، ص 29 وما بعدها.
[2] – لواليش فتيحة: الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن 18، مخطوط ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 1993-1994م، ص 17.
[3] – المدني أحمد توفيق: حرب الـ 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا (1492م-1792م)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 1976، ص 09 وما بعدها.
[4] حميدة عميراوي: دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية (1827-1840) ط1، دار البعث ، الجزائر، 1987، ص 63 .
5 التلي بن الشيخ: دور الشعر الشعبي في الثورة (1830-1945م) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983م، ص 11.
[6] العيد مسعود: حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني ، مجلة سيرتا العدد: 3، قسنطينة، ماي 1980م، ص: 60.
[7] – المدني أحمد توفيق: محمد عثمان باشا داي الجزائر (1766-1791)، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986م، ص 12.
[8] – لواليش فتيحة: الحياة الحضارية في بايلك الغرب الجزائري، ص 165.
[9] – سعيدوني ناصر الدين: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: العهد العثماني، ص 250.
[10] – بلحميسي مولاي: دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية والثقافية من القرن 15م الى منتصف القرن ال20م، مجلة العصر، عدد 11، السلسلة الرابعة، الجزائر، 1414هـ-1997م، ص 08،.وأعيد نشر نفس المقال بكتاب جنان الطاهر: مازونة عاصمة الظهرة، ص88.
[11] – المصدر نفسه: ص 08.
[12] – نفسه: ص 08.
[13] أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1998م، ج1 ، ص 403 وما بعدها.
[14] للتفصيل في هذا المبحث ينظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد الأخضر، القسم الثاني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1983م، ط2، ص36، وينظر أيضا:
Belhamissi (moulay), Histoire de Mazouna (des origines à nos jours) Alger, SNED.1981.P:25-37.
[15]– جنان الطاهر: مازونة عاصمة الظهرة، ثغر حربي ومركز إشعاع حضاري، منشورات جمعية الظهرة، دت، دط، ص10.
[16] – أحمد بحري: حاضرة مازونة دراسة تاريخية وحضارية في العصر الحديث (1500-1900)، مخطوط دكتوراه، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 2012-2013، ص20.
[17] محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق المهدي البوعبدلي، دار عالم المعرفة، الجزائر، ط1، 2013م، ص77.
[18]– أحمد بحري: حاضرة مازونة، مرجع سابق، ص20.
[19] – المرجع السابق، ص 19.[20] – نفسه، 19.
[21] الإدريسي محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ج1، 2002م، ص271.
[22]– الحسن الوزان: وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، 1983م، ص36.
[23]– ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق مجيد عبد المنعم العريان، مراجعة مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، ط1، 1987م،ج1، ص667.
[24]– العبدري أبو عبد الله: رحلة العبدري، تحقيق علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط2، 2005م، ص561.
[25]– الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق واختراق الآفاق، مجموعة من المحققين، مكتبة الثقافة الدينية، المجلد 1، الإقليم الثالث، ج 1، بور سعيد، القاهرة، ، ص 09-10.
[26]– المصدر نفسه، ص 10.
[27]-Moulay Belhamissi, histoire de Mazouna, sociéte nationale d’édition et de diffusion, Alger, p 25.
[28]– جنان الطاهر، مازونة عاصمة الظهرة، ص 11.
[29]– مولاي بلحميسي: مازونة مقصد الدّارسين وقلعة الخليليين، منشورات الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، ط 1، 2005، ص 31.
[30]– جنّان الطاهر، مازونة عاصمة الظهرة، ص 103.
[31] بكير سعيد: المدينة الجزائرية في الشعر العربي الحديث، مازونة أنموذجا، مجلة الحضارة الإسلامية، عدد 18، المجلد14، وهران، ص 713.
[32]– مولاي بلحميسي: مازونة مقصد الدارسين وقلعة الخليليين، ص 05.
[33]– المصدر السابق، ص 38.
[34] يراجع: بكير سعيد: المدينة في الشعر العربي، مازونة أنموذجا، ص713.
[35] توجد بالجهة اليمنى عند مدخل المسجد التابع للمدرسة.
[36] ينظر أيضا بوعزيز يحيى، المساجد العتيقة بالغرب الجزائري منشورات ANEP، الجزائر، ط1، 2002م،ص20.
[37] أبو راس الناصري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، حياة أبي راس الذاتية والعلمية، تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري، الجزائر، المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر، 1990، ص43.
[38]بوعبد الله غلام الله: نظرة عامة على التعليم الأهلي في سهل الشلف خلال النصف الأول من القرن العشرين (أعمال الأسبوع الوطني الثالث للقرآن الكريم)، الجزائر، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 1424هـ/ 2003م، ص37.
[39]للتفصيل في الموضوع يراجع كلا من: محمد الأمين بلغيث: دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي، دار التنوير، 1427هـ/2006م، ص113، وأيضا: أحمد بحري: حاضرة مازونة، ص241، وأيضا: جنان الطاهر: مازونة عاصمة الظهرة، ص42.
[40]بوكفة يوسف، مدرسة مازونة الفقهية، النهضة والسقوط، مخطوط ماجستير، قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، 2002-2003م، ص 29.
[41] – يراجع أحمد بحري: حاضرة مازونة، ص241.
[42] الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، دار الخليل العلمية، الجزائر، 2012م، ج2، ص 58.
[43] أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط1، 1989م، ص ص 605-606.
[44] الحفناوي أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، موفم للنشر، الجزائر، 1991م، ج2، ص: 448.
[45] عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 1980م، ص 280.
[46] جنان الطاهر: مازونة عاصمة الظهرة، ص54.
[47] عادل نويهض، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (1830-1960م)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995م،ص: 110. ينظر أيضا: الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1991م، ج:2، ص: 441.
[48] عبد القادر بن عيسى المستغانمي: مستغانم وأحوازها عبر العصور، المطبعة العلاوية، مستغانم، ط1، 1996، ص 97.
[49] أحمد بحري: حاضرة مازونة، ص250.
[50] حمدادو بن عمر وبوعمامة العربي: الشيخ سيدي عدة بن غلام الله وآثاره في الفكر والتصوف، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، ص ص 9-15.
[51] محمد أبو راس الجزائري، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ( حياة أبي راس الذاتية والعلمية)، حققه وضبطه محمد بن عبد الكريم الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990م، ص: 19.
[52] أحمد بحري: حاضرة مازونة، ص252.
[53] عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق وتنسيق وتعليق محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، ط2، 1413هـ-1993م، ص ص 1281-1282
[54] أحمد بحري: حاضرة مازونة، ص253 وما بعدها.
[55] سفيان شبيرة: دور علماء مازونة في خدمة المذهب المالكي، مجلة عصور الجديدة، عدد 11-12، 1435هـ/2014م، ص 186.
[56] – نفسه: ص 160.[57] – BELHAMISSI Moulay : histoire de Mazouna, P 49.
[58] – بلحميسي مولاي: دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية الثقافية، مقال مجلة العصر، ص 08.[59] – الناصري أبو راس: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1990، ص 20 وما بعدها.
[60] – BELHAMISSI Moulay : histoire de Mazouna, P 50.
[61] – بلحميسي مولاي: دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية والثقافية، مقال العصر، ص 08 وما بعدها.
[62] – المصدر السابق، ص 09.
[63] – نفسه، ص 30.
[64] – أبوراس الناصري، فتح الاله، ص 20.
[65] – مولاي بلحميسي، مدرسة مازونة، 31.
[66] – المصدر نفسه، 31.
[67] – بوكفة يوسف، المرجع السابق، ص 31.
[68] – مولاي بلحميسي، المرجع السابق، ص 31.
[69] – مولاي بلحميسي، معلم القرآن في التاريخ والفقه والأدب، منشورات المجلس العلمي، الجزائر، 2007، ص 38.
[70] – أبوراس المازوني، محمد بن محمد بن أحمد بن هني بن محمد أبو طالب المازوني بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الشارف المازوني، المعروف بأبي راس المازوني نسبة إلى جده لأمه أبو راس الناصر المعسكري، ولد بمازونة حوالي منتصف القرن 19 م من أم تدعى زولة بنت الشيخ أبي راس الناصر ومن أبناءه المعروفين أحمد، محمد، ومحمد الشانبيط تولى منصب الإفتاء، كما كان مشتركا في جريدة كوكب إفريقية العربية من شيوخه والده محمد بن أحمد بن هني وعبد القادر بلحميسي وجده أحمد بن هني، حيث تولى التدريس بعد وفاته والده محمد بن أحمد بن هني وعبد القادر بلحميسي وجده أحمد بن هني، وقد كان ذا علم ووجاهة عند الناس بتمكنه بواسطة دوره التعليمي على أن يبقى الإشعاع لمدرسة مازونة الفقهية بالبايلك الغربي فدامت فترة تدريسه أكثر من 50 سنة، مولاي بلحميسي، مازونة مقصد الدارسين، ص ص 27-28.
[71] – أبوراس الناصر، المصدر السابق، ص 21.
[72] – مولاي بلحميسي، مازونة مقصد الدارسين، ص 32.
[73] -المرجع نفسه، الصفحة نفسها
[74] – المرجع السابق، ص 33.
[75] – المرجع نفسه، ص 35.
[76] – ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1984، ص 197.
[77] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[78] – بوجلال قدور، العلم والعلماء في بايلك الغرب 1711-1830م، معسكر ومازونة نموذجا، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة معسكر، 2008- 2009، ص 198.
[79] – Bousquet, promenade sociologique : «une medersa dechue mazouna »in : revue africaine, 1947, pp 412-413.
[80] – مولاي بلحميسي، مازونة مقصد الدارسين…، المرجع السابق، ص 36.
[81] – المرجع السابق، الصفحة نفسها.[82] – بوكفة يوسف، المرجع السابق، ص 52
[83] – أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري 16-20م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ج1، ص 53.
[84] – بوكفة يوسف، المرجع السابق، ص 53.
[85] – ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص 196 وما بعدها.
[86] – بوكفة يوسف، المرجع السابق، ص 52 .
[87] – المرجع نفسه، ص 55.[88] – العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سيرتا، العدد 32، رجب 1400هـ ، ماي 1980، ص 67.
[89] – محمد يوسفي، نظام التعليم في بلاده زواوة بإيالة الجزائر خلال العهد العثماني، ملتقى الحياة الفكرية في الولاية العثمانية، تقديم عبد الجليل التميمي، منشورات في البحوث العثمانية والموركسية والتوثيق والمعلومات، تونس، 1990، ص ص 206-207.
[90] – مولاي بلحميسي، مازونة مقصد الدارسين وقلعة الخليليين، ص 38.
[91] بوكفة يوسف: مدرسة مازونة الفقهية، النهضة والسقوط، ص38.
[92] المرجع نفسه، ص39.
[93]مخلوفي جمال: التعليم الحر في حوض الشلف خلال الفترة (1930-1956)، مخطوط ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، 2008م-2009م، ص55.
[94] بوكفة يوسف: مدرسة مازونة الفقهية، النهضة والسقوط، ص72.
[95] المرجع نفسه، ص 72.[96] سفيان شبيرة: دور علماء مازونة في خدمة المذهب المالكي، مجلة عصور الجديدة، عدد 11-12، 1435هـ/2014م، ص188.
[97] سفيان شبيرة: دور علماء مازونة في خدمة المذهب المالكي، مجلة عصور الجديدة، عدد 11-12، 1435هـ/2014م، ص189.
[98] ابن خلدون: المقدمة، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دت، ط4، ص245.
[99]سفيان شبيرة: دور علماء مازونة في خدمة المذهب المالكي، مجلة عصور الجديدة، عدد 11-12، 1435هـ/2014م، ص189.
[100] الجندي أنور، الثقافة العربية الإسلامية أصولها وانتماؤها، الموسوعة العربية الإسلامية، دار الكتاب، ط1، 1982م، ص69- 70.
[101] مخلوفي جمال: التعليم الحر في حوض الشلف؛ ص55.
[102] الدوال أو الدوان وهو كاتب الحلقة ( المدون).
[103] بوكفة يوسف: مدرسة مازونة الفقهية: النهضة والسقوط، ص 73.
[104] بلحميسي مولاي: دور مازونة في الحركة العلمية والثقافية، مجلة العصر، العدد 11، أكتوبر 1997، ص09.
[105] بوكفة يوسف: مدرسة مازونة الفقهية: النهضة والسقوط، ص74. [106] مرسي محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب، طبعة منقحة 1983، ص161. [107] جاء في نظم شعري لمحمد الصادرق بلحميسي المازوني ( توفي سنة 1936) دون تاريخ وهو رثاء في الشيخ أبو راس المازوني. [108] بوكفة يوسف: مرجع سابق، ص79.[109] BOUSQUET ,G,H, Promenade Sociologique une Madersa dechu-Mazouna-revue Africaine-Bulletin trimestriel-Tome XCL-société historique Algérienne 92 année-1ere et 2eme trimester-1947-P306
[110] أبو العيد دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط1، 1975، ص13.

