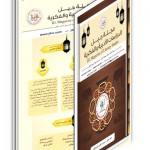مقال نشر بالعدد الأول من مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، ص 39 بقلم الدكتور عبد العزيز خلوفـــة؛ أستاذ اللغة العربية بأكاديمية الغرب/ المملكة المغربية
للاطلاع على كل العدد اضغط على لوجو المجلة:
ملخص المقال:
تعالج المقالة تطلعات شيخ النقاد المحدثين محمد مندور إلى نظرية الأدب، على اعتبار أن التراث الأدبي العربي رغم غناه يظل في حاجة إلى إطلالة بعين جديدة، لاستخلاص نظرية الأدب، تقوم على قواعد وأصول مميزة له عن باقي ألوان الكلام، ولن يتأتى ذلك إلا بالانفتاح على الأدب الغربي الذي قطع أشواطا مهمة في هذا المجال، حيث أعجب مندور بما تضمنه من مفاهيم و تعاريف تحدد ماهية الأدب ووظيفته، إذ إن الأدب يخلق بخصائص صياغته، لدى المتلقي، صورا خيالية أو انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية، أما وظيفته فتنحصر في نقد الحياة، مما يفيد أن الأديب يجب أن يتناول موقفا إنسانيا أو تجربة بشرية، حتى يفتح آفاقا إنسانية رحبة. وننتهي في الأخير إلى ما أشار إليه مندور بخصوص الفرق الملحوظ بين النقد الأدبي وتاريخ الأدب، فإذا كان النقد الأدبي عند العرب قد نضج واتخذ مذاهب عدة، فإن تاريخ الأدب ظل متخلفا لأن كل مؤرخي الأدب العربي من القدماء لم يصدروا عن منهج دقيق.
تقديم:
استشعر شيخ النقاد محمد مندور مسؤوليته التاريخية، التي لا تقف عند اجترار جهود النقاد العرب القدامى، وإنما في تطوير ما خلفوه من تراث أدبي غني يحتاج إلى من ينظر إليه بعين جديدة. وقد جاء عصر النهضة والحاجة ملحة إلى قيام نظرية الأدب، تأخذ في الحسان تطور الأدب عالميا وضرورة تأصيل المفاهيم بالنظر إلى التراث العربي، حيث إن” الجيل التالي لجيل طه حسين كان بمثابة الركيزة الأولى والدعامة الأساسية لقيام “نظرية الأدب” في اللغة العربية، ليست نظرية عربية، وليست نظرية مستوردة، ولكنها شيء جديد تحمل عبء صياغته العلمية أبناء الجيل الجامعي الجديد، وفي مقدمتهم الدكتور محمد مندور.”[i]
المطلب الأول: أصول الأدب
وإذا كان تراثنا الغني يخلو من تصور شامل وعميق لماهية الأدب، فإن الوقت قد حان لتجاوز هذا النقص، الذي يجعلنا نحس بالانحطاط الحضاري أمام التفوق الغربي. وهذه المسؤولية سيتحملها مندور، وقد شق هذا الطريق على الرغم من وعورته. لكن، وبإصرار شديد اقتدر على استخلاص النظرية العامة في الأدب، مازجا في ذلك بين الملامح القومية للأدب العربي وخصوصيات آداب باقي العالم،”لهذا السبب يكتب مؤلفيه ((الأدب ومذاهبه)) ثم ((الأدب وفنونه)) تحت سيطرة هذا المركب من تصوره للمبادئ والقواعد والأصول التي استقرت في تاريخ النقد العالمي، بين أحضان فلسفة الفن أو علم الجمال الذي اقترن بمعظم الفلسفات الأوروبية، وبين أحضان روائع الفن الشامخة عبر العصور. والعنصر الآخر هو تصوره التفصيلي لمراحل تطور الأدب العربي.”[ii]
إن تأثر محمد مندور بالأدب الغربي الحديث كان وراء الماهية التي قدمها للأدب، إذ كان ينكر أن يكون القدامى حددوا ماهية الأدب بالنظر إلى حقيقته وأصوله، فالقول بأن الأدب هو الشعر والنثر الفني، أي نثر الخطب والرسائل والمقامات والأمثال السائرة وغيرها من الفنون، هو تعريف لا صلة له بالمفهوم الحقيقي للأدب، بل هو تعريف –كما يرى – سطحي ضيق لا يحدد للأدب أصولا ولا أهدافا اللهم إلا أن تكون الصنعة في الشعر ثم النثر الفني.[iii]
هذا ما جعل مندورا يعمد إلى تحديد مفهوم دقيق للأدب، يميزه عن باقي ألوان الكلام، مستندا في طرحه إلى ما قدمته الثقافة النقدية الغربية، كما يصرح بذلك:”وذلك بينما نرى الغربيين يُعرّفون الأدب في نفس المجالات الدراسية بتعريف أوسع وأعمق، فيقولون إن الأدب يشمل كافة الآثار اللغوية التي تثير فينا بفضل خصائص صياغتها انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية، وبذلك لا يميزون الأدب بالصنعة فحسب، بل يميزونه بأثره النفسي الذي ينبعث عن خصائص صياغته، وهذا الأثر هو الانفعالات العاطفية والإحساسات الجمالية، وبهذا التمييز قد يخرج من الأدب التفكير العلمي الجاف والتفكير الفلسفي المجرد ولكنه لا يخرج الكثير من الكتابات الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخية المصوغة بصياغة أدبية كمحاورات أفلاطون أو تاريخ مشليه أو توسيديد، التي تحمل من عوامل الإثارة، ومن الخصائص الجمالية، ما يفرضها على كتب تاريخ الأدب ومناهجه.”[iv]
فمندور ينتقص من قيمة ما جاءت به العرب بخصوص ماهية الأدب، ويعتبرها غير كافية بالنظر إلى تعاريف الأوربيين، وهذا الأمر يتكرر في معظم كتبه. وهو ما يستنتجه الدكتور محمد برادة أيضا إذ يقول:”لكن مندورا، في تأثراته وتفاعلاته، وفي تكوينه لمصطلحاته ومقاييسه، ظل مشدودا إلى الثقافة الغربية كما كانت تمثلها جامعة السوربون والمفكرون القريبون منها.”[v]
ومن جهتنا نتساءل كيف أن مندورا ينكر أن العرب القدامى، لم يربطوا الأدب بالآثار التي يحدثها في المتلقي، بل إن وظيفته التأثيرية الجمالية تظل ركنا أساسيا عند القدامى، كقول الباقلاني “إذا علا الكلام في نفسه، كان له من الوقع في القلوب والتّمكن في النفوس، ما يُذهل ويبهج، ويُقلق ويؤنس، ويُطمع ويؤيس، ويُضحك ويبكي، ويُحزن ويُفرح، ويسكن ويزعج، ويُشْجي ويطرب، ويَهُزُّ الأعطاف، ويَستميل نحوه الأسماع، ويورث الأريحية والهزة.”[vi]
إلى غير ذلك من المؤلفات النقدية القديمة التي تظل تحرص أن يكون مفهوم الأدب لا يكتمل إلا بمراعاة استجابة المتلقي، على حد قول حازم القرطاجني: “وجب أن تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان وكانت دواعي آرائه متوفرة عليه. وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها أو من حصول ذلك إليها بالاعتياد.”[vii]
وأما قول مندور بأن “الأدب صياغة”، فهو كلام، أيضا، ليس بغريب عن الأدباء القدامى، فعلى سبيل المثال لا الحصر عنون أبو هلال العسكري كتابه القيّم “الصناعتين”، وهو يعني بذلك الشعر والنثر اللذين ينفردان عن باقي ألوان الكلام. وفي هذا الصدد يستخلص الدكتور محمد الواسطي:”وإنما شبه النقاد العرب “الصناعة الأدبية”بغيرها من الصناعات، على الرغم من أن الأولى لسانية والثانية يدوية مادية لما بينهما من علاقة تتمثل في دقة الإتقان وحسن التنميق وجمال الإخراج.”[viii]
وعلى الرغم من ذلك فمندور يرى التراث العربي مخلا بأصول نظرية الأدب، بدعوى أن الغرب في عصرنا الحديث هم من قدم تعريفا للأدب يأخذ في الحسبان حقيقته وأصوله، لذلك نراه يستشهد بتعاريف الرواد الغربيين: “وذلك لأن الأدب كما قال لانسون:”هو المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفين، وتثير لديهم بفضل خصائص صياغتها، صورا خيالية أو انفعالات شعورية أو إحساسات فنية.”[ix]
وبناء عليه، يميز مندور بين أسلوب الأدب وأسلوب باقي المعارف، ويرى بأن ثمة أسلوبين هما: الأسلوب العقلي والأسلوب الفني. فأما الأسلوب العقلي فهو:”الذي نستخدمه في العلم والتاريخ والفلسفة وأدب الفكرة إن صح أن يسمى ذلك أدبا “[x]، ويقصد بذلك العبارة الدقيقة التي لا تحتمل أكثر من معنى، فهي منتقاة تؤدي وظيفتها المباشرة، وذلك انسجاما مع طبيعة المعرفة التي تنقلها، أي أن المعاني تصبح جاهزة إلى المتلقي. بمعنى آخر” فالمعنى الواحد لا يمكن أن يعبر عنه إلا لفظ واحد.” وصاحب الأسلوب العقلي “لا يطمئن حتى يقع على الجملة الدقيقة التي تحمل ما في نفسه حملا أمينا كاملا، بحيث تصبح العبارة كجسم لا يمكن أن ينتقص منه أو يزداد عليه شيء.”[xi]
وعلى النقيض من هذا الأسلوب العقلي الذي لا صلة له بالأدب، يأتي كلام مندور عن الأسلوب الفني باعتباره” أسلوب الأدب بمعناه الضيق كما يفهمه الأوربيون بل هو الأدب ذاته.”[xii] وللتمييز أكثر بين الأسلوبين يورد مندور بعض الأمثلة، منها ما له صلة بالتراث العربي القديم:[xiii]
– من اليسير مثلا أن نقول:” إن وقت الظهيرة قد حان “فنؤدي المعنى الذي نريد أن ننقله إلى السامع، ومع ذلك يقول الأعشى:”وقد انتعلت المطي ظلالها” للعبارة عن نفس المعنى، فنحس لساعتنا أن عبارته فنية.
– و”سارت الإبل في الصحراء عائدة من الحج” كما يقول ابن قتيبة وكما يريد أن يفهم من قول الشاعر:”وسالت بأعناق المطي الأباطح.” ولكن عبارة الشاعر عبارة فنية قصد منها إلى نشر ذلك المنظر الجليل، أمام أبصارنا، منظر الإبل قادمة من مكة متراصة متتابعة في مفاوز الصحراء، وكأن أعناقها أمواج سيل يتدفق.[xiv]
وانطلاقا من هذا التباين بين الأسلوبين العقلي والفني ينتهي مندور إلى أن الأسلوب الفني تتحقق منه وظيفتان:[xv]
– التعبير عن المعنى كان بعبارة حسية، أي أن من سمة الفنية “أن تصاغ العبارة من معطيات الحواس.”[xvi] وذلك على خلاف الأسلوب العقلي حيث تكثر المعاني المجردة والألفاظ المجردة التي أصبحت ((مجازات ميتة))أمثال: الرفعة.الانحطاط، التي لم يعد أحد يفكر فيما اشتقت منه من ((رفع)) و((حط)).
– أنها تربط بين عوالم الحس المختلفة، فتحررنا مما اضطرنا إليه ضعف عقلنا من تقاسيم مفتعلة.
ومن خلال الوظيفتين يستخلص مندور من جديد مفهومه للأدب، وهو الأصح بالنظر إلى باقي التعريفات يقول:”إنه العبارة الفنية عن موقف إنساني، عبارة موحية.”[xvii] على اعتبار أن الأدب ليس كباقي الفنون بل هو”إخضاع الفكرة أو الإحساس للفظ”[xviii]لأن وسيلة الأدباء في التعبير هي اللغة ومن هنا فالأدب عنده “فن لغوي”.[xix]
الشيء ذاته نجده عند الأدباء اللغويين الغربيين، فإذا كان “جاكبسون لغويا وصاحب نظرية في الشعرية في الآن ذاته، فإن ذلك لم يكن مجرد صدفة. بل إنه يختبر الأدب باعتباره عملا لغويا.”[xx] كما نجد هذا التعريف نفسه عند الأديب البنيوي رولان بارت الذي يعرف الأدب بأنه “ليس سوى لغة، أي نظام من العلامات، ووجوده ليس في رسالته، بل في هذا النظام.”[xxi]
وإذا كان مندور يركز كثيرا على مسألة الصياغة كأحد أصول الأدب، بمعنى أن “الأديب يعبر باللفظ كما يعبر المصور بالألوان، والناحت بالأوضاع “[xxii] فإنه لم يلغ المحتوى، بل جعله شرطا ثانيا تتحدد به أصول الأدب. وهو الذي يظهر في تعريفه كما ذكرنا سالفا “الأدب صياغة فنية لتجربة بشرية.”[xxiii] لكن ماذا يعني مندور بالتجربة البشرية؟
إن التجربة البشرية التي وجب أن يتضمنها الأدب عند مندور لا تعني أن يكون الأديب صادقا فيما يقول، بمعنى هل من الضروري أن تكون التجربة التي ينقلها الأديب شخصية حقيقية؟ والأمر غير ذلك إذ ” لا شك فيه أن هذا الفهم الضيق خليق بأن يضيق من مجال الأدب والشعر وأن ينضب موارده، كما أن معايير الصدق والكذب لا يمكن أن تصبح مرادفة للتجربة الشخصية أو انعدامها. وذلك لأن الأدب لا يمكن أن يقتصر عن العبارة عن التجارب الشخصية. كما أن الأديب ذا الخيال الخصب الخلاق أو ذا الملاحظة الدقيقة النافذة يستطيع أن يخلق بخياله تجارب بشرية، قد تكون أعمق صدقا وأكثر غنى من واقع الحياة، كما يستطيع بقوة ملاحظته أن يصوغ تجارب للغير يستمدها من محيطه الإنساني. ومع ذلك، لا تقل صدقا ولا مشاكلة لواقع الحياة الإنسانية العام عن تجاربه الخاصة، وذلك لما هو معلوم من أن الخيال والملاحظة، يستطيعان أن يلتقطا ملامح الحياة وخصائصها وأن يؤلفا بينها على نحو يكاد يكون خلقا للحياة وأشد مشاكلة لها من التجارب الشخصية.”[xxiv]
وهو ما يعني أن الأدب عند مندور ذو طابع إنساني على الرغم من أنه يصدر من ذات مبدعة فردية، فالأديب يجب أن يتجاوز في معالجته للقضايا كل الحدود والخصوصيات والإقليميات، ويهتم بالفرد الإنسان لا فردا بعينه. ومن ثم يأتي الحديث عن مصادر الأدب التي تكشف حتميته. فالملاحظة والخيال منهما يولد ما يسمى بالأدب. والدليل هو جعله التجربة البشرية تشمل: التجربة الشخصية والتجربة التاريخية والتجربة الأسطورية والتجربة الاجتماعية والتجربة الخيالية.
فأما التجربة الشخصية فيعني بها كل “أحداث الحياة”[xxv] التي تراءت للأديب، لأنها تعمل على “تغذية كل ملكة أدبية صادقة”[xxvi]على خلاف الافتعال الذي يكون سببا في “الإفلاس الفني”.[xxvii]
وبخصوص التجربة التاريخية فالمقصود بها تلك الوقائع التاريخية، وبالأخص ما له صلة بشخصيات عظمى تركت بصمتها في التاريخ، لكن يفرض في نقلها أن لا يصور “تجربة هذا الرجل أو ذاك كما وقعت في التاريخ وإنما يصور تجربة كل رجل تحيط به نفس الظروف التي أحاطت بهذا الرجل التاريخي أو ذاك، بحيث تصبح قصة إنسانية عامة يستطيع كل فرد أن يتصور فيها نفسه، أو نفس غيره إذا اتفقت الملابسات.”[xxviii]
وأما التجارب الأسطورية التي يحفظها التاريخ للبشرية جمعاء، فمندور يراها كنزا غنيا يمكن أن تصبح مادة خامة يمتح منها الأديب مواضيعه، لكن ذلك مشروط بتحويرها بحيث”يستطيع أن يجسم رموزها أو أن يحيلها إلى كائنات بشرية تحس وتتألم وتفكر وأن يتصور التجربة وينفعل بها ويفكر خلالها.”[xxix]
وأخيرا تأتي التجارب الاجتماعية التي يعتمد، في نقلها إلى عالم الأدب، على الملاحظة والخيال. فالوقائع الاجتماعية قد تكون مصدر الأدب. فالأديب الذي يعمل على تصويرها ليس ضروريا أن يكون قد عايشها “فلربما كان نظره أدعى إلى تصويب ملاحظته وشمولها، كما أنه قد يستطيع بخياله أن يتصور الواقع وأن يجسده على نحو يبرز الحقيقة في قوتها.”[xxx]
كما يستدرك مندور من أن تكون تلك المصادر بعيدة عن الخيال، “فالتجارب التي لا تمكنه ظروف الحياة من أن يعيشها نراه يتخذ الأدب وسيلة لكي يعيشها بالخيال، فالأديب إذا كان قادرا بتخيله أن ينقل مشاعره بقوة وحرارة جعلنا نحس في أدبه”بما نسميه الصدق إحساسا لا يقل قوة عما يمكن أن يثير فينا نفس الشاعر أو الأديب فيما لو حدث وتحدث عن تجربة واقعية.”[xxxi]
وبالاستناد إلى التجارب السابقة التي يمكن أن تكون إحداها مادة الأدب يميز مندور بين أدبين أولهما ذاتي، والثاني موضوعي. فإذا كانت التجربة الشخصية هي الحاضرة في متن الأدب يسميها بالأدب الذاتي، وإذا كانت تجربة غيرية فهي الأدب الموضوعي، لكن كليهما لا يمكن أن” يخلو من شخصية الأديب، ومن طابعه الخاص، الذي تتميز به عبقريته.”[xxxii]
المطلب الثاني: وظيفة الأدب
كما أورد محمد مندور تعريفا آخر يتضمن وظيفة الأدب، وهو ما يلخصه قوله “إن الأدب نقد للحياة”[xxxiii] وفيه، أيضا، ما يحيل على ماهية الأدب، حيث إنه ” تعريف لا يتعارض مع التعريف السابق بل لعله يكمله، وذلك إذا كان منوال الأدب ينصب لكي ينسج تجربة بشرية فإن عملية النسج يجب أن تقوم على نقد دقيق لخيوط ذلك النسيج وتمييز ألوانها ودرجة سمكها وقوة أو ضعف صلابتها، ثم تحديد موقعها في رقعة النسيج ومدى تنافرها أو تنافرها مع الخيوط الأخرى، ثم النهاية وقع كل خيط وتأثيره على نفسية الناسج وبالتالي على نفسية الغير الذين قد يشاهدون الرقعة المنسوجة.”[xxxiv]
ومن ثم نفهم أن وظيفة الأدب عند مندور هي نقد الحياة، ونقدها يتطلب تجاوز نقد حياة الأفراد بل وحياة المجتمعات لتصل إلى تجاوز حياة الإنسانية كلها، وذلك”لأن الحياة أعم وأشمل من التجارب البشرية، وقد يمتد معناها إلى ما وراء العالم المحسوس من مجردات، كما أن مدلول الحياة لا يرفض أن يضم ما بعد الحياة من مصير بل ما يحيط بتلك الحياة من معضلات ومشاكل، كالقوى الإلهية وقوانين الطبيعة الجبرية، وإطاري الزمان والمكان، وما يجري بين عنصر الحياة وبين كل هذه القوى والكائنات من صراع وتآلف.”[xxxv]
إن هذه الوظيفة التي أرادها مندور للأدب، تكشف مدى تشبعه بأفكار أرنولد،[xxxvi] بل تشبعه بأطروحة “الواقعية النقدية”، حيث جعل الأدب يجابه الاختلالات التي تعترض الحياة الاجتماعية السليمة، ومن ثم يظل الأديب رهين تطلعات الكائن البشري.
واستنادا إلى ما سبق، يتغيا مندور، مما سبق ذكره، أن يكون الأدب ملتزما، فيه إصدار لأحكام صريحة أو ضمنية على عناصر الأدب المختلفة، وذلك لأنه يسهم في تطوير نفسه أو مجتمعه أو الإنسانية كلها. بل إن وظيفة الأدب تتمثل في كون الأدب “يمهد للثورات من حيث إنه نقد للحياة، ولكنه لا يعاشرها ولا ينمو أثناء اندلاع لهيبها، إذ يكون قد أدى مهمته ولم تعد أمامه حياة مستقرة أعيد تكوينها نهائيا على أسس جديدة بحيث يستطيع الأدب أن يعود إلى نقدها وتمييز خطوطها أو تقويمها، ليدفع إلى تطورها من جديد على نحو يساير ركب الإنسانية العام الذي لا يني عن الحركة إن لم نقل عن التقدم المطرد.”[xxxvii]
وفي المقابل، يرفض مندور ما فهمه بعض النقاد من أن يتحول الأدب إلى وسيلة لخدمة الحياة الراهنة وما تعرفه من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية، وهذا في نظره تجاوز لمهمة الأدب إلى مواضيع هي أنسب لحقول معرفية أخرى كالسياسة والاقتصاد والاجتماع. بحيث سئل كيف يمكن أن يكون للأدب وظيفة سياسية، أجاب قائلا:”للأدب وظيفة سياسية، ولكنه لا يؤديها بأسلوب مباشر وإلا انقلب إلى مجرد دعاية سياسية.”[xxxviii] بل إن مهمته هي تطوير الحياة السياسية، وذلك لأن الأدب “يستخلص القيم المحركة التي تكمن خلف مظاهر التطور المادي والاجتماعي للحياة، وهو بكشفه هذه القيم الكامنة يحيلها إلى قوة إيجابية فعالة تدفع نحو مزيد من التطور في نفس الاتجاه.”[xxxix]
وهذا الكلام الذي تشبع به مندور حصل بعد أن انتشرت الفلسفة الوجودية و الاشتراكية اللتان أسهمتا في تغيير مفهوم الأدب ووظيفته. فالأدب عند هؤلاء الإديولوجيين “يرتكز على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الإنسان المعاصر.”[xl]
وإذا كان كذلك، فالأدب مرآة تعكس ما في الواقع وتلتقطه “ومعنى هذا أن الأدب انعكاس لواقع الحياة وتطورها، ولكنه ليس انعكاسا سلبيا، بل انعكاس ايجابي، فهو يرتد ثانية إلى تلك الحياة ليحث خطاها، ويدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، وبذلك يأخذ من الحياة، ثم يعطيها أكثر مما أخذ.”[xli]
إن الفلسفة الاشتراكية التي يمكن اعتبارها رافدا مهما، لدى مندور، في تحديد وظيفة الأدب، يمكن تقسيمها إلى وظيفتين؛ فالأولى تقول بالانعكاس الإيجابي، والثانية تقول بالانعكاس الآلي. لكن مندورا كما هو واضح يميل إلى المفهوم الأول للاشتراكية. “وهذا هو المفهوم الديالكتيكي للفلسفة الاشتراكية بالنسبة للأدب، وهو يختلف عن المفهوم الميكانيكي للاشتراكية، الذي يعتقد أن التطور المادي للحياة هو الذي يطور الفكر في حين أن الفكر لا يمهد لهذا التطور ولا يسبقه، فهو يضع الفكر في موضع الذنب لا الرأس، بينما المفهوم الديالكتيكي يجعل الفكر قوة فعالة نحو التطور والتقدم لا مجرد انعكاس آلي لذلك التطور”[xlii]
وفي موضع آخر يرى مندور أن ما يقابل عبارة “نقد الحياة” أو القول بالوظيفة الإديولوجية، هو معنى “فهم الحياة.”[xliii] وفهمها هو”فهم النفس البشرية، ذلك الفهم الذي يغضبك أن توفر عليه قلمنا.”[xliv] كما أن إدراكها يمكن أن يكون “عن خوالج نفسية أو طرائق لغوية أو موضوعات نموذجية، أو آلام وآمال خاصة.”[xlv]
فبعد أن يتفهم الأديب الحياة، ويتفهم التجربة البشرية يصبح فيها قادرا على خلق حياة جديدة، وهذه الحياة ملؤها الحق والجمال. فالأديب يعمل على تغذية النفوس بالحق والجمال. لكن هذه النفوس المختلفة الأذواق، تجعلنا نقول بأن مهمة الأديب، كما يرى مندور، هي إيقاظ النفس إلى ما تملكه “ونحن بعد ذلك لا نكتب لنسكب ما في نفوسنا في أنفس الغير، وإنما لنعين كل نفس على الوعي بمكنونها، إذ النفوس عامرة بكل حق وجمال، والمقال الجيد هو ما يأخذ بتلك النفوس إلى حيث يستقر منها ذلك الحق وذلك الجمال.”[xlvi]
انطلاقا مما تقدم، فالأدب هو الفن الوحيد الذي بمقدوره كشف حقائق النفوس. أما باقي الفنون والعلوم فيصعب عليها ذلك، بحيث “يثق الدكتور محمد مندور بالأدب في معرفة حقائق النفوس، ثقة راسخة ولكنه لا يثق بما يقوله الفلاسفة أو علماء النفس عن الإنسان إطلاقا أو ملكة من ملكاته.”[xlvii]
وصفوة القول، فالأدب عند مندور إضافة إلى وظيفته السياسية التي تجعل منه مرآة تعكس الواقع بشكل إيجابي، والثقة به لكونه يمدنا بأسرار النفس البشرية، فهو يعمل على”مد آفاق تفكيرنا ويرهف إحساسنا ويبعث ماضينا.”[xlviii] كما أنه يروم إلى ” نشر الثقافة الحرة.”[xlix] ومن قال بغير ذلك فكلامه عند مندور “هراء وادعاء وحذلقة.”[l]
المطلب الثالث: تاريخ الأدب
من الأمور التي ناقشها مندور وباستفاضة، مسألة تاريخ الأدب، وذلك لأهميتها وللبس مازال يشوبها، خصوصا الفرق بين تاريخ الأدب والنقد الأدبي، وكذا الفرق الوارد بين تاريخ الأدب والتاريخ العام. على اعتبار أن هناك سوء فهم للحدود الواردة بينها،”وعلى أية حال فسواء فهمنا تاريخ الأدب بالمعنى الضيق الذي تقف عنده الكتب العربية أو بالمعنى الواسع على النحو الأوروبي، فمن الواجب أن نفرق بين تاريخ الأدب ونقده.”[li]
سنترك فن النقد إلى حينه، ونذهب مع مندور في ما يقوله بخصوص تاريخ الأدب، إذ يرى في تاريخ الأدب صلة وطيدة بالتاريخ العام “تاريخ الأدب جزء من التاريخ العام، وهو خاضع لمناهج التاريخ بوجه عام. “[lii] لكن هناك فروقا و اختلافات واضحة من حيث طبيعتهما “فالتاريخ العام يتناول حقائق انقطع بها الزمن فلم تعد تمتد إلى الحاضر وتؤثر فيه، وعلى العكس من ذلك الأدب فهو ماض مستمر في الحاضر، وإذا كانت مادة التاريخ وثائق ومحفوظات تحفظ في دور الكتب، ويبحث عنها لقيمتها الإخبارية، فإن الأدب على العكس من ذلك عبارة عن مؤلفات شعرية أو نثرية لا تزال حية لقدرتها المستمرة على الإثارة الفكرية أو العاطفية.”[liii] وتكمن فائدة الأدب المسترجع في كونه “ضرورة من ضرورات الحياة عند الشعوب المتحضرة، لأنها تربي ملكات الذوق والإحساس عند البشر، كما تربي العلوم الرياضية ملكات المنطق والتفكير.”[liv]
وغالبا ما يهتم رجال التاريخ العام بالظواهر أو الكليات المشتركة وهي أحداث أسهم في صنعها تكتل بشري معين. أما مؤرخ الأدب فهمه هو أن “يبحث عن الخاص المفرد،”[lv] كأن يسعى على سبيل المثال ” إلى أن يوضح قبل كل شيء خصائص المدرسة الأدبية التي يتحدث عنها أو خصائص الكاتب الذي يدرسه.”[lvi] والهدف من وراء ذلك، الكشف عن “الفارق الذي تتميز به المدرسة أو الكاتب عن غيرهما.”[lvii] في حين نرى التاريخ العام “يتناول نظما أو حركات اجتماعية أو اقتصادية كتيارات عامة أو ظواهر اجتماعية شاملة.”[lviii]
ويستخلص مندور أنواع التأريخ الأدبي من خلال الدراسات التاريخية المنجزة لدى الغربيين، حيث وجد فيها تجاوزا للأسس الزمنية المتبعة في دراسة تاريخ الأدب العربي. فهم يؤرخون أحيانا لفنون الأدب، ويمكن أن يحصل ذلك في أدبنا العربي “لو كتب كاتب مثلا عن تاريخ الرثاء أو الهجاء في الأدب العربي على طول الزمن، فهو عندئذ يكتب تاريخا لنوع منها، وفي الآداب الأوربية عن تاريخ الأدب القصصي أو التمثيلي أو الغنائي.”[lix] كما أنهم يؤرخون لعصور الذوق المختلفة، ويمكن أن نجد له مثيلا في تراثنا الأدبي كأن “يدرس مؤلف نشأة مذهب البديع والصنعة مثلا. ويتتبعه منذ ((مسلم بن الوليد))إلى ((أبي تمام ))، أو مذهب الترسل وعمود الشعر عند ((البحتري)) ومدرسته.”[lx] ويمكن أن يتحقق التأريخ على مستوى التيارات الفنية الأدبية. وقد يحصل ذلك في أدبنا كأن “يدرس مؤلف شعر الفكرة في الأدب العربي كما نشأ عند ((أبي العتاهية ))، ثم ((المتنبي)) و((أبي العلاء))، أو يدرس التصوف أو الأدب الإباحي كما نجده عند(( بشار )) و((أبي نواس)).”[lxi]
وهذا العمل غير وارد عند العرب منذ اهتمامهم بتاريخ الأدب، لذلك يرفض مندور كل المحاولات التأريخية المنجزة من لدن العرب القدامى، فهذا ابن قتيبة صاحب الشعر والشعراء لم يحظ بتقدير لديه، لأنه لم ” يصدر في كتابه عن منهج في التأليف كما سبق أن قررنا، بل إن كل مؤرخي الأدب العربي من القدماء لم يصدروا عن منهج بحيث نستطيع أن نقرر أنه إذا كان النقد قد انتهى به الأمر إلى النضوج والأخذ بمذاهب صحيحة في التأليف والمناقشة والعرض، فإن تاريخ الأدب ظل متخلفا، شأنه في ذلك التاريخ العام كما دونه مؤرخو العرب، فهو أقرب إلى المادة الأولية ومصادر التاريخ منه إلى التاريخ بالمعنى الذي نفهمه اليوم.”[lxii]
لكن مندورا، يستدرك إلى القول بأن هذا العمل التأريخي المماثل للغرب لم يقم به أيضا نقادنا المحدثون أنفسهم” وإذن فليس لنا أن نطلب إلى ابن قتيبة أن يفعل في تاريخ الأدب العربي ما لم نفعله حتى اليوم، وما نزال نجد صعوبة في عمله ومجازفة يخشى أن تفسد الحقائق إذا أخذنا بمناهج ولدتها دراسة آداب مغايرة بطبيعتها التاريخية لأدبنا، وخصوصا إذا ذكرنا أن فكرة الدعوة إلى مدارس بعينها والاقتتال في سبيلها لم تكد تظهر في الأدب العربي حتى كانت دولته قد دالت وأخذت في الانحلال، ومن المعلوم أنه لا الأدب الجاهلي ولا الأدب الأموي قد شهدا معارك فنية كتلك التي نشأت حول البديع وعمود الشعر بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتري في القرن الرابع، وإنما كانوا يقتتلون في تفضيل شاعر على آخر لأسباب كثيرا ما كانت غريبة عن الأدب والفن. وأين هذا من الخصومات الفنية التي قامت حولت مذاهب الأدب المختلفة بأوربا فمهدت لها وأوضحت من مبادئها.”[lxiii]
وهو ما يفيد أن مندورا يراعي الفرق الملحوظ بين بين النقد التاريخي والنقد الأدبي، فكتب النقد التاريخي عبارة عن “كتب علمية، تستند إلى مناهج في البحث التاريخي، أكثر اعتمادها على الأدلة النقلية.”[lxiv] ولكنها تفتقر إلى عنصر الأدب والنقد الأدبي حيث إن “نصيبها من ذلك محدود.”[lxv] وهذا الأمر يتبين بالتحديد من خلال وقوفه على بعض الأبحاث التاريخية التي دارت حول الشاعر العربي القديم أبي العلاء المعري، كما الشأن في دراسات نيكلسون ومرجليوت وسلمون وفون كريمر والراجا كوتى.[lxvi]
صفوة القول:
وصفوة القول، إن تأثر محمد مندور بالأدب الغربي الحديث، كان بهدف تحيين الأدب العربي، لاستخلاص نظرية الأدب، قائمة على مبادئ وأصول عامة، تمتح بشكل معقول من الأدب العربي القديم، فالأدب يجب أن تراعى فيه مقوماته الفنية الجمالية التي تثير لدى المتلقي صورا خيالية أو انفعالات شعورية أو إحساسات فنية، والأدب شعرا كان أم نثرا وجب أن يتناول موقفا إنسانيا أو تجربة بشرية، وعندما يتحقق ذلك يكون المبدع قد فتح آفاقا إنسانية رحبة.
الهوامـش:
– محمد مندور الناقد والمنهج، غالي شكري. ص: 12 [i]
– المرجع السابق، ص: 13/14[ii]
– الأدب ومذاهبه، محمد مندور، ص:7 وما بعدها[iii]
– المرجع السابق، ص: 8 [iv]
– محمد مندور وتنظير النقد الأدبي، محمد برادة، ص:41[v]
– إعجاز القرآن، الباقلاني، ص:419[vi]
– منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، ص:20[vii]
– مفهوم الأدبية في الخطاب النقدي، محمد الواسطي، ص: 13[viii]
– في الميزان الجديد، محمد مندور، ص: 18[ix]
– الأدب وفنونه، محمد مندور، ص: 4[x]
– في الميزان الجديد ص: 99[xi]
– المرجع السابق، ص: 99[xii]
– المرجع السابق، ص: 100[xiii]
– المرجع السابق، ص: 100[xiv]
– المرجع السابق ، ص: 100[xv]
– المرجع السابق، ص: 156[xvi]
– المرجع السابق، ص: 100[xvii]
– المرجع السابق.، ص: 156[xviii]
– المرجع السابق، ص: 148/155[xix]
– بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل ، ص: 53 [xx]
– المرجع السابق، ص: 42[xxi]
– في الميزان الجديد، ص: 156[xxii]
– الأدب ومذاهبه، محمد مندور. ص: 9[xxiii]
– المرجع السابق، ص: 10[xxiv]
– الأدب وفنونه، محمد مندور. ص: 12[xxv]
– المرجع السابق، ص: 12[xxvi]
– المرجع السابق، ص: 12 [xxvii]
– الأدب ومذاهبه، محمد مندور.ص: 13[xxviii]
– المرجع السابق، ص: 14[xxix]
– المرجع السابق، ص:15[xxx]
– المرجع السابق، ص:17[xxxi]
– المرجع السابق، ص:18[xxxii]
– المرجع السابق، ص: 20[xxxiii]
– المرجع السابق، ص: 20[xxxiv]
– المرجع السابق، ص: 21[xxxv]
[xxxvi]– ماثيو أرنولد شاعر وناقد إنجليزي. (1822 ـ 1888)تعلم في أشهر مدارس إنجلترا. عمل أستاذاً للشعر في أكسفورد، فبدأت صلته بالنقد. وللكاتب مؤلفات منها: السلسلتان النقديتان اللتان تحملان العنوان نفسه: «مقالات في النقد» (طبعت الأولى منهما عام 1865, والثانية عام 1888) ومن أهم الموضوعات التي يتكرر ذكرها في هاتين المجموعتين: وظيفة النقد التي يعرّفها آرنولد بالمحاولة المتجردة, أي رؤية الأشياء كما هي عليه, لتعلم أفضل ما عرف في العالم والعمل على تأسيس تيار من الأفكار الصادقة والملهمة. إِن مهمة الدارس الأمين, في رأيه, تقتصر على كشف عوامل التغير في المجتمع وإِقناع الآخرين بصحة ترجمته لهذه العوامل. أما في الشعر فأفضل ما يتميز به ماثيو آرنولد إِثارة الدين ودعوته إِلى اللجوء إِلى الشعر في ترجمة الحياة اليومية حتى يكون الشعر الصادق غذاء وعزاء روحيين للإِنسان. من الموقع الالكتروني: http://ar.wikipedia.org
– الأدب ومذاهبه، محمد مندور، ص: 21/22[xxxvii]
– عشرة أدباء يتحدثون، فؤاد دوارة، ص: 263[xxxviii]
– المرجع السابق، ص:263[xxxix]
– النقد والنقاد المعاصرون، محمد مندور، ص:234[xl]
– عشرة أدباء يتحدثون، فؤاد دوارة، ص: 263[xli]
– المرجع السابق، ص: 263[xlii]
– في الميزان الجديد، محمد مندور، ص: 165[xliii]
– المرجع السابق، ص: 165[xliv]
– المرجع السابق، ص: 165[xlv]
– عشرة أدباء يتحدثون، فؤاد دوارة، ص: 262[xlvi]
– التأثير الفرنسي في أدب محمد مندور، عبد المطلب صالح، ص: 62[xlvii]
– في الميزان الجديد، محمد مندور، ص: 164[xlviii]
– المرجع السابق، ص: 164[xlix]
– المرجع السابق، ص 164[l]
– في الأدب والنقد، محمد مندور، ص: 2[li]
– المرجع السابق، ص: 2[lii]
– في الأدب والنقد، محمد مندور، ص: 2[liii]
– المرجع السابق، ص: 3[liv]
– المرجع السابق، ص: 3[lv]
– المرجع السابق، ص: 3[lvi]
– المرجع السابق، ص: 3[lvii]
– المرجع السابق، ص: 3[lviii]
– المرجع السابق، ص :5[lix]
– المرجع السابق، ص: 5[lx]
– المرجع السابق، ص:5[lxi]
– النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، ص:27[lxii]
– المرجع السابق. ص:28[lxiii]
– في الميزان الجديد، ص: 105[lxiv]
[lxv] – المرجع السابق، ص: 105
[lxvi] – المرجع السابق، ص: 105
لائحة المصادر والمراجع:
1 – الأدب وفنونه، محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة القاهرة، (دون طبعة ودون تاريخ)
2 – الأدب ومذاهبه، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة القاهرة، (دون طبعة ودون تاريخ)
3 – بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت العدد 164، أغسطس 1992 م
4 – التأثير الفرنسي في أدب محمد مندور، عبد المطلب صالح، دار الشؤون الثقافية، بغداد.(دون طبعة) 1997 م
5 – عشرة أدباء يتحدثون، فؤاد دوارة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة، 1996م
6 – في الأدب والنقد، محمد مندور، مكتبة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة1376 هـ.1956 م.
7 – في الميزان الجديد، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،( دون طبعة) يناير2004 .
8 – محمد مندور الناقد والمنهج، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1981 م
9 – محمد مندور وتنظير النقد العربي، محمد برادة، منشورات دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، يناير 1979م
10 – مفهوم الأدبية في الخطاب النقدي، محمد الواسطي، مقال ضمن مجلة آفاق أدبية، مطبعة آنفو برنت، فاس، العدد الأول، 1428هـ -2007م
11 – منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لأبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1986م
12- النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، محمد مندور، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة السادسة، يناير 2007م.
13- الموقع الالكتروني: http://ar.wikipedia.org