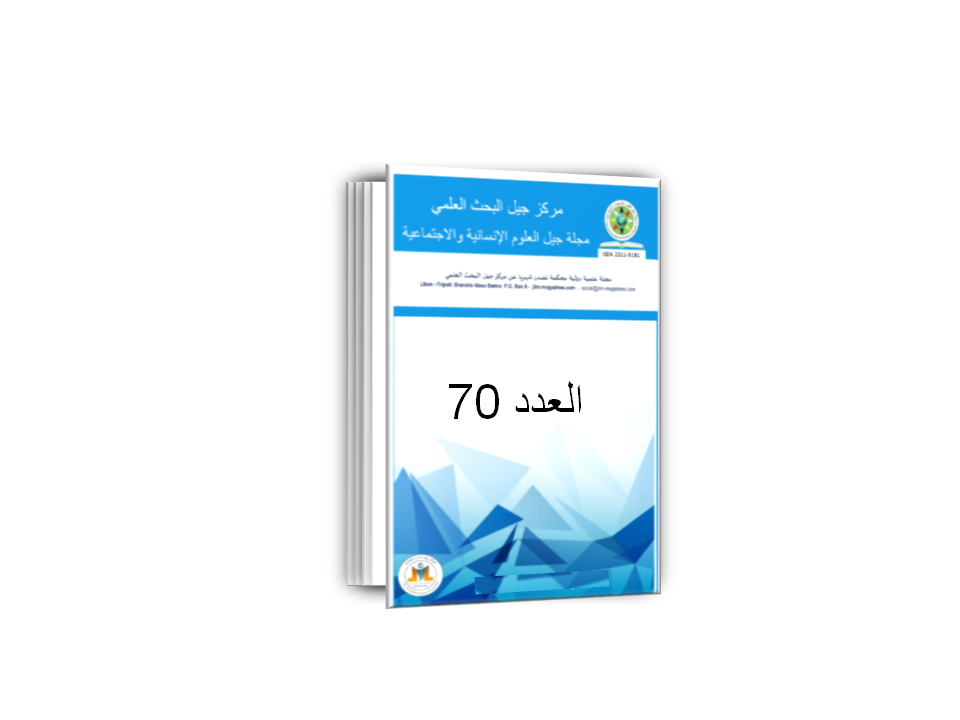
التغير الاجتماعي وأثره في بروز ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر
Social change and its impact on the emergence of the phenomenon of juvenile delinquency in contemporary Algerian society
|
د.رتيبة طايبي/جامعة البليدة 2، الجزائر |
Dr. Ratiba Taibi/Blida 2 University , Algeria |
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 70 الصفحة 113.
ملخص:
قمنا من خلال هذه الورقة البحثية تناول بالتحليل إشكالية العلاقة بين التغير الاجتماعي وبروز ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر، حيث نسعى من خلالها إلى تحديد أهم العوامل المتحكمة في تفاقم مشكلة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري منذ فترة الاستقلال إلى غاية العصر الراهن الذي يشهد تحولات وتغيرات سريعة متعددة الأبعاد عرفتها الساحة الدولية في ظل العولمة. هذا وقد تم التوصل في نهاية الدراسة إلى استنتاجات محورية تؤكد حقيقة مفادها أن التفكك الأسري يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في تنامي ظاهرة جنوح الأحداث، سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، خلال السنوات الأخيرة، والناتج أساسا عن تأثير التغيرات الاجتماعية التي أصابت المجتمع الجزائري المعاصر في عصر العولمة، وهو ما يفسر أن الأسرة تعاني في العصر الراهن من قصور في أدائها لوظيفتها الأساسية في تربية الحدث وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية التي تحصنه من الوقوع في الجنوح.
الكلمات المفتاحية: التغير الاجتماعي، جنوح الأحداث، التفكك الأسري، المجتمع الجزائري المعاصر، العولمة.
Abstract:
Through this research paper, the problematic relationship between social change and the emergence of the phenomenon of juvenile delinquency in contemporary Algerian society was addressed in this paper. So that this study aims to identify the most important factors affecting the aggravation of the problem of juvenile delinquency in Algerian society from the period of independence until the present era. Accordingly, at the end of the study, a conclusion was reached that family disintegration is one of the main factors affecting the growth of the phenomenon of juvenile delinquency in recent years, and mainly resulting from the impact of social changes that have afflicted contemporary Algerian society in the era of globalization, which explains that the family is suffering in the current era Of the failure to perform its basic function of raising a suitable social upbringing for the juvenile.
Key words: social change, juvenile delinquency, family disintegration, contemporary Algerian society, globalization.
مقدمة:يمثل التغير الاجتماعي (Social Change) إطارا مرجعيا لمعظم المشكلات التي تحدث داخل المجتمع لأنه سنة الحياة لا يتوقف أو ينقطع عن استمراره في التحولات والتطورات التي تحدث تدريجيا لدرجة لا يستطيع المرء أن يلاحظ ما يحصل فيه من تحولات وتقلبات، وهناك تغير يحصل في بعض الأحيان بشكل مبرمج ومخطط له سلفا بينما في أغلب الأحيان يقع التغير ويأخذ مساره واتجاهه دون تخطيط مسبق[1]. ومن هذا المنطلق، فكل تغير اجتماعي يحصل داخل المجتمع يفرز مشكلات اجتماعية التي بدورها تنتج مشكلات أخرى تؤدي إلى التفكك الاجتماعي، فمثلا توسع وارتقاء حركة التصنيع تفرز مشاكل اجتماعية عديدة مثل اشتغال الأم خارج منزلها وابتعادها عن تربية أبنائها وانحرافهم وارتفاع معدل الطلاق بسبب استقلالية الزوجة ماليا من خلال عملها، والإدمان على المسكرات والمخدرات بسبب ارتفاع دخل الفرد ورفاهيته، والهجرة ومشاكلها الثقافية والاجتماعية وارتفاع معدل الجرائم بسبب الاختلاف الطبقي، وانتشار ظاهرة التفرد -أو العيش المنفرد- بسبب تسطح العلاقات الاجتماعية وتقطع العلاقات الأسرية وتباعد الأماكن الجغرافية بين أفراد الأسرة الواحدة، وإساءة تربية الأطفال وانتشار ظاهرة جنوح الأحداث وغير ذلك[2].
هذا ونظرا للارتباط الوثيق بين جنوح الأحداث وظروف المجتمع عموما فإن عوامل الجنوح ومسبباته يجب أن لا يبحث عنها فقط لدى الحدث الجانح أو أسرته أو الجماعات الأولية أو الثانوية الأخرى –رغم أهميتها- بمقدار ما يبحث عنها أيضا في التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تحدث في بيئته، لذا انتقل الاهتمام من دراسة شخصية الحدث الجانح إلى دراسة المجتمع الذي نشأ وعاش فيه بكل ما يتضمنه من متغيرات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية. من هنا يعتبر تحليل البناء الاجتماعي للمجتمع أولى الخطوات نحو فهم العلاقة بين التغير الاجتماعي وجنوح الأحداث، وهذا التحليل يجب أن يتناول عوامل وخصائص التغير من جهة والعمليات والعوامل التي تسهم في هذا التغير وتعوقه من جهة أخرى، وأهمها التحضر أو التمدن والهجرة والعوامل السكانية بالإضافة إلى التحولات والتغيرات السريعة المتعددة الأبعاد التي فرضتها ظاهرة العولمة (Globalization)[3]. على أن العولمة قد جاءت بذلك لتعبر عن مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية أسهمت في إحداثها مجموعة من العوامل وبرزت لها العديد من المؤشرات الكيفية والكمية، وفق هذا التصور تكون العولمة ضربا من التغير الاجتماعي الحادث في المجتمعات الإنسانية، فهي لا تعدو أن تكون نقلة من النقلات التي تخطوها المجتمعات الإنسانية نحو مزيد من التعقيد الاجتماعي المادي والاعتماد على التكنولوجيا المعقدة، فهي في ذلك حالة من التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي[4].
ويمكن القول إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي قد جسدت ما أصبح يعرف بالعولمة، هذه الأخيرة أصبحت كيانا له عنفه على بعض الفئات الاجتماعية، ولا نقصد بذلك عنفا خشنا، ولكننا نقصد بالعنف هنا تعريض هذه الفئات لظروف حياة قاسية مما يدفعها أحيانا إلى سلوك طريق الانحراف ومبادلة العنف بعنف مقابل، حيث فرضت هذه التحولات العنف على بعض الفئات الاجتماعية أو أنها بالأحرى تتولى تدريبها وتأهيلها لتسلك طريق العنف، والطفولة والشباب هم الفئات التي ربطت هذه التحولات بينها وبين العنف، وقد أثرت هذه التحولات والتغيرات في تزايد النمو السرطاني للعشوائيات وانتشار أحزمة الفقر في المدن تأسيسا لمجتمعات العنف وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الجهل والأمية[5]، وزيادة معدلات الطلاق والتفكك الأسري واختلاط الأنساب وانفصال الأولاد عن محيط الأسرة بفعل التباين الثقافي والصراع بين الحداثة والتقليدية، وتصدير القيم المدمرة للترابط الأسري والقيم الأخلاقية عبر الرسالة الإعلامية المرئية على وجه الخصوص[6]. وهو ما كان له بالتالي أثرا بالغا في تزايد معدلات الجريمة وجنوح الأحداث بين فئات المجتمع وانتشار المخدرات والإدمان بين الشباب في مجتمعات العالم النامي ومنها على وجه الخصوص المجتمعات العربية[7].
مشكلة الدراسة أهدافها وأهميتها: استنادا إلى ما تقدم تتمحور مشكلة الدراسة المتناولة بالتحليل ضمن هذه الورقة البحثية -والتي جاءت في شكل دراسة نظرية تحليلية- في التساؤل الرئيسي التالي:إلى أي مدى يؤثر التغير الاجتماعي في بروز ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر؟ وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية المحورية نستعرضها على النحو الآتي:- ما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين التغير الاجتماعي والتفكك الاجتماعي؟- ما هي أهم العوامل المؤثرة في بروز ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال؟- هل يمكن اعتبار العولمة عامل مؤثر في تفاقم مشكلة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر؟- ما هي الأساليب الوقائية العملية المقترحة لمكافحة ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر؟ ومن هذا المنطلق، تهدف الدراسة إلى تناول بالتحليل إشكالية العلاقة بين التغير الاجتماعي وبروز ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر، حيث نسعى من خلالها إلى تحديد أهم العوامل المتحكمة في تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري على اختلاف الحقب الزمنية منذ الاستقلال إلى عصرنا الراهن، وذلك في ضوء التحولات والتغيرات السريعة والمتلاحقة متعددة الأبعاد التي صاحبت ظهور العولمة وتداعياتها. كما نسعى أيضا إلى زيادة الوعي لدى الأسرة الجزائرية بضرورة التصدي لهذه المشكلة الاجتماعية وبأهمية الاضطلاع بتحمل مسؤولياتها المناطة بها تجاه أبنائها وهذا من خلال ضمان حمايتهم من مخاطر الاستخدام اللاواعي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة، وتفعيل الرقابة الأسرية من خلال مراقبة سلوكيات الأبناء وإرشادهم وتوجيههم، مع التأكيد على أهمية تعزيز الترابط والتلاحم داخل النسق الأسري واستخدام أسلوب الحوار والتواصل الأسري للتقرب أكثر من الأبناء والتعرف على مشكلاتهم وتفهمهم وتلبية حاجاتهم، بما يكفل بموجب ذلك الوقاية من بلورة السلوك الانحرافي لدى الأبناء، ساعين في خضم كل ذلك إلى استخلاص في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات تتضمن اقتراح بعض الأساليب الوقائية لحماية الأبناء من مخاطر ظاهرة الجنوح والحد من آثارها على المجتمع. هذا وتستمد مشكلة الدراسة أهميتها من كون أن ظاهرة جنوح الأحداث تعد من المشكلات الاجتماعية التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائري المعاصر، وهذا في ظل مجموعة التغيرات الاجتماعية التي طرأت على بنية ووظائف المجتمع والتي مست البنية الأسرية وأثرت في إصابة الخلية الاجتماعية “الأسرة” بما يسمى بالوهن الأسري، إذ انقطعت الروابط الأسرية بين أعضاء الأسرة الواحدة وحصل لها خلل في أدائها للوظيفة الضبطية باعتبارها من الوظائف الاجتماعية الأساسية المناطة بأدائها تجاه أبنائها، والتي تقوم أساسا على فرض الضوابط الاجتماعية وتوجيه وإرشاد الأبناء وضمان لهم تنشئة اجتماعية قويمة. كما تنبع أهمية مشكلة الدراسة من كونها تطرح من جانب مصير مستقبل جيل من النشء يعيش داخل نسق أسري قد أصيب بالوهن الأسري والتصدع، حيث لم تعد الأسرة قادرة على أداء مهامها تجاه أعضائها الأبناء، وتطرح من جانب آخر التساؤل عن مصير مجتمع يعاني من استفحال ظاهرة جنوح الأحداث، مما يدعو إلى ضرورة العمل الجاد لصياغة إستراتيجية وطنية فاعلة للحد من انتشار الظاهرة وبعث الأسرة على أداء وظائفها تجاه الأبناء على أكمل وجه.
1.مفهوم جنوح الأحداث: 1.1.مفهوم الجنوح:الجناح في اللغة معناه الإثم أو الجناية أو الجرم[8]، ويتمثل الجناح في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، ويكمن في ارتكاب الحدث لفعل معاقب عليه ويمس سلامة المجتمع وأمنه مما يعتبر انحرافا حادا أو انحرافا جنائيا، وهو الذي اصطلح على تسميته بالجنوح. ويعد التعريف الذي قدمه الباحث “كوهن” (Cohen) من أكثر التعاريف استخداما حيث يعرف الجنوح بأنه: “ذلك السلوك المنحرف الذي يخرق التوقعات المؤسسية والتوقعات التي يشترك بها جماعة من الأفراد يعترف بها وتكون مشروعة، ولهذا فإن مجموعة الأفعال المتكررة التي يقوم بها الجانح هي التي تميزه عن غيره والتي تستلزم إجراءات قانونية بحقه”[9]. وعرف في هذا السياق عالم النفس “سيرل بيرت” (Cyril Burt) الجنوح على أنه: “حالة تتوافر في الحدث كلما أظهر ميولا مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله أو يمكن أن تجعله موضوعا لإجراء رسمي”[10].
كما يشير جنوح الأحداث إلى تورط المراهقين في سلوك غير قانوني عادة ما يكونون دون سن 18 عامًا وارتكاب فعل يعتبر جريمة، ويُعرف الطفل بأنه جانح عندما يرتكب خطأ مخالفًا للقانون ولا يقبله المجتمع. لكن علماء الاجتماع ينظرون إلى مفهوم جنوح الأحداث على نطاق أوسع من خلال الاعتقاد بأنه يشمل عددًا كبيرًا من الانتهاكات المختلفة للأعراف القانونية والاجتماعية من الجرائم البسيطة إلى الجرائم الجسيمة التي يرتكبها الأحداث[11]. وبحسب أحد الأخصائيين الاجتماعيين فإن “الجنوح يتكون من أفعال انحرافية غير مقبولة اجتماعياً”، ويقترح طبيب نفسي أن السلوك المنحرف هو نشاط ينحرف عن الطبيعي[12]. وبذلك فإن الجنوح بحد ذاته هو عبارة عن سلوك غير ملائم اجتماعيًا من جانب الحدث في المواقف الصعبة والعوامل التي تشكل هذه المواقف الصعبة ترتبط بالظروف العقلية والجسدية والاجتماعية التي تؤثر في قدرة الحدث على التكيف الاجتماعي والتي تشكل سبب الانحراف. هذا وإن كل جريمة حدث هي نتيجة تعقيد الأسباب التي تعود أصول بعضها إلى سنوات قبل ارتكاب الجريمة والبعض الآخر يرتبط أصله بشكل أوضح وفوري بفعل الانحراف[13].
2.1.مفهوم الحدث:تم اشتقاق كلمة حدث من المصطلح اللاتيني « Juvenis » والذي يعني شابًا وأصلًا[14]. هذا وتجمع قواميس اللغة العربية على أن الحدث هو عبارة عن صغير السن فإن ذكر السن يقال حديث السن وغلمان حدثان أي أحداث، وانحراف الأحداث تخصيص نوعي لحالة من السلوك تقترن بصغر السن[15]. أما الحدث في المفهوم الاجتماعي فهو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي، وتتكامل عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام لمعرفة الإنسان لطبيعة عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي، فهو الطفل أو المراهق الذي يصدر عنه سلوك منحرف عن النموذج الوسط الذي تعارف عليه المجتمع[16]. فيرى بعض علماء الاجتماع “إن الحدث الجانح هو ذلك الشخص الذي يقوم بأفعال اجتماعية ينظر إليها على أنها منحرفة أو غير اجتماعية بناءا على المعايير الاجتماعية والقانون السائد ويشترط أن تكون هذه الأفعال مكتسبة من المجتمع”[17].
ويصف بذلك علماء الاجتماع الأحداث المنحرفين على أنهم ضحايا ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والاضطراب الاجتماعي، وذلك لأسباب متعلقة بالانخفاض الكبير لمستوى المعيشة الذي يعيشون فيه[18].
أما تعريف الحدث من الناحية القانونية فقد اختلفت التعريفات حوله تبعا لاختلاف المجتمعات واختلاف التشريعات والقوانين التي ترتكز على البعد الاجتماعي والحضاري لتلك الدول والمجتمعات في تحديد سن التمييز وبلوغ سن الرشد[19]. وفي التشريع الجزائري حدد قانون العقوبات مفهوم الحدث على أنه الذي لم يبلغ 18 سنة، فهو يبلغ سن الرشد الجنائي ابتداء من سن 18 ويبلغ سن الرشد المدني ابتداء من سن 19. ويعترف التشريع الجزائري بمسؤولية محدودة للحدث بمنحه عناية خاصة عندما يرتكب مخالفة للقانون، ويميز هذا التشريع بين فئتين من الأعمار حيث يعتبر الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة بأنهم غير ناضجين وبالتالي غير مسؤولين ولا يمكن معاقبتهم بالسجن. كما يعتبر الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة بأنهم مسؤولون جزئيا عن أفعالهم ويخضعون لنصف العقوبات مقارنة بتلك التي تطبق على الكبار[20].
2.إشكالية التغير الاجتماعي وعلاقته بالتفكك الاجتماعي:يعد التفكك الاجتماعي كأحد أثمان أو تكلفة التغير الاجتماعي إذ أن المجتمع وهو تحت وطأة التغير يفقد بعض أغراضه أو وظائفه أو يكتسب أهدافا أو وظائف جديدة، ودائما ما يتعرض المجتمع وتنظيماته إلى بعض أنواع التفكك أو الانحلال أو سوء التنظيم وقد يبدو ذلك مسايرا بالضرورة للتغير الاجتماعي أو أنه ناتج عنه[21]. وتنطلق تفسيرات مدخل التفكك الاجتماعي من فكرة أن الحياة الاجتماعية تفرض مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد والجماعات وتحدد توقعاتهم وتصرفاتهم في المواقف المختلفة، وهكذا يستمر المجتمع إلى أن تحدث عمليات تغير اجتماعي وتختفي الممارسات القديمة لأنها تصبح بالية وغير مناسبة، في حين لا يحدث تكيف من أعضاء المجتمع مع التغيرات الجديدة ولذلك تظهر مشكلات التفكك الاجتماعي. والخلاصة أن تغير المجتمع يؤدي إلى ظهور مناطق تفكك اجتماعي وهي مناطق موبوءة ينتشر فيها الفقر والجهل والمرض، وهي مناطق ذات طابع انحرافي أي أن المجتمع يعاني نتيجة التغير من تفكك بعض مناطقه المتحولة، ومع وجود الفقر والتميز الاجتماعي تظهر الانحرافات والجريمة، وإن مشكلات مثل الطلاق وكافة صور الجريمة وظاهرة جنوح الأحداث ينظر إليها على أنها مؤشرات على تفكك الأسرة ذلك أنه مع تغير المجتمع تتغير الأسرة ويظهر الانحراف[22].
ويربط عالم الاجتماع الأمريكي “وليام أوجبرن” (William Ogburn) التفكك الاجتماعي بالتغير السريع والواسع الانتشار الذي يصيب أحد أجزاء أنماط أنساق حياة الأفراد الثقافية والاجتماعية، حيث يرى الحياة الاجتماعية من منظور تنظيمي مترابط المفاصل والأجزاء إنما متباين في أشكاله ومختلف في وظائفه ومتكامل في أدائه، علما بأن “أوجبرن” يشبه تنظيم المجتمع بجسم الإنسان. باختصار ينتج التفكك الاجتماعي (الاختلال البنائي والاعتلال الوظيفي) عن تأثير القوى المحدثة والمحركة للتغير الاجتماعي. غني عن البيان من أن المجتمع ما هو سوى تنظيم اجتماعي يتضمن العادات والمؤسسات والجماعات المترابطة بشكل متوازن، بيد أن هذا التوازن يختل توازنه عندما يتعرض لهزات وضربات فواعل التغير، عندئذ تتبلور حالات عديدة من الاعتلالات والتداعيات للعادات الاجتماعية فتظهر تصدعات وتفككات لمفاصل التنظيمات فيختل سكون وركود المجتمع[23].
وعليه، فإن التغير الاجتماعي بصفة عامة والتمدن بصفة خاصة كانا من العوامل المهمة لظهور نظرية التفكك الاجتماعي في بداية هذا القرن في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك في بريطانيا وأماكن أخرى في العالم، وقد استعمل مصطلح التفكك الاجتماعي بطرق مختلفة في علم الاجتماع حيث أنه ليس هناك تعريف عام له، إلا أنه قد تم تعريفه على أنه “هو كل ما يعمل على خلخلة القيم التقليدية والتنظيم الاجتماعي مثل انهيار أو اختفاء قيمة المجموعات الاجتماعية التي توفر العلاقات الشخصية المتينة والصراعات التي تترتب عن التغير الثقافي”. لقد كانت نظرية التفكك الاجتماعي عنصرا أساسيا في النظرية الإيكولوجية التي ظهرت في المجتمع الأمريكي في وقت كان يعرف فيه تغيرا سريعا اقتصاديا واجتماعيا، فالطبيعة الإجرامية لحياة المدينة -وخاصة في مناطقها الفقيرة- أكد عليها كل من الباحثان “كليفورد شو” (Clifford Shaw) و”هنري مكاي” (Henry Makay)، وقد قاما ببحث معمق في شيكاغو ومدن أمريكية أخرى بين سنة 1929 وبداية 1940، محاولين دراسة أسباب المشاكل الاجتماعية بصفة عامة والجريمة وجنوح الأحداث بصفة خاصة وعلاقة ذلك بنمو المدن، وفي دراستهما الإيكولوجية توصل الباحثان “شو” و “مكاي” إلى أن المعدلات العالية لجنوح الأحداث توجد في المناطق المتميزة بالتغير السريع للسكان، سكنات غير لائقة، فقر، أمراض مثل السل، جرائم الكبار والأمراض العقلية. وفي شرحهما لجنوح الأحداث أكدا بأن الصغار كانوا سيكولوجيا أسوياء لكنهم انخرطوا في سلوكيات إنحرافية تحت تأثير ظروف إجرامية في المنطقة التي يعيشون فيها، وهو ما يجعل بذلك جنوح الأحداث يظهر كنتيجة لانهيار الضبط الاجتماعي على مستوى المجموعات التقليدية مثل العائلة والجيرة[24].
هذا وقد رأى في ذات السياق الباحثان “توماس” (W.I.Thomas) و”زنانيكي” (Znaniecki) بأن التفكك الاجتماعي هو مهم جدا لفهم الانحراف وعلى أنه يعد كإجراءات مصاحبة وتمدن المهاجرين من أصل ريفي، ولهذا التفكك مظهران هما انهيار مجموعات القرابة عن طريق ضياع رقابة الآباء على أولادهم وانحطاط قدرة المهاجرين للعمل جماعيا[25]. ولقد أشار الباحث “روبرت بارك” (Robert Park) في كتابه عن “التغير الاجتماعي والتفكك الاجتماعي” إلى تلك العلاقة السببية التي تربط بين هاتين الظاهرتين بقوله: “كل شيء يبدو أنه عرضة لتغير وأي شكل من أشكال التغير ينتج عنه تحول وتبدل يمكن قياسه في روتين الحياة الاجتماعية يميل إلى أن يحطم العادات التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي القائم، وكل وسيلة جديدة تؤثر في الحياة الاجتماعية والنظام الاجتماعي لها تأثيرها الواضح في التفكك، وكل اكتشاف واختراع جديد وكل فكرة جديدة تعتبر شيئا مزعجا ومقلقا، ومن الواضح إذن أن أي شيء يجعل الحياة أكثر جاذبية وتشويقا يعتبر خطرا على النظام القائم”[26].
3.ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال:
أصبحت مشكلة جنوح الأحداث ظاهرة أكثر تعقيدًا وعالمية وإن برامج منع الجريمة ومكافحة جنوح الأحداث هي إما غير مجهزة للتعامل مع الواقع الحالي أو غير موجودة، فلم تفعل العديد من البلدان النامية، ومنها الدول العربية، سوى التقليل من حدة المشكلة ومنها من لم تفعل شيئًا للتعامل مع هذه المشكلة، فضلا عن أن البرامج الدولية قد باتت غير كافية لمكافحة ظاهرة جنوح الأحداث والجريمة[27]. ومنه فقد حاول علماء الاجتماع وعلماء النفس تحليل الظروف التي تؤدي إلى بروز ظاهرة الجنوح ولكن لا يوجد تفسير أو نظرية واحدة تبدو كافية لتفسير كل السلوك المنحرف، ومع ذلك يمكن رؤية بعض النقاط المشتركة في نظريات الانحراف مثل الفقر والمشاكل التي تحدث في العلاقات الأسرية[28]. على أن جنوح الأحداث يحدث بطرق مختلفة وقد يختلف من حيث الدرجة والتكرار والخطورة ويتضمن أشكالًا مختلفة مثل السرقة والنشل وتعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم الجنسية وأفعال العنف وما إلى ذلك. وللجنوح مثل المشاكل الاجتماعية الأخرى جذور معقدة ولا يوجد سبب واحد لجنوح الأحداث بل هناك أسباب لا حصر لها أساسا والتي يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع: أسباب بيولوجية، اجتماعية وبيئية، فسيولوجية وشخصية[29].
ومن هذا المنظور فإن جنوح الأحداث في العالم أجمع يشكل ظاهرة خطيرة وهي تمثل بحق تهديدا متناميا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري بصفة خاصة، وهذه الظاهرة الاجتماعية ليست جديدة على المجتمع الجزائري وإنما عرفها المجتمع منذ الاستقلال[30]، حيث كان لمشاكل التمدن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علاقة متينة بعوامل جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، كما هو مشار إليه في قول الباحث “ريدوح “: “….الهجرة الريفية داخل البلاد وخارجه كون التمدن أكثر سرعة من التصنيع، زيادة السكان وآثار التصنيع على تغير البنى الاجتماعية وذهنية السكان في المناطق الريفية، عمل المرأة في المناطق الريفية وأثر ذلك على دور العائلة….وكل هذه التغيرات هي مصدر لعدم التوازن والانحراف”[31]. فضلا عن ذلك فإن القانون الصادر في 10 فيفري 1972 والمتعلق بحماية الأطفال والمراهقين أكد بأن: “الفقر والهجرة الريفية يشكلان مشكلا في المناطق الحضرية والمتمثل في عدم تكيف الأطفال والمراهقين والذين هم في خطر اجتماعي مع المحيط الذي يعيشون فيه”[32]. وقد جاء في تقرير حول جنوح الأحداث في الجزائر، الذي تم تقديمه في الملتقى الدولي المنعقد في الجزائر العاصمة بتاريخ 12-14 نوفمبر 1974، “أن أسباب جنوح الأحداث في الجزائر تكمن في التغير الاجتماعي الذي زعزع البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة العائلة التي انتقلت من النموذج التقليدي الموسع إلى نموذج العائلة النووية، كما ظهرت طريقة حياة جديدة في المناطق الريفية وتعرض المهاجرين-الريفيون لعملية تمزيق خلال عملية التثاقف في المناطق الحضرية وقد تأثر الشباب كثيرا بهذا التغير”.
وحسب ما جاء في دراسة الباحث “ريدوح” المتعلقة بمقارنة جنوح الأحداث خلال السنوات 1967-1969 في ثلاثة مناطق هي الجزائر العاصمة، تيزي وزو، ورقلة، والتي كانت لها نسب مختلفة في التمدن، تم التوصل إلى أن أكثر المناطق تمدنا وهي الجزائر العاصمة تعد أكثرها انحرافا، مما يفسر أن جنوح الأحداث في الجزائر المعاصرة آنذاك هو في الأساس مشكل حضري. كما بينت الدراسة لحوالي 15229 قضية جنائية من مختلف جهات البلاد لسنتي 1966-1977 أن 45% من هذه القضايا الجنائية كانت متمركزة في منطقة الحضر، وأن 35% منها كانت لها خلفية ريفية و20% منها غير معروف[33].
وفي دراسة أخرى منجزة من طرف وزارة العدل سنة 1979 جاء فيها أنه من خلال تحليل 100472 قضية جنائية لفترة 1965-1978 وجد بأن %61.76 من هذه القضايا كانت متمركزة في مناطق حضرية، و%38.24 منها في مناطق ريفية. وبناء عليه، كانت جرائم الأحداث في الجزائر تتمركز أساسا في المدن الكبرى وهذه حقيقة معترف بها في معظم بلدان العالم، ففي سنة 1976 ارتكب 40% من مجموع جنوح الأحداث الجرائم في أكبر المدن الجزائرية وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطية، والتي كانت تحتوي كلها على أقل من %20 من مجموع السكان خلال نفس السنة، وعرفت الجزائر العاصمة -بارتفاع وكثافة سكانها- تسجيل %20 من مجموع جرائم الأحداث[34]، بينما سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الصغيرة %2 فقط من مجموع جنوح الأحداث.
ونشير في ذات السياق إلى أن الجريمة وجنوح الأحداث تتمركز في ما يسمى بالأحياء القصديرية (Bidonvilles)، أي المناطق المنهارة والمنحلة اجتماعيا والواقعة على ضواحي أو مراكز المدن، فكثير من المجرمين يعيشون في المناطق الكوخية ويرتكبون جرائمهم في وسط المدينة حيث المتاجر والأماكن العامة المكتظة مثل محطات السكة الحديدية والحافلات، وفي أماكن ترفيهية أخرى كالسينما الملاعب الرياضية والمقاهي وغيرها[35]. ويبدو أن جنوح الأحداث في الجزائر بعد الاستقلال قد عرف ارتفاعا معتبرا تبعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمدن التي عرفتها البلاد آنذاك، ومن أجل شرح هذه الحقيقة تم تحليل إحصاءات فترة 1967-1978، أما عن اختيار هذه الفترة فقد كان بسبب توفر المعطيات الإحصائية وأهميتها بالنسبة للتصنيع والتمدن الحاصلان في الجزائر إبان تلك الحقبة التاريخية، فخلال نفس الفترة ارتفعت نسبة الساكنين في المناطق الحضرية من %32 سنة 1967 إلى %42 سنة 1978، أي بارتفاع عددي متمثل في أكثر من %68 من سكان الحضر[36]. وكما هو متوقع مع تطور التمدن ارتفع الطلاق في الجزائر بـــنسبة %65 من مجموع 12500 حالة سنة 1969 إلى 22138 حالة سنة 1978، كما ارتفع بالتوازي مع ذلك جنوح الأحداث خلال نفس الفترة[37].
وفيما يتعلق بحجم وأنماط الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث الجانحين في الجزائر بعد الاستقلال يختلف من نوع لآخر حيث تشكل الجرائم المرتكبة ضد الأموال النسبة الكبيرة من جرائم الأحداث، ويمكن إرجاع ذلك جزئيا إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتغير الاجتماعي السريع الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال، ويطلق أحيانا في الجزائر مصطلح “جرائم الضرورة” (Offences of Necessity) على الجرائم ضد الأموال وهذا نظرا لطبيعتها السببية، وبتعبير آخر ترتكب جرائم السرقات من أجل تلبية ضروريات الحياة وقد أشار في هذا الإطار الباحث “ريدوح” إلى أن %90 من جرائم الأحداث كانت جرائم ضرورة[38]. كما تبين وفقا للمعطيات الإحصائية المتوصل إليها –من خلال الدراسة المرشدة (Pilot Study)- بشأن نوع جرائم الأحداث حسب المناطق لسنة 1978، أن %85 من الجرائم ضد الممتلكات المرتكبة من طرف الأحداث الذكور كانت قد ارتكبت في المناطق الحضرية، بينما حوالي %77 من الجرائم ارتكبت ضد الأشخاص، و%62.5 من الجرائم ضد الأخلاق وقعت في المناطق الريفية. وقد تأثرت أيضا جرائم الإناث في الجزائر آنذاك بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمدن بحيث أن جرائم البنات المرتكبة في المدينة هي أكثر مما ارتكبت في المناطق الريفية[39]، ويمكن إرجاع هذه الحقيقة إلى أن هناك تسامحا أكثر في المدن تجاه المرأة فيما يخص خروجها للتمدرس والعمل والتنزه والتسوق. وقد بينت في هذا الإطار دراسة أجريت في مؤسسة عقابية للنساء في ولاية سطيف، حيث كان %11 منهن من الأحداث، بأن %60 من المحبوسات لهن خلفية حضرية و%40 ذات خلفية ريفية[40].
وقد عرفت بذلك جرائم العنف ضد الأشخاص والممتلكات ارتفاعا بين أوساط النساء وخاصة البنات الأحداث، فطبقا للإحصاءات الجنائية الرسمية لسنة 1976 فإن %6 من مجموع جنوح الأحداث ارتكبت من طرف البنات أغلبهن في سن 16 سنة أو أكثر. ويمكن القول إن عوامل جنوح البنات غير مختلفة بصفة عامة عن عوامل جنوح الأولاد فبناء على التقرير الوطني لوزارة الشبيبة والرياضة لسنة 1978، وجد بأن البنات الجانحات كن ينتمين إلى عائلات منحلة بسبب الطلاق أو غياب الأب حيث اعتبر التفكك الأسري عاملا مهما مرتبطا بجنوح البنات في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال[41].
4.العولمة ومشكلة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري المعاصر:
لقد توالت التغيرات الاجتماعية على المجتمع الجزائري في العقود القليلة الماضية لعل أبرزها ظهور ظاهرة العولمة وما رافقها من ثورة معلوماتية حيث أحدثت تغيرا، بل ثورة، في المواقف والاتجاهات والقيم الإنسانية لدى أفراد المجتمع وبشكل سريع ومروع، إذ يتوقع الكثير من الباحثين أن تتم في عمر الجيل الواحد تغيرات متتالية وعديدة[42]. ففي ظل تلك التغيرات العالمية يلاحظ تراجع دور العملية الثقافية الاجتماعية في المجتمعات التقليدية والنامية، تلك العملية التي كانت الأكثر عراقة وتأثيرا في تطور وإدارة هذه المجتمعات وذلك بسبب الاختراق الكاسح للعمليات الاقتصادية والإعلامية والثقافية، ولقد بات واضحا أن الاختراق الثقافي في ظل العولمة بآلياتها المعاصرة، من أهمها تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الحديثة، يعمل على تهديد منظومة القيم الأصلية ويشكل نوعا من الازدواجية الثقافية التي تجتمع فيها تناقضات الأصالة والمعاصرة، مما يؤدي إلى تهميش أو تغير ملامح الثقافة الوطنية. ويقول في ذلك المفكر “حسن”: “….لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يتصور أن كل ذلك يمكن أن يمر دون أن يحدث خلخلة وتغيرا في كل ما هو سائد مهما كان عزيزا، سواء شئنا أم أبينا، من سلطة الدولة إلى التقاليد الاجتماعية والسياسية إلى الأسرة”[43]. ومما لاشك فيه أن تأثير الثورة الاتصالية على الأسرة –التي تمثل نواة المجتمع- كبير وله جوانبه الايجابية والسلبية، فقد كان لها الأثر الأعظم على ركائز ودعائم المجتمع وبنية الأسرة وقيمها الحياتية، كما ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تدهور القيم وانفلات الأخلاق المجتمعية فيما ضعفت الروابط الأسرية والأواصر المجتمعية بين أفراد المجتمع، وعملت على هدم الأسر وانهيار قوامها وتفكك بيوت الأفراد، وهناك آلاف القصص التي دمرت الأسر نتيجة الاستغلال السيئ لتكنولوجيا الاتصال الحديثة[44].
وعليه فقد كان لهذه التحولات والتغيرات العالمية تأثير على المجتمعات العربية عامة -والمجتمع الجزائري بخاصة- في المجال الاجتماعي بظهور ما يسمى “بالوهن التنظيمي” أي التفكك الاجتماعي والأسري، إذ أصاب الوهن أصغر خلية اجتماعية في المجتمع التي هي الأسرة حيث تقطعت فيها روابط العلاقات بين أفرادها فأصبحت واهية الحبكة ومنقطعة في بعض أواصلها، وتخلت عن أدائها لوظيفتها الضبطية في تنشئة وتوجيه أبنائها حسب القيم والمعتقدات السائدة والموروثة في المجتمع، وقيام بذلك مؤسسات جديدة للتنشئة بأداء هذا الدور التي استطاعت اجتذاب الأجيال الجديدة لها بما تحتويه من جاذبية وإثارة وتشويق، نذكر منها وسائل الإعلام والاتصال الحديثة كالمحطات الفضائية والإنترنت، الأقراص المدمجة…الخ. حيث تبث هذه الوسائل على مدار الساعة ملايين الصور والرموز وبما تحتويه من توجهات سلوكية وقيم ودلالات تنتمي للثقافة الغربية، كما تفيض بالعنف وتعلي من شأن القوة وتعزز قيم الاستهلاك والروح الفردية التي لا تتفق وأسس ومقومات الثقافة العربية الإسلامية. هذا بالإضافة إلى تأثيرها على جوانب التفاعل والتواصل الأسري بين الآباء والأبناء داخل نطاق الأسرة، وذلك نتيجة جلوسهم المستمر أمام الشاشة لساعات طويلة[45]، أو لتصفح شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهاتف النقال أو الإنترنت أو مشاهدة “اليوتيوب”، وتراجع سلطة الأب في السيطرة على سلوكيات الأبناء فيما يتعلق باختيار الأصدقاء أو بالالتزام باللباس المحتشم أو مراعاة الذوق العام[46].
هذا وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين جنوح الأحداث وتصدع الأسرة بسبب الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما وتبين من خلالها أن الإناث أشد تأثرا بالتصدع العائلي من الذكور، كما وجد أن نقص التماسك الأسري في المجتمع الجزائري المعاصر كان عاملا رئيسا في جنوح الأحداث والذي ظهر بشكل بارز في المناطق الحضرية. وقال في هذا السياق “قلواكس” (Gluecks) في دراسة له “إن أهم القوى التي تحدد فيما إذا كان الطفل ينحرف أم لا هي الجو العائلي، ففي البيت وفي نوع علاقة الآباء والأطفال توجد أسباب انحراف أو استواء سلوك الطفل، فإذا لم تتمكن الأسرة من توفير احتياجات الولد المتمثلة في الحب والعطف والأمن والتقبل…فمن المحتمل أن يؤثر ذالك في سلوكه مستقبلا”[47].
غير أنه لا تقف آثار التغيرات العالمية المعاصرة عند هذا الحد بل تضمنت ضعف الحياة الاقتصادية للأسرة الجزائرية بسبب تنامي معدلات الفقر وازدياد معدلات البطالة بين أفرادها، لاسيما الشباب من الجنسين، وضعف الوازع الديني لدى الأبناء وسيطرة الروح الفردية والأنانية على سلوكيات الأبناء مع تزايد معدلات مصروفاتهم الكمالية والترفيهية على حساب ميزانية الأسرة، حيث يرفعون مطالبهم إلى الآباء بإلحاح شديد لمواكبة الموضات وشراء وتبديل الهواتف الخلوية وتصفح الإنترنت…الخ. ناهيك عن تغير النظرة للمرأة في ظل عصر العولمة من خلال وسائل الإعلام فبدعوى الحرية أصبحت المرأة خاضعة لبيولوجيا الجسد تتجسد قيمتها بما تلبس وبما تظهر من مفاتن جسدية وبما تملك من علاقات متحررة مع الجنس الآخر، فقدمها الإعلام الغربي سلعة رخيصة والهدف من وراء ذلك كله إغواء الشباب من جهة وتقديمها كنموذج للفتيات قصد الاقتداء به من جهة أخرى، وقد رافق ذلك كله تهميش متعمد من قبل الإعلام لصورة المرأة المثقفة، العاملة، المنتجة، المربية والمناضلة، يضاف إلى ذلك تراجع وتبدل القيم الأصيلة في الأسرة لتحل محلها قيم ذات صبغة براجماتية نفعية وقيم الربح والكسب والاستهلاك…الخ[48]. وإلى جانب هذا كله تظهر البحوث أن التصدع الخلقي في العائلة يأتي في مقدمة العوامل التي تسوق الحدث إلى الجنوح، فالتجرد من معاني الشرف والفضيلة واختلال السلوك العائلي والمعايير الاجتماعية داخل العائلة، وقيامها بتصرفات منافية للقواعد الخلقية وانعدام القيم الروحية وفقدان المثل العليا وسوء الخلق وعدم الإحساس بمعنى الخطيئة، كلها عوامل تسهل جنوح الأحداث[49].
هكذا يعيش المجتمع الجزائري المعاصر في ظل العولمة مسار عصرنة متسارعة ومضطربة في نفس الوقت بسبب تأثير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وانعكاسات الانفتاح الاقتصادي والثقافي في عصر العولمة، ويقوم هذا المسار على التقدم الذي أحرزه الفرد في استقلاليته وتطور أنماط الاستهلاك وتفرق الأسرة الممتدة، والمطالبة من أجل ترقية شاملة لظروف المرأة وغير ذلك. وفي مواجهة هذه التناقضات يجد الشباب نفسه في حيرة خاصة وأن هذه الوضعية صعبة التسيير لاسيما بالنسبة للبنات اللواتي تستهويهن أنماط السلوك التي تعمل وسائل الإعلام الأجنبية على ترقيتها وتصطدم بما يعتبره الأولياء والمجتمع محرما، ويولد هذا التصادم في الأنماط الثقافية صراعات عائلية التي قد تؤدي بالفتيات إلى قطع أواصر الارتباط بالأسرة وهذا خاصة عندما يتعذر عليهن تلبية حاجاتهن الأساسية ويقعن بعد ذلك في حالة من الخطر الأخلاقي والاستغلال الجنسي، ويشهد على هذا الاتجاه العدد المتزايد للفتيات الأمهات العازبات واللواتي تخلين في غالب الأحيان عن أبنائهن بصفة إجرامية.
وعلى هذا النحو، أثرت تلك المتغيرات العالمية المعاصرة -وغيرها من القوى والمؤثرات التي تتفاعل بدرجات متفاوتة- على الحياة الأسرية الجزائرية، بخلقها جوا اجتماعيا ونفسيا أثر سلبا على تنشئة الأبناء وتكوين شخصياتهم وجوهر ثقافتهم، مما أدى بالتالي إلى تفاقم الانحراف الأخلاقي والسلوكي لدى الأبناء –أطفالا ومراهقين- أو ما يسمى بمشكلة الأحداث الجانحين، على اعتبار أن الاندماج الاجتماعي واحترام الآخرين وعدم اختراق القواعد والمبادئ الأخلاقية ليست وليدة الفطرة بل يكتسبها الطفل داخل الأسرة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية[50]. هذا وتعتبر خصائص الأسرة مثل ضعف مهارات الأبوة، حجم الأسرة، الخلاف الأسري، سوء معاملة الأطفال والآباء المعادين للمجتمع من عوامل الخطر المرتبطة بجنوح الأحداث، وقد وجدت دراسة “ماكورد 1979” (McCord’s) التي أجريت على 250 حدث جانح أنه من بين الأحداث في سن العاشرة كانت أقوى أسباب الإدانات اللاحقة بجرائم العنف راجعة إلى ضعف الإشراف الأبوي والصراع الأبوي والاعتداء الأبوي، بما في ذلك التأديب العقابي القاسي[51]. إن ممارسات الأبوة والأمومة السيئة مثل الافتقار إلى الإشراف الأبوي والإفراط في السماحة والانضباط غير المتسق أو الصارم بشكل مفرط والرابطة الأسرية الضعيفة وعدم القدرة على وضع حدود واضحة داخل النسق الأسري، تمثل عوامل خطر كبيرة في تبني الأبناء للسلوك المنحرف[52].
على أن الرعاية المناسبة للأطفال هي المسؤولية الأساسية للوالدين لأن القيم المعطاة للأطفال ونوع التنشئة التي يتلقونها من والديهم يبدو أنها تحدد إلى حد كبير نمط حياتهم في المستقبل، حيث يساعد الآباء أطفالهم على إنشاء مواقف سلوكية معينة وبمجرد تأسيس هذه المواقف يصعب تغييرها أو قمعها. فالآباء والأمهات هم الذين يغرسون في أطفالهم المواقف والسلوكيات المعادية للمجتمع ويشجعون مثل هذه المواقف على الاستمرار في مرحلة البلوغ، إذ يلعب هيكل الأسرة دورًا مهمًا في تكوين الطفل من خلال توفير الأمن وتنمية قيمه ومهاراته[53]. ذلك أن الجنوح ظاهرة اجتماعية فعلى الرغم من أن العوامل البيولوجية والنفسية والجغرافية والعرقية وغيرها تلعب دورًا مهمًا جدًا في تكوين الجريمة ونوعها فإن تفسير المشكلة يعتمد أساسا على البيئة الاجتماعية، وخاصة الطريقة التي تلعب فيها أصغر وأهم مؤسسة اجتماعية “الأسرة” دورًا مهمًا في التعاون والمواءمة بين السلوكيات المعيارية للأفراد والبيئة الاجتماعية، وهنا يبرز دور الأسرة كعائق أمام جنوح الأحداث فإذا كان من الممكن أن تكون الأسرة عاملاً رئيسياً في بروز جنوح الأحداث فإن الظروف المثلى في الأسرة تسمح بنمو الطفل العقلي والعاطفي والنفسي والاجتماعي ليكون أهم خطوة في منع الجنوح، وبذلك فإن تفكك الأسرة يلعب دورًا مهمًا في جنوح الأحداث[54].
هكذا فقد كان لتلك العوامل العالمية السالفة العرض تأثير إلى حد خطير في انتشار ظاهرة جنوح الأحداث على نطاق واسع في مجتمعنا الجزائري المعاصر خلال السنوات الأخيرة، وتغيرها من حيث الصورة والطبيعة وتطورها بشكل متزايد نحو الإجرام في أشكاله الأكثر خطورة، حيث يتم جلب الشباب المراهقين إلى صفوف الإرهابيين ويتم استغلالهم من طرف هذه القوى الضارة في ضرب استقرار وأمن الوطن بأبنائه[55]. فالملفت للانتباه هو انتشار الظاهرة الإجرامية بين الأوساط الشبابية بشكل أدى إلى تفاقم معدلات جرائم الأحداث إلى مستوى ينبئ بالخطر ويدعو إلى القلق على مستقبل هذه الفئة من رجال الغد حيث الجانح الصغير يشكل مشروع مجرم كبير[56].
5.حقائق وأرقام حول ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري:
يميل جنوح الأحداث في مجتمعنا الجزائري المعاصر إلى أن يصبح أكثر خطورة ويتجلى أكثر فأكثر في أعمال العنف حيث عرفت هذه الظاهرة تطور مستمر في المدن أكثر منه في الريف باعتبارها في ذلك ظاهرة حضرية، وهو ما تؤكده بشكل ملموس تلك المعطيات الإحصائية المستقاة من واقع مجتمعنا التي تشخص واقع جرائم الأحداث في الجزائر لسنوات مختلفة، بحيث تبرز تحاليل قوات الأمن زيادة هامة في جنح العنف. وفيما يتعلق بجنح الضرب والجرح العمدي فقد سجلت مصالح الأمن الوطني زيادة هذه الجنح بنسبة %40 بين سنتي 2001 و2002، في حين أن جنح السرقات لم تتزايد إلا بنسبة %12، وتم تسجيل هذه الظاهرة على مستوى الدرك الوطني وبلغت زيادة نسبة الجنح الخاصة بالضرب والجرح العمدي %76 بين سنة 1998 وسنة 2002، ويتأكد هذا الاتجاه بانتشار العنف في الملاعب وفي المؤسسات الدراسية والميادين العمومية الجماعية ومحطات النقل البري.
وتبين معطيات وزارة العدل بين سنتي 2000-2001 تزايدا معتبرا في الجنح المرتكبة ضد الأشخاص والجنح ذات الصلة بالآداب العامة مقارنة بالجنح ضد الممتلكات[57]. ويحتل جنوح الذكور الدرجة الأولى مقارنة بجنوح الإناث الذي يشكل أقلية فهو لم يتطور كثيرا خلال سنة 2001 إذ لم تحص مصالح الأمن الوطني إلا 325 حالة من بين 9964 حالة مما يمثل أقل من %4، وبلغ عدد الحالات 377 حالة من بين 12.645 في سنة 2002 بنسبة تقل عن %3[58].
وجاء في إحصاءات حديثة تضمنتها تقارير إعلامية على موسوعة (Encarta 2006) أن المكتب الوطني لحماية الطفولة بمديرية الشرطة أحصى خلال السداسي الأول من سنة 2006 حوالي 3925 قضية تورط فيها 5462 حدث منهم 75 فتاة، وفي سنة 2005 تورط في الجرائم 11302 حدث مقابل 10965 حدث سنة 2004. وفيما يخص نوع الجرائم المرتكبة نذكر في مقدمتها جرائم السرقة، الضرب والجرح العمدي، ترويج استهلاك المخدرات، الدعارة، وقد تصل إلى جرائم القتل. وبالرجوع إلى تقارير موسوعة (Encarta 2006) فإن توزيع هذه الجرائم سنة 2006 ومن مجموع 3925 جريمة احتلت فيها الصدارة جرائم السرقة بـ 1760 قضية، ثم الضرب والجرح العمدي بـ 750 قضية، وتحطيم ممتلكات الغير بـ 156 قضية، واستهلاك وحيازة المخدرات بـ121 قضية، وتكوين جمعية أشرار بـ 100 قضية، والاعتداء على الأصول بـ 46 قضية، وأخيرا جرائم القتل بـ 03 قضايا بعدما سجل منها 25 قضية سنة 2005 و 13 قضية سنة 2004[59].
وتشير أحدث أرقام الجريمة لدى فئة الأطفال في الجزائر إلى تنامي ظاهرة جنوح الأحداث خلال سنة 2011، حيث أن ما لا يقل عن 11 ألفا منهم يحالون على العدالة سنويا أي بمتوسط 30 طفلا في اليوم، وفي نفس الاتجاه تشير تقارير مصالح الدرك الوطني أن أكثر من ثلاثة آلاف قاصر -ألقت بهم الأسرة أو المدرسة إلى الشارع- تورطوا في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن. وفي نفس السياق أشار تقرير أنجزته “خلية حماية الأحداث” التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني إلى أن القصر أصبحوا أكثر عنفا من خلال احترافهم لجرائم السرقة بـ 887 قضية تم معالجتها، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي بـ 656 قضية. وما ميز التقرير هو تورط الإناث في مختلف الجرائم المرتكبة إذ تم توقيف 141 فتاة، بينما أخذ الذكور حصة الأسد بتوقيف 3140 طفل مع تورط 151 آخرين بتهمة التحطيم والتخريب.
وتأتي الجزائر العاصمة في مقدمة الولايات التي تعرف جنوح الأحداث تليها سطيف ثم تمنراست، من جانب آخر أصبح القصر مستغلين من قبل شبكات إجرامية تسعى إلى تجنيدهم للإفلات من الرقابة والملاحقة الأمنية، وهو ما يعني توقيف 351 قاصر متورطين ضمن الشبكات الإجرامية الأكثر خطورة، ويعد تحريض القصر على الفسق والدعارة من أكبر قضايا العنف التي سجلت ضد الأحداث بـ 160 قضية يليها الضرب والجرح العمدي بـ 133 قضية ثم السرقة بـ27 قضية[60]. وقد أفاد تقرير أمني رسمي حول ارتفاع نسبي في مستويات تورط الأطفال والقصر في الجرائم والاعتداءات في الجزائر خلال سنة 2013 أن 5729 قاصرا بينهم 244 فتاة تورطوا في أكثر من أربعة ألاف قضية بين جنح وجرائم، وكشف نفس التقرير أن %35 من جرائم الأطفال تتصل بالسرقة وتكوين جماعات أشرار، فيما تورط قصر في 363 قضية تتعلق بجرائم المساس بالعائلة والآداب العامة[61].
بهذا يتأكد وضع جرائم الأحداث التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة في مجتمعنا الجزائري المعاصر، وذلك بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الشرطة القضائية أو المحاكم أو مراكز إيداع الأحداث الجانحين وغيرها من النظم والمؤسسات المعنية بشؤون الأحداث والتي لا تبعث على الارتياح، وهو ما دفع بالسلطات لاتخاذ تدابير عاجلة للتكفل بهؤلاء الأحداث من خلال عزم السلطة التنفيذية بإنشاء ما يزيد عن 15 مؤسسة عقابية جديدة تزود بأجنحـة خاصة لإيداع الأحداث الجانحين[62]. كما نجد التشريع الجزائري قد خص فئة الأحداث بجملة من القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الحدث الجانح، وهذه القواعد المتميزة يغلب عليها الطابع التربوي والتهذيبي أكثر منه عقابي وردعي هادفا من وراء ذلك إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى وخصوصية سنه لإبعاده قدر الإمكان عن سلوك طريق الانحراف والإجرام وعلاجه وتربيته إذا وقع فيها، ويكون بذلك المشرع الجزائري قد أخذ بالأساليب الحديثة لمعاملة الحدث مراعيا من وراء ذلك مصلحة الطفل[63].
خاتمة:من أهم الاستنتاجات التي نخلص إليها من خلال ما سبق عرضه هي أنه ثمة حقيقة لابد أن نؤكد عليها مفادها أن التفكك الأسري يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث، والناتج أساسا تحت وطأة تأثير التغيرات الاجتماعية التي أصابت المجتمع الجزائري المعاصر في ظل عصر العولمة، وما صاحبها من تحولات وتغيرات سريعة ومتلاحقة أهمها ظهور ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي كانت لها انعكاسات على تعقد الحياة الاجتماعية وتحول المجتمع وتطوره في كافة الأصعدة، وبروز بالتالي مشكلات التفكك الاجتماعي والتي من أبرز مظاهرها مشكلة التفكك الأسري. مما يفسر أن الأسرة، وباعتبارها من أهم المؤسسات الاجتماعية، تعاني في العصر الراهن من قصور، أو بالأحرى شلل، في أدائها لإحدى وظائفها الاجتماعية الأساسية المناطة إليها من المجتمع والمتمثلة في تربية الحدث وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية التي تحصنه من الوقوع في الجنوح. على أن الأسرة لم تعد في ذلك قادرة على توفير لأبنائها المناخ الأسري المتماسك والمناسب الذي يتم فيه تحقيق ميولاتهم وإشباع حاجاتهم المادية ومطالبهم الحيوية والنفسية والاجتماعية، وبخاصة ما تعلق منها الشعور بالأمن والاطمئنان والمحبة والقبول والتقدير والرعاية والمعاملة الحسنة من قبل العائلة، فضلا عن الحاجة إلى الخضوع لسلطة أبوية مرشدة تقوم على ضبط ومراقبة تصرفات وسلوكيات الأحداث وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.
وعليه، فمن أجل وقاية الأبناء من الجنوح ينبغي الحرص على تقوية الروابط الأسرية وحماية البيت الأسري من التصدع من خلال إرساء قيم التسامح والتكافل والتواصل والحوار الأسري المتواصل، مع ضرورة اعتماد أسلوب التربية الإسلامية الصحيحة للأبناء وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في البيئة العائلية، وذلك لما لها من أثر كبير في حماية الأسرة من التفكك والانحلال الأخلاقي والروحي والتربوي وتفعيل دورها في تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية صالحة. على اعتبار أن الدين هو العنصر الأساسي في تكوين الأسرة الصالحة فإذا غاب يغيب بذلك الأمن والحماية ويكون الجو الأسري مهيئا لجنوح الأحداث، وهذا من منطلق تلك الحقيقة البديهية المسلم بها كون أن الأسرة تعد الخلية الأولى في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع.
توصيات:هذا، ولكون أن مكافحة ظاهرة جنوح الأحداث يتوقف أساسا على مدى فعالية الأساليب الوقائية المنتهجة لحماية القصر من الجنوح، نقترح عمليا بعض التدابير الوقائية التي من شأنها المساهمة إلى حد ما في حماية النشء الجديد من الوقوع في بؤرة الانحراف والجرائم بشتى صورها على مستوى مجتمعنا وهي على الشكل الآتي:
–العمل على إنشاء منظمات على مستوى الأحياء تتخصص في شؤون الأسرة حيث تتولى القيام بمهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الاستشارات الزوجية ومساعدة الأسر على حل المشاكل التي تعترضها، بحيث تظم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، أطباء ورجال القانون. ومن الضروري أن تأخذ هذه المنظمات الشكل الرسمي بحيث تكون معتمدة تحظى بالدعم التشريعي والمادي للدولة، وذلك حتى يتسنى لها أداء دورها بصورة إيجابية وأكثر فاعلية دون عراقيل تدعيما لدور الأسرة الجزائرية في التكوين السليم للمواطن الصالح.
–القيام بحملات تحسيسية بمخاطر ظاهرة جنوح الأحداث والعوامل المؤدية إليها وذلك بالتكثيف من تنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية، وإعداد برامج إعلامية وتوجيهية عن دور الأسرة في تنشئة ورعاية الأبناء طبقا لأساليب صحيحة، ويكون ذلك بمشاركة المجتمع برمته بما فيه الشركاء الاجتماعيين ونخص بالذكر هنا كل من الإذاعة والتليفزيون والدور الريادي الذي يمكن أن تؤديه المساجد في تنمية الوازع الديني لدى الأسرة الجزائرية، وهذا من خلال التكثيف من الخطب وحلقات الإرشاد الديني المتضمنة لمواضيع مرتبطة أساسا بتحديد الأسس الكفيلة والمناهج الحكيمة – التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف- في وقاية الأحداث من الانحراف والتطرف.
–تحفيز وتوجيه الشباب، أطفالا ومراهقين، لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وذلك لملء وقت فراغهم واستغلال طاقاتهم المكبوتة فيما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة، وحتى لا يكونوا فريسة للسلوكيات الإنحرافية خاصة منها الإدمان على المخدرات. ومن هنا تأتي أهمية الرياضة في امتصاص طاقة الشباب وتوجيهها الوجهة السليمة، وتنمية لياقته البدنية والمحافظة على صحته وقدراته العقلية والنفسية وإظهار مواهبه، وتبرز في هذا المجال مسؤولية المراكز الثقافية والجمعيات والنوادي الرياضية في استقطاب الشباب إليها وذلك بتفعيل دورها في حمايته من مخاطر الجنوح من خلال المبادرة بالتقرب إليه وبعثه على الانضمام إليها لشغل وقت فراغه في أنشطة إيجابية.
–التفكير في إنشاء خلايا إصغاء لصالح الشباب الذين هم في سن المراهقة تحت إشراف أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء تتوزع على مستوى الأحياء، حيث تتولى هذه الخلايا القيام بالإصغاء لمشاكل هذه الفئة التي تقصدها ومتابعة سلوكياتها وتوجيهها وإرشادها، وذلك لكون أن مرحلة المراهقة هي مرحلة حساسة وحاسمة بحيث يكون المراهق أثنائها عرضة لسلوك طريق الانحراف الاجتماعي إذا لم توجه له العناية اللازمة، مما يستدعي مساعدة الراشدين وتوجيهاتهم لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية في حياته دون أن تكون هناك مخاطر جسيمة عليه.
–إعداد مخطط مشروع وطني لمكافحة من جهة ظاهرتي التشرد والتسول المنتشرتين بخاصة بين أوساط الأحداث عبر القطر الوطني، والعمل من جهة أخرى على التكفل الأحسن بهؤلاء الأحداث المتشردين الذين يتسكعون في الشوارع والقطارات، هذا في الوقت الذي يفترض فيه أن يتواجدوا بين مقاعد الدراسة طلبا للعلم أو مراكز التكوين المهني لبناء مستقبلهم المهني كغيرهم من الأحداث الأسوياء، ويتم ذلك عن طريق فتح مراكز خاصة بهذه الفئة من الأحداث المتشردين لإيوائهم فيها والعناية بهم على كل المستويات. مع البحث عن صيغ جديدة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، ونعني هنا مواصلة تعليمهم أو متابعة تكوين معين بمراكز التكوين المهني، بما يكفل بذلك تجنب وقوع هؤلاء الأحداث المتشردين تحت سيطرة الجماعات المتطرفة الإرهابية وعصابات الاجرام.
–ضرورة العمل على صياغة استراتيجية اجتماعية ناجعة وذات فاعلية تقوم على تضافر الجهود والتعاون المشترك ما بين السلطات الرسمية والهيئات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية لمكافحة ظاهرة جنوح الأحداث التي تعد قضية الجميع. على أن يتم استغلال الدراسات الأكاديمية، التي تتضمن بيانات ميدانية وحقائق مستقاة من عمق واقع المجتمع، والمنجزة على مستوى الجامعة في إطار مخابر البحث من قبل فرق البحث المختصة في معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته، على نحو يمكن من خلاله إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة جنوح الأحداث.
قائمة المراجع:1. أحمد زايد، اعتماد علام (2006). التغير الاجتماعي، مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.2. السيد رشاد غنيم (2008). التكنولوجيا والتغير الاجتماعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- سناء الخولي (2011). التغير الاجتماعي والتحديث، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- عبد الخالق يوسف الختاتنة (2006). عوامل جنوح الأحداث في الأردن، أريد-الأردن: منشورات جامعة اليرموك.
- علي محمد جعفر (2004). حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، بيروت: المؤسسة الجامعية النشر.
- علي مانع (2002). جنوح الأحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة -دراسـة في علم الإجـرام المقارن-، الجزائر: دار المطبوعات الجامعية.
- العربي بختي (2014). جنوح الأحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- لمياء محمود لطفي، نزيه عبد الحميد دياب (2016). التربية الأسرية والصحية، ط1، عمان: دار الثقافة.
- معن خليل عمر (2005). علم المشكلات الاجتماعية، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر.
- معن خليل عمر (2004). التغير الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر.
- معن خليل عمر (2005). التفكك الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر.
- مصلح الصالح (2002). التغير الاجتماعي وظاهرة الجريمة، الطبعة الأولى، عمان: مؤسسة الوراق للنشر.
- محمد يحي قاسم النجار (2013). حقوق الطفل بين النص القانوني والواقع وأثرها على جنوح الأحداث، الطبعة الأولى، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
- محمد طلعت عيسى وآخرون، الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين، مصر: مطبعة مخيمر للنشر، دون سنة.
- محي الدين توق، “ظاهرة الأحداث في الأردن”، مجلة دراسات، عمان، الجامعة الأردنية، العدد الثاني، دون سنة.
- منال محمد عباس (2011). الانحراف والجريمة في عالم متغير، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول حماية الشبيبة، “جنوح الأحداث”، الجزائر، الدورة العامة الثانية والعشرون، ماي 2003.
- ماجد الزيود (2011). الشباب والقيم في عالم متغير، الطبعة الثانية، عمان: دار الشروق للنشر.
19.هاني خميس أحمد عبده (2008). سوسيولوجيا الجريمة والانحراف، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
المراجع الإلكترونية:
- خبابة عبد النور (2013). “حتى لا ينحرف أبناؤنا: ظاهرة انحراف الأحداث الأسباب والعلاج”، الندوة الولائية الثانية حول الطفولة، جامعة البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، صحيفة الوطن، فيفري، على الخط: https://www.elwatandz.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 15/09/2016 الساعة 17h00).
- مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنـوان “ظاهرة جرائم الأحداث المشكلة والأسباب”، 2008، على الخط: https://www.ingdz.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 20/09/2016 الساعة 19h15).
- مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنوان “آلاف القصر دخلوا السجن في 2011، 30 طفلا يحالون على العدالة يوميا في الجزائر”، جريدة الخبر، 21 فبراير 2011، على الخط: https://www.ar.algerie360.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 20/09/2016 الساعة 13h25).
- عثمان لحياني: “تقرير أمني جزائري يكشف ارتفاع تورط الأطفال في الجرائم”، 4/12/2013، على الخط:https://www.alarabiya.net (تاريخ وتوقيت الزيارة: 06/10/2016 الساعة 14h10).
- عقيدي أمحمد، “جنوح الأحداث: التشريع الجزائري يرجح التربية والإصلاح”، جريدة الشعب، 15/06/2013، على الخط: https://www.djazairess.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 15/11/2018 الساعة 14h25).
Electronic references in English:
1.Kavita Sahmey(2013). “ A Study on Factors Underlying Juvenile Delinquency and Positive Youth Development Programs”, Master of Arts Development Studies, Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology, India, May, Website: https://ethesis.nitrkl.ac.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H25.
2.Saroj Choudhary(2017). “Juvenile Delinquency: Elementary Concepts, Causes and Prevention”, International Journal of Humanities and Social Science Research, Vol. 3, Issue 5 May, Website: https://www.socialsciencejournal.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H30.
3.K. M. Banham Bridges, “Factors Contributing to Juvenile Delinquency”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 17, Issue 4 February, Website: scholaritycommons.law.northwestern.edu. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H10.
4.World Youth Report(2003). ”Delinquent and Criminal Behaviour”, Website: https://www.un.org/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H20.
5.Mary E. Murrell, David Lester (1981). “Introduction to Juvenile Delinquency”, Macmillan Publishing CO. INC. New York . Website: https://www.researchgate.net/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H25.
6.W. Healy, “The Individual Delinquency”, P.218. Website: https://www.shodhganga.inflibnet.ac.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H35.
7.Michael Shader, “Risk Factors for Delinquency: An Overview”, Office of Justice Programs, US Department of Justice, Website: https://www.ncjrs.gov/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H35.
8.Julie Savignac (2009). “Families, Youth and Delinquency: The State of Knowledge and Family-Based Juvenile Delinquency Prevention Programs”, Research Report, Website: https://www.publicsafety.gc.ca/pdf. Date and time of the visit:12/09/2020.17H45.
9.Rosemary Kakonzi Mwangangi (2019). “The role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency”, open Journal of Social Sciences, Scientific Research Publishing, Website: https://www.researchgate.net/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H20.
10.Hassan Mohammadi Nevisi (2019). “Family Impact on Social Violence (Juvenile Delinquency) in children and Adolescents”, Research Article, SM Journal of Forensic Research and Criminology, Website: https://www.jsmcentral.org/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H30.
[1]معن خليل عمر (2005). علم المشكلات الاجتماعية، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر، ص29.
[2]معن خليل عمر (2004). التغير الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر، ص.ص.274، 275.
[3]مصلح الصالح (2002). التغير الاجتماعي وظاهرة الجريمة، الطبعة الأولى، عمان: مؤسسة الوراق للنشر، ص.16.
4السيد رشاد غنيم (2008). التكنولوجيا والتغير الاجتماعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص.12.
[5]هاني خميس أحمد عبده (2008). سوسيولوجيا الجريمة والانحراف، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص.ص.19-21.
[6] أحمد زايد، اعتماد علام (2006). التغير الاجتماعي، مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، ص.276.
[7]هاني خميس أحمد عبده (2008)، مرجع سابق، ص.ص.19-21.
[8]سناء الخولي (2011). التغير الاجتماعي والتحديث، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص. 175.
[9]عبد الخالق يوسف الختاتنة (2006). عوامل جنوح الأحداث في الأردن، أريد-الأردن: منشورات جامعة اليرموك، ص.12.
[10]محمد يحي قاسم النجار (2013). حقوق الطفل بين النص القانوني والواقع وأثرها على جنوح الأحداث، الطبعة الأولى، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص.63.
[11]Kavita Sahmey(2013). “A Study on Factors Underlying Juvenile Delinquency and Positive Youth Development Programs”, Master of Arts Development Studies, Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology, India, P.P.3, 4. Website: https://ethesis.nitrkl.ac.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H25.
[12] Saroj Choudhary(2017). “Juvenile Delinquency: Elementary Concepts, Causes and Prevention”, International Journal of Humanities and Social Science Research, Vol. 3, Issue 5 May, P.P.52-54. Website: https://www.socialsciencejournal.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H30.
[13]K. M. Banham Bridges, “Factors Contributing to Juvenile Delinquency”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 17, Issue 4 February, P.531. Website: scholaritycommons.law.northwestern.edu. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H10.
[14]Kavita Shamey, Op.cit, P.P.3, 4.[15]عبد الخالق يوسف الختاتنة (2006)، مرجع سابق، ص.12.
[16]محمد طلعت عيسى وآخرون، الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين، مصر: مطبعة مخيمر للنشر، دون سنة، ص.49.
7حمد يحي قاسم النجار (2013)، مرجع سابق، ص.58.
1محي الدين توق، “ظاهرة الأحداث في الأردن”، مجلة دراسات، عمان، الجامعة الأردنية، العدد الثاني، دون سنة، ص.10.
[19]علي محمد جعفر (2004). حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، بيروت: المؤسسة الجامعية النشر، ص.2.
[20]عبد الخالق يوسف الختاتنة (2006)، مرجع سابق، ص.12. [21]معن خليل عمر (2004)، التغير الاجتماعي، مرجع سابق، ص.ص.274، 275. 5منال محمد عباس (2011). الانحراف والجريمة في عالم متغير، مصر: دار المعرفة الجامعية، ص.ص.52، 53. [23] معن خليل عمر (2005). التفكك الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان: دار الشروق للنشر، ص.ص.65-67.[24] SHAW.C.R and Mckay, H. D. (1931). ” Social Factors in Juvenile Delinquency”, vol.2 Washington D.C., National Commission on Low Observance and Enforcement, P.P.99, 100,
نقلا عن علي مانع (2002). جنوح الأحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة -دراسـة في علم الإجـرام المقارن-، الجزائر: دار المطبوعات الجامعية، ص.ص.39-41. [25] Fine Stone (1976). “Victim of Change”, London, Green Wood Press, P.88, نقلا عن علي مانع (2002)، مرجع سابق، ص.40. [26] معن خليل عمر (2004)، التغير الاجتماعي، مرجع سابق، ص.ص.274، 275.[27]World Youth Report (2003). ”Delinquent and Criminal Behaviour”, P.189. Website: https://www.un.org/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H20.
[28]Mary E. Murrell, David Lester (1981). “Introduction to Juvenile Delinquency”, Macmillan Publishing CO. INC. New York, P.2. Website: https://www.researchgate.net/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H25.
5W. Healy, “The Individual Delinquency”, P.218. Website: https://www.shodhganga.inflibnet.ac.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H35.
[30]خبابة عبد النور (2013). “حتى لا ينحرف أبناؤنا: ظاهرة انحراف الأحداث الأسباب والعلاج”، الندوة الولائية الثانية حول الطفولة، جامعة البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، صحيفة الوطن، فيفري، على الخط: https://www.elwatandz.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 15/09/2016 الساعة 17h00). [31]المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول حماية الشبيبة، “جنوح الأحداث”، الجزائر، الدورة العامة الثانية والعشرون، ماي 2003، ص.ص.18،19.[32]RIDOUH, B. et al : «Approche Epidémiologique Psychiatrique de La Criminalité Algérienne à travers une tranche d’expertises Médicolégal de 1963-1968», Revue Pratique de Psychologie de La vie Social et d’Hygiène Mentale, Vol.3, P.P.135-170,
نقلا عن علي مانع (2002)، مرجع سابق، ص.175. [33]وزارة العدل 1972، ص.209، نقلا عن نفس المرجع، ص.175. [34] RIDOUH, B. et al, Op.cit., P.P.135-170. [35]وزارة العدل 1974-1977، حزب جبهة التحرير الوطني، 1980، نقلا عن علي مانع (2002)، مرجع سابق، ص.184. [36]مجلة الشرطة رقم 1- 1955، رقم10- 1978، نقلا عن نفس المرجع، ص.184. [37]وزارة التخطيط 1980، نقلا عن نفس المرجع، ص.186. [38]وزارة العدل 1979، نقلا عن نفس المرجع، ص.186. 6وزارة العدل 1980، نقلا عن نفس المرجع، ص.ص.100،101. [40] RIDOUH, B. et al, Op.cit., P.P.135-170. [41]بن معيوف (1982)، نقلا عن علي مانع (2002)، مرجع سابق، ص.198. [42]تقرير وزارة الشبيبة والرياضة 1978، نقلا عن نفس المرجع، ص.200. 4ماجد الزيود (2011). الشباب والقيم في عالم متغير، الطبعة الثانية، عمان: دار الشروق للنشر، ص.ص.89، 105. 5لمياء محمود لطفي، نزيه عبد الحميد دياب (2016). التربية الأسرية والصحية، ط1، عمان: دار الثقافة، ص.ص.203-240. 1ماجد الزيود (2011)، مرجع سابق، ص.105. [46]معن خليل عمر (2005)، علم المشكلات الاجتماعية، مرجع سابق، ص.138. 3علي مانع (2002)، مرجع سابق، ص.ص.44-57. 1معن خليل عمر (2005)، علم المشكلات الاجتماعية، مرجع سابق، ص.138. 2العربي بختي (2014). جنوح الأحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص.128. [50]معن خليل عمر (2005)، علم المشكلات الاجتماعية، مرجع سابق، ص.74.[51] Michael Shader, “Risk Factors for Delinquency: An Overview”, Office of Justice Programs, US Department of Justice, P.6. Website: https://www.ncjrs.gov/pdf. Date and time of the visit:12/09/2020.17H35.
[52] Julie Savignac (2009). “Families, Youth and Delinquency: The State of Knowledge, and Family-Based Juvenile Delinquency Prevention Programs”, Research Report, P.5. Website: https://www.publicsafety.gc.ca/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H45.
[53]Rosemary Kakonzi Mwangangi (2019). “The role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency”, open Journal of Social Sciences, Scientific Research Publishing, p.55. Website: https://www.researchgate.net/pdf. Date and time of the visit:12/09/2020.17H20.
[54] Hassan Mohammadi Nevisi (2019). “Family Impact on Social Violence (Juvenile Delinquency) in children and Adolescents”, Research Article, SM Journal of Forensic Research and Criminology, P.2. Website: https://www.jsmcentral.org/pdf. Date and time of the visit:12/09/2020.17H30.
5المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص.ص.67،68. 6مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنـوان “ظاهرة جرائم الأحداث المشكلة والأسباب”، 2008، على الخط: https://www.ingdz.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 20/09/2016 الساعة 19h15). 1المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص.ص.41،43.2مذكرة نقابة الشركة الوطنية للسكك الحديدية (2002)، نقلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص.ص.43-45.
[59]ظاهرة جرائم الأحداث المشكلة والأسباب”، مرجع سابق.1مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنوان “آلاف القصر دخلوا السجن في 2011، 30 طفلا يحالون على العدالة يوميا في الجزائر”، جريدة الخبر، 21/02/2011، على الخط: https://www.ar.algerie360.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 20/09/2016 الساعة 13h25).
2عثمان لحياني: “تقرير أمني جزائري يكشف ارتفاع تورط الأطفال في الجرائم”، 4/12/2013،على الخط:https://www.alarabiya.net (تاريخ وتوقيت الزيارة: 06/10/2016 الساعة 14h10). [62]ظاهرة جرائم الأحداث المشكلة والأسباب”، مرجع سابق.[63]عقيدي أمحمد، “جنوح الأحداث: التشريع الجزائري يرجح التربية والإصلاح”، جريدة الشعب، 15/06/2013، على الخط: https://www.djazairess.com (تاريخ وتوقيت الزيارة: 15/11/2018 الساعة 14h25).


