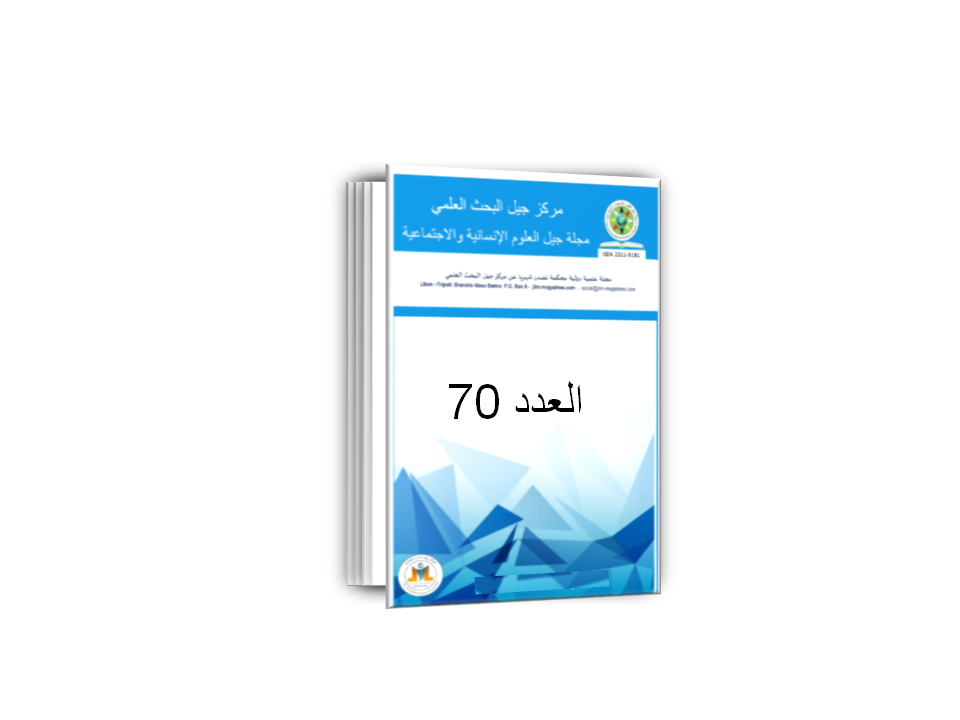
قراءة في التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
An interpretation of Educational Guidelines and Curricula of Arabic Language Teaching in the Secondary Institutions
ط. د. ابتسام بلفضة/ كلية علوم التربية، المغرب
Btissame Belfadda PhD Student at faculty of Education Sciences; Morocco
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 70 الصفحة 9.
ملخص:
يروم هذا البحث تقديم قراءة موجزة حول التوجيهات التربوية، والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي بالمملكة المغربية وكذلك الإحاطة بجوانب الإصلاح التي عرفتها تلك التوجيهات استجابة للمقاربة الجديدة المعتمدة في إصلاح نظام التربية والتكوين، وانسجاما مع ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
الكلمات المفتاحية: الميثاق الوطني للتربية والتكوين- التوجيهات التربوية –الرؤية الاستراتيجية .
Abstract :
This research aims to provide a brief interpretation of the educational guidelines and curricula of Arabic Language Teaching in the secondary institutions of the Kingdom of Morocco. Besides, the study seeks to unveil the different reform aspects that came in response to the new approach adopted in reforming education and the training system, and in line with the stipulations of the National Charter for Education and Training.
Keywords: The National Charter for Education and Training-Educational guidance- Strategic vision.
مقدمة:فرض واقع التأزم الذي طبع النظام التعليمي في المغرب منذ منتصف الثمانينات، أو أكثر، التفكير الجدي في إصلاح جذري في النظام التعليمي، والتربوي المغربي. وكذا دعم السبل الكفيلة برفع جودة التربية والتكوين. فكان بذلك ظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين في أكتوبر من سنة 1999، والذي تمت صياغته من قبل لجنة ملكية خاصة تكونت من هيئات تربوية، ونقابية، ومهنية، وسياسية… التي عينها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، و التي عزز مقتضياتها جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي في أكتوبر 1999.
وقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على مجموعة من الإجراءات التي تم العمل على تنفيذها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000.وباعتبار ذلك الميثاق مشروعا إصلاحيا يشمل نظام التربية والتكوين بشكل كلي، فقد خص مجموعة من المجالات، وأسس لدعامات عدة من شأنها تحقيق التغيير، والمعالجة والإصلاح التام في النظام التعليمي.
وبذلك صمم الميثاق الوطني للتربية والتكوين عبر تقسيمه لقسمين رئيسيين متكاملين على النحو التالي:
- “[1]القسم الأول: تضمن المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين، والغايات الكبرى المتوخاة منه، وحقوق وواجبات الشركاء، وشكل التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح.
- القسم الثاني: يحتوي على ستة مجالات خاصة من أجل التجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير وهي:
- نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي.
- التنظيم البيداغوجي.
- الرفع من جودة التربية والتكوين.
- الموارد البشرية.
- التسيير والتدبير.
- الشراكة والتحويل .”1
وقد جاءت هذه المجالات كتوفيق مدروس بين ما هو مرغوب فيه، وبين ما هو ممكن التطبيق. واقتراح مجموعة من الدعامات الخاصة بتلك المجالات كتدبير من شأنه تحقيق غاية التغيير، وقد تم بالموازاة مع ذلك صياغة مقترحات مساعدة على ذلك.
ويعد المجال الثالث الذي يهدف إلى الرفع من جودة التربية والتكوين من أهم المجالات التي تصب في صلب الإصلاح، والتي استهدفها الميثاق الوطني وخصها بالمعالجة التامة. وقد تأسست على دعامة أساسية وهي: مراجعة البرامج، والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية باعتبار أن هذا المجال هو عماد المنظومة التعليمية، وبناء عليه يمكن تقويم النتائج المتوصل إليها.
1.السياق العام لمراجعة منهاج اللغة العربية
عملت وزارة التربية الوطنية على مراجعة منهاج اللغة العربية في السلك الثانوي التأهيلي على غرار باقي الأسلاك الدراسية تماشيا مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه، ومع بوادر التطوير، والتجديد الذي تعرفه المنظومة المجتمعية، الذي فرضه مطلب المنافسة مع باقي المجتمعات المتقدمة في المجال.
فلا يمكن فصل الموضوعات التي يتضمنها منهاج اللغة العربية عما يمكن أن يسهم في الاندماج مع المحيط الخاص، أو العام. “كما تمتح هذه المقررات الجديدة بمحتوياتها من الأطروحة اللسانية الوظيفية ذات البعد التداولي التي تربط المقام بالسياق التواصلي، وخاصة تعليم اللغات وتلقينها بدل الاعتماد على الطرائق التقليدية في التدريس، والتلقين. كما استفادت من أحدث التطورات، والمنجزات الإعلامية، والاتصال الرقمي، والمعلوماتي. فضلا عن التقدم الهائل الذي تحقق على مستوى تقنيات الطباعة، والتشكيل، والتغليف، والطبع، والنشر.”[2]
وقد ارتبط مطلب مراجعة منهاج اللغة العربية بما عرفه المغرب أيضا من إصلاحات شملت مجموعة من الميادين سواء السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وعليه لم تنفصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية عن عالم التغيرات التي شهدها المغرب، والعالم ككل فكانت بذلك ملزمة بمواكبة كل تلك التغيرات، وأن تنحى منهج التجديد، والمراجعة لكل المناهج التعليمية بشتى أنواعها، منها منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي.
- المدخل العام لمراجعة منهاج اللغة العربية لسلك الثانوي التأهيلي
حتمت ظروف مراجعة منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي اعتماد مقاربة جديدة تراعي مختلف التحولات، والتطلعات المجتمعية كل ذلك “بشكل يجعلها تحقق نقلة نوعية من مفهوم البرنامج التقليدي، نحو مفهوم المنهاج التربوي كخطة عمل تربوية، وتكوينية تساعد في بناء مواطن مستوعب لمختلف قضايا مجتمعه متمكنا من الكفايات الثقافية والمنهجية، والتكنولوجية، والتواصلية التي تؤهله للاندماج والمشاركة، والإنتاج والإبداع والمساهمة في بناء صرح التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد“[3]
فما المداخل والمرتكزات التي تأسست عليها المقاربة الجديدة في مراجعة منهاج اللغة العربية الخاص بسلك الثانوي التأهيلي؟ وكيف تم تصريف مضمونها بيداغوجيا، وديدكتيكيا في مختلف عناصر المنهاج؟
1.2.المداخل والمرتكزات
أولا: مدخل الكفايات
فشل المناهج التقليدية في إعداد متعلم مؤهل للانخراط في مجتمعه والمشاركة في بنائه فرض كما قلنا التفكير في اعتماد منهاج تربوي قادر على إعداد متعلم يسهل عليه تقلد المسؤولية، وإنجاز المهام الخاصة بمجموعة من المجالات خارج أسوار المدرسة. أي الكفاية أو القدرة على الإنجاز بشكل عام.
إذن المنهاج الجديد يسعى إلى الانتقال من بنقل المعارف الجاهزة للمتعلمين إلى تمهيرهم واقدارهم على استثمار مكتسباتهم في وضعيات جديدة مرتبطة بحياتهم اليومية. “وتحدد الوثيقة الإطار لمراجعة المناهج 2001(ص:6) أنواع الكفايات المنتظر تنميتها من طرف مختلف المواد الدراسية في الآتي:
جدول (1): أنواع الكفايات المنتظر تنميتها من طرف مختلف المواد الدراسية
| أنواع الكفايات | مضمونها |
| الاستراتيجية | تستهدف التعبير عن الذات والتموقع في الزمان والمكان. والتموقع بالنسبة للآخر والمؤسسات المجتمعية، والتكيف معها ومع البيئة، وتعديل المنتظرات والاتجاهات والسلوكات. |
| التواصلية | تستهدف التمكن من إتقان مختلف أنواع التواصل والخطاب وإتقان اللغات |
| المنهجية | تستهدف اكتساب منهجيات التفكير والعمل وتنظيم الذات والوقت وتدبير التكوين الذاتي |
| الثقافية | تستهدف تنمية الرصيد الثقافي للمتعلم، وتوسيع دائرة إحساسه وتصوراته ورؤيته للعالم وللحضارة والبشرية في تناغم مع تفتح شخصيته، وترسيخ هوياته كمواطن مغربي… |
| التكنولوجية | تعتمد أساسا القدرة على رسم وإبداع وإنتاج منتجات متنوعة، وتطويرها وتكييفها مع الحاجات.[4] |
ثانيا: مدخل القيم
تعتبر القيم إحدى مؤشرات الرقي في مختلف المجتمعات. وباعتبار القيم مرتبطة بشكل أساسي بسلوكيات الأفراد فإن أهم فضاء يتم فيه التشبع بها، والتربية عليها هو المؤسسة المدرسية. وقد تم تلخيص مرتكزات القيم الأساسية داخل الميثاق الوطني للتربية والتكوين بحيث تشمل القيم الدينية، والحضارية ، والأخلاقية.
وبهذا تم تكييف مرتكزات القيم تلك حسب الحاجات الشخصية للمتعلمين والخاصة بمجال القيم فيما يلي:
“-إعمال العقل واعتماد التفكير النقدي والاستقلالية تفكيرا، وممارسة.
-المبادرة والإبداع والتنافسية الإيجابية والإنتاجية.
-الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في المدرسة والحياة.
-التفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي والبيئة الطبيعية والموروث الثقافي والحضاري.”[5]
ثالثا: مرتكزات الأجرأة
تتأسس أجرأة المنهاج التربوي الخاص بالسلك الثانوي التأهيلي على مجموعة من المرتكزات، منها ما هو متعلق بالمتعلمين حيث كان من بين الأولويات احترام خصائص الفئة المستهدفة ، وجعل المتعلمين، أيضا قطب رحى العملية التعليمية، التعلمية.
ومرتكزات أخرى تتعلق بديدكتيك المادة بحيث يتم فيها احترام المرجعيات التي تتأسس عليها المادة، وكذا المنهجية الخاصة بها. كل ذلك، دون إغفال ضرورة ربط الجسور بين مختلف المواد الدراسية حتى يتسنى للمتعلمين امتلاك كفايات ممتدة خارج أسوار المدرسة يمكنها أن تسعفهم في الممارسات الحياتية العلمية منها أو المهنية.
2.2. طرائق وأشكال العمل الديدكتيكي
تظهر لنا داخل جماعة أي قسم مجموعة من الفوارق التي يعاينها الأستاذ بصريا، حتى وإن كان أمام مجموعة من المتعلمين المتشابهة أعمارهم، أو المتقاربة. تلك الفوارق قد تكون متعلقة بجنس المتعلمين( ألجنس الذكور النسبة العليا أم للإناث؟) أو متعلقة باختلاف بنياتهم الجسمانية ، ونوع التنشئة الاجتماعية، ومستوى التربية…
هذه الاختلافات أو الفروق الفردية قد تكون أساس بروز فروق فردية أخرى متعلقة بمستوى المكتسبات الخاصة بالمراحل السابقة من التعليم، وأيضا لنوع الاستجابة للطرق (للطرائق) والوسائل والأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية التعلمية.
وبناء عليه، فإن الأستاذ ملزم برصد الفروق الفردية التي تكشف قدرات، ومهارات التلاميذ، ومستويات اكتسابهم للكفايات المستهدفة ليبني على إثرها الوضعيات التعليمية التعلمية وما يناسبها من طرائق، ووسائل مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتعلم هو صلب العملية التعليمية التعلمية . بحيث يتم تجاوز كل الممارسات التقليدية التي تتأسس على التلقين، والإلقاء، واعتماد استراتيجية توزيع الأدوار والمهام بين أقطاب العملية التعليمية، التعلمية وذلك كله “قصد تمكين التلميذ من الثقة في النفس والمشاركة الفعالة والشعور بالمسؤولية، والقدرة على تدبير تعلمه، وتدبير الزمن. وهذا يستدعي إعطاءه الفرصة في التفكير فيما يتعلم، وكيف يتعلم، ولماذا يتعلم”[6].
3.منطلقات بناء منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي
يستمد برنامج مادة اللغة العربية أسسه بناء على ما جاء من مبادئ سطرت في الكتاب الأبيض، تحقيقا لمقاصد الميثاق الوطني للتربية والتكوين. يعد أهمها، اعتبار التربية على القيم وتنمية الكفايات والتربية على الاختيار مدخلا أساسيا لبناء المناهج الدراسية. والاعتماد على مرجعية تربوية تتجاوز التعليم الذي يبنى على أساس التلقين، وإنما على أساس التعلم الذاتي من أجل إقدار المتعلمين على تنمية قدراتهم، ومهاراتهم وذلك حتى يتسنى لهم توظيفها في وضعيات حياتية مختلفة.
ويعد الهدف الأسمى في بناء منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي، هو خلق الوعي بأهمية اللغة العربية وآدابها، وبقدرتها على استيعاب مختلف المعارف الحضارية، والثقافية وتوظيفها تواصليا.
وبهذا تتلخص الأسس التي تؤطر بناء المنهاج فيما يلي:
“-أسس فلسفية: هي مجموعة من القناعات، والتصورات العامة التي تسير وفقها العملية التعليمية، التعلمية، وكذا المواقف المحددة من المتعلمين وما ينبغي أن يتعلموه أكثر من غيرهم.
-أسس اجتماعية-اقتصادية: هي مجموعة من الخصائص الحضارية، والمقومات الاقتصادية للمجتمع عبر صيرورته التاريخية المتجذرة في تاريخه السياسي والاقتصادي وتراثه ، وقيمه الدينية والأخلاقية، وتفاعله مع الحضارات المعاصرة له.
– أسس سيكولوجية تربوية: هي مجموعة من المعطيات المتصلة بالخصائص السيكولوجية كطبيعة المرحلة العمرية للمتعلم وحاجاته المختلفة والأساليب، والتقنيات التي تساعده على التعلم بدافعية وفعالية، وتنظيم الخبرات التعليمية وفق مستواه العمري والعقلي.”[7]
4.أسس ومبادئ اختيار مضامين برنامج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
روعي في اختيار مضامين برنامج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي الفئة المستهدفة في هذه المرحلة، ومجموع الكفايات التي يفترض أن تكون قد اكتسبتها في نهاية هذه المرحلة بشكل يجعلها قادرة على استكمال الدراسة الجامعية، والانخراط في الحياة المجتمعية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية بشكل يستجيب لحاجات المجتمع المغربي، وتطلعاته. وتشبع تلك الفئة أيضا بالقيم الإسلامية والحضارية. وتمكنها أيضا من منهجيات التفكير الخاصة بالتحليل، والبرهنة، والحجاج، والنقد إلى غير ذلك من القدرات، والكفايات التي تستجيب لخصائصها.
يعتبر قسم الجذع المشترك مرحلة هامة لتثبيت مكتسبات المرحلة الثانوية الإعدادية ودعامة أساسية لترسيخ مكتسبات جديدة من شأنها تأهيل المتعلمين لاستكمال دراستهم في سلك البكالوريا.
فبالنسبة للجذع المشترك للآداب والإنسانيات فقد تم التركيز على إكساب المتعلمين في هذه المرحلة مهارات متنوعة في التعبير والإنشاء، والارتقاء بالقراءة المنهجية للنصوص ما من شأنه السماح لهم بامتلاك وعي أكبر بمقاصدها” وربط القراءة المسترسلة بدراسة المؤلفات، وتعويد المتعلمين على قراءة أعمال كاملة وفق خطة منهجية محكمة تتيح لهم الانفتاح على أعمال أخرى لتوسيع مداركهم وتنمية تكوينهم”.[8]
وتنفيذا لذلك تم الاعتماد على مقاربات ومنهجيات مناسبة لكل مكون من مكونات المادة “وبناء على ذلك ينبغي تأكيد ما يلي:
-اعتبار القراءة المنهجية أداة أساسية في مقاربة النصوص؛
-التركيز على البعد الوظيفي والتداولي لعلوم اللغة؛
-جعل التعبير والإنشاء وسيلة للإنتاج وتحقيق التواصل في وضعيات محددة؛
-الانفتاح على المناهج النقدية واللسانية في مقاربة النصوص والمؤلفات المقررة”.[9]
وفيما يخص الجذع المشترك الخاص بقطب العلوم والتكنولوجيا، فقد تم مراعاة كون هذا القسم -أيضا – جسرا رابطا بين المراحل الموالية في سلك البكالوريا وما قبلها. وقد كان أهم أسس بناء البرنامج هو الاهتمام بحاجيات المتعلمين، والرفع من أساليب التعلم الذاتي مع مراعاة جعل اللغة العربية مادة ذات امتدادات في مختلف مكونات القطب.
ولا تخرج منطلقات بناء برنامج اللغة العربية للسنة الأولى من سلك البكالوريا عن مقاصد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووثيقة الاختبارات والتوجيهات التربوية العامة. ونلاحظ تقاطعا بينا بين أسس بناء برنامج اللغة العربية الخاص بسلك البكالوريا مع الأسس العامة التي سطرت لبناء البرنامج الخاص بالجذوع المشتركة.{ويمكن تخصيص الأسس المرتبطة بمسلك الآداب باستحضار مرجعيتين اثنتين:
- مرجعية نظرية تمتح من النظريات الأدبية، واتجاهاتها المختلفة انطلاقا من تاريخ الأدب ومرورا بالاتجاهات الاجتماعية والنفسية، واللسانية، والتواصلية وانتهاء بنظرية التلقي.
- مرجعية تربوية تتجاوز التعليم إلى التعلم، وترفض التلقين والإملاء، وترسيخ مبادئ التعلم الذاتي. ثم قبول ما يستتبع ذلك من توسيع هامش اجتهاد المدرسين للتصرف في المقاربات المعتمدة تبعا لاختلاف الوضعيات التعليمية”[10].
وأما بالنسبة لبناء برنامج مسلك العلوم والتكنولوجيا الخاص بالسنة الأولى بكالوريا فقد تم احترام خصوصيات هذا القسم فكان من أولويات بنائه هو جعل اللغة العربية ذات امتدادات في مختلف مسالك العلوم والتكنولوجيا.
5.مكونات منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
تستند مكونات منهاج اللغة العربية إلى مرجعتين أساسيتين هما: مرجعية أدبية نظرية، ومرجعية بيداغوجية وديداكتيكية.
- مرجعية أدبية نطرية:
“تستند إلى نطرية الأدب بكل تياراتها، ومدارسهاـ واتجاهاتها الفنية، ومناهجها النقدية وما تطرحها من ظواهر أدبية، وقضايا نقديةـ وآليات تعبيرية إيقاعية، ونحوية، وصرفية، ودلالية، وبلاغية، ومقامية .
- مرجعية بيداغوجية وديدكتيكية:
تتجاوز التعليم، والتلقين إلى التعلم الذاتي، والاجتهاد الفردي في إطار التوجيه، والإرشاد، وفرض الإملاء والإلقاء. كما تستمد هذه المرجعية مقوماتها من فلسفة الميثاق الوطني للتربية، والتكوين، وبيداغوجيا الكفايات، وفلسفة الجودة، وصيغة المجزوءات، أو التعليم المندمج.”[11]
وموازاة مع كل الغايات المعرفية الكبرى المستهدفة خلال مراجعة، وتجديد المنهاج، هناك غايات أخرى وجدانية، وحركية تصبو إلى خلق مواطن متشبع بروح المواطنة، ومنفتح على العالم، مبدع، وفاعل داخل مجتمعه…
وذلك عبر تزويده بمجموعة من المهارات، والكفايات التي تمكنه من تكوين مشروعه الشخصي عبر التعلم الذاتي، والبحث الدائم عن المعرفة.
6.مكونات منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
تنقسم مكونات اللغة العربية إلى أربعة مكونات هي: مكون النصوص، ومكون علوم اللغة، ومكون التعبير والإنشاء، ومكون المؤلفات. تربط بين هذه المكونات علاقة تكاملية لكن كل مكون ينفرد بخصوصيات منهجية تراعي خصوصياته.
- أولا: مكون النصوص
يعتمد تدريس مكون النصوص على القراءة المنهجية وهي” نشاط ديدكتيكي يستدعي بناء معنى النص في سياق تواصلي قائم على توظيف عمليات ذهنية حدسيةـ لوضع فرضيات قرائية، ولالتقاط العناصر النصية، ولخلق تعالق مبنين بين هذه المؤشرات بغرض تمحيص الفرضيات المنطلق منها.”[12]
بذلك فالقراءة المنهجية تبنى تباعا وبشكل متدرج من خلال أربعة مراحل أساسية هي:
- مرحلة الملاحظة
التي تشمل التعليق على المؤشرات الخارج نصية (العنوان، الكاتب، المصدر…) من أجل صياغة فرضية لقراءة النص.
- مرحلة الفهم
وهي مرحلة تقوم على القراءة الفاعلة للنص، تنبني على التفاعل البناء بين القارئ والنص من خلال الانخراط التام في الفعل القرائي من أجل استخلاص المفاهيم، والمعاني.
- مرحلة التحليل
يتم خلال هذه المرحلة تفكيك النص إلى عناصر أساسية تمثل الطرائق، والأساليب والمنهجيات والحقول الدلالية التي تم اعتمادها في كتابة النص.
- مرحلة التركيب والتقويم
تقوم هذه المرحلة على تجميع المعطيات التي تم التوصل إليها خلال المراحل السابقة من القراءة المنهجية ضمن فقرة تركيبية.
- ثانيا: مكون علوم اللغة
يتعلق بالأساليب الفنية، والتعبيرية، والآليات الجمالية المضمنة في علوم البلاغة، والعروض، والصرف، والنحو. وتتمثل منهجية هذا المكون في ملاحظة، وتحليل أمثلة وشواهد تتضمن الظاهرة اللغوية المدروسة، واستخلاص القاعدة المتعلقة بها. وإنجاز تطبيقات خاصة بتلك الظاهرة المدروسة من أجل تقويم التعلمات، والوقوف عند التعثرات، وتصويبها.
- ثالثا: مكون التعبير والإنشاء
يختص مكون التعبير والإنشاء بمجموعة من الأنشطة التي تقوم عليها المهارة المدروسة، والتي تنقسم إلى:
1.أنشطة الاكتساب
تخصص للحصة الأولى من دراسة المهارة، يقوم فيها المدرس بمعية المتعلمين بتحديد خطوات المهارة انطلاقا من النص المدروس، للخروج باستنتاج عام وخلاصة حول المهارة.
- أنشطة التطبيق
تمثل الحصة الثانية لدراسة المهارة وهي مخصصة للتعلم الذاتي يمكن للمتعلمين إنجازها بشكل فردي، أو على شكل مجموعات. وتكون فرصة للتقويم ، والإرشاد من قبل المدرس للخروج بإنجاز نموذجي كتطبيق لخطوات المهارة.
3.أنشطة الإنتاج
تخصص للإنتاج الفردي من قبل المتعلمين.
4.أنشطة التقويم
يتم فيها تقويم إنجازات المتعلمين وتصويبها.
- رابعا: مكون المؤلفات
تتم تدريسية مكون المؤلفات عبر منهجية تنبني على ثلاث قراءات هي:
1.القراءة التوجيهية
نقصد بهذه القراءة كل ما يتعلق بالمناصات: (نوعية النص، العنوان، اسم الكاتب، صورة الغلاف، التصدير، الإهداء، الكلمة المثبتة على ظهر الغلاف، المفتتح، والمختتم…).
2.القراءة التحليلية
تستهدف كل ما يتعلق بالمكونات الدلالية، والبنائية التي يسفر عنها تحليل النص:(المتن الحكائي، والحبكة، والرهان، وتحديد دلالات وأبعاد الحدث، والقوى الفاعلة، والأبعاد النفسية، والأبعاد الاجتماعية، والأسلوب…).
3.القراءة التركيبية
تختص هذه القراءة باستجماع العناصر والمعطيات التي تم التوصل إليها خلال المرحلتين السابقتين(القراءة التوجيهية، والتحليلية) وتركيبها في ملخصات، وتقارير فردية من أجل الخروج بأحكام، ومسلمات فردية أو جماعية.
خلاصة:
استمرارا لجهود الإصلاح المراد الوصول إليه في قطاع التربية والتكوين المغربي، بادر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبلورة استراتيجية جديدة هدفها الإصلاح التربوي وهي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح [13]. تعتمد هذه الرؤية على إرساء مدرسة مغربية جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وقد حددت المدى الزمني لها بين سنة 2015 إلى 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار المدى القريب والمتوسط والبعيد. وهي مدة كافية لإنجاز تقييم شامل لسيرورة الإصلاح ونتائجه عبر تقييمات مرحلية بغرض التصحيح، والاستدراك، والتحسين.
وعليه وجب العمل على تقييم المناهج التربوية والوقوف عند مدى تحقيقها للغايات الكبرى التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية ، واستهدفتها.
قائمة المراجع :
1.المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي –المملكة المغربية-, الرؤية الاستراتيجية من أجل الإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
2.المملكة المغربية .الميثاق الوطني للتربية والتكوين.1999.
3.موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. مصوغة الجذع المشترك: المنهاج-الكفايات-التقويم. من إعداد مديرية الوحدة المركزية لتكوين الأطر، ومديرية التقويم والامتحانات والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات لتكوين الأساتذة المتدربين وتأهيلهم. سنة 2010-20011.
4.وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.( نونبر 2007) .التوجيهات التربوية وبرامج تدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.
- 5. جميل الحمداني(2020).”ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي”-الجزء الأول-. الطبعة الأولى. دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني. الناظور- تطوان, المملكة المغربية.
- 6. محمد حمود.(1998).”مكونات القراءة المنهجية للنصوص- المرجعيات، المقاطع، الآليات، تقنيات التنشيط-“.الطبعة: الأولى . دار الثقافة للنشر والتوزيع. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء.
[1]) المملكة المغربية .الميثاق الوطني للتربية والتكوين.1999.ص:4
[2].جميل الحمداني(2020).“ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي”-الجزء الأول-. الطبعة الأولى.دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني.الناظور- تطوان,المملكة المغربية. ص:119
[3]. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.( نونبر 2007) .التوجيهات التربوية وبرامج تدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.ص:2
[4].ينظر نفس المرجع أعلاه.ص:4
[5]. نفس المرجع .ص:4
[6]. ينظر التوجيهات التربوية ص:5
[7].موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. مصوغة الجذع المشترك: المنهاج-الكفايات-التقويم. من إعداد مديرية الوحدة المركزية لتكوين الأطر، ومديرية التقويم والامتحانات والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات لتكوين الأساتذة المتدربين وتأهيلهم. سنة 2010-2011.ص:9-10.
[8].التوجيهات التربوية.ص:13.
[9].التوجيهات التربوية.ض:15
[10]. ينظر نفس المرجع.ص:29.
[11].ينظر: جميل الحمداني(2020).”ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي”-الجزء الأول-.ص:120.
[12].محمد حمود.(1998).”مكونات القراءة المنهجية للنصوص- المرجعيات، المقاطع، الآليات، تقنيات التنشيط-“.الطبعة: الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء.ص:15.
[13].المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي –المملكة المغربية-، الرؤية الاستراتيجية من أجل الإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

