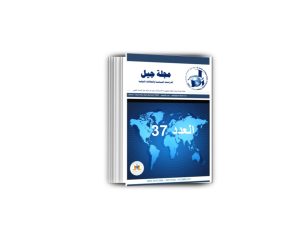الأحزاب السياسية ومسألة وصناعة القرار السياسي في الدول المغاربية (المغرب-الجزائر)
فدوى مرابط: باحثة في الحياة السياسية والدستورية جامعة محمد الأول وجدة (المغرب)
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 14 الصفحة 35.
مقدمةتعتبر عملية صنع القرار السياسي أحد أبرز مهام الأنظمة السياسية على اختلاف أشكالها، وهي نتاج تفاعل أركان النظام السياسي ضمن عملية معقدة تتداخل فيها عوامل ومؤثرات متعددة، بهدف الاختيار بين البدائل المتاحة لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية التي ترتبط بمصالح الشعوب والبلدان.[1]
فتحليل عملية صنع القرار السياسي يكشف عن مدى ديمقراطية الأنظمة الحاكمة ودرجة تطورها، والتوجهات الأساسية للنخبة الحاكمة، وعلى أهم الأشخاص المسيطرون على العملية السياسية، ويرى دافييد استون أن القرارات هي بمثابة مخرجات النظام السياسي أيا كان شكله والتي يتم من خلالها التوزيع السلطوي للقيم في المجتمع سواء كانت هذه القيم داخلية أو خارجية[2].
فعملية صنع القرار السياسي عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل، ويتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل:
1-المرحلة الأولى (المدخلات) وتشمل المعلومات والملاحظات ونقل المعلومات .
2- المرحلة الثانية(القرارات) وتشمل استعمال المعلومات وعملية التخطيط وعملية التحليل التي تركز على الأهداف والاستراتيجيات البديلة والمناقشة والمساومة والنصح والتوصيات.
3- المرحلة الثالثة( المخرجات)، وتشمل الخيارات السياسية والتنفيذ والمتابعة والإعلام والمفاوضة والتعلم من خبرة التطبيق.
ويمكن تقسيم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة القرار السياسي إلى ما هو داخلي وما هو خارجي، فالعوامل الداخلية هي مجمل الظروف القائمة في إطار الدولة أي النظام السياسي والأحزاب وجماعات الضغط السياسي، ومن المعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي تقبل الرأي والرأي الآخر فإن صنع القرار فيها يشهد تقدما ملموسا على أرض الواقع.
والسبب في ذلك هو توسيع دائرة المشاركة للأحزاب والمنظمات والصحافة والرأي العام عموما من خلال الكثير من الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل معرفة رد الفعل حول القرار .
وعلى العكس ذلك، مساحة الرأي الآخر موجودة شكلا دون أن توجد مضمونا إن لم نقول أنها منعدمة تماما في الأنظمة غير الديمقراطية رغم تبني هذه الأنظمة للدساتير والقوانين التي تعطي للأحزاب والمنظمات والصحافة والرأي العام الحق في طرح أفكارها واقتراحاتها وآراءها المؤيدة أو المعارضة للنظام القائم، إلا أنها تبقى نصوصا قانونية غير مفعلة في هذا المجال .
أما العوامل الخارجية فهي ظروف المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنه من دول ومنظمات دولية، وتؤثر في عملية صناعة القرار السياسي بحيث أصبحت معالجتها تتم وفق أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان والبيئة والمناخ والنزاعات الداخلية ومدى توفر الديمقراطية في الحكم وغير ذلك من الأمور[3].
وفي الدول المغاربية ( المغرب، الجزائر ) محل الدراسة تمر عملية صناعة القرار السياسي بمجموعة من المراحل ومن خلال مجموعة من المؤسسات ، حيث تشارك الأحزاب السياسية في عملية صنع القرار من خلال تمثيلها في مجموعة من المؤسسات كمؤسسة رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان، وأيضا من خلال الدور الذي تمارسه المعارضة في الأنظمة السياسية .
فما هي مؤسسات صناعة القرار السياسي في كل من المغرب والجزائر؟ وإلى أي مدى تساهم الأحزاب السياسية في صناعته ؟ وماهي حدود تأثيرها في صناعة هذه القرارات؟ وماهي المعيقات التي تواجهها في هذه البلدان ؟
المحور الأول: مؤسسات صناعة القرار السياسي ودور الأحزاب السياسية في هذا المجال.
إن تأثير الأحزاب السياسية في صناعة القرار السياسي يمكن أن يتم من خلال شكلين مختلفين ، إما أن يتم من داخل مؤسسات النظام السياسي، أو من خارج نطاق هذه المؤسسات، إذ أن الأحزاب السياسية تقوم بمجموعة من الوظائف فهي التي تستلم السلطة ومقاليد الحكم ، أو تقوم بمجموعة من الوظائف منها بلورة المطالب والقضايا العامة التي تناقش عند رسم السياسات العامة، وإثارة الرأي العام حولها، ومحاولة إقناع المواطنين بتبني المواقف التي تتخذها الأحزاب للضغط على الحكومات ، كما تعد وسيلة من وسائل الرقابة السياسية على النشاط الحكومي.
وفي هذا المحور سنحاول أن نسلط الضوء على المؤسسات التي تقوم بصناعة القرار السياسي في كل من المغرب الجزائر ودور الأحزاب السياسية في صناعته.
فعند الحديث عن القرار السياسي نجد أن هناك مؤسسات رسمية وغير رسمية تساهم في صناعته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتختلف درجة مساهمة هذه المؤسسات من نظام لآخر وذلك حسب درجة الديمقراطية التشاركية وطبيعة البيئة التي تحيط بصانع القرار، لذلك سنحاول في هذا المحور تسليط الضوء على المؤسسات التي تساهم في صنع القرار السياسي في كل بلد من بلدان محل الدراسة وسنبين ما دور الأحزاب السياسية في صناعة هذا القرار من خلال معرفة هل الأحزاب السياسية جزء من هذه المؤسسات أم لا.
- مؤسسة رئاسة الدولة
أ -في النظام السياسي المغربي.
يعتبر الحديث عن المؤسسة الملكية حديث عن مؤسسة رئاسة الدولة في المغرب، إنها مؤسسة المؤسسات إنها الدولة المغربية بذاتها، تمثل استمرارية النظام السياسي، بعكس المؤسسات السياسية الأخرى سواء كانت حديثة كالأحزاب السياسية او النقابات، أو مؤسسات تقليدية كالقبيلة و الزاوية ، حيث تتأسس مشروعية المؤسسة الملكية على أساس تاريخي و ديني ودستوري وتتمثل في إمارة المؤمنين ثم في العادات والتقاليد المغربية.
لقد استطاعت المؤسسة الملكية على مدى التاريخ السياسي المغربي إحلال نوع من التوازن السياسي بين مجموعة من الفاعلين السياسيين، ففي السنوات الأولى للاستقلال ، حسمت الملكية صراعها مع حزب الاستقلال الذي كان القوة الثانية إلى جانبها بخيار التعددية الحزبية، ثم بعد المحاولتين الانقلابيتين التي عرفها المغرب في السبعينيات من القرن الماضي استطاعت المؤسسة الملكية ان تبعد مؤسسة الجيش عن السياسة.
ثم جاءت مرحلة التناوب التوافقي الذي أدى إلى دخول المعارضة الى الحكم، وانتقال الحكم بشكل سلس من الراحل الحسن الثاني إلى إبنه محمد السادس.
ثم أخيرا في ظل الربيع العربي على المستوى الإقليمي تم مطالب حركة 20 فبراير لتنفرد المؤسسة الملكية بالتعديل الدستوري شكلا و مضمونا، فعلى مدى التطور الدستوري المغربي كانت للمؤسسة الملكية مكانة سامية في الهندسة الدستورية[4].
وعلى هذا الأساس تتجه الملكية إلى الدلالات الدينية لتوظيفها في خطابها السياسي قصد تأكيد سموها السياسي الدستوري، معتبرة أن أمر الحكم في المغرب يتصل برابطة بين الملك وشعبه.
وبصرف النظر عن الاختصاصات الكلاسيكية لرئيس الدولة يبدو أن المكانة السياسية الدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري برمته، كما يجسد ذلك الفصل 19 من دساتير المغرب المتعاقبة والفصول 41 و 42 من الدستور الحالي لسنة 2011 . فهو الذي يحدد الاختيارات الإستراتيجية في الميادين التي تهم مصير و مستقبل المغرب ، أي ان الملك يحكم وحكمه يستمده من الدستور ومن عقد البيعة الذي يجمعه بالشعب وليس بالأحزاب.
فالمؤسسة الملكية جعلت نفسها فوق المنافسة السياسية مع كونها محور كل العمليات السياسية، فهي تؤكد طابعها القدسي باعتبارها ” مؤسسة المؤسسات”، لأن الملك في المغرب يحظى بمكانة متميزة ، فهو من جهة أمير المؤمنين يملك السلطة الروحية، ومن جهة ثانية يملك السلطة المدنية، حيث يعتبر الملك سلطانا شريفا ينتسب لآل البيت وحفيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، تمنحه هذه المكانة رمزية وقدسية.
فالبرامج الحقيقية للحكم وتوجهات السياسة العامة تصنع بعيدا عن الأحزاب السياسية لأن الأورش الكبرى والبرامج الإستراتيجية تدخل ضمن مخططات المؤسسة الملكية، حيث دشن الملك محمد السادس عهده بعدة قرارات أساسية ، مثل القرارات المتخذة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ، كقرار تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ، وإقرار التعددية الثقافية بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقرارات المتعلقة بوضعية الصحراء، وقرار إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.[5]
وهذا واقع لا يساعد أن تكون مصداقية للأحزاب السياسية بل بالعكس يفقدها ثقة المواطن العادي الذي يرى في الحزب السياسي مجرد عبئ وليس له تأثير على حياته الاقتصادية والاجتماعية إلى التجديد، تجديد على مستوى البرامج وعلى مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى التواصل مع الناس، حيث نلاحظ في المغرب منذ الاستقلال هيمنة منطق التشرذم ومنطق التفكك والانشقاق على الأحزاب السياسية بدل الاتجاه نحو الانصهار والتكتل[6] .
ب- في النظام السياسي الجزائري
من خلال الدساتير التي عرفتها الجزائر يمكن القول أن النظام السياسي عزز مكانة وسلطة هذه المؤسسة، وذلك بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي وضعت تحت تصرف رئيس الجمهورية، فدستور 1976 ، رغم تنصيصه على مبدأ فصل السلط إلا أنه حافظ على المكانة البارزة للرئيس مثله مثل دستور 1963، إذ نجد أن رئيس الجمهورية هو قائد الحزب والدولة معا، كما أن وجوده على رأس السلطة التنفيذية مكنه من المحافظة على مركزه السياسي على كل المؤسسات وأبعاد كل محاولة للنيل من مكانته وسلطته الواسعة التي يتمتع بها من خلال الدستور، ومن ثم تجسدت وحدة القيادة والتوجيه في ممارسة السلطة في شخص رئيس الجمهورية الذي يجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية التي شكلت أداة للتدخل في شؤون الحزب والدولة معا، وبذلك أصبح النظام السياسي الجزائري قائما على نظام الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني، وعدم السماح لأي تشكيلة سياسية النشاط في الحياة السياسية واعتباره الممثل الوحيد لمصلحة الشعب واستخدامه في تهيئة مختلف المنظمات الجماهيرية لمساندة قرارات النظام وسياسته.وقد تميزت تلك الفترة بين إقرار دستور 1989 وهو دستور التعددية السياسية وإلغاء أول انتخابات تنافسية فكانت مؤسسة الرئاسة محور المبادرة في القرار ، حيث اختار الشاذلي بن جديد التعايش مع الوضع الجديد إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن القائمين على المؤسسة العسكرية ، ومن خلفهم مؤسسة الحكومة ارتأوا وقف المسار الانتخابي بدفع رئيس الدولة إلى تقديم استقالته في يناير 1981، وبعد إلغاء الانتخابات التشريعية ، وبعد اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، تم تعيين السيد علي كافي على رأس المجلس والذي استمر في المنصب إلى حين انتهاء مهمة المجلس، ليتم اختيار الجنرال اليمين زروال وزير الدفاع لتولي منصب رئيس الجمهورية[7] . انعكس العنف السياسي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينات سلبا على المسار الديمقراطي، و أعلنت حالة الطوارئ سنة 1992، و أمام هذه الوضعية، أصبح من الصعوبة العودة الى المسار الديمقراطي، لكــــون الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية للبلد لا تسمح بذلك . و قد أثرت حالة الطوارئ من ناحية على الحريات الفردية و الجماعية، فأصبحـــت المسيرات و التجمعات السياسية التي تعد أشكالا للتعبير السياسي الحر ممنوعة و تراجــع أيضا نشاط الأحزاب السياسية و دورها من ناحية أخرى، أثرت حالة الطوارئ على المجتمع المدني، على أساس أن وجوده يرتبط بوجود الديمقراطي[8].
وفي عام 1995 تم انتخاب السيد ليامين زروال كأول رئيس للجمهورية منتخب في ظل التعددية، وفي عهده تم اقرار دستور 1996، ولم تمض سنتان على ذلك حتى عبر الرئيس عن عزمه مغادرة منصب رئيس الدولة بتقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، وهو ماتم فعلا في أبريل 1999، ليخلفه عبد العزيز بوتفليقة على كرسي الرئاسة.
وقد حملت الانتخابات الرئاسية المسبقة عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، في ظل أجواء سياسية مشحونة وبخاصة بعد الشرخ في شرعية الانتخابات الذي تسبب في انسحاب جميع المترشحين المتنافسين مع عبد العزيز بوتفليقة ما حمل البعض إلى وصفه بمرشح السلطة[9].
فالمؤسسة العسكرية مثلت ولازالت تمثل أساس النظام الجزائري حيث لعب مسؤولوها دورا مركزيا في اختيار النخب التي تقود مؤسسة رئاسة الدولة و المؤسسات الحكومية ، فالجيش هو القوة الفاعلة والوحيدة المنظمة والمهيكلة للخريطة السياسية في الجزائر، خاصة وأن السيد عبد العزيز بوتفليقة حكم لأربع ولايات متتالية وهذا كفيل بإبراز موقع مؤسسة رئاسة الدولة كفاعل أساسي في صنع القرار السياسي في الجزائر.
إن إقبال النظام في نهاية الثمانينات على فتح المجال السياسي لم يكن بنية إطلاق دينامية التحول نحو الديمقراطية ، وإنما فعل ذلك تحت ضغط الأحداث المحلية لمواجهة أزمة داخلية متفاقمة نزعت عن النظام كامل شرعيته وجعلت الحزب الذي كان يحكم باسمه مسؤولا عما آلت إليه الأوضاع .
فكان القصد من التخلي عن الأحادية الحزبية وتعويضها بتعددية حزبية تضم العديد من الأحزاب يبقى للنظام ضمنها حزب مهيمن يقوم بوظائف الحزب الواحد سابقا، لضمان استقرار النظام ، وأحزاب أخرى محدودة الوزن للتعبير عن مختلف الحساسيات السياسية في المجتمع دون الطمع في الوصول إلى السلطة، وتزويد النظام بواجهة ديمقراطية تضمن له البقاء وترد له شرعيته المفقودة التي تم تجديدها تجديدا دوريا بواسطة انتخابات تعددية.[10]
2-المؤسسة العسكرية
- في النظام السياسي الجزائري
يلعب الجيش دورا محوريا في صناعة القرار السياسي بالجزائر، باعتباره أحد المؤسسات المهمّة في المشهد السياسي للبلاد منذ الاستقلال فخصوصية هذا الجيش تكمن في كونه قد خلق الدولة الجزائرية وليس العكس، أي أن الدولة الجزائرية هي التي أنشأت جيشها. تؤكد هذه الفكرة الباحثة الفرنسية ميراي دوتاي عندما تقول بصفة عامة، أراد الجيش في الجزائر أن يكون مالكا للدولة التي صنعها. فهو الشرعية وهو السلطة[11]. وجاءت سيطرة الجيش على الحياة السياسية نتيجة صراع عرفته الجزائر قبل الاستقلال، كان الحسم فيه لصالح الجيش والذي مثلته مؤسسة قيادة الأركان على بعض حساب بعض قوات الولايات الداخلية والحكومة المؤقتة، هذا الصراع تنبهت له قيادات الثورة عام 1956 عندما أقرت في مؤتمر الصومال مبدأي أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج، لتبقى الكلمة الأخيرة لصالح العسكر، ثم تطور الأمر لتصبح الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مخابرات الجيش النواة الفعلية لمركز القرار السياسي في الجزائر، ولتتمظهر هذه السيطرة الفعلية بصور مختلفة في علاقاتها بمراكز القرار ومؤسساته الظاهرة المعينة أو المنتخبة ، السياسية والإدارية أو الاقتصادية[12].
فالجيش الجزائري هو الذي فرض وضمن جميع الاختيارات السياسية والاقتصادية الأساسية في البلاد. كذلك، هو الذي فرض كل رؤساء الجزائر المتعاقبين الذين عرفتهم منذ الاستقلال، حيث قام بشطب كل تعدد سياسي ومنعه من النشاط بحجة الأحادية الحزبية، ليبقى الجيش القوة السياسية الأساسية والوحيدة في البلاد، وهكذا مسحت تقاليد عقود من النشاط السياسي التعددي خبرها الجزائريون في ظل الإدارة الفرنسية، وتم تهميش حزب جبهة التحرير الوطني الذي عد الحزب الطلائعي في البلاد خاصة بعد انقلاب 1965 وتحويله إلى امتداد للجيش، بينما تحول الأمن العسكري إلى نظام سياسي حقيقي يشتغل ميدانيا كمنظمة لتأطير قطاعات النشاط في البلد، ويراقب الجميع.[13]
حيث أصبحت المؤسسة العسكرية تتدخل في اختصاصات باقي المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والتدخل في جميع شؤون الدولة ، فهي التي قررت عزل الرئيس الشاذلي بنجديد، وفرض حالة الطوارئ وإطلاق العنان للجيش وقوات الأمن لقمع المعارضة ، وممارسة سياسة الاستئصال والإقصاء، وتغليب منطق الحوار على العنف.[14]
لقد أبرز هذا الجيش مدى تضامنه الداخلي في مواجهة تهديدات الإنقاذ والجماعات الإسلامية المسلحة حيث تميز موقف الجيش الجزائري في مواجهته للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالصلابة والشدة رغم صراعاته الداخلية المتعددة التي اخترقته منذ تأسيسه في أول نوفمبر 1954، وحافظ علي وحدته الداخلية وتضامنه العسكري وانضباطه الهرمي رغم تسجيل بعض حالات الفرار منه، خاصة بين سنتي 1992 وسنة 1994. لقد عاش مفارقة صعبة، تكاد تكون مستحيلة لو تعلق الأمر بغيره من الجيوش، وهي كيف يدير صراعاته الداخلية وتناقضات ضباطه دون المساس بوحدته المقدسة في مواجهة عدوه المشترك[15].
ثم قام بعد ذلك بخلق أحزاب موالية له من أجل أن تكون أداته السياسية، حيث تشهد الساحة الجزائرية في السنوات الأخيرة صراعا بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة التي يقودها حلفاء الرئيس بوتفليقة[16]. وقد أخذ الصراع يشتد للبحث عن بديل الرئيس الحالي، حيث قام الرئيس بوتفليقة بحملات من أجل دعم مؤسسة الرئاسة كإحالة بعض رموز الدولة الذين كانوا في القريب يسيطرون على دواليب الحكم على التقاعد، أبرز هذه القرارات إحالة الجنرال “محمد مدين” المعروف بالجنرال توفيق قائد إدارة الأمن والاستعلامات الذي عايش أربعة رؤساء دولة على التقاعد، وهناك من يقول أن هذا الصراع هو أصلا صراع في المؤسسة العسكرية بين من يدعم الرئيس ومن يدعم جهات أخرى، بالنظر للحالة الصحية للرئيس التي قد تمنعه من اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الشكل[17].
- في النظام السياسي المغربي.
تُبرز الخصائص الأساسية للجيش المغربي ضعف مركزه السياسي في مجال الشأن العام، ويعود أهم أسباب هذا الضعف بصفة عامة إلى تبعية الجيش المغربي المطلقة للملك، وما يتمتع به هذا الأخير من سلطات على هذا القطاع تسمح له بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة تمسُّ هذه المؤسسة. ومن جهة أخرى فإن ظاهرة بُعد الجيش في المغرب عن الشؤون السياسية تم تكريسها عبر القوانين المنظِّمة لهذه المؤسسة التي جعلت دور الجيش المغربي يقتصر على تنفيذ التعليمات والأوامر في ميدان الدفاع الوطني والمساهمة في بعض عمليات الإنقاذ أو التنمية دون أن يكون له الحق في التدخل فيما تموج به الساحة السياسية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي[18].
يندرج النموذج المغربي فيما يصطلح عليه صامويل فاينر بـ”الأنظمة المدعومة بالعسكر والتي تضم الدول التي يحكمها رئيس دولة ويهيمن على السلطات التنفيذية، ويمثِّل الجيش ضامنًا لحكمه ضد التهديدات الداخلية والخارجية. ويظهر ولاء الجيش في المغرب للملك أولًا من الاسم الذي يحمله، فهو لا يحمل اسم القوات المسلحة المغربية أو الجيش الوطني المغربي، بل يُعرف رسميًّا باسم القوات المسلَّحة الملَكية كما يظهر من خلال طبيعة أهداف القوات المسلحة الملكية والتي حددها الملك الحسن الثاني عندما كان وليًّا للعهد، حيث أعلن في الذكرى الثالثة لتأسيس القوات المسلحة الملكية أن هذه القوات هي جيش الشعب الذي ليس له إلا هدف واحد خدمة جلالتكم وخدمة الشعب المغربي.
ويُضاف إلى ما سبق أن الملك الراحل الحسن الثاني هو الذي كُلِّف -عندما كان وليًّا للعهد- مباشرة بعد الاستقلال بتنظيم القوات المسلحة الملكية حيث كان بمثابة المخطط والمدبر والخبير الذي أشرف على تنظيم هذا الجيش الذي أسسه الملك سنة 1956[19].
لكن التحول البارز في بنية المؤسسة العسكرية ارتبط بمحاولة الانقلاب ضد الملك الراحل، في صيف سنة 1972، وهو تحول نتجت عنه تداعيات كبيرة على مؤسسة الجيش، أبرزها إلغاء وزارة الدفاع بموجب الظهير الشريف الصادر سنة 1972، وتكريس الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، لتجنيب الدولة نفوذ المؤسسة العسكرية، كما هو واقع في كثير من البلدان اليوم.
لقد ساهمت المؤسسة العسكرية في حماية الأمن والنظام العام، و في حالات الطوارئ أو وضعيات أمنية استثنائية، ويقوم بتأمين المؤسسات وحمايتها. كما يشارك في حفظ الأمن الداخلي، في حال وجود أخطار داهمة وحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الإرهابية[20].
دور الأحزاب السياسية في صناعة القرار السياسي
في النظام السياسي المغربي
تمتد جذور التعددية الحزبية في المغرب إلى عهد الحماية، حيث أثمر النضال ضد الاستعمار الفرنسي حركة وطنية موحدة في البداية قبل أن تتباين المواقف بين زعاماتها فيما بعد وجعلت المؤسسة الملكية بعد الاستقلال من التعددية الحزبية مبدأ دستوريا ثابتا، حيث ينص البند الثاني من الفصل الثالث من دساتير التي سبقت دستور 2011 على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع، كما يشدد البند الثالث من الفصل التاسع من الدستور على حرية جميع المواطنين في تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية حسب اختيارهم. وينص الفصل 7 من دستور 2011 على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
حيث أن المعيار الوحيد لمشاركة الأحزاب في صناعة القرار السياسي يكمن في العمليات الانتخابية والوصول إلى المؤسسات الدستورية ألا وهي الحكومة والبرلمان، وما يؤكد هذا الطرح أن الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها التاريخ السياسي المغربي قد ساهمت فعلا في ترسيخ إطار تعبر من خلاله التنظيمات الحزبية عن رؤيتها للحياة السياسية مما تطلب تجديدا مستمرا للحقل الحزبي، لكن استمرار مراقبة المؤسسة الملكية للأداء الحزبي قلص من البعد التنافسي بين الأحزاب المغربية ولم يتح لها الفرصة للدخول في غمار الوصول إلى السلطة ورغم انطلاق النظام المغربي نحو نظام أكثر لبرالية خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي دفعت إلى القول بوجود ديناميكية على الصعيد الحزبي وتجديد على مستوى الفكر الحزبي، فإن الحزبية المغربية ظلت بين معضلتين بالنسبة للأحزاب القبول بالاستمرار في التعاون والاندماج التي قد تسبب إضعاف دورها ورصيدها لدى القاعدة الشعبية التي تساندها، وبالنسبة للملكية ضمان مشاركة الهياكل الحزبية لإضفاء الشرعية على الانتخابات إن لم يكن ذلك بغرض تكريس هيمنتها فهو ضمان استقرارها وبقاءها[21].
فالمغرب شهد عدة انتخابات تشريعية منذ الاستقلال تكون من خلالها 16 حكومة و10 برلمانات بين عامي 1963 و2016، حيث عرفت الأحزاب السياسية تنافسا من أجل الوصول إلى المؤسسة التشريعية التي تطورت بشكل ملموس خلال هذه الفترة، فباستثناء الفترة الوجيزة التي حلت فيها الملكية البرلمان ظل البرلمان موجودا باستمرار، ومن دستور إلى أخر، تعززت سلطات البرلمان بأسلوب تنظيمي، فالبرلمانات الأولى ما عدا برلمان 1963، كانت تعتبر شكلية، اقتصر دورها على الاستشارة وإصدار القرارات المتخذة خارجها، لكن التجارب الأحدث في أواخر تسعينيات القرن العشرين، وتلك التي قامت في ظل حكم الملك محمد السادس تظهر أن البرلمان ينزع إلى تأدية دور فعال على نحو متنامي في مجال التشريع ومراقبة الحكومة وقد تعززت صلاحيات البرلمان بالإصلاح الدستوري عام 1996 الذي أنشأ نظام المجلسين التشريعيين للحلول محل البرلمان أحادي المجلسين[22].
وقامت الهيئة التشريعية الحالية في المغرب بموجب دستور 2011 الذي يمنح البرلمان مزيدا من الصلاحيات خصوصا مجلس النواب، إذ وسع نطاق سن القوانين واعترف بمكانة المعارضة، وخولته عدة صلاحيات في مجال الرقابة على العمل الحكومي ومنحت المعارضة وضعية متميزة وحقوقا متعددة بغية النهوض بالعمل البرلماني والرفع من جودة القوانين والسياسات العمومية التي يتولى تشريعها، ولم تعد مسؤوليته تنحصر فقط في مناقشة السياسات العمومية بل أضحت مسؤولية تقييم هذه السياسات من اختصاص البرلمان[23] .
لكن رغم هذا التطور لازال البرلمان المغربي يعاني مجموعة من العوائق تجعل مساهماه في صناعة السياسة العامة محدودا، حيث تتأسس الهندسة الدستورية المغربية على البرلمانية المعقلنة، التي تؤدي إلى تعميق الهوة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية وترجيحها لصالح هذه الأخيرة، و بالرغم من صدور الوثيقة الدستورية الجديدة التي منحت تصورا أكثر انفتاحا اتجاه البرلمان إلا أن من الصعوبة تجاوز محددات اتخاذ القرار السياسي بالمغرب في ظل بنى كلاسيكية لممارسة تعتمد على التوافقات و المساومات في ظل ديمقراطية متعثرة ومترددة إلى حد أننا لا زلنا نتحدث عن ما يسمى بالانتقال الديمقراطي[24].
فمن مكامن ضعف البرلمان المغربي صعوبة تكوين أغلبية وازنة و منسجمة قادرة على توجيه وتتبع و تقييم العمل الحكومي، فإذا استثنينا التجربة البرلمانية الأولى 1963-1965 حيث تقاربت التوازنات داخل المؤسسة التشريعية، فإن التجارب اللاحقة كرست أغلبية محدودة بسبب نمط الاقتراع والتقطيع الجغرافي الذي لا يسمح بوجود أغلبية قادرة على تكوين جبهة موحدة و متراصة تملك إمكانية الفعل و الأداء في التتبع و تقييم العمل الحكومي، كما تأثرت أيضا بطبيعة الأحزاب المسؤولة دستوريا عن تأطير المواطنين و انتقاء ما يسمى النخبة البرلمانية، و بالرغم من الجديد الذي أتى به الدستور الجديد منها المنع من ظاهرة الترحال السياسي بعد الانتخابات، فقد أبانت الحصيلة من الحياة الحزبية وجود أعطاب حالت دون قيام الأحزاب المغربية بالأدوار و الوظائف المنوطة بها فقد ساهمت ظاهرة الانشقاقات في صعوبة بناء الديمقراطية داخلها و في ما بينها على تعميق نزاعات الانشقاق وعزوف المواطنين على الانتماء إليها[25].
وبالنسبة للحكومات المغربية وإن ظلت لمدة طويلة تابعة تبعية مطلقة للمؤسسة الملكية فإنها هي أيضا عرفت تطورا ملموسا منذ الاستقلال إلى الآن، فلم تعد الحكومة هي حكومة جلالة الملك [26]، بل أصبحت الحكومة في المغرب بعد التعديل الدستوري لسنة 2011 هي حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، حيث تمت تقوية مركز الوزير الأول وأصبح يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي[27].
وتمارس الحكومة في المغرب سلطات تنفيذية وأخرى تنظيمية، وتضمن تنفيذ القوانين، واداء الوظائف الإدارية، ويعين رئيس الحكومة الموظفين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات العمومية، لكن الملك يحتفظ بتعيين كبار الموظفين بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
ويحق لرئيس الحكومة أن يحل مجلس النواب بمرسوم يقتضي من المجلس الوزاري دراسته، وهذا الامتياز يعطي للسلطة التنفيذية نفوذا اكبر على السلطة التشريعية، ويدعو رئيس الحكومة المجلس للانعقاد برئاسته، ويتداول المجلس في بعض القضايا مثل السياسة العامة للدولة، والسياسات العمومية وتعهد للحكومة بتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب، والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، كما يتداول أيضا في بعض النصوص مثل مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، ومراسيم القوانين والمراسيم التنظيمية، والمعاهدات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري برئاسة الملك، ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة[28].
وقد ربط الدستور الجديد لسنة 2011 المسؤولية بالمحاسبة[29] ، حيث لم يعد تقتصر دور الحكومة على تنفيذ السياسة العامة التي تحددها المؤسسة الملكية، وإنما أصبح أعضاء الحكومة يحاسبون على عدم تنفيذ هذه المشاريع من طرف الملك وخير مثال على ذلك قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس في 24/10/2017، اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين حكوميين بسبب التقصير في أداء واجباتهم، تضمنت عزل بعض الوزراء والمسؤولين الكبار وحرمان آخرين من المناصب مستقبلا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور بعد استشارة رئيس الحكومة.
في النظام السياسي الجزائري
وفي الجزائر إذا كانت مشاركة الأحزاب محدودة في تولي رئاسة الجمهورية وتقتصر على الترشح لهذا المنصب دون الفوز به أو على مساعدة المرشح الحر، فإنها على عكس ذلك فإنها تشارك في الحكومة، سواء من خلال تولي زعيم الحزب لرئاسة الحكومة أو من خلال تولي الحزب لحقائب وزارية.
ولكن هيمنة رئيس الجمهورية الواسعة على مختلف المؤسسات وتدخله في كل المجالات قلص من صلاحيات رئيس الحكومة وحصر صلاحياته فقط في الأمور التقنية والاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية[30]. خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي أصبح بموجبه رئيس الحكومة وزيرا أولا مساعدا لرئيس الجمهورية حيث جرى العرف السياسي في الأنظمة الديمقراطية ان يعين الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية، ولكن في الجزائر يعين الوزير الأول دون تحديد انتمائه إلى الأغلبية فهو يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وبالنسبة للبرلمان فإنه يؤثر في السياسة العامة من خلال الاختصاص التشريعي والرقابي،حيث يساهم في صناعة القرار السياسي من خلال مايلي:
- مهمة تشريع القوانين العادية والعضوية.
- مراقبة البرلمان لعمل الحكومة.
- مناقشة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة قبل المصادقة عليه.
- فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس إحدى الغرفتين
- يمارس أعضاء البرلمان حق استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة
- يمكن لأعضاء البرلمان حق استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
- يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي او كتابي أي عضو في الحكومة.
- يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بيان السياسة العامة التصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة شريطة تصويت أغلبية ثلثي النواب[31].
وبصفة عامة كرس المشرع الدستوري الجزائري ضعف البرلمان بوضع آليات العقلنة البرلمانية، فقد أعطى للحكومة حق تقديم مشاريع القوانين، وأعطى للبرلمان حق التقدم بمقترحات قوانين وضع أمامه عدة حواجز في مساره مما يجعلها صعبة إن لم نقل مستحيلة، كما أسندت صلاحيات التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية مما ساهم بشكل كبير في هذا الضعف.[32]
أضف إلى ذلك ضعف البرلمان الجزائري في المجال الرقابي، حيث تعتبر آليات الرقابة البرلمانية ضعيفة بسبب الآليات التي وضعها المؤسس الدستوري وكذا العوائق التي وضعت في القانون الأساسي المنظم لغرفتي البرلمان، باستثناء آلية الأسئلة الشفوية والكتابية، مقابل عدم تفعيل مهام اللجان التحقيق والاستجواب.
المحور الثاني:العوائق التي تواجه الأحزاب السياسة المغاربية في كل من المغرب والجزائر .
هناك عدة أسباب جعلت الأحزاب السياسية في كل من المغرب والجزائر لا تستطيع المساهمة في مجال صناعة القرار السياسي، فهي تعاني من عدم الوضوح السياسي والإديولوجي، ومن الهشاشة لتعدد منابعها ومكوناتها، ومن غياب التنظيم الديموقراطي داخلها ، ويمكن حصر هذه الأسباب في ضعف البرامج الحزبية (1)، مما أدى إلى ضعف التأطير والمشاركة السياسية.
- ضعف البرامج الحزبية
يفترض التحول الديمقراطي أن تكون الحياة السياسية تتميز بالتعددية السياسية التنافسية، حيث يتم التداول على السلطة بين الأحزاب السياسية من خلال المشاركة السياسية الواسعة في رسم السياسات العامة للحكومة مع الرقابة القبلية والبعدية على الطرق التي يصرف بها المال العام من قبل السلطة التشريعية ، وبالرجوع إلى الاحزاب السياسية في هذه الدول نجدها لم تنشأ كما نشأت الاحزاب السياسية في الغرب كاستجابة للواقع الاجتماعي والسياسي في تلك المجتمعات إذ ارتبطت بنمو الديموقراطية والحياة البرلمانية ، بل اختلفت في ظروف نشأتها عن الحالة الغربية، فالتجارب الحزبية في هذه الدول كانت محكومة بردّ الفعل أكثر منه بالفعل . لأن العامل التاريخي كان هو العامل الأهم في قيام معظم الأحزاب ، فأغلب الأشخاص المنتمون إلى الأحزاب لا تجذبهم البرامج الحزبية، وإنما الولاء لشخص لديه تأثير معين، وبخلاف ذلك نجد الحالة الغربية تعبِّر فيها الأحزاب عن روح التكامل من خلال الاتفاق على تقسيم العمل السياسي بين أحزاب حاكمة وأخرى تلعب دور المعارضة ومثل هذا التصور للعمل الحزبي قد افترض بداية الانطلاق من فكرة القبول بوجود الآخر وهي فكرة غير متجذرة في الممارسة السياسية في دول المغرب العربي ، ويرى بعض الباحثين أنَّ ارتباط النشأة الحزبية في هذه الدول بفترة الخضوع للاستعمار جعل هذا الأخير ينجح في استثمار هذه الخاصية لضرب القوى الوطنية بعضها ببعض ونشر الشكوك والاتهامات بينها عن طريق تصنيف الأحزاب القائمة إلى معتدلة وأخرى متطرفة حسب قربها منه.
إن الأحزاب السياسية في كل من المغرب والجزائر لم تنجح حتى الآن في التعبير عن الهموم اليومية للمواطن، وما زالت بعيدة عن المطالب الوطنية لشعوبها ، فوسائل الاتصال مع الشارع ضعيفة بالرغم من أن لها الحرية في التعبير عن برامجها وأفكارها في جميع وسائل الإعلام ، ومن خلال الصحف الحزبية .
حيث ارتبطت نشأة الأحزاب السياسية في المغرب والجزائر واستمرارها بشخص مؤسِّسها، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه شخصنة الأحزاب وينجم ذلك عادةً عن غياب الديمقراطية داخلها فلا توجد انتخابات داخلية لتجديد القيادة والتداول السلمي للسلط، كما أن برامجها متشابهة ولا تظهر إلا أثناء الحملة الانتخابية حيث لا يتم الاهتمام بالبرامج بقدر ما هناك اهتمام بالأشخاص فأغلبية الأحزاب لم تعطي للبرنامج الانتخابي قيمته الحقيقية.
فمثلا في الجزائر إن البرامج الحزبية غير واضحة، وذلك لعدة أسباب منها افتقاد لرؤية واضحة حول التنمية بمختلف أبعادها، وتفتقر إلى وضوح للرؤية حول الخروج من الأزمة الأمنية والسياسية، وحول مواجهة المشاكل الاجتماعية. ومن نتائج ذلك خفوت النقاش الإيديولوجي والسياسي بين الأحزاب السياسية، وتراجع الحماس للعمل الحزبي في أوساط المواطنين والسلوك النضالي. فتأييد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول السلم والمصالحة ومشاريع التنمية على سبيل المثال يمثل علامة فشل الأحزاب السياسية في بلورة برامج للتنمية ولحكم البلاد ومعالجة الأزمات، فبدلا من سعي الأحزاب السياسية لتقديم برامج واقتراحات بديلة ومثرية حول مشروع المصالحة وكيفية إنجاحه إن كانت فعلا تسعى لتأييده وإنجاحه، وتقديم برامج واقتراحات حول الأولويات التنموية والموقف من الاستثمارات الأجنبية، ومسألة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والسياسة الضريبية، وغيرها، وبدلا من ذلك اكتفت معظم الأحزاب بالتأييد أو بالتركيز على جوانب أخرى من القضايا السياسية ، لذا ينتقد الكثير من الباحثين والملاحظين غياب القضايا الجوهرية والأساسية من برامج الأحزاب السياسية الجزائرية، مثل تقييم العملية الديمقراطية، الفساد السياسي، علاقة السلطات المدنية مع العسكرية[33].
كما تعرف الأحزاب السياسية في المغرب والجزائر ظاهرة الانشقاقات الحزبية، ويعود ذلك إلى أسباب سياسية وشخصية وطائفية ، وتُعَدُّ الحالة المغربية بالغة الدلالة على تداخل العديد من العوامل المُسَببة لظاهرة الانشقاقات الحزبية حيث انشّق حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية عن حزب الاستقلال ، وعن هذا الأخير انشقت حركة 23 مارس التي لم تسلم أيضاً من الانقسام ، ثم عاد بعض المنشقين إلى الاتحاد الوطني من جديد. ومن الاتحاد الوطني للقوى الشعبية انشَّق الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية . وفي عام1957، تأسَّس حزب الحركة الشعبية الذي انشّق عن حزب الحركة الشعبية الديمقراطية والدستورية في عام1967، كما استفحلت في العقود الاخيرة الاختلالات الداخلية للاحزاب السياسية ، مما اسفر عن تصدعات داخلها حيث افضت في غالب الأحيان إلى فض هذه النزاعات بالانشقاق وتأسيس أحزاب جديدة عوض معالجتها بالطرق الديموقراطية، حيث أن هناك مجموعة من الأحزاب اختارت أن تؤسس أحزاب خاصة بها كحزب الاصلاح والتنمية المنشق زعيمه عبد الرحمان الكوهن عن التجمع الوطني للاحرار، والمؤتمر الوطني الاتحادي الذي اسسه المنشقون عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما ظهرت مجموعة من الأحزاب إما بمبادرة أفراد من المجتمع المدني أو السياسي وأحيانا بمبادرة فرد واحد، مثل حزب قوات المواطنة بزعامة عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورابطة الحريات بزعامة علي بلحاج رئيس جمعية مغرب 2020[34].
وفي الجزائر, أصبحت الانشقاقات داخل الأحزاب ظاهرة حقيقية لم يسلم منها أي حزب، وتزداد حدة هذه الانشقاقات والانقسامات مع اقتراب كل موعد انتخابي. أو اثناء انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجديد هياكل الحزب، فقد عرف هذا النوع من الأزمات كل من حماس في سنة 2008، والنهضة والإصلاح وجبهة التحرير الوطني في 2003. حيث بات من المألوف على الساحة الحزبية أن يحدث الانشقاق بين تيار تصحيحي والأخر موال للقيادة الحزبية الحالية. والكيفية الثانية لحدوث أزمات التناوب تتم عن طريق الانقلابات داخل الأحزاب السياسية كما حدث مع عبد الحميد مهري في حزب جبهة التحرير الوطني، وجاب الله مع حزبه الأول النهضة وحزبه الثاني حركة الإصلاح.
إن السبب الرئيسي لهذه الانشقاقات يرجع بالأساس إلى عدم تفكير الأحزاب السياسية في تحديد آليات تنظيمية واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها. والسبب الثاني يرجع إلى النشأة الحديثة للأحزاب السياسية حيث أن الديمقراطية الداخلية للأحزاب لم تكن من بين الأولويات أمام اعتبارات انتخابية وسياسية أخرى، حيث أن بروز قيادات سياسية غير معروفة للحزب سيكون له ثمن انتخابي باهض على حساب شعبية الحزب التي تتمحور حول القيادات السياسية المؤسسة لها. والسبب الثالث يكمن في الطبيعة الأتوقراطية للأحزاب السياسية في الجزائر حيث تنحصر معظم الصلاحيات في رئيس الحزب من الناحية الفعلية، فالنمط السائد للأحزاب السياسية هو النمط الرئاسي[35].
2-ضعف التأطير والمشاركة السياسية
تمثل المشاركة السياسية أرقى تعبير للديمقراطية لأنّها تقوم على مساهمة المواطنين والمواطنات في قضايا المدينة أو الحي أو المؤسسة.
وتندرج المشاركة السياسية في إطار التعبير السياسي الشعبي وتسيير الشأن السياسي من قبل كلّ أطراف المجتمع وهي مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة سياسية فهي حق وواجب في آن واحد، فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع وواجب والتزام عليه في نفس الوقت، وإنه لمن حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا العامة التي تهمه، وأن ينتخب من يمثله في البرلمان، و يرشح نفسه إذا ارتأى في نفسه القدرة والكفاءة على قيادة الجماهير والتعبير عن آرائهم وطموحاتهم في المجالس النيابية. كما أن المشاركة واجب على كل مواطن، حيث إنه مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات ومسؤوليات اجتماعية تجاه قضايا مجتمعه، لإحداث التغيير اللازم نحو التوجه التنموي في المجتمع. المشاركة إذاً هي الوضع السليم للديمقراطية، فلا ديمقراطية بغير مشاركة.
وعادة ما تظهر المشاركة السياسية في أشكال ومستويات متنوعة، يحتل المستوى الأعلى فيها من يمارسون النشاط السياسي من خلال الانضمام إلى عضوية الأحزاب السياسية، ويحرصون على حضور الندوات والمؤتمرات السياسية، والمشاركة في الحملات الانتخابية، ويشمل المستوى الثاني أولئك المهتمين بالنشاط السياسي، ممن يصوتون في الانتخابات ويتابعون ما يحدث بالساحة السياسية بشكل عام، ويعتبر التصويت هو أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعاً حيث تعرفه الأنظمة الديمقراطية وشبه الديمقراطية، وتعتبر الأحزاب السياسية من الهيئات التي تحمل على عاتقها تاطير المواطنين سياسيا، وإشراكهم في تحمل مسؤولية التسيير وذلك بتكوينهم سياسيا، وتعريفهم بالقضايا الوطنية، وإشراكهم في القرار السياسي، وإعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات، بواسطة الندوات والبيانات والإعلام….وهي بذلك تهيئ منخرطيها للدفاع عن مشروعها السياسي في مختلف مجالات التمثيل كالهيئات المنتخبة والمجالس الجماعية والتشريعية. وتؤهل مناضليها للتعريف بثوابت الحزب، بهدف كسب العديد من المنخرطين.
فالمشاركة في العمل السياسي، تعني الانخراط الجماهيري في الأحزاب السياسية وفي النقابات والمنظمات حيث أنه من وظائف الأحزاب السياسية وظيفة التأطير، سياسيا وتربويا، فكل مشاركة في العمل السياسي ترتبط بمدى قدرة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، على تأمين الديمقراطية وصيانة سلامتها داخل فضاءاتها وهياكلها، وبمدى قدرتها على جعل الديمقراطية، قاسما مشتركا بين قواعد التنظيمات في العمل السياسي، حيث تترجم الديمقراطية كفعل وممارسة، على أرض الواقع، بجلاء ووضوح[36].
كما تعرف الأحزاب السياسية في هذه الدول عزوفا كبيرا من طرف الجماهير لانضمام إليها خاصة لدى الشباب وتردد وإحجام شريحة واسعة من المجتمع عن المشاركة في العمل السياسي الحزبي، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
– عدم قدرة الأحزاب السياسية على تلبية أمال وطموحات المواطنين وترجمتها الى برامج عملية ، واقتصار هذه الأحزاب على النخب السياسية وفشلها في الوصول الى الجماهير وإقناعها ببرامجها وأهدافها فهي لا تجيد فن وآليات التواصل معها لأنها أحزاب موسمية، بمعنى أنها تظهر فقط أيام الحملات الانتخابية أو المناسبات المعينة ثم تختفي بعد ذلك ، فالانتخابات تجري ليس على أسس البرامج الحزبية, وإنما استناداً إلى قضايا وتوازنات أخرى لا علاقة لها بالبرامج الانتخابية. ويمكن إرجاع ذلك إلى عجز الأحزاب في هذه الدول على خلق ثقافة سياسية مدنية ووعي سياسي، ما يعني أنَّ الأحزاب السياسية لمَّ تنضج بعد الأمر الذي يفتح المجال للتشكلات والانتماءات الأخرى مثل العائلة والطائفية.
- معظم الأحزاب السياسية في المغرب والجزائر لا تملك قواعد شعبية تمتد إلى كل أنحاء البلد، فهي تكتفي بوجود مكاتب لها في العواصم والمدن الكبرى وهذا يبين مدى الانقطاع بين الأحزاب وقواعدها الشعبية، لإنها ليست أحزاب توحيد وصهر ودمج، فمعظمها يوجه كل عنايته للمثقفين أو فئة منهم ، كما أن أغلبها لا تلتزم بمبادئها وقراراتها، ولذلك نجد في الغالب هوة سحيقة بين المبادئ البرَّاقة التي تعلنها وبين التصرفات السياسية التي تصدر عنها، فهذه الأحزاب تكتفي فقط برفع شعارات وتدوين مبادئ عامة وحشو بياناتها بأحدث الأفكار والنظريات المستوردة[37] .
- أضف إلى ذلك الواقع التنظيمي داخل الأحزاب السياسية الذي انعكس بدوره على العلاقة بين الأحزاب والمجتمع، والتي هي علاقة محدودة وأصبحت تبنى على أسس مصلحية وانتخابية، من خلال ممارسات القبلية والجهوية والزبائنية في الانتخابات. ونتيجة لذلك فقد المجتمع خصوصا في أوساط المدن الكبرى الأمل من الأحزاب السياسية والتغيير عبر صناديق الاقتراع من خلال الارتفاع المتواصل في نسب المقاطعة الانتخابية في أوساط المدن، والإقبال على النشاطات السياسية، وقد تبلورت توجهات بديلة في المجتمع تنفر من العمل الحزبي والسياسي باللجوء إلى العمل في جمعيات المجتمع المدني.
- ضعف الصلة بين الأحزاب السياسية والمجتمع خاصة الشباب جعل الأحزاب السياسية تبتعد عن أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في محاولة الوصول إلى السلطة فاقتصرت وظيفتها على الوساطة بين المجتمع المدني والسلطة.
- معظم الأحزاب السياسية في هذه البلدان أصبحت امتدادا للإدارة الحكومية وامتداد للسلطة، مما افقدها الكثير من المصداقية أمام الناخبين والمتعاطفين. هذا يبرز من خلال خروج الأحزاب السياسية وتجاوز الأحداث لها أو عدم قدرتها على الاستجابة للمطالب التي يعبر عنها المواطنون في العديد من المناسبات، من خلال العديد من مظاهر الاحتجاجات الاجتماعية والتي اتسمت بالعنف التلقائي( الجزائر مثلا) في منطقة القبائل، بل إن هذا العنف والسخط أتجه بدوره إلى الأحزاب السياسية مثل ما حدث من حرق مقرات أحزاب الارسيدي والأفافاس في منطقة القبائل رغم أنها تمثل معقلا لها ، وحراك الريف في المغرب الذي يدين الأحزاب السياسية [38].
- ظاهرة الترحال السياسي، بمعنى الانتقال من حزب إلى آخر، أو من فريق إلى آخر، أو من تحالف إلى آخر (معارضة حكومة) ، ليست بالظاهرة الجديدة في كل من المغرب والجزائر، فقد لازمت ورافقت هذه الممارسة الحياة السياسية منذ أول انتخابات تشريعية عرفها المغرب سنة 1963، وامتدت واستمرت عبر مختلف المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الجماعية، أو المهنية… وهذه الظاهرة أيضا لا تخص المغرب لوحده، بقدر ما هي ظاهرة يمكن أن نقول عالمية ولكن حدتها وتكرارها تختلف من دولة لأخرى.[39] وهذه الظاهرة، تؤثر على السير العادي للمؤسسات التمثيلية حيث يكون عدد أعضاء كل من الأغلبية والمعارضة غير قار وغير ثابت، مما يفتح المجال أمام كل الاحتمالات ، وقد عانت الطبقة السياسية ومعها بعض الأحزاب السياسية من ظاهرة الترحال السياسي ومن كائنات انتخابية متخصصة وذات مهنية عالية في هذا المجال، والتي أفسدت في أحيان كثيرة، بل ساهمت إلى حد كبير في تمييع الحياة السياسية وتلطيخ المشهد الحزبي، ليهتدي جزء كبير من الطبقة السياسية إلى الحد من ظاهرة الترحال السياسي وعقلنة المشهد الحزبي، وإعطاء عمق ومدلول للانتماء الحزبي وللديمقراطية التمثيلية، في ظل سياقات سياسية جديدة أفرزتها مرحلة ما بعد الربيع العربي[40].
- تردي الخطاب السياسي الذي ينفر المواطن من العملية الانتخابية برمتها وهنا تحيل على الاتهامات التي يتبادلها السياسيون سواء في الحملات الانتخابية وحتى في قبة البرلمان، فخطابها ليس خطابا سياسيا جادا ينبني على التنافس من خلال البرامج والوعود الصادقة ، وهنا نعود إلى دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حيث أن 68% من المغاربة لا يثقون بالأحزاب السيايسية و57 %لا يثقون بالبرلمان.
[1] – بهاء الدين مكاوي، القرار السياسي ماهيته-صناعته- اتخاذه-تحدياته، معهد البحرين للتنمية السياسية، سلسلة كتيبات برلمانية، 2017، ص 6
[2] – جمال علي زهران، الإطار النظري لصنع القرار السياسي، http://www.pidegypt.org
[3] – عملية صنع القرار السياسي: دراسة حالة المجلس الشعبي البلدي في الجزائر “كصانع قرار سياسي،”المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، http://www.democraticac.de
[4]– للمزيد من المعلومات ينظر فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات، عدد 82، 2010.
– يونس برادة، طبيعة النظام السياسي المغربي وجوهر الممارسة الحزبية، www.aljazeera.net
[5] – عبد الله ساعف وآخرون، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، يوليوز 2010، ص 518.
[6] – يونس برادة ، مقال سبق ذكره.
[7] -محمد علي ندور، آليات صنع القرار في السياسات العامة بالجزائر الإطار المؤسساتي، المجلة العربية للعلوم السياسية، العددان 49-50، 2016، ص94-95
[8] – للمزيد من المعلومات ينظر
– فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، مرجع سبق ذكره.
– بوطيب بن ناصر، المؤسسة العسكرية والسياسة في الجزائر، مجلة الديمقراطية،العدد 52،25/10/2013، http://democracy.ahram.org.eg-رياض الصيداوي، سوسيولوجيا الجيش الجزائري ومخاطر التفكك 1و2، الحوار المتمدن، العدد، 1888،بتاريخ17/04/2007
-مسلم بابا عربي، المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر، http://www.ingdz.net [9] – محمد علي ندور، مقال سبق ذكره، ص 95 [10] – صالح بلحاج، أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر، مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، الجزائر، 2011، ص83-84.[11] -رياض الصيداوي،أي دور بقي للمؤسسة العسكرية في الوطن العربي،الحوار المتمدن-العدد: 1966 بتاريخ 2007 / 7 / 4 ، http://www.ahewar.org
[12] – عبد الناصر جابي ومجموعة من المؤلفين، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، يليوز 2010، بيروت لبنان، ص 82-83.[13] – الطاهر سعود،أدوار الجيش في مراحل الانتقال بالجزائر، سياسات عربية عدد 24، 2017يناير ، مركز الدراسات وتحليل السياسات، ص38
[14] محمد علي ندور،آليات صنع القرار في السياسات العامة بالجزائر، الإطار المؤسسي، مجلة العلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية،ص 97
[15] – رياض الصيداوي،أي دور بقي للمؤسسة العسكرية في الوطن العربي، مقل سبق ذكره.
[16] – للمزيد من المعلومات ينظر
كمال القصير، الحسم مع الاستخبارات يعيد رسم خارطة صناعة القرار بالجزائر، مركز الجزيرة للدراسات، 15 سبتمبر 2015.
[17] – محمد الخلوقي، الأحزاب السياسية وصراعاتها في الدول المغاربية، مركز برق للأبحاث ودراسة السياسات، http://barq-rs.com
[18] -سعيد الصديقي،تطور الجيش المغربي: عهدان ونهج واحد، مركز الجزيرة للدراسات، مارس 2015، ص7
[19] – سعيد الصديقي، مقال سبق ذكره ، ص 8
للمزيد من المعلومات ينظر
جون واتربوري، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرون، أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية، مؤسسة الغني، الطبعة الثالثة 2013، ص 381 إلى 385 .
[20] – وللمزيد من المعلومات في هذا الشأن ينظر:
-إحسان حافظي، الجيش، الملكية والنخبة السياسية في المغرب، البنية والسلوك، سياسات عربية، مارس 2017
[21] Jean-Claude Santucci, Le multipartisme marocain entre les contraintes d’un « pluralisme contrôlé » et les dilemmes d’un « pluripartisme autoritaire «,in les partis politiques dans les pays arabes,Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, N°111-112- Mars 2006, pp.63-117
[22]– محمد مدني وأخرون، دراسة نقذية للدستور المغربي لسنة 2011، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2012، http://www.constitutionnet.org، ص27
[23] – الفصل 70 من دستور 2011،
[24] – طه لحميداني، البرلمان المغربي و تقييم السياسات العمومية، أنفاس حقوقية، مجلة مغربية للتنمية الثقافية الحقوقية و القانونية العدد الرابع، ص 10-11
[25] – ينظر العوامل الخاصة بضعف الأحزاب السياسية في المحور الثاني من هذا البحث.
[26] – للمزيد من المعلومات ينظر
فدوى مرابط، موقع الحكومة في دساتير دول المغرب العربي، مجلة دفاتر سياسية، يونيو، يوليوز2008، عدد101
[27] – حيث فاز السيد عبد الإلاه بنكيران برئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
[28] – محمد مدني وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 43.
[29]– الفصل 1 من دستور 2011.
[30]-للمزيد من المعلومات ينظر
ياسين ربوح، الأحزاب ودورها في التنمية السياسية بالجزائر(19996-2008)، رسالة لنيل دبلوم الماجستير، رسم سياسات عامة ،جامعة الجزائر3. كلية العلوم السياسية و الإعلام ،2009
[31] – مصطفى بلعور، طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة القاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر العدد05، جوان 2011، ص 186-.187
[32] – عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لسنة 1996، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص 32
[33] -للمزيد من المعلومات في هذا الصدد ينظر
الامين سويقات، الانشقاقات الحزبية في المغرب والجزائر، دفاتر السياسة والقانون،العدد 5 ، جوان 2016.
[34] – لمزيد من المعلومات ينظر سعيد خمري ، تأملات حول مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية ، أي إطار قانوني للاحزاب السياسية بالمغرب؟ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،ى 2005.
[35] – عبد القادر عبد العالي، مقال سابق.
[36] – محمد اديب السلاوي ،المشاركة السياسية في انتخابات 27 سبتمبر، جريدة الشرق الاوسط، 4 سبتمبر 2002 العدد 8701،//www.aawsat.co
[37] – ألب ولد معلوم، اقع الأحزاب السياسية في الوطن العربي ( سماتها العامة وأهم أزماتها الراهنة،//www.alakhbar.info
[38] – للمزيد من المعلومات ينظر
محمد باسك منار، المشاركة السياسية والانخراط المدني للشباب المغربي بعد تحولات الربيع العربي، أوراق أبحاث مؤسسة قرطبة بجنيف، أكتوبر 2015.
[39] – أحمد مفيد ،الترحال السياسي قراءة سوسيوقانونية ، جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 05 – 05 – 2010.
[40] – للمزيد من المعلومات ينظر:
الأمين سويقات، الأحزاب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغاربية، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر.