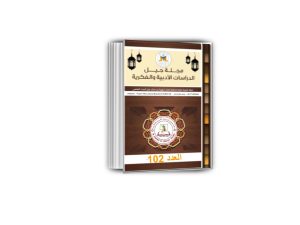مقال نشر بالعدد الرابع من مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ص 9، من إعداد أ.د عبد الحميد عبد الواحد من جامعة صفاقس. تونس، ملحق بجامعة أمّ القرى – مكّة الكرّمة.
للاطلاع على كل العدد يرجى الضغط على غلاف المجلة:
 ملخّص البحث :
ملخّص البحث :
نحن نروم في هذه الدراسة أن نقيم مقابلة بين النحو العربيّ القديم واللّسانيّات الحديثة، وذلك في ما يتعلّق بالبعدين النظريّ والإجرائيّ. وإذا كانت اللّسانيّات البنيويّة الوصفيّة، ممثّلة في بعض اللّغويّين المحدثين العرب، قد وقفت موقفا سلبيّا من النظريّة النحويّة القديمة وانتقدتها كأشدّ ما يكون الانتقاد، فإنّ النظريّة التوليديّة التحويليّة قد أنصفت، في ما أمكننا أن نتمثّله، النحو العربيّ القديم، وذلك للتوافقات الكثيرة التي وجدناها بين النظريّتين، سواء في ما يتعلّق بالتصوّرات المجرّدة المفترضة، أو الإجراءات التوليديّة، وضبط القواعد
وتحديد سياقاتها الموجبة لتطبيقها، وذكر شروطها الملازمة لها. وهذا بغاية الوصول إلى نسق، أو أنساق نحويّة تمثّل النحو أفضل تمثيل.
الكلمات المفاتيح :
اللّسانيّات – النحو – القاعدة النحويّة – النسق النحويّ – التوليد – المنجز – المفترض .
هل هناك ما يسوّغ الجمع في هذا الموضوع بين طرفين قد يبدوان للوهلة الأولى على أشدّ ما يكون الاختلاف. الطرفان، مثلما هو جليّ ومن خلال ما يُوحي به العنوان، هما النحو العربيّ من جهة واللسانيّات الحديثة من جهة ثانية . وهل من شأن هذا الطرح أن يقرّبنا من حقيقة العلاقة القائمة بين هذين الطرفين، وهل الواو الرابطة بين ركني المعادلة هي الواو العاطفة أم غيرها ؟ وإذا ما رجّحنا واو العطف فهل هي تفيد الجمع وحده أم الجمع والترتيب ؟
هذه الأسئلة نطرحها في مستهلّ بحثنا لاعتقادنا في أهميّتها في إثارة جوانب نظريّة إجرائيّة هي نتاج الجمع بين مسألتين هامّتين تبدوان في الظاهر على طرفي نقيض، لا من حيث الفارق الزمنيّ والمكانيّ، وإنما من حيث الخلفيّات المعرفيّة والاختيارات المنهجيّة أيضا.
ولعلّ ما يعمّق هذه البينيّة أو هذا البعد بين النحو من جهة واللسانيّات من جهة أخرى الصفتان الملازمتان لكلّ منهما، إذ الصفة الأولى المتعلّقة بالنحو ، ومثلما هو بيّن ، هي عبارة “العربيّ” .ولا توحي هذه العبارة بالنحو الخاصّ المتعلّق باللغة العربيّة وحدها، وإنما توحي بالبعد التاريخيّ الذي يحيل على النحو القديم أيضا. وأما الصفة الثانية أي المتعلّقة باللسانيّات فهي لا توحي بالحداثة وحدها، وإنّما توحي بالتقابل بين النحو الغربيّ القديم واللسانيّات الحديثة.
هذه المقابلة بين الطرفين المذكورين ظلت قائمة في الأذهان، وذلك منذ عقود، بداية من تأسيس هذا المجال المعرفيّ المختصّ في بلاد الغرب أي اللسانيّات، وكأنّ لا نحو إلّا النحو القديم ( سواء كان عربيّا أو غيره)، ولا لسانيّات إلا اللسانيّات الحديثة .
ومن باب المفارقة قد نشير إلى أن مصطلح النحو، وإن كان مصطلحا قديما، فهو ما فتئ يفرض نفسه في المجالات المعرفيّة الحديثة، وإنّه لَأدلّ على ذلك الاستعمالات الراهنة المتعدّدة الشائعة اليوم والتابعة للأدبيّات اللسانيّة، مثل النحو التوليديّ التحويليّ والنحو المعجم و النحو الخاصّ و النحو الكليّ والنحو الذهنيّ[1]. وفي المقابل فإن مصطلح اللّسانيّات بدوره لم يعد حكرا على اللسانيّات الحديثة، وإنّما هو يطلق على اللسانيّات القديمة أيضا . ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى ما سبق أن ذكره شومسكي في كتابه اللسانيّات الديكارتيّة، وذلك بأنّ اللسانيّات الحديثة ” انقطعت بطواعية عن النظريّة اللسانيّة التقليديّة ، وحاولت إنشاء نظريّة لغويّة بكيفيّة جديدة كلّ الجدّة ومستقلّة. ولم يهتمّ اللسانيّون المحترفون عموما إلا قليلا بالإسهامات المقدّمة إلى النظريّة اللسانيّة من قبل التقليد الأوروبيّ السابق، واهتمّوا بمسائل مختلفة جدّا، داخل نطاق ثقافيّ بعيد عن أن يجعلهم مدركين للمسائل التي أثارتها الدراسات اللسانيّة الأكثر قِدما، والتي أوصلت إلى النتائج المحققّة إلى حدّ الآن، وما زلنا إلى اليوم نجهل كثيرا إسهامات الماضي هذه أو ننظر إليها باستخفاف غير خفيّ”.[2]
إن هذا النقد الصريح الذي يوجّهه شومسكي إلى اللسانيّين المحدثين يجعلنا نعتقد في أهمّية التراث اللسانيّ عموما، والتراث اللسانيّ العربيّ على وجه أخصّ، ويجعلنا لا نأبه بالقطيعة المعرفيّة المفترضة بين الدرس اللسانيّ القديم والدرس اللسانيّ الحديث. وهذا من شأنه أن يجعلنا نعيد النظر في النحو العربيّ (وفي التراث اللسانيّ العربيّ عموما)، لا باعتباره نحوا معياريّا تقعيديّا Grammaire normative مثلما هو قائم في أذهان الكثيرين، وإنّما باعتباره نظريّة لسانيّة . وتبعا لهذا فإن الهوّة بين النحو العربيّ واللّسانيّات الحديثة في اعتقادنا هي هوّة متوهّمة أحدثها البعد الزمنيّ من جهة وتمثُّل اللسانيّات الحديثة (أو لنقل بعض توجّهاتها ) للنظريّات اللسانيّة القديمة من جهة ثانية . ولتوضيح الأمر وحتى لا نسقط في التعميم والخلط سوف نميّز في بحثنا بين اتّجاهين عريضين في اللسانيّات الحديثة ألا وهما :
– اتجاه اللسانيّات البنيويّة الوصفيّة .
– واتجاه اللسانيّات التوليديّة التحويليّة.
ومن باب التوضيح أيضا نشير إلى أنه ليس بمقدورنا الحديث عن اللسانيّات الحديثة بإطلاق، عندما نريد التفصيل في جزئيّات بعض المسائل، لأن هذه اللسانيّات في عمومها باعتبارها علما حديثا هي مشارب شتّى و مدارس مختلفة، ومناهج متفاوتة ما فتئت تنمو وتتطوّر، و بشكل سريع، منذ تأسيسها على يد فردينان دي سوسير في نهاية الربع الأوّل من القرن العشرين إلى يومنا هذا .
1- اللسانيّات البنيويّة الوصفيّة :
إنّ اللسانيّات البنيويّة الوصفيّة في حدّ ذاتها اتجاهات عدّة، ومدارس مختلفة، تُنسب إمّا إلى أصحابها كالسوسوريّة والبلومفيلديّة والهاريسيّة، أو إلى البلد الذي نبتت ونشأت فيه، وذلك مثل دائرة براغ ودائرة كوبنهاغن والمدرسة الفرنسيّة والألمانيّة والأمريكيّة، أو تُنسب إلى اتجاهاتها النظريّة كالوظيفيّة والبنيويّة والتوزيعيّة وغيرها .
بيد أنّ هذه المدارس، وإن اختلفت في توجّهاتها اللسانيّة، وخلفيّاتها المعرفيّة ومناهجها المعتمدة، هي قائمة على جملة من المبادئ المشتركة التي لا يمكن إنكارها،ونحن نسعى إلى إجمالها في النقاط التالية:
1-ادّعاء العلميّة، والتحلّي بالموضوعيّة، ودراسة اللغة أو اللسان دراسة مجرّدة بعيدة عن كلّ انتماء عرقيّ أو إيديولوجيّ، باعتبار أن الكلام موضوع قابل للتحليل والتوصيف، وباعتباره موضوعا جديرا بالدراسة في حدّ ذاته ولذاته، الغاية منه البحث في بنية هذا اللسان أو ذاك، والبحث عن النظام أو الأنظمة المتحكّمة فيه.
2- إنّ هذا المبدأ العلميّ المفترض يقرّ بالقطيعة المعرفية (أو الإبستمولوجيّة) بين اللسانيّات الحديثة و اللسانيّات القديمة ، واعتبار أنّ الأولى قامت على أنقاض الثانية. وعموما يلخّص دي سوسير اتجاهات هذه اللسانيّات القديمة في الأطوار التالية:
_ النحو القديم : وهو ما يعرف بالنحو المعياريّ أو التقعيديّ وقوامه المنطق، وهمّه التمييز بين الصحيح والخاطئ في الاستعمال، وضبط القاعدة النحويّة المتعلّقة بالاستعمال الأمثل le bon usage .
– فقه اللغة (أو الفيلولوجيا): وهو يَدرس اللغة من خلال النصوص المدوّنة وتأويلها، وذلك في علاقتها بالتاريخ أو الأدب أو الدين .
– النحو المقارن: ويبحث في أصل اللّغات، والتوافقات أو الاختلافات الموجودة بين لسانَيْن مختلفين، أو بين ألسن مختلفة ترجع إلى أرومة واحدة.
إنّ هذه الاتجاهات اللّسانيّة القديمة حسب دي سوسير لم تؤسّس علما حقيقيّا، ولم تضبط منهجا محدّدا، ولم تحدّد أهدافا واضحة إلاّ في ما ندر. وهذا ما يشرّع في تصوّره إرساء ما يسمّى باللّسانيّات الحديثة.
3- ومن هذه المبادئ أيضا التمييز بين البحث اللّسانيّ في بعده الزمنيّ (أو الدياكرونيّ) وبعده الآني أي الظرفيّ، ولا مجال للتداخل بين هذين البعدين.
4- اقتصار المدارس البنيويّة الوصفيّة على الملاحظة والوصف والتصنيف بغاية التحليل اللّسانيّ، ولا مجال للافتراضات العلميّة في هذا، وإنّما الاهتمام كلّ الاهتمام ينصبّ على المنجز من الكلام وحده La parole.
5- إنّ دراسة اللّغة أو اللّسان من خلال الكلام هي المبدأ الأساس بالنسبة إلى المدارس البنيويّة الوصفيّة، وذلك في ما يتعلّق بأسبقيّة المنطوق على المكتوب. وما اللّغة عند أصحاب هذه المدارس إلاّ لغة المشافهة، وما الكتابة إلاّ ترميز للمنطوق وصورة تقريبيّة له، هذا فضلا على أنّ الكتابة من شأنها أن تقضي على حيويّة اللغة و تلقائيّتها، وهي تظلّ في كلّ الحالات تقريبيّة لما تنطق به المجموعة اللّسانيّة الواحدة.
6- هذا المنطوق باعتباره أصواتا تتلاشى في الفضاء الخارجيّ، يجدر تدوينه، لا بالكتابة وإنّما بالتسجيل الحيّ، وذلك باعتماد التقنيّات الحديثة لجمع المادة المطلوبة.
7- هذه المادة المجمّعة هي ما يُطلق عليها اسم المدوّنة le corpus. وهي مجموع ما يُسَجَّل، وتُنتقَى منه عيّنات ممثّلة للشريحة الاجتماعيّة التي يُراد دراسة لغتها، أو بالأحرى سجلّها اللّغويّ.
8- تُكثّف هذه المدارس الاهتمام بالشكل أكثر من الاهتمام بالمضمون أو المعاني. ومن هذا التصوّر توسم هذه المدارس اللّسانية بأنّها بنيويّة أو شكلانيّة formalistes .
وملخّص القول، وللخروج بصورة مجملة عن هذه التوافقات الحاصلة بشأن المدارس البنيويّة الوصفيّة بمختلف اتجاهاتها، يكفي أن نشير في هذا الصدد إلى ما ذكره ليونز، وهو من أبرز أعلام هذه المدارس، من أنّ نقاط الاتفاق بين مختلف أصحاب هذه المدارس تتمثّل في اعتبار اللّسانيّات علما تجريبيّا، يقوم على التجربة لا على التأمّل أو الحدس. واللّسانيّ في هذه المدارس يتعامل مع حقائق ملموسة هي حقائق اللّسان أو الكلام. وبالنظر إلى أنّ هذا العلم علم تجريبيّ فهو موضوعيّ، وهو موضوعيّ بقدر ما يبتعد عن الذاتيّة، وعن كلّ التحيّزات الفرديّة والاجتماعيّة والعرقيّة.[3]
2- اللّسانيات البنيويّة الوصفيّة و النحو العربيّ :
للحديث عن العلاقة بين اللّسانيّات البنيويّة الوصفيّة والنحو العربيّ لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ الاستفادة من اللّسانيّات البنيويّة حاصلة لا محالة، وذلك بالنسبة إلى كثير من علماء اللّغة العرب المحدثين، مثلما هي حاصلة بالضرورة للكثير من اللّسانيّين الغربيّين، وهذه الاستفادة عند هؤلاء وأولائك متفاوتة فيما يتعلّق بالتعامل معها، وهم يتراوحون بين الرفض و القبول، أو بين القبول الجزئي أو الرفض الجزئي.
وفي ما يتعلّق باللّغويين المحدثين العرب نحن لا نشكّ في قيمة أعمال كثيرة أنجزوها، تناولت مسائل تهمّ اللّغة العربيّة بالدرس والتحليل والإضافة، فأفرزت بحوثا جيّدة، الاستفادة فيها من اللسانيّات الحديثة واضحة ولا ريب، وإنّ ما أضافته إلى التراث النحويّ مكسب لا ينكره إلّا جاحد. ولكن حسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض الهنات أو النقائص التي طبعت أبحاث هؤلاء، وذلك لوقوفهم عند أطروحات هذه المدارس البنيويّة الوصفيّة المشار إليها وعدم القدرة (أو الرغبة) في تخطّيها إلى ما أُنشئ بعدها، وفي مواكبة تطوّر الدرس اللّسانيّ الحديث. وللتدليل على صحّة ما نذهب إليه لنقف عند جيل من هؤلاء اللغويّين العرب المحدثين ممّن حاولوا إرساء تصوّرات لسانيّة جديدة تسعى إلى أن تقيم أركانها على أنقاض التراث النحويّ العربيّ، وذلك بنقده ودحض أطروحاته والتشكيك في الكثير من منطلقاته وتوصيفاته وتعليلاته، بتعلّة أنّها لا تتماشى وما وصل إليه علم اللّغة الحديث. ولعلّ من أبرز هؤلاء، وممّا لا يخفى على أحد، لغويّون مشهورون لهم باع في هذا المجال أمثال إبراهيم أنيس وتمّام حسّان وكمال محمد بشر وغيرهم. إنّ هؤلاء ودون مزايدات كَالُوا الاتّهامات إلى النحاة العرب القدامى في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضع، وانتقدوهم انتقادات شديدة، وذلك أسوة بالنقد الذي كان يوجّهه أعلام كبار من المدارس البنيويّة الوصفيّة في أوروبا إلى الأنحاء الغربيّة القديمة، وخاصّة منها النحوَيْن اللاتينيّ والإغريقيّ، وكأنّ ما ينطبق على الأنحاء الغربيّة ينطبق بالضرورة على كلّ الأنحاء القديمة، ومن ضمنها النحو العربيّ.
وللتدليل على ما نقول لنعرض لبعض ما ورد في كتابات بعض من هؤلاء اللغويّين المحدثين العرب لنبيّن هذه التصوّرات المجحفة في حقّ التراث النحويّ العربيّ من جهة، وفي حقّ التطوّرات اللّسانيّة التي ما فتئت تظهر يوما بعد يوم من جهة ثانية. فممّا جاء على لسان الدكتور كمال محمّد بشر في حديثه عن المنهج المتّبع في الدرس الصرفيّ، وفيما يخصّ الأفعال المعتّلة على وجه الدقّة قوله: ” إنّ للأفعال المعتلّة منهجين منفصلين: أحدهما تاريخيّ والثاني وصفيّ. ويعنى الثاني منهما بوصف الموجود بالفعل، مضيفا قوله، ولا يجوز لنا أن نتعدّى هذا الواقع بحال من الأحوال ونحصر عملنا في الوصف دون التورّط في افتراض أو تقدير أو تخمين”[4]. وبالنظر إلى ما يقوله الأستاذ كمال بشر وإذا ما قبلنا بالفصل المنهجيّ عنده، وفي اللّسانيات البنيويّة الوصفيّة في التمييز بين المنحى الزمنيّ والمنحى الآنيّ، فليس بالضرورة أن نقبل الحكم على أنّ الدرس اللّسانيّ (وهو وصفيّ بالأساس) أن يقتصر على الموجود، أي على المنجز أو المتحقّق على ألسنة الناس. وبناء على ذلك لا حديث في ما يرى عن الأفعال المعتلّة مثل “قال” و”خاف” و”دعا” و”رمى” إلاّ باعتبارها كذلك. ولا مجال، كما يقول الدكتور بشر، ليتعدّى هذا الوضع بحال من الأحوال. وعليه فإنّ التصوّر المفترض في صيغ من نحو /قَوَلَ/ و/يَقْوُلُ/ و /يَوْصِفُ/ و /مِوْزان/ الخ.. هي من باب الافتراض والتخمين، الذي لا يُقرّه العلم الحديث، أو هي صور مفترضة من باب ما نَطق به الناس تاريخيّا في يوم من الأيّام [5].
إنّ هذا الكلام الذي أورده الدكتور بشر بشأن التصوّر والافتراض مردود عليه. ومبدأ الافتراض هذا مبدأ من مبادئ اللّسانيّات الحديثة مثلما سنراه لاحقا. وهذا الافتراض ليس من باب التصوّر التاريخيّ، وإنّما هو من باب التصوّر النظريّ المجرّد.
و نقرأ للدكتور الطيّب البكّوش، وفي المضمار نفسه، وبشأن النظريّة الصرفيّة أيضا قولَه: ” تتضمّن النظريّة النحويّة عيوبا جوهريّة”، وذلك كالخلط في المصطلحات وفي بعض المفاهيم الصوتيّة والخطأ في تعليل بعض التغيّرات الصوتيّة لانطلاقها من الرسم المرئيّ لا من سلسلة الأصوات المنطوقة[6].
إنّ الحديث عن العيوب الجوهريّة والخلط والخطأ لممّا يشين النظريّة الصرفيّة القديمة حقّا، إن كان هذا موجودا فعلا، وهذا يدعونا بلا شكّ إلا مزيد التمحيص في هذه النظريّة، والالتزام بالقراءة المتأنيّة والموضوعيّة، وعدم التعجّل بإصدار الأحكام.
وأمّا بشأن الأخطاء في هذه النظريّة التي مردّها إلى الانطلاق من الرسم المرئيّ أو الكتابة فهذا لا سبيل إلى قبوله لا من باب التحيّز إلى النحاة القدامى، وإنّما بالنظر إلى أنّ المقصود الذي يرمي إليه هؤلاء ليس الرسم المكتوب مطلقا، وإنّما الصور الصوتيّة الافتراضيّة التي يقرّ علم الأصوات الحديث بأصالتها. فـ “الواو” في يَقُولُ التي أصلها /يَقْوُلُ/ مثلا تعتبر في الحالة الصوتيّة الوظيفيّة مصحّحة عندما تتبعها حركتها، وهي حرف إشباع في حالة التحقّق الصوتيّ عندما تسبقها الحركة التي هي من جنسها. وفي هذه الحالة نطبّق نظريّا قاعدة النقل أو ما يطلق عليه إسكان متحرّك وتحريك ساكن لتصبح الصيغة الجديدة “يَقُوْلُ”. إنّ هذا الإجراء الذي أنجزه النحاة القدامى لهو على درجة عالية من التجريد في تمثّل وضع الحركات من الحروف و الالتجاء إلى الصيغ المجرّدة وتطبيق جملة من القواعد تدخل ضمن نسق القواعد المفترض والذي هو أساس النحو بالمعنى الحديث.
وفي هذا الشأن أيضا يقرّ الدكتور فوزي حسن الشايب بأنّ نظرة النحاة العرب القدامى للمسائل اللغويّة “قد أثقلت كاهل الدراسة اللغويّة بكثير من الأحكام والتأويلات التي تُجافي طبيعة اللغة، ممّا جعل النحو والصرف من أكثر الميادين التي باضت وفرّخت فيها كثير من التخيّلات والمفاهيم الخاطئة والآراء المعدّة سلفا”[7].
إنّ الحكم على النحو العربيّ هكذا بجرة قلم واحدة باعتباره قائما على التخمينات، والمفاهيم الخاطئة، والأحكام المسبقة، لهو أمر ينمّ في تقديري مجدّدا عن عجلة واضحة في إطلاق الأحكام ، وينمّ عن قراءة غير متأنّيّة للنظريّة أو النظريّات النحويّة القديمة، وعن نظرة قاصرة في فهم التراث النحويّ واللّغوي عموما. وليست التصوّرات والافتراضات الصوتيّة (أو الفونولوجية) في اعتقادنا من باب ما ذهب إليه هؤلاء، وإنّما هي من باب الافتراض العلميّ الذي تقرّه مسائل التصريف والاشتقاق في العربيّة. وليس من باب الوهم في تصوّرنا وتصوّر النحاة أن نُرجع “قال” إلى فَعَل و”خاف” إلى فَعِل و”طال” إلى فَعُلَ، وليس من باب التخمين أيضا أن نرجع “قال” و”خاف” و”طال” إلى الواويّ لا إلى اليائيّ، فكلّ هذا له ما يدلّ عليه للبرهنة على صحّته ومقبوليّته.
إنّ هذه النماذج من الأحكام التي تعرّضنا لها ومثل ما تبيّناه، لا تتوانى في وصف التراث النحويّ بالخلط في المفاهيم والمصطلحات، ولا تتوانى في اتهامه بأنه قائم على الأوهام والتخمينات، وبأنه يجافي طبيعة اللغة والوقائع اللّسانيّة. هذه الأحكام هي أحكام، في تقديرنا، أبعد ما تكون عن الموضوعيّة، ولعلّها جاءت من تبنّي الأطروحات اللسانيّة التي روّجت لها المدارس البنيويّة الوصفيّة التي تناوئ الأنحاء القديمة. لكن وللملاحظة نقول إنّ ما يمكن إطلاقه على الأنحاء القديمة الغربيّة، لا يمكن إطلاقه بالضرورة على النحو العربيّ، فضلا عن القصور الواضح عند علماء اللغة المحدثين العرب في فهم أطروحات النحو العربيّ القديم فهما دقيقا من جهة، وفي القدرة على تجاوز حدود هذه النظريّات اللّسانية الحديثة المشار إليها من جهة ثانية ، وفي عدم الاستفادة من أطروحات جديدة غيرها، وعدم الاطّلاع على ما استجدّ في الدرس اللّساني من الحديث.
3- اللّسانيات التوليديّة التحويليّة :
بعد التطرّق إلى اللّسانيّات البنيويّة الوصفيّة وتأثيرها السلبيّ على جملة من اللّغويين العرب المحدثين لنرى ما مدى أهميّة المدرسة التوليديّة التحويليّة في تحويل مسار البحث وتصحيح بعض المواقف المشار إليها سابقا. إنّ اللّسانيّات التوليديّة التحويليّة لهي من نتاجات التطوّر اللّسانيّ الحديث. ولعلّ انبعاثها قائم على نقدها العلنيّ للمدارس البنيويّة الوصفيّة التي كنّا بصدد الحديث عنها. إذا انتقد شومسكي وبشدّة أطروحات أستاذه هاريس، مثلما انتقد أطروحات بلومفيلد وسكنر ونظريّة الانعكاس الشرطيّ، وقلبَ جملة من المفاهيم في الدرس اللّسانيّ والسلوك اللّفظيّ والاكتساب اللّغويّ وغيرها. ولا يخفي أنّ اللّسانيّات التوليديّة التحويليّة سعت إلى أن تُرسي نظرة جديدة للّغة والنحو والتحليل اللّسانيّ وفهم منطلقات الكلام ، ممّا أدّى بها إلى رفض جملة من المفاهيم اللّسانيّة الشائعة، واستبدالها بمفاهيم جديدة ومصطلحات غير المصطلحات السائدة، وباتت النظريّة التوليديّة التحويليّة تنظر إلى اللغة لا باعتبارها أداة للتواصل، وإنّما باعتبارها عددا غير محدود من الجمل أي (+ ما لا نهاية ). وهي تميّز في هذا المنوال بين الجمل الصحيحة والمقبولة، والمقبولة وغير الصحيحة، والصحيحة وغير المقبولة، مثلما هي قادرة على التمييز أيضا بين الجمل الملتبسة ،وبين حقيقة الجمل في بنيتها العميقة وبنيتها السطحيّة . وكلّ هذا حسب ما يقّره حدس المتكلّم المستمع. وتعني الصّحة في هذا المضمار الصحّة التركيبيّة ، في حين تعني المقبوليةّ المقبوليّة من حيث المعنى.
ولا يخفى أنّ النحو التوليديّ التحويليّ حاول في بناء مشروعه النظريّ أن يبني نماذج نحويّة هي عبارة عن أنساق أو جملة من القواعد، هي قواعد توليديّة من جهة، وتحويليّة transformationnelles من جهة أخرى. ومصطلح النحو على ما هو شائع في النظريّة التوليديّة التحويليّة مصطلح مُلتبس، إذ يمكن نظريّا الوصول لا إلى نحو وحيد، و إنّما إلى جملة من الأنحاء المختلفة، وليس ثمّة ما يمنع من المقارنة بينها، وذلك بغاية الوصول إلى النحو الأفضل أو الأمثل. وأفضليّة هذا النحو أو ذاك لا تعود إلى الكفاية الوصفيّة وحدها، بل تعود إلى الكفاية التفسيريّة أيضا، وبهذا المعنى نفهم النحو في بحثنا هذا ولا فرق فيه بين مسائل التركيب أو الإعراب ومسائل الصرف، ولا فصل فيه بين التركيب والدلالة وبين التركيب والمعجم. وانطلاقا من هذا التصوّر
فإنّ النحو التوليديّ قائم على مكوّنات ثلاثة، هي المكوّن التركيبيّ و الصوتيّ و الدلاليّ . والمكوّن الرئيسيّ فيها هو المكوّن التركيبي Le Composant syntaxique . ويتّسم توليد الجمل السليمة في هذا النحو انطلاقا من المعجم أو من الوحدات المعجميّة، وتطبيق القواعد التركيبيّة بما فيها الصوتيّة والصرفيّة، وذلك بغاية الوصول في نهاية المطاف إلى التمثيل الصوتيّ، أي الوصول إلى الجملة باعتبارها كلاما منجزا أو متحقّقا.
وأمّا القواعد التوليديّة والتحويليّة التي يقوم عليها هذا النحو فهي قواعد إعادة كتابة ، وتكون هذه القواعد حرّة أو مقيّدة، أي هي مقيّدة بسياقات محدّدة . وهي تمثّل في كلّ الحالات صياغات صوريّة، تجعلها أقرب ما يكون إلى المعادلات الرياضيّة أو الفيزيائيّة. وأمّا في ما يخصّ بناء هذا النحو، وبالنظر إلى ما سبق أن ذكرنا، رفضت المدرسة التوليديّة التحويليّة فكرة المستويات اللّسانيّة المختلفة في التحليل اللّساني، وفكرة الفصل بين هذه المستويات، مثلما رفضت فكرة المدوّنة والاهتمام بالعيّنات والولع بالمنطوق وما ينتجه المتكلّم المستمع في وضع معيّن. وانطلقت في المقابل من الحدس اللغويّ L’intuition linguistique ، ومن العام إلى الخاصّ، ومن بنية الجملة المفترضة لبلوغ التمثيل الصوتيّ. وفي هذا المضمار ميّزت النظريّة التوليديّة التحويليّة بين البنى العميقة والبنى السطحيّة، وجعلت البنى التركيبيّة تفسيريّة، والبنى الدلاليّة تأويليّة. ولم تَعد اللّغة، في نطاق هذه المدرسة، درسا “علميا” قائما على التجريب، هو أقرب ما يكون إلى العلوم الطبيعيّة، وإنّما جعلتْ منه موضوعا ذهنيّا ، يحاول اللّسانيّ أن يتعرّف من خلاله على ما يجري في الدماغ البشريّ. وهذاممّا دعا أصحاب المدرسة التوليديّة إلى الحديث عن الاستعدادات الفطريّة، والجينات الوراثيّة، ودور هذه الاستعدادات في الاكتساب اللغويّ، والحديث عن النحو الذهنيّ في مقابل النحو النظريّ، والحديث عن الكفاية اللّسانية في مقابل الإنجاز.
وفي الأخير نشير إلى أنّ المدرسة التوليديّة التحويليّة ما فتئت تتطوّر، وتنفي نفسها بنفسها للوصول إلى النموذج الأمثل في دراسة الألسن لا بغرض الوصول إلى الأنحاء الخاصّة أي الخاصّة بكلّ لغة، وإنّما بغرض الوصول إلى ما يسمّى بالنحو الكليّ Grammaire universelle .
4- النحو العربيّ :
من منطلقات المدرسة التوليديّة التحويليّة ليس من اللائق أن نرفض النحو العربيّ أو أن نقبله دون الحكم عليه، أو أن نقلّل من شأنه لا لشيء إلّا لكونه قديما. وقد يكون من الإجحاف أن ننتقد النحو العربيّ انتقادا ينّم عن سوء تقدير أو فهم وعجلة في الخروج بأحكام أو استنتاجات تسمه بالخلط، أو أنّه متورّط في الافتراض والتخمين، أو هو قائم على تأويلات تجافي طبيعة اللّغة على نحو ما سبق أن قدّمناه.
ممّا لا شكّ فيه في أنّ الأسباب الداعية إلى نشأة النحو العربيّ تاريخيّا تكمن في محاولة التصدّي لظاهرة اللّحن، وتقويم اللّسان والعمل على فهم النّص القرآني وتأويله. إلاّ أنّ الطفرة الحقيقيّة التي جاءت مع الخليل وسيبويه ومع من جاء من بعدهما تؤكد بأنّ الصبغة التقعيديّة التعليميّة للنحو ليست هي الطاغية على هذا النحو، وإنّما أمرها متداخل مع البعد التنظيريّ للمسائل النحوية والصرفيّة والصوتيّة. وذلك ممّا جعل النحو العربيّ في عزّ نضجه يمثل نظريّة لسانيّة قائمة بذاتها، تضاهي دون ادّعاء، الكثير من النظريّات اللّسانية الحديثة، وذلك بالنظر إلى كلّيّتها وتكاملها، مع الفارق في الزمان والمكان.
ولهذه النظرية، ولا شكّ، مقوّماتها، وما الفرق بينها وبين النظريات اللّسانية الحديثة إلاّ في ما تروّج له هذه الأخيرة بشأن الجانب النظريّ، وما تقدّمه له، وما تدافع به عنه، وذلك بغاية اختبارها وتوسيع دائرة تطبيقاتها، وتحسين مردوديّتها، وترسيخها وتصحيحها في كلّ مرّة، وصياغتها الصياغة الأمثل. وهذا خلافا، وبلا ريب، لما عليه النظريّة النحويّة العربيّة القديمة التي لا تفصح عن أبعادها، ولا عن منهجها أو خلفياتها المعرفيّة. وإن كان كلّ هذا مضمّنا للعين الفاحصة في غضون الدرس النحويّ، وهو غير معلن، فلا يمكن الاهتداء إليه إلاّ بعد نظر واستقصاء، وذلك من خلال القرائن الدّالة التي نستشفّها من أبعاد التحليل والتأويل والتبويب وتنظيم المادة اللغويّة ، أو من خلال بعض الإشارات والتعريفات والتلميحات القليلة الواردة في ثنايا البحث. علما أنّ المنهج المتّبع في الآثار النحويّة القديمة غير معلن بدوره إلاّ لماما، وإن لا بدّ من حسن تمثّله من خلال ربط الجزئيّات بالكليّات، وإعادة تنظيم المادة أو ترتيبها.
ولعلّ من أبرز مقوّمات هذه النظريّة ما شاع في كتب أصول النحو مثل السماع والقياس والتعليل، فضلا عن الاستقراء والاستنباط والوصف والتصنيف. وهي كلّها مقومات متّبعة في الدرس اللّسانيّ الحديث، وإن اختلفت الرؤى والمفاهيم والمصطلحات. والنظريّة عموما لا بدّ أن تقوم بضبط مجالها المعرفيّ، وأن تضع الحدود الفاصلة بينها وبين مجالات أخرى قريبة منها أو بعيدة عنها. وعلى هذا الأساس رسمت النظريّة النحويّة العربيّة القديمة العلاقات التي تربطها بمجالات أخرى قريبة منها مثل الصرف والاشتقاق وعلم اللغة والإعراب. فجمعت بين الإعراب والصرف في حالات، وفصلت بينهما في حالات أخرى. و نظرت إلى الصرف باعتباره قسمين: قسم يهتمّ بالصيغ والأبنية والزيادة، و قسم يهتمّ بالتغيّرات الطارئة على الكلمات. وقربّت بين الاشتقاق وعلم اللّغة، وباعدت بين الاشتقاق والإعراب. ومن هنا تتداخل الأصوات بالأبنية، وتتداخل الأصوات بالإعراب، ويتداخل الصرف بالتركيب، والتركيب بالمعجم والدلالة الخ..
ولا تكتفي النظريّة النحويّة العربية بضبط مجالها المعرفيّ، وإنّما هي تسعى إلى إرساء جهازها المفاهيميّ والاصطلاحيّ، والعمل على وضع التعريفات أو الحدود والرسوم اللّازمة. وتعتبر المفاهيم، والحالة هذه، المقوّم الأساسيّ للنظريّة لأنّها هي التي يقوم عليها التحليل والدرس اللّساني عموما. وهذه المفاهيم تستمدّ مصطلحاتها من اللّغة ليغدو المصطلح وضعا على وضع، أو مفتاحا من مفاتيح أهل الصناعة.
و قد يكون من السهل حقّا أن نتحدّث في بداية التأسيس للنحو العربي عن مفاهيم باتت رائجة عندنا، من نحو الإسناد والإعراب والعمل والأثر العاملي والابتداء والخبر والتجرّد والزيادة والصحة والإعلال و البدل والقلب والإدغام والإسكان والحركة والوقف والإمالة وغيرها.
و لا تقف هذه النظريّة عند حدود المفاهيم أو المصطلحات أو التعريفات، وإنّما لا بدّ لها من رصد الظاهرة ووصفها، والبحث عن الخصائص المشتركة المتعلّقة بها وما يقابلها بغيرها، بغاية الوصول في آخر الأمر إلى استنباط القوانين العامّة أو الشاملة، والتثبّت من صحّة تطبيق هذه القوانين، وما يخرج من مجال تطبيقها.
و بهذه الاعتبارات، وإذا ما نظرنا إلى أيّ مسألة من مسائل اللّغة الكفيلة بالدرس، فإنّنا سوف نجد مدخلا منهجيّا واحدا لا يفتأ يتكرّر هو الملاحظة. والملاحظة في النظريّة تستند إلى السماع أي إلى ما يُنجز من الكلام، و ما هو متواتر في الاستعمال. ولا تعدّ الملاحظة غاية في حدّ ذاتها، إذ هي صالحة للوصف والتصنيف ثمّ التفسير أو التعليل، وذلك بغاية استنباط القاعدة بالاعتماد على جملة من المقوّمات كالقياس والاستقراء والاستنتاج الخ..
ومن باب التوضيح وإثبات صحّة ما تذهب إليه النظريّة النحويّة العربيّة، نأخذ أمثلة من الصرف العربيّ، وتحديدا مثال قلب حرف العلّة ألفا، فنخلص إلى ما يلي: تقول القاعدة الصرفيّة الصوتيّة في هذا المضمار “إذا تحرّك حرف العلّة وكان ما قبله مفتوحا قلب ألفا”. هذه القاعدة مثلما ضبطتها النظريّة النحويّة، ومثلما تعلّمناها ونعلّمها، لا بدّ لها من قدرة على الإلمام بحقائق اللّغة وجزئياتها، ولا بدّ لها من حسّ لغويّ يجعل النحويّ قادرا على أن يعالج مثل هذه القضايا، وإن بدت لنا اليوم بديهية إلّا أنّهها لم تكن كذلك في بداية التأسيس. فمفهوم القلب لا يدرك وحده ولا قيمة له في حالة انعزاله عن بقيّة الظواهر الصوتيّة الصرفيّة الأخرى، وبالتالي لا بدّ من ربطه بمسائل أخرى كثيرة كالحذف والنقل والبدل والإسكان. وهذه المسائل مجتمعة لا معنى لها بمعزل عن التغيّرات الطارئة على الكلمة في باب الصرف. والكلمة نفسها لا تفهم إلاّ في نطاق أقسام الكلم وعلاقة الفعل بالاسم وعلاقة الفعل و الاسم بالحرف الصحيح. والحرف عموما لا معنى له إلاّ في مقابل الحركة. والحركات لا بدّ من ضبطها، والحروف كذلك، وكلّ هذه الأصوات أو الصواتم (الفونيمات) لا بدّ من معرفة مخارجها أو مواضع نطقها، وتحديد صفاتها، ودرجة الانفتاح فيها. ولا حديث عن السياق الموجب للتغيير، أي تحرّك حرف العلّة وانفتاح ما قبله إذا كنّا غير قادرين على إدراك معنى الافتراض. والافتراض في هذه الحالة يتعلّق بالأفعال والأسماء المعتلّة خاصّة، وذلك من قبيل الأجوف والناقص والمضاعف والمهموز. وهذه الأفعال والأسماء القابلة للتغيير عموما لا بدّ من إرجاعها إلى أبنية محدّدة، ليكون باب الأفعال أو الأسماء الصحيحة والمعتلة واحدا، وذلك من باب التقدير.
وأمّا التغيير الذي تمليه هذه القاعدة فلابدّ له من أن يتعلّق بقواعد أخرى فرعيّة، وذلك بالإضافة إلى القاعدة الأساسيّة. والقواعد الفرعيّة في حالتنا هذه هما قاعدتان مكمّلتان للقاعدة الأصل، تعرف الأولى بقاعدة الإيهان وتعرف الثانية بقاعدة الإشباع. وقاعدة الإيهان من شأنها أن تضعف حرف العلّة، وذلك بحذف حركته حتّى نتمكّن من قلبه. والقاعدة الثانية (أو الثالثة في الترتيب) هي قاعدة الإشباع التي تقضي بإشباع الحركة في جوارها لحرف من حروف المدّ واللّين يكون مجانسا لها. وقاعدة القلب في حدّ ذاتها لها أصل وفرع. فأمّا الأصل فما نحن بصدد الحديث عنه، وأمّا الفرع فهو أن يُقلب حرف العلّة إذا جاء متحرّكا وكان ما قبله ساكنا، وذلك في أمثلة من نحو “أقام” و”استقام” و”استبان” التي أصلها وعلى التوالي /أَقْوَمَ/ و/اسْتَقْوَمَ/ و/اسْتَبْيَنَ/. ويتمّ التغيير في هذه الحالات بشروط إضافية تتعلّق بالصيغ لا بالسياقات لا حاجة لنا للدخول في تفاصيلها[8]. وجدير بالملاحظة أنّ لكلّ من القاعدتين الأم والفرع شواذا تُطرح من مجال تطبيقهما. والقاعدة الأمثل في النحو هي التي تأخذ بعين الاعتبار هذه الشواذ، وتحدّ منها بقدر الإمكان وذلك بالزيادة في فعاليّة هذه القاعدة أو تلك، وبتدقيق صياغتها، وضبط سياقاتها والشروط الملازمة لها.
هذا مثال من النظريّة النحويّة مأخوذ من مجال الصرف. وكلّ جزئيّة من جزئيّات النحو أو الصرف هي في اعتقادنا بحاجة إلى إعمال نظر وتدبّر. وكلّ هذا يجعلنا نقرّ بأنّ النحو العربيّ بالمعنى الدقيق للكلمة ليس نحوا معياريّا تقعيديّا مثلما يشاع عند الكثير من الناس، من شأنه أن يضبط الصحيح والخاطئ أو أن يقوّم الألسن، أو أن يقول هذا فاعل وهذا مفعول، وهذا مبتدأ وهذا خبر، وهذا صحيح وهذا معتلّ وما شابه ذلك، وإنّما هو في الواقع يذهب إلى أبعد من هذا، وذلك في وصف الظاهرة في حدّ ذاتها، ومقابلتها بغيرها من الظواهر الأخرى القريبة منها أو البعيدة، وتصنيف المسائل النحويّة بالنظر إلى الخصائص المشتركة، ومعالجة كلّ ظاهرة وتوليدها من ظواهر أخرى، وتعليلها في نهاية المطاف، وكلّ هذا من عمل اللّسانيات بامتياز.
5- التوافق بين النحو التوليديّ والنحو العربيّ :
قد يكون من المفارقات، أو لعلّه من باب توارد الخواطر أن نجد هذا التوافق العجيب بين النحو العربيّ والنحو التوليديّ، وذلك بالرغم من الهوّة الزمنيّة الفاصلة بينهما، واختلاف الخلفيّات المعرفيّة المتحكّمة في كلّ منهما، واختلاف المنطلقات وبيئة النشأة أيضا. هذا التوافق الذي نَلفت الانتباه إليه يثير في الحقيقة دهشة كبيرة بالنظر إلى الشبه الحاصل بين النظريّتين،أي النظريّة النحويّ القديمة والنظرية التوليديّة التحويليّة، وخاصّة في ما يتعلّق ببعض التصوّرات والافتراضات، وتطبيق القاعدة وضبط سياقاتها والشروط الملازمة لتطبيقها. ومن هذه التوافقات، ونحن حريصون أن نبقى في مجال الصرف باعتباره مكوّنا من مكوّنات النحو، نشير إلى ما يلي:
– اللّجوء في التحليل اللّسانيّ إلى الاستعمال، والتعويل على الحدس اللّغوي أو ما يُطلق عليه السجيّة اللغويّة عند اللّغويّين العرب القدامى.
– افتراض الصيغة المجرّدة أو ما يعبّر عنه بالأصل في مقابل الصيغة المنجزة. وإذا كانت الصيغة المنجزة أو المتحقّقة التي ينطق بها المتكلّم المستمع هي من باب الحاصل المنطوق، فإنّ الصيغة المجرّدة هي من باب الافتراض. ولا يعني الافتراض هنا التخمين، مثلما يرى بعض علماء اللّغة المحدثين، وإنّما هو افتراض له ما يقّره ويبيّن صحّته، وذلك بالنظر إلى آليات الاشتقاق وتوليد الصيغ بعضها من بعض.
– التحوّل من الصيغة المفترضة إلى الصيغة المنجزة، ويتمّ هذا وفق تطبيق جملة من القواعد، في مجملها هي قواعد إعادة كتابة، أي أن نعيد كتابة العنصر (أو مجموع العناصر) “أ” بالعنصر أو مجموع العناصر “ب”. وما إعادة الكتابة هذه إلاّ توليد صيغة من أخرى، تتحقّق في سياقات معيّنة تُحدّ يمنة بالعنصر “س” ويسرة بالعنصر “ع”. هذا فضلا على بعض الشروط الملازمة للقاعدة، وذلك للتقليل أكثر ما يمكن من الشواذّ التي تفلت من تطبيق القاعدة. هذه القواعد يَفيض بها النحو العربيّ، وذلك من قبيل “قلب حرف العلّة ألفا” و”قلب الواو ياء” والعكس، و”الحذف لالتقاء الساكنين” و “إدغام المثلين” الخ…
– تُكوّن هذه القواعد نسقا نحويّا تخضع فيه لترتيب معيّن، بحيث لا يمكن تقديم قاعدة على أخرى، أو الإخلال بهذا الترتيب، أي أنّ القاعدة الأولى لا بدّ أن تطبّق قبل الثانية، والقاعدة الثانية لا بدّ أن تطبّق قبل الثالثة وهكذا دواليك. فلو أخذنا على سبيل المثال توليد صيغة “قال” من /قَوَلَ/، وللوصول إلى الصيغة السليمة انطلاقا من الصيغة المفترضة نطبّق ثلاث قواعد متتالية: هي قاعدة الإيهان، وقاعدة القلب، وقاعدة الإشباع، ولا سبيل إلى تقديم قاعدة على أخرى.
– و ممّا تُمكن ملاحظته بشأن هذه القواعد أنّ لها أولويّات في التطبيق، بمعنى لا يجب تطبيق قاعدة على حساب أخرى، وذلك إذا ما تشابهتا، ممّا يجعل قاعدة معيّنة أقوى من قاعدة أخرى، وهذا من نحو تطبيق قاعدة “التقاء الساكنين” على حساب قاعدة “الإشباع”، وذلك في حالة وجود حرف ساكن بعد حرف المدّ واللّين .
– تراعي هذه القواعد في التطبيق حالات أمن اللّبس، فيُمنع تطبيق قاعدة ما إذا كان تطبيقها يؤدّي إلى الالتباس، سواء كان في المعنى أو الصيغة. ومن هذه الحالات عدم تطبيق قاعدة “الإدغام” على أمثلة من قبيل “جَلببَ” أو “اسْحَنْكَكَ”، لأنّ في تطبيقها إبطال للإلحاق.
إنّ هذه التوافقات المعتبرة في تصوّرنا هي التي تجمع بين طرفي المعادلة، أي بين النحو العربيّ القديم واللّسانيّات الحديثة، وممّا يجعل إمكانية ربط الصلة بين هذين الطرفين المذكورين قائمة، وإن اختلفت الخلفيّات المعرفيّة ونشأة الأصول. وما التوافقات التي أشرنا إليها في هذا العرض إلاّ مجال من مجالات النظريّة (أو النظريّات) اللّسانيّة. اقتصرنا فيها على جوانب من النظريّة النحويّة القديمة، هي الجوانب الصرفيّة أو بالأحرى الصرفيّة الصوتيّة (أو الصوتميّة)، حاولنا من خلالها أن نعيد قراءة بعض المسائل الصرفيّة، وذلك بالتوسّل بأدوات منهجيّة حديثة نراها مفيدة لإعادة قراءة النظريّة الصرفيّة، بل النحويّة عموما والتراث اللّسانيّ العربيّ بوجه أعمّ. ويظّل النحو المفترض في هذه الحالات نحوا من جملة الأنحاء القابلة للمقارنة في ما بينها، وذلك بغاية الوصول إلى النحو الأفضل. والأفضليّة على ما ذكرنا آنفا لا تتعلّق بالكفاية الوصفيّة وحدها، وإنّما تتعلّق بالكفاية التفسيريّة أيضا.
الهوامش :
1-النحو التوليديّ التحويليّ:
نظريّة لسانية قائمة على مكوّنات النحو والصوت والدلالة، نشأت على يد نعام شومسكي ومرّت بمراحل أهمّها مرحلة 1957 و1965 و 1973 و 1980 و ما بعدها. و يركّز النحو التوليديّ على المتكلم المستمع المثاليّ في إنجاز كلامه، ومن هنا جاء التمييز بين الإنجاز والكفاية اللسانيّة، وبين البُنى العميقة للجمل و البنى السطحيّة. والنحو التوليديّ قائم على قواعد توليديّة من جهة وقواعد تحويليّة من جهة ثانية ، وذلك في محاولة لإرساء نسق من القواعد وبالتالي إرساء النحو. والقواعد في مجملها هي قواعد إعادة كتابة سواء كانت حرّة أو مقيّدة.
النحو المعجم:
نظريّة لسانيّة تهتمّ بوصف اللّغة شكليّا بغاية إنشاء ما يُطلق عليه القواميس الإلكترونيّة. نشأت هذه النظريّة على يد اللّسانيّ الفرنسيّ موريس غروس في أواخر الستّينات ، وهي تطوير للنظريّة التوزيعيّة الأمريكيّة التي تُنسب إلى زليق هاريس والقائمة أساسا على التحويل. و النحو المعجم يهتمّ كثيرا بالجانب الإجرائيّ وجمع الوقائع اللّسانيّة والاعتماد على الاستعمال الشائع، كما تهتمّ بالمتطلّبات الشكلانيّة في التحليل اللّساني بغاية المعالجة الآليّة . وهي تدرس الوحدات المعجميّة في علاقتها الوثيقة بالخصائص التركيبيّة ولا أهميّة للمعنى خارج التركيب، ومن هنا جاءت شرعيّة التسميّة القائمة على الدمج بين النحو والمعجم.
النحو الخاصّ:
هو نظام القواعد المتعلّقة بلسان ما والمتعلّق بالتصوّر نفسه الذي سبق أن أشرنا إليه في النحو التوليديّ التحويليّ، وذلك بناء على البنى العميقة والسطحيّة، وعلى القواعد التوليديّة و التحويليّة وعلى قواعد إعادة الكتابة التي تحاول أن تجمع في التحليل اللسانيّ بين المكوّنات الثلاثة : التركيبيّة والدلاليّة والصوتيّة.
و يتقابل النحو الخاص مع النحو الكليّ وإذا كانت قواعد هذا الأخير هي قواعد كليّة أو كونيّة فإنّ قواعد النحو الخاصّ تتعلّق بلسان معيّن، وإن شابه ألسنة أخرى أو خالفها.
النحو الكليّ:
و هو ممّا يهتمّ به النحو التوليديّ، غايته أن يطبّق على كلّ اللّغات الطبيعيّة، سواء منها المنطوقة أو المكتوبة، و ترجع جذور هذه النظريّة إلى بور روايال Port Royal ولها علاقة بالمنطق. و يشيع النحو الكليّ في جوانبه الدلاليّة عند مونتان montagne أيضا و الخلاف بين شومسكي و مونتان غير خاف، باعتبار أنّ الدلالة عند مونتان هي مكوّن من مكوّنات المنطق ولا ترجع إلى علم النص وقد لا تكون بالضرورة قاعدة تركيبيّة أو دلاليّة تُعزى إلى المتكلّم المستمع مثلما يتصوّر شومسكي ذلك، وإنّما تُعزى إلى النحو الكليّ المشترك بين كل الألسن، والنحو الكليّ هو القواعد الكليّة التي تشترك فيها الألسن الطبيعيّة ولها مساس شديد بالمبنى لأهميته وتظهرجليّا في عمليّة الاكتساب اللغوي.
النحو الذهنيّ :
النحو الذهنيّ نسق قواعد مفترضة توجد في ذهن المتكلّم المستمع، وهو يعود إلى الاكتساب اللغويّ والاستعدادات الفطريّة الموجودة عند كلّ الناس ، وهو يرجع إلى التعامل مع كلّ لغة خاصّة في نطاق المجوعة اللّسانيّة الواحدة مهما تكن صورتها. و قد يشمل هذا النسق الخاص قاعدة تعود إلى النحو الكليّ أو إلى النحو الخاصّ. وتمسّ هذه القواعد المكوّنات اللّسانيّة الثلاثة، التركيبيّة والصوتيّة و الدلاليّة. والنحو الذهنيّ لا يُتعلّم وإنّما هو موجود بالقوة في الذهن أو الدماغ.أشرنا إليه في النحو التوليدي التحويلي
-Shomsky, N. : La linguistique cartésienne, P.152
3- ليونز: اللغة و علم اللغة. ترجمة التوني. ص ص 50- 51.
4- كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة. ص.16
5- و يقول ابن جنّيّ في هذا الغرض: ” و إنّما معنى قولنا إنّه كان أصله كذا: أنّه لو جيء مجيء الصحيح ولم يُعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا. فأمّا أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك، ثمّ انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر”. (الخصائص ج.1 ص.257) .
6- الطيّب البكّوش: التصريف العربيّ من خلال علم الأصوات الحديث. ص 20.
7 – فوزي حسن الشايب: تأمّلات في بعض ظواهر الحذف الصرفيّ .ص.16
8- لمزيد من التفصيل انظر مقالنا “قلب حرف العلّة ألفا” .
قائمة المراجع
1- بالعربية:
* الأستراباذي (رضي الدين): شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق محمّد نور الحسن ، ومحمّد الزقراف، و محمّد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية. بيروت 1982.
* د.بشر (كمال محمد): دراسات في علم اللغة. دار المعارف بمصر. القاهرة 1973.
* د. البكّوش (طيّب): التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. ط.2. المطبعة العربية. تونس 1987 .
* ابن جنّيّ (أبو الفتح): الخصائص. تحقيق علي النجّار، ط.2. دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت (د.ت).
* د.الشايب (فوزي حسن): تأمّلات في بعض ظواهر الحذف الصرفيّ. حوليّات كليّة الآداب. الحوليّة العاشرة. الرسالة 62. جامعة الكويت. 1988 – 1989 .
*شومسكي (نعام): اللغة و مشكلات المعرفة. ترجمة د.حمزة بن قبلان المزيني. دار توبقال للنشر. الدار البيضاء، المغرب 1990 .
* عبد الواحد (عبد الحميد): من أصول التصريف: شرح التصريف الملوكي. وحدة بحث اللسانيّات والنظم المعرفيّة المتّصلة بها. قرطاج للنشر والتوزيع. صفاقس. تونس 2010.
* عبد الواحد (عبد الحميد): “قلب حرف العلّة ألفا”. بحوث جامعية. مجلّة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة. العدد الثاني. صفاقس. تونس. جانفي 2002.
* عبد الواحد (عبد الحميد): بنية الفعل. قراءة في التصريف العربي. كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة. صفاقس. تونس 1996.
* ليونز (جون): اللغة و علم اللغة. ترجمة مصطفى التوني. ج.1. دار النهضة العربيّة. القاهرة 1987.
* ليونز (جون): نظريّة شومسكي اللغويّة. ترجمة د. حلمي خليل. دار المعارف الجامعيّة، الإسكندريّة. مصر 1985 .
* ابن يعيش (موفّق الدين): شرح الملوكيّ في التصريف. تحقيق د. فخر الدين قباوة. المكتبة العربيّة بحلب. سوريا 1973.
2- بالفرنسية:
- Chomsky, N. : (1965) Aspects de la théorie syntaxique, Tr. Milner, Seuil. Paris 1971.
- Chomsky, N. : La linguistique cartésienne, Tr. Delanoé, N. et Sperber, D. Seuil. Paris 1969.
- Chomsky, N. et Halle, M. : (1968) Principes de phonologie générative, Tr. Encrevé,P. Seuil. Paris 1973.
.