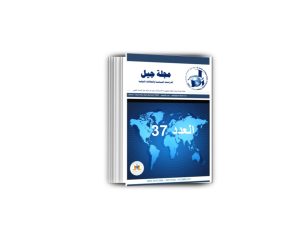النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير -صراع إقليمي بأبعاد دولية-
India-Pakistan dispute over Kashmir: Regional conflict with international dimensions
زكرياء الهكار- معهد الدوحة للدراسات العليا-
Zakaria El-Hagar – Doha institute for graduate studies-
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 33 الصفحة 69.
ملخص:
تلخص هذه الورقة أبرز مراحل النزاع بين باكستان والهند، حول أزمة كشمير، الأزمة التي اندلعت قبل أزيد من ثمانين سنة بين دولتين نوويتين وهما الهند وباكستان، ما جعل من هذه الأزمة محط أنظار العالم وتوجسه، فبعد مرور عقود لا زال النزاع القائم بين الجارتين يطفو على الساحة الدبلوماسية العالمية، وبهدف فهم حقيقة هذه النزاع سلطنا الضوء على تاريخه وأبرز محطاته الكبرى، معتمدين على تقديم تحليلات جيوسياسية لطبيعة النزاع، وكذلك أثاره الحالية والمستقبلية، لا على الأطراف فقط وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.
Abstract
In this research, we touched on the most prominent stages of the conflict between Pakistan and India, over the Kashmir crisis, the crisis that erupted more than eighty years ago between two nuclear-armed states, which made this crisis the focus of the world’s attention and apprehension. After decades, this crisis between the two neighbors is still floating in the diplomatic arena The international community has repeatedly, and to understand the reality of this conflict, we have shed light on its history and its major milestones, relying on providing geopolitical analyzes of the nature of the conflict, as well as its current and future effects, not only on the parties, but on the regional and international levels.
مقدمة:
في هذه الورقة نسلط الضوء على أزمة كشمير، بين دولتين كبيرتين في المحيطين الإقليمي والدولي، بقوتهما البشرية ومساحتهما الكبيرة والأهم قوتهما النووية، التي تجعل من هذه الأزمة محط أنظار العالم وتوجسه، فالنزاع حول الأرض من النزاعات التي تطول مدة حلها، وهذا راجع بالأساس إلى عدم القدرة على استنباط حلول مقبولة للأطراف، ما يشكل تحد حقيقي في سبيل حل هذا النوع من النزاعات التي في الغالب ما خلفتها القوى الإمبريالية على الأراضي التي كانت تحت سيطرتها.
تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند من الجنوب، هو إقليم كشمير الذي تبلغ مساحته أزيد من 84400 ميل مربع، يقسمها خط وقف إطلاق النار منذ عام 1949، ويعرف بخط الهدنة منذ اتفاقية شملا الموقع عليها عام 1972[1] ،يشكل المسلمون فيه أزيد من %90، من أصل ستة ملاين نسمة حسب الإحصائيات الهندية، بينما تتحدث المصادر الكشميرية المحلية عن أزيد من ثلاثة عشر مليون نسمة[2].
المصدر: http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/5/13/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8
إن الموقع الاستراتيجي الذي يحتله إقليم كشمير بين وسط أسيا وجنوبها جعل منه بؤرة نزاع بين الهند وباكستان، تمثلت في صراعات مسلحة تخللتها بعض فترات الهدنة، خاصة بعد دخول مجلس الأمن على الخط وعقد عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للحيلولة دون نشوب نزاعات مسلحة بين الطرفين، كان أبرزها اتفاقية شملا سنة 1972، وانطلاقا من هذه السنة ستتطور الأحداث بشكل متسارع على المستويين الإقليمي والدولي.
وبغية فهم هذا التطور نطرح التساؤلات الإشكالية التالية:
ما هي تمظهرات أزمة كشمير؟ ومن هي الأطراف الرئيسية و الثانوية في النزاع؟ وكيف تعاملت مختلف الأطراف مع هذه القضية؟ وهل هناك حلول مقترحة؟
سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال تقديم خريطة لهذا النزاع conflict mapping انطلاقا من سنة 1972 وهي السنة التي تميزت بعقد إحدى أهم الاتفاقيات بين الجانبين الهندي والباكستاني.
- الجذور التاريخية للنزاع
بعد استقلال باكستان عن الهند بموجب القرار الذي اتخذه حزب الرابطة الإسلامية لعموم الهند في لاهور بتاريخ 23 مارس 1940، ستنشأ مشكلة كشمير في ظل إعطاء حرية تقرير المصير للإمارات الهندية، فانضمت كلها لباكستان والهند، ما عدا ثلاث إمارات وهي: جوناكادا، وحيدر اباد، وكشمير[3].
أغلبيتها الإسلامية وقربها الجغرافي والاقتصادي لباكستان لم يشفع لكشمير بالانضمام لها، حيث أن حاكمها الهندوسي مال نحو الانضمام للهند، من هذه النقطة سيتشكل الصراع الهندي الباكستاني، فمباشرة بعد خروج المستعمر البريطاني من الهند، نشب النزاع بين الطرفين، ورأى الرئيس الباكستاني محمد علي جناح حينها أن التاريخ والدين والشعب المسلم في صالحه، أما الحاكم الهندوسي نهرو فقد ضرب رغبة شعبه المسلم في الانضمام إلى باكستان عرض الحائط، بيد أنه تردد في إعلان انضمام الإقليم لإحدى الدولتين عكس باقي الإمارات التي سارع حكامها في إعلان الانضمام، ورغم نشوب صراعات في بعض الإمارات خاصة السالفة الذكر، بحيث أن إمارة جوناكادا ذات الأغلبية الهندوسية والحاكم المسلم أعلنت الانضمام إلى باكستان وهذا ما رفضته الهند بالتالي دخولها للإقليم وتنظيمها لاستفتاء انتهى بضمها إلى الحظيرة الهندية، ذات الأمر حصل مع إقليم حيدر اباد.
ستتطور الأحداث بعد هذه المرحلة بشكل متسارع حيث شهدت المنطقة نشوب حرب 1947 بين الهند وباكستان والتي أطلق شرارتها إقليم كشمير، بالتالي تقديم سبب وجيه لبدأ المناورات الدبلوماسية، إذ عرضت الهند الملف على أنظار مجلس الأمن الدولي في يناير 1948، الذي عكف على معالجة القضية عبر إصداره عدد من القرارات المتضمنة لاتفاق وقف لإطلاق النار في كشمير، وكذلك اتفاقية هدنة بين البلدين، وانطلاقا من مبدئ حرية تقرير المصير عملت اللجنة المشكلة من مجلس الأمن والأطراف موضوع النزاع إلى تحديد الشروط العادلة التي تكفل التعبير الحر عن إرادة سكان كشمير وذلك عن طريق تنظيم استفتاء بإدارة مشتركة، إلا أن الطرف الهندي رفض هذا الخيار وذلك إيمانا منه بأن النتائج لن تكون لصالحه، بسبب الأغلبية المسلمة التي تفضل الانضمام إلى باكستان، وهو الأمر الذي اعترف به مجلس الأمن ضمن قراره[4] .
إن فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للمشكل المتفاقم وإقراره بذلك كان إيذانا ببدء فترة جديدة من تاريخ النزاع، والمتمثلة في انصراف كل من الهند وباكستان لمعالجة الموقف تبعا لمصالح قومية بعيدا عن أي التزامات إقليمية، وفي ظل هذه المتغيرات المتصاعدة ستنشب حرب كشمير الثانية عام 1956، خاصة وأن الهند صعدت من حدة الصراع عبر تضمينها مادتين للدستور تعلقا بدمج إقليمي كشمير وجامو إلى أراضيها وبالتالي اعتبارهما جزء لا يتجزأ من الهند.
كل هذه الأحداث اعتبرتها باكستان سياسة تتحدى بها الهند عامل الجغرافيا والانتماء الديني للشعب الكشميري، ما أجج رغبة هذا الشعب في طلب الانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، فبدأت باكستان من خلال هذا المعطى بدعم الشعب الكشميري المسلم بداية بالضغط على مهارجا كشمير الهندوسي بإعلان الانضمام إلى باكستان، وقد تم ذلك عن طريق تفويض الرئيس الباكستاني لسكرتيره الذي توجه إلى الإقليم من أجل التفاوض معه على حل يرضي الطرفين وذلك بضمان مكان المهرجا في السلطة بعد الإعلان عن الانضمام[5]، لكن قوبل طلب الرئيس الباكستاني بالرفض، ما دفعه نحو تغيير السياسة السلمية، لتبدأ مباشرة بعدها عمليات تمرد داخل المجتمع بين الهندوس والمسلمين، ولا شك أن باكستان عملت على إشعال هذه الأعمال عبر تحريض شعب كشمير ضد المهرجا، غير أن هذا الأخير واجه هذه التمردات بالاستعانة بالمتطرفين الهندوس، بالتالي مذابح كبيرة في صفوف المسلمين، قوبلت برد فعل عنيف من طرف وحدات قتالية باكستانية توجهت نحو تحرير أزيد من ثلث الأراضي الكشميرية، فوجد المهرجا نفسه شبه مجبر على إعلانه الولاء للهند عبر “وثيقة الانضمام” في 26 أكتوبر 1948[6]بهدف ضمان منصبه في السلطة.
مباشرة بعد وثيقة 26 أكتوبر دخلت القوات الهندية للأراضي الكشميرية، على أساس حماية سلطة المهرجا الشرعية، لكن الحكومة الحرة الشعبية طلبت تدخل القوات الباكستانية، معلنة عن بداية صراع طويل بين الهند وباكستان.
- الأطراف الفاعلة في النزاع
تميز هذا النزاع بتعدد اطرافه وتداخلها وهي:
- الأطراف الرئيسية:
اتخذ هذا النزاع منذ البداية شكل الصراع المباشر بين الهند وباكستان من أجل ضم إقليم كشمير فعملت الهند على استغلال السلطة الهندوسية بالإقليم، والضغط عليها من أجل اعلان الانضمام إليها، بينما استغل الطرف الباكستاني الأغلبية المسلمة من سكان كشمير وميولهم للانضمام لباكستان كدولة مسلمة، فالطرفان وظفا كل الأساليب من أجل السيطرة على الإقليم.
باكستان:
شكلت باكستان طرف رئيسي في النزاع طمعت في الظفر بإقليم كشمير لاعتبارات أسلفنا ذكرها، فاستغلت رغبة الشعب الكشميري، الذي كان يطالب بانضمامه إلى باكستان، واستقطبت قادته، وعملت على إنشاء الحكومة الحرة، والجيش الكشميري الحر[7]، وذلك من أجل معارضة المهرجا وخلق أزمات داخل كشمير بهدف الضغط عليه وتسريع عملية دخول باكستان إلى الإقليم، كما أن المصالح الخاصة للدولة الباكستانية والمتمثلة في بسط السيطرة على الإقليم بغية توفير منطقة شبه عازلة عسكريا بينها وبين الهند.
الهند:
الهند هي الأخرى من الأطراف الرئيسية في النزاع، وذلك إيمانا منها أن كشمير أرض هندية كما كانت باكستان في السابق، فاستحضار تاريخ 1940 في الهند لا يدل إلا على خروج باكستان من الإمبراطورية الجغرافية الهندية، بالتالي الدفاع عن كشمير لتفادي تكرار هذه الخسارة التي قد تكلف موقع استراتيجي للهند، يزيدها قوة عسكرية واقتصادية عبر فتح أبواب التجارة مع أربع دول أبرزها الصين.
- الأطراف الثانوية:
هناك العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي يمكن اعتبارها فاعلة ثانوية في هذا النزاع، وذلك نظرا لتدخلاتها غير المباشرة على العديد من المستويات، سواء أمنيا، أو ماليا عن طريق دعم شراء الأسلحة على سبيل المثال، أو حتى بتوفير معلومات استخباراتية.
إن طول مدة الصراع والأهمية التي اكتسبها خلال هذه الفترة سواء من فاعليين إقليمين أو دوليين ساهم في دخول أطراف عديدة على خط هذا النزاع، لكن سنقتصر في هذه الدراسة عل ذكر أهم الأطراف الثانوية، من الدون الإشارة إلى الأطراف الأخرى غير الدولية كالمنظمات الحقوقية والسياسية.
الصين:
في سنة 1962 غزت الصين إقليم التبت واحتلت أراضي ترجع إلى ملكية الهند، بالتالي دخولها في النزاع كطرف ثانوي لا يطالب بكشمير وإنما يدعم تواجد باكستان فيه، خاصة بعد توقيع إعلان اتفاق الحدود، 2مارس 1963، بين الصين وباكستان وهذا ما استغلته الصين كموقع عسكري متقدم، وكذلك باكستان التي حاولت ممارسة الضغط على الهند، الأمر الذي انتهى بنشوب حرب سنة 1965[8]، كما تم تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين عبر انشاء طريق “تاراتورم” عام 1978، وهو ما اعتبرته الهند تهديدا عسكريا لها.[9]
المقاومة الكشميرية:
عبر قراءات لوضعية المقاومة الكشميرية خلال فترة النزاع، خلصنا إلى أنها غالبا ما كانت الحلقة الأضعف فيه، فلم تكن بذلك الزخم الذي كانت عليه المقاومة الأفغانية خلال نفس الفترة، فقد كانت عبارة عن مقاومة موجهة تحكمت فيها الحكومة الباكستانية وساعدتها، بالتالي لم تكن قادرة على صياغة مواقف مستقلة عنها، إلا أنها شكلت طرف فاعلا وقادرا على إفشال مخططات سياسية خاصة ضد الطرف الهندي الذي حاول بدوره استقطاب الفاعلين السياسيين.
إيران:
عملت الدولة الإيرانية بحكم انتمائها للعالم الإسلامي على دعم الوجود الباكستاني في كشمير وذلك بطريقة معلنة حيث انتمى الطرفين إلى الحلف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كما عملت إيران على دعم باكستان خلال الحرب الهندية الباكستانية سنة 1965، لكن هذاالوضع سيتغير مباشرة بعد الهزيمة التي تلقتها باكستان سنة 1971، وانفصال بانغلادش عنها، اذ بدأت إيران في تكوين علاقات استراتيجية مع جارتها الهند، وبالتالي الانحياز لها وهذا ما تجلى في خطاب الشاه الإيراني الذي أكد فيه عدم تقديم إيران لأي مساعدات لباكستان في حالة بدأها العدوان على الصديقة الهند.[10]
الاتحاد السوفيتي:
دخل الاتحاد السوفيتي كطرف مساند للطرح الهندي، خاصة بعد إعلان رئيس الاتحاد سنة 1956 أن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند، فالاتحاد خلال هذه الفترة شكل القائد الدولي للتحالف الشرقي ضد التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، والتي كانت باكستان تحت لواءه، وهذا الوضع سيستمر حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مع روسيا إذ ستعمل على توطيد العلاقات مع الهند عبر عقد اتفاقية “إعلان المشاركة الاستراتيجية” سنة 2000[11].
الولايات المتحدة الامريكية:
تميز الموقف الأمريكي بالتذبذب، فمع بداية الأزمة كان المحايد، إلا أنها شكلت موقفا داعما لباكستان خاصة بعد انضمامها للتحالف الغربي بقيادة أمريكا، لكن تراجع هذا الموقف بعد التقارب الصيني الباكستاني، ويمكن أن نجمل تدخل أمريكا في محاولتها لحل النزاع، لكن مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر، سيتغير موقف أمريكا تجاه باكستان وستعمل على تقوية علاقاتها بالهند، واعتبارها شريك في عدة قضايا استراتيجية، أهمها محاربة الإرهاب [12].
- أطراف أخرى:
إضافة إلى هذه الأطراف دخلت أخرى عملت على الحياد في النزاع كمصر خلال فترة جمال عبد الناصر، أو حتى الانحياز خاصة الإمارات وذلك بدعمها الموقف الباكستاني، فهي العدو الأساسي لإيران حليف الهند.
- قضايا النزاع وأسبابه:
تميز النزاع الباكستاني الهندي بعمق جذوره التاريخية فالنزاع لم يكن وليد مرحلة الحرب الباردة، بل قبل ذلك بكثير فهو يعتبر من مخلفات الاستعمار البريطاني للمنطقة بعد تركها دون تحديد مستقبلها وترك الخيار في يد قادتها التي لم يكن يخفى عليها أن انتمائهم الديني للهندوسية كفيل بجعلهم يختارون الانضمام للهند، وهذا ما كان سيخلف نزاع لا محيد عنه حيث أن باكستان دائما ما اعتبرت الدفاع عن كشمير أمر يستحق العناء، وذلك راجع في نظرنا لسببين رئيسين الأول يتعلق بالدافع الديني الهوياتي، فالكشميريون مسلمون ومن منظور الدين الإسلامي يجب الدفاع عن حقوقهم وأرضهم. أما المحدد الثاني فنرجعه إلى أن إقليم كشمير يقع على موقع استراتيجي يضمن لباكستان موقع استباقي في حالة وجود مواجهة عسكرية بين الطرفين، وكذلك دوره الاقتصادي كممر بين أربع دول. فسياق سيرورة النزاع الممتد من 1947 إلى اليوم، بتداخل كافة الأطراف السالفة الذكر، أدى إلى نشوب حروب دموية خلفت ضحايا كثر، كما سجل أيضا فشل مجلس الأمن في تحقيق السلام بين الأطراف، وذلك منذ يناير1948 وهي الفترة التي رفعت فيها الهند ملف كشمير للنظر فيه، لتندلع بعدها حرب 1965 بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني[13]، ثم بعدها حرب 1971، التي نشبت إثر اتهامات باكستانية للهند بدعمها لباكستان الشرقية (بنغلادش)، وهذا ما أسفر بالفعل عن انفصالها بعد الخسارة التي تلقتها باكستان.
كل هذه التطورات المتسارعة في الأحداث أعطتنا نزاع مزمن لم يجد له حله إلى اليوم، عمقه بحث الكشميرين عن هويتهم التي ضاعت بين الهند وباكستان خاصة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، التي يعتبرها صامويل هنتغتون فترة انبعاث الهويات والثقافات والشعوب، هذا الانبعاث الذي يعتبر قادرا على تهديد استقرار الدول والجماعات[14].
يفسر هذا النزاع بشكل نظري من خلال مقاربتين:
- أولا: يمكن ان نعتبر من خلال ما سبق أن الصراع بين الطرفين هو صراع هويات Social Identity بين طرف يعتبر الأضعف وهو الشعب الكشميري وطرفين يحاولان إثبات شرعيتهما التاريخية على الإقليم وهما الهند وبكستان.
- ثانيا: يمكن فهم هذا النزاع عن طريق المقاربة القانونية بحيث أن التحرك العنيف الذي حصل بين الطرفين راجع إلى اعتقاد الهند بأن باكستان خرقت وثيقة 1947، التي أعلن فيها المهرجا انضمامه للهند، ونفس الأمر الذي تعتبره باكستان، فهي ترى أنها مخولة للدفاع عن شعب كشمير الذي تربطه بها الديانة الإسلامية، بالتالي الحديث أيضا عن العوامل المثالية الأخلاقية في التحرك نحو العنف.[15]
- ديناميات النزاع:
سلك هذا النزاع طرق مختلفة، بداية بالمواجهة العسكرية المباشرة، ثم دعم باكستان للمقاومة الكشميرية بالسلاح والأدوات اللوجيستيكية، ودعم الهند للجماعات الهندوسية المتطرفة، كذلك سلك النزاع مراحل تخللتها مبادرات الحوار.
- تصعيد العمليات العسكرية:
بدأت المواجهة العسكرية بين الطرفين منذ 1947-1948 إثر هجوم الهند على إقليم كشمير أسفر عن احتلالها لثلثي أجزاءه دون تدخل مباشر للقوى الباكستانية.
نشوب حرب 1965 التي بدأت من خلال محاولة الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين، إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة فنشب أول صراع مباشر بين الطرفين، استمر لسبعة عشر يوما، وانتهى بعقد اتفاقية لوقف إطلاق النار بعد جهود دولية[16].
هذا التصعيد عرف نوعا من التراجع بعد اتفاقية “طشقند” التي جاءت بمبادرة من الاتحاد السوفيتي، سنة 1969، فعملت من خلالها الأطراف على سحب كل قوتها العسكرية، واسترجاع علاقتها الدبلوماسية ببعضها، نجحت هذه الاتفاقية في الحفاظ على أجواء السلم لسنتين فقط.
بعدها نشبت حرب ثالثة بين الطرفين سنة 1971، غير أن أسبابها لم تتعلق في الظاهر بإقليم كشمير، وإنما تعلقت بانفصال بنغلادش عن باكستان فتدخلت الهند على خط الأزمة بعدما لجأ إليها عدد كبير من البنغال وكذلك محاولة منها لتقسيم باكستان وخلق واجهة جديدة من شأنها إضعافها على مستوى التعاطي مع جبهة كشمير [17] .
- التخفيف من حدة الصراع:
بعد خسارة باكستان الواضحة في حرب 1971 وفقدانها منطقة (بنغلادش)، ستعمل إلى جانب الهند نحو تطبيع العلاقات بعد اتفاقية “سيملا“، وكان ذلك بهدف إقرار الأمن والسلم الإقليمين، عبر الاستعداد لحل المشكل بينهما، إلا أن المسجل في هذه الاتفاقية هو غياب حل واضح لمشكل كشمير، حيث جاء في الفقرة السادسة من نص الاتفاقية ما مضمونه أن تسوية مشكل كشمير تبقى من المسائل المعلقة التي تنتظر إيجاد حل ثنائي (هندي- باكستاني) لها[18].
- عودة المواجهات العسكرية:
خلال فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ستعرف الأوضاع الداخلية للهند تغيرات كثيرة لتساهم في إعادة تحديد أولوياتها، حيث تراجعت فاعلية السلطة المركزية في الهند بسبب تصاعد حركة التطرف، خاصة حركة “السيخ البنجاب” الذين كانوا يطالبون بإنشاء دولتهم، كما حدث في السابق مع المسلمين في باكستان[19].
أما الطرف الشعبي في كشمير فقد رفع من حدة نشاطه، الذي كان مرتبطا بالدعم الباكستاني، بالتالي تصاعد حركة العنف التي ارتبطت أيضا بتصاعد المد الاسلامي المؤسس داخل أحزاب سياسية أبرزها “الجبهة الإسلامية المتحدة ” التي قادت إلى جانب مجموعات أخرى (أعمال شغب) طائفية، وهذا ما جعل الحكومة الهندية تدخل على الخط، باعتمادها سياسة العنف الدموي في مواجهة الثورات، الأمر الذي لأثر سلبا على الهدنة المؤقتة بين البلدين إذ بدأت باكستان تصعد من جهتها، فسمحت بمرور أعداد كبيرة من المسلمين الراديكاليين القادمين من باكستان بالتسلل إلى كشمير بأسلحة وخطط حرب برعاية جهاز مخابرات باكستان[20]، تطورت الأحداث مباشرة بعد 11 سبتمبر 2011، حيث تصاعد الهجوم على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من هنا حاولت الهند استغلال هذه الازمة لصالحها، لتعمل على التوظيف السياسي للإرهاب وذلك بوضعها باكستان في موقع المتهم المباشر الذي يدعم الحركات الإرهابية داخل إقليم كشمير.
في الأخير نستنتج تراجع مد القوى الباكستانية داخل إقليم كشمير بداية القرن الحالي وذلك راجع بالأساس إلى التضيق الذي مورس عليها من كافة الجوانب حتى من جارتها أفغانستان التي اتهمتها بدعمها لقادة حركة طالبان، وكذلك تراجع الدعم الإيراني، والأمريكي وهذا ما ندرجه ضمن السياقات الدولية، التي أعيد تشكيلها عقب انهيار المعسكر الاشتراكي، وبالتالي تضييق المساحات على الحكومة الباكستانية التي أصبحت مجبرة على طلب الحوار من الهند.
أما الهند المنتصرة في ثلاث حروب متوالية على باكستان، فقد رفضت الخضوع لقرارات الأمم المتحدة، وأبرزها إجراء استفتاء يضمن لسكان كشمير حق تقرير المصير، وكذلك وقوف القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا إلى جانبها سهل من تحكمها في أوضاع الإقليم وفرض سلطتها الشبه مطلقة عليه.
- بعض الحلول المقترحة:
إن طبيعة النزاع حول كشمير جعل منه نزاعا معمرا ليومنا هذا، فهو من أقدم النزاعات الدولية في منطقة آسيا، ولعل طول الحيز الزمني الذي حظي به هو دليل على عدم توصل الأطراف إلى اتفاق يرضيهم، فالأهداف واضحة لكلا الطرفين ولا نتوقع تنازلهما عليها، بل بالعكس من ذلك فمن الممكن التصعيد في أي وقت، مادام التاريخ يشهد على مد وجزر في مواقف كلا الطرفين، وهذا ما رسخته فكرة “في مقابل الفائز في هذا النزاع الطويل، يكون الطرف الآخر بالضرورة خاسر”، بالتالي فأي طريق نحو حل النزاع يجب أن ينطلق من فكرة win-win وليس win-lose .
وهو ما يمكن أن يتأتى عن طريق:
- معالجة كل المشاكل الأمنية بين الهند وبكستان عن طريق الحوار الفعال، تحت وصاية مجلس الأمن، لأن الاتفاقيات الثنائية السابقة بين الطرفين لم تكن نتائجها تعمر طويلا.
- معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع على أرضية ما بعد 1947 وإلغاء رسالة المهرجا للهند، والعمل على تأسيس دولة كشمير ضمن حدود المملكة الأميرية (بعد فترة الاحتلال البريطاني)، تحت إشراف ثنائي باكستاني هندي.
- العمل على حل قد لا يتوافق مع السياسة الخارجية للبلدين وهو إعادة تنظيم استفتاء لسكان كشمير من أجل الانضمام لإحدى الدولتين أو الاستقلال التام عنهما.
- اللجوء إلى الحل السلمي يبدأ بتوقف كل من الهند وباكستان عن النظر إلى القضية من زاوية عدائهما التقليدي، وأن يرى البلدان الأمر في بعده الحقيقي كعنوان لأزمة إنسانية وحقوقية في ظل ما يعانيه الكشميريون في الشطرين من تمزق ومظالم وضحايا قارب عددهم ثمانين ألف قتيل.
خاتمة:
بعد استعراض خريطة النزاع الهندي-الباكستاني حول إقليم كشمير، يظهر أن تعمير هذا الصراع لأزيد من ثمانين سنة، صعب من تحديد نتائج عملية من شأنها تسهيل عملية الوصول لحل مرضي للطرفين، بالتالي توجه البلدين بخطى فاترة تفتقد إلى الإرادة اللازمة التي لن تتأسس إلى على الثقة المتبادلة ومحاولة نسيان التاريخ الدموي بينهما.
فبعد كل هذه السنوات تبين أن الحلول العسكرية التي انتهجها الطرفان والمتمثلة في ثلاث حروب ومئات المعارك الصغيرة على الحدود بين الطرفين، بالإضافة إلى الحوارات الكثيرة التي عقدتها حكومتي الهند وباكستان، لم تخرج المنطقة من صلب هذا النزاع الذي لم يعرف طريقه للحل، باستثناء بعض الحلول المؤقتة والترقيعية التي لم تعمر طويلا، بالتالي سيكون الحل الحقيقي الدائم هو ذلك المبني على أساليب وحلول جديدة من قبيل الرضوخ لمطلب الشعب الكشميري ومنحه حق الاستقلال الذاتي عن كلتا السلطتين الهندية والباكستانية.
قائمة المراجع:
- إبراهيم، موسى، قضايا دولية وعربية معاصرة، بيروت، دار المنهل اللبناني، 2010.
- إسماعيل، أحمد ياغي محمود شاكر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، الرياض، دار المريخ للنشر، 1984م، الجزء 1 الجناح الآسيوي.
- بلعيد، سمية، النزاعات الاثنية في افريقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها، رسالة ماجيستير. جامعة قسنطينة: الجزائر،2010.
- الحديثي، هاني الياس، قضايا دولية وعربية معاصرة، بيروت، دار المنهل اللبناني، 2010.
- سامي، ابراهيم الخرندار، ادارة الصراعات وفض المنازعات اطار نظري، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2014.
- سومانترا بوز، أراض متنازع عليها إسرائيل-فلسطين، كشمير، البوسنة، قبرص، وسيريلانكا، ترجمة: اياد احمد- حسان البستاني، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009.
- الطحاوى، عبد الحكيم عامر طايل، قضية كشمير 1947-1990،منشورات كلية الداب، جامعة المنصورة، عدد35، غشت2004.
- عبد العاطي، محمد،” كشمير…نصف قرن ن الصراع”، http://www.aljazeera.net
- عربي عوده، فلة. قضية كشمير بين المواقف الاقليمية والتأثيرات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 3، 2011
[1] موسى إبراهيم، قضايا دولية وعربية معاصرة، بيروت، دار المنهل اللبناني،2010، ص227.
[2] الجزيرة الإخبارية، تمت الزيارة في تاريخ 2021/05/08: http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/5/13/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8
[3] هاني الياس الحديثي، سياسة باكستان الإقليمية 1971-1994،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة اطروحات الدكتوراه 33، 1989 ، ص119
[4] القرار رقم (47) لعام 1948 والوثيقة (s/1100) المؤرخة في التاسع من نوفمبر 1948، والوثيقة رقم( s/1196)، في العاشر من يناير 1949، والقرار رقم (91) في الثلاثين من مارس 1951،( للتفصيل، انظر: هاني الياس الحديثي، مرحع سابق، ص121)
[5] عبد الحكيم عامر طايل الطحاوى، قضية كشمير 1947-1990، (منشورات كلية الداب، جامعة المنصورة، عدد35، غشت2004)، ص537
[6] نفسه 538
[7] – إسماعيل أحمد ياغي محمود شاكر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، الرياض، دار المريخ للنشر، 1984م، الجزء 1 الجناح الآسيوي، ص 278.
[8] هاني الياس الحديثي، مرجع سابق، ص 123.
[9] نفسه 128.
[10] فله عربي عوده، قضية كشمير بين المواقف الاقليمية والتأثيرات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 3، 2011، ص75.
[11] نفسه، ص86.
[12] موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص243.
[13] موسى إبراهيم، مرجع سابق ، ص239
[14] سمية بلعيد، النزاعات الإثنية في افريقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها، رسالة ماجيستير. جامعة قسنطينة: الجزائر،2010، ص26.
[15] سامي ابراهيم الخرندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات اطار نظري، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2014، ص134.
[16] محمد عبد العاطي،” كشمير…نصف قرن ن الصراع”، http://www.aljazeera.net
[17] فله عربي عوده، مرجع سابق، 24.
[18] هاني الياس الحديثي، ص 124-125.
[19] نفسه، ص128
[20] سومانترا بوز، أراض متنازع عليها إسرائيل-فلسطين، كشمير، البوسنة، قبرص، وسيريلانكا، ترجمة: إياد احمد- حسان البستاني، (بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009)، ص189.