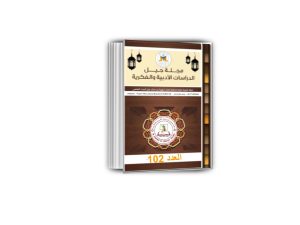صراع الوجود في لاميّة الشّنفرى ( دراسة تحليلية )
Existance Conflict in Al-Shenfery Lamiya (Analytic Study)
ا.د. حسين عبد حسين الوطيفي / كلية الآداب / جامعة الكوفة / العراق
ا.م . هادي سعدون هنون / كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة / العراق
Prof. Dr. Hussain Abd Hussain Al-Witaify, College of Arts/ University of Kufa, Republic of Iraq
Asst. Prof. Hady Sa`doon Hannoon, College of Basic Education / University of Kufa, Republic of Iraq
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 51 الصفحة 43.
ملخّص :تبوّأ الشاعر الجاهلي منزلة كبيرة في قبيلته ، انسجاما مع طبيعة الدور الذي نهض به ، والمهمة الكبيرة التي تكفّل بها ، فهو لسانها المعبّر عنها ، والمنافح عن وجودها بقريحته الشعريّة الوقّادة ، وقوله المؤثر النّفّاذ، وقد ظلّ وجوده مرتبطا بقبيلته بوصفه جزءا من بنائها الإجتماعي .
إنّ هذه العلاقة الإجتماعية قد فرضت عليه علاقة فنيّة ، قد شابتها ـ أحيانا ـ اضطرابات نتج عنها خروج الشاعر من هذه البوتقة ، باحثا عن ذاته المنفردة بعيدا عن هيمنة القبيلة وسلطتها .
ويُعَدُّ الشّنفرى أحد الشعراء الذين سعوا جاهدين للخروج على هذا النظام الإجتماعي السائد والبحث عن وجوده ، يدفعه الى ذلك نزعة ذاتيّة هيمنت عليه ، فراحت تصوّر له أنّه لا يقلّ شأنا عن أسياد قومه ؛لما يمتلكه من مقومات لعلّ في مقدّمتها النّبل والشّجاعة، فإنْ لم ينل مبتغاهُ، ويُحقّقُ وجوده بينهم ، فلن تسمحَ له نفسهُ بأنْ يستمرّ على منواله هذا، ومن ثمّ فَرضَتْ عليه التحللّ من القبيلة والبحث عن بديل آخر ، وهذا كله لم يكن لينتابه لولا الصّراع الوجوديّ الكامن في نفسه .
Abstract
The pre-Islamic poet had occupied a great status in his tribe due to the great and important role he played; he is the one who expresses the tribe demands and conditions and defends its existence by his powerful poetic talent, his existence was connected to the tribe as a basic element of its social structure.
This social relation had imposed, on the poet, an artistic relation, that, sometimes, had passed some disturbances resulted in the poet desire to go out of this relation seeking for his identity beyond the tribe power and domination.
Al-Shenfery is one of the poets who attempted to go out of that dominating social system and sought for his existence, motivated by a subjective tendency which made him believed that he is equal or a peer of his tribe`s masters as he is as brave and gentle as them. He could not obtain this status within his tribe so he looked for a substitution, leaving his tribe. This would not be occurred without the inner conflict of existence.
المقدّمةلقد كان للشاعر منزلة كبيرة في قبيلته ، فهو لسانها المعبّر عنها ، والمنافح عن وجودها تجاه القبائل الأخرى ، من هنا كان وجوده مرتبطا بقبيلته بوصفه جزءا من بنائها الإجتماعي الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعلاء شأن تلك القبيلة أمام الآخرين ، والدّفاع عنها ، قبالة الدفاع عنه ، إذا ما المّ به خطبٌ ما .
إنّ هذه العلاقة الإجتماعية قد فرضت على الشاعر علاقة فنية ، قد تشوبها_ أحيانا _ اضطرابات ينتج عنها خروج الشاعر من هذه البوتقة التي وجد نفسه منصهرا فيها ، باحثا عن ذاته المنفردة بعيدا عن هيمنة القبيلة وسطوتها .
ويُعَدُّ الشنفرى أحد الشعراء ـ الصعاليك ـ الذين سعوا جاهدين للخروج على النّظام الإجتماعي السائد – الظالم لهم كما يعتقدون- والبحث عن وجودهم ، ولاسيما في( لاميّته) التي تُعَدُّ أنموذجا يمكن الركون اليه .
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هناك دراسات قد وقفت عند ( لاميّة الشنفرى ) منها ( قراءة جديدة لشعرنا القديم ) لـ ( وهب روميّة ) و ( النص الشعري وآليات القراءة ) لـ ( فوزي عيسى ) و( مقالات في الشعر الجاهلي لـ ( يوسف اليوسف )و ( الشّنفرى شاعر الصحراء الأبي ) لـ ( محمود حسن أبو ناجي ) وغيرها من الدراسات التي كان لكلّ منها رؤى مختلفة تسلط الضوء على القصيدة أو محطات منها فقط تكشف البعد الجماليّ أو اللغويّ أو الأسلوبيّ أو النّفسيّ فيها ، أمّا هذه الدراسة فراحت تسلط الضوء على الجانب الذّاتيّ والقبليّ معا، والصّراع الدائر بينهما ، الكامن في نفس الشاعر والمتبدّي في القصيدة نفسها سالكا في سبيل ذلك منهجا تحليليّا لا يخلو من البعد النّفسيّ ، يسعى إلى سبر أغوار القصيدة والبحث في مكامنها .
من هنا قُسّمتْ الدراسة على مبحثين تقدمهما تمهيد في ( الذّاتية والقبليّة ) تلاه المبحث الأول بعنوان ( صراع الذّات مع الذّات في شعر الشّنفرى) ، للكشف عن ذلك الصّراع المهيمن على نفسه ، أما المبحث الثاني فكان ( صراع الذّات مع القبيلة في شعر الشّنفرى) ، محاولة لتتبع هذا الصّراع الذّاتيّ القبليّ وآلية التعبير عنه ، والأدوات التي وظّفت في سبيل ذلك ، وخُتِمت الدراسة بجملة من النتائج .
تمهيد
( الذّاتية والقبليّة في الشعر الجاهلي )
تتفاعل الذّات الإنسانية بصورة شعورية ، أو غير شعورية ، مع كلّ ما يُحيط بها من مظاهر البيئة من إنسان وحيوان ونبات ، ولا بدّ من أنّ الشاعرَ في العصر الجاهلي ، شأنه شأن غيره من البشر قد تفاعل ذاتيّا مع بيئته ، ورسم حدودها مع الجماعة ، وعلى وفق ما فرضته عليه تلك الظروف تحتّمَ عليه أنْ يتفاعل مع قبيلته ، ويساندها ، فهي التي تتكفّل برعايته ، وحمايته من الأخطار المحدقة به على تنوّعها ، واختلاف مصادرها .
إنّ هذه الظروف قد فرضت على الشاعر العيش في حالة صراع دائم مع تلك البيئة ، وعليه مواجهتها فهل يستطيع وحيدا أنْ يقارعَ تلك الصحراء المقفرة ، ويحقق وحده ما يلبّي مطامحه وآماله ورغباته؟
يبدو أنّ هذا الأمر لم يكن يسيرا ؛ لذلك فُرض على الإنسان العربيّ و الشاعر بوجه خاص أنْ تكونَ القبيلة هي المحطّ الآمن له ولأقرانه ، لمواجهة تلك التحديات ، وتحقيق ما يمكن تحقيقه ، فكيف تعامل الشاعر مع قبيلته ؟
إنّ مَنْ يعود لديوان الشعر العربيّ يجد أنّ الفرد العربيّ تتقاسمه نزعتان ، نزعة قبليّة ، وأخرى ذاتيّة ، ويمكن تبيانهما على النحو الآتي :
أولا : النّزعة القبليّة : ويُقصد بها تمسك العربيّ بقبيلته تمسّكا شديدا ، وخضوعه التام لشريعتها ، وهذه القبليّة تفرض على الشاعر أمورا كثيرة منها: الإلتزام بقضايا القبيلة وتبنيّها ، فسيّد القبيلة هو مثلها الأعلى ، ولا بدّ من الدفاع عن القبيلة أيّا كانت الظروف التي تواجهها، فهو مسؤول عنها في السّراء والضّراء معا[1]، فالقبليّة كانت مهيمنة على نفوس العرب جميعا في العصر الجاهلي من هنا جاء قولهم: ((انْصُر أَخَاكَ ظَالماً أو مَظْلُوماً ))[2] فهي (( إحساس الفرد برابطته القبلية ، وواجب تأييد مصالحها ، والعمل لها بكلّ ما يملك من قوة))[3] وشجاعة ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ، وإنما ((عليه أن يحترم رأيها الجماعي فلا يخرج عليه ، ولا يتصرف تصرفا بدون رضاها ))[4] ومباركتها، وهذه الصورة تتجلى بوضوح في قول دُريد بن الصّمة[5]:
ثانيا: النّزعة الذّاتيّة: وتعني خروج الشاعر من نزعته القبليّة المعتادة ، فالإنسان في طبيعته تتقاسم حياته نزعة جماعيّة ، ونزعة فرديّة ( ذاتيّة ) ولا شكّ في أنّ حياة الإنسان العربيّ في عصر ما قبل الإسلام في نزعتيه الجماعيّة والفرديّة أكثر وضوحا من أيّ وقت مضى ؛لشدة حاجة الفرد للمجموعة التي ينتمي اليها ، بسبب من الظروف القاسية التي تسوّره ، من هنا كان (( الإنسان العربي ذا نزعتين تتجاذبانه نزعة جماعية نحو القبيلة ، وهي ما دعوناها بالنزعة العصبية ، ونزعة فردية تجعله متميزا من طغيان روح الجماعية))[6] ، وهذه النّزعة هي التي جعلت الشّنفرى ـ مدار البحث ـ شاعرا مبدعا في ضمن مجموعة عُرفوا بالصّعاليك ، وليس من وكْدِ البحث الخوض في التعريف بهم ، فهناك مصادر قد تكفلت بذلك[7] ، ولكنْ ما يعمق فكرة البحث أنّ هؤلاء الصعاليك ـ ومنهم الشنفرى ـ أرادوا (( أن يشقوا طريقهم بالقوة نحو حياة كريمة أبية ، يفرضون فيها أنفسهم على مجتمعهم ، وينتزعون لقمة العيش من أيدي من حرموهم منها ، دون أن يبالوا في سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة ، فالحق للقوة ، والغاية تبرر الوسيلة ))[8] ، كما يعتقدون .
ومما لا شكّ فيه أنّ (( هؤلاء الشعراء الصعاليك قد مرت بهم في حياتهم فترات عاشوا فيها مع قبائلهم حياة قبلية متوافقة توافقا اجتماعيا))[9] ،ولكنهم ما لبثوا أن انسلخوا عن انتمائهم القبلي بسبب من الفقر والعوز ، والوضع الإجتماعي المزري الذي كانوا يرزحون تحت وطأته ، وقد كانوا على ثلاث طوائف مختلفة ، الأولى طائفة ( الخُلعاء والشُذّاذ ) وهم الذين تخلّتْ قبائلهم عنهم ، وتبرّأت منهم ؛ لما ارتكبوه من الجرائر ومن أشهرهم حاجزُ الأزْديّ ، وقيسُ بن الحدّاديّة ، وأبو الطّمْحانُ القَيْني [10]، وأمّا الثانية فطائفة ( الأغربة السود) الذين سرى السواد إليهم من أمهاتهم الحبشيّات ، ولم تكن قبائلهم تسوّي بينهم وبين أبنائهم الأُصلاء ممن ورثوا عروبة الأصل ، ونقاء الدم في الآباء والأمّهات ، ومنهم السُّليكُ ابن السُّلَكة ، وتأبّط شرّا ، والشّنْفرى[11]، وأمّا الثالثة فطائفة ( الفقراء ) الذين كانوا يحيون حياة شاقّة قاسية لم يجدوا معها ما يُعينُهم على أعباء العيش ويمثلهم عروةُ بن الورد ومن التفّ حوله منهم [12]، ويبدو أنّ هؤلاء الصّعاليك قد عاشوا صراعا وجوديّا مريرا ، كشفه تراثهم الشعري ، وسيعمد البحث الى دراسة أحدهم ، وهو الشّنفرى في ( لاميته المشهورة )[13]ويكمنُ السببُ في أنّها تصورُ حياةَ الصعاليك تصويرا رائعا ، ومن ثمّ يمكن الركون إليها لتكونَ مصدرا مهما من مصادر دراسة حياتهم الإجتماعية [14] ، وهذا ما يُعينُ على تعقّب جزء كبير من حياة الشاعر والوقوف عند ملامح صراعهِ الوجوديّ وأشكاله على وفق مبحثين :
الأول : صراعُ الذّات مع الذّات.
الثاني: صراعُ الذّات مع القبيلة .
المبحث الأول
( صراعُ الذّات مع الذّات )
يُعَدُّ الشنفرى من الشعراء الصعاليك الذين اختلفوا في نسبه كثيرا ، ولكنّهم اتفقوا على أنّه من أغربة العرب[15]، وليس من همّ البحث الخوض في هذا الاختلاف ، فما يعنيه في هذا المقام أنّ الشعراء الصعاليك _ ومنهم الشنفرى _ قد خطّوا لأنفسهم منهجا مختلفا عن أقرانهم من الشعراء في العصر الجاهلي نتيجة الظروف الإجتماعية والإقتصادية التي أحاطت بهم .
إنّ العودة إلى شعر الصعاليك يكشف ما ينماز به شعرهم من واقعية في تصوير البيئة التي يعيشون فيها ، وتجربة صادقة حقيقية [16]، ووحدة موضوعية [17]، إلا أنّ هناك سمة مميزة ، وظاهرة تمنح البحث عمقا وتدليلا وهي التّحلل من الشخصية القبلية نتيجة فقد التوافق الإجتماعي بين الصعاليك وقبائلهم ، مما قاد الى انحسار الإحساس بالعصبية القبلية [18]، وسيكون التركيز في هذا المقام على قضية التّحول من القبيلة إلى الذّات ، ومن الذّات إلى القبيلة ، وهي سمة مميزة ومدار اهتمام البحث في شعر الشّنفرى .
حمل هذا المبحث عنوان ( صراع الذّات مع الذّات ) في شعر الشنفرى ، ولعل من المجدي والضروري في بداية البحث تشْخيص من الذات الأولى ، ومن الذات الثانية ؟ وهل هناك حدود عينيّة فاصلة تمكننا مِنْ أنْ نشخّص بينَ الذّاتينِ تشخيصا ماديا ؟.
لاشكّ في أنّ حالات الصراع الذّاتية للفرد الواحد يصعب تحديدها ، وتشخيصها إلى الحدّ الذي يمكن بوساطتها الإجابة عن السؤال ، وتحديد الذّات الأولى من الذّات الثانية ؛ لأنها متعمقة في داخل النّفْس البشرية وليس خارجها، ومهما يكُنْ من أمر، فلابدّ من وجود طرفي معادلة لهذا التنازع ، تمثلُّ طرفا أوّلا ضدّ طرفٍ ثانٍ ، وقد كشفت النّصوص القرآنية المباركة وجود الأنفس المتصارعة من أجل إثبات الذّات المتصارعة ، من ذلك قوله تعالى : ( تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ)[19] وقوله تعالى: ( وطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)[20].
وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)[21]
ومن يرجع للتفسير القرآنيّ لهذه الآيات المباركة ، يجد أنّ الله سُبحانه وتعالى قد شخّص حالة الصّراع التي يعيشُها الإنسانُ مع نفسه عند اقترافه الذّنوبَ ، فيحثّهم على التّوبة وهذا (( ما يرغبهم الله فيه ثم يرغبهم في أن لا ينقطعوا عن ربهم بقواطع الذنوب والمعاصي فإن أتوا بما لا يرضاه لهم ربهم تداركوا بالتوبة والرجوع إليه ثانيا وثالثا من غير أن يكسلوا أو يتوانوا ))[22] عن ذلك .
فتتضح حالة الصراع الإنسانيّ مع الوجود حالة واقعية يعيشُها الإنسانُ ، وتترك له الحرّيّة في اتخاذ القرارات المناسبة ، وهنا لابدّ من العودة إلى صراع الذّات مع الذّات ، لنُحدّدَ الذّات الأولى مِن الذّات الثانية ، ولكن قبل ذلك نُعرّج بشكل سريع على نشأة الشّنفرى التي اختلف الرواة في تحديدها ، والتي يمكن حصرها بثلاث روايات:
*- الرواية الأولى : قال بعضهم إنّه نشأ في قومه الأزد ، ثم أغاضوه فهجرهم .
*- الرواية الثانية : قال آخرون إنّ بني سلامان قد أسروه وهو صغير فنشأ فيهم ، حتى هرب، ثم انتقم منهم .
*- الرواية الثالثة : يرى أصحاب هذه الرّواية ، أنّه وُلِدَ في بني سُلامان ، فنشأ بينهم ، وهو لا يعلم أنّه من غيرهم ، حتى قال يوما لبنت رأس القبيلة : ( إغسلي رأسي يا أُخيّة ) فغاظها أن يدعوها بأخته ، فلطمته ، فسأل عن ذلك ، فأُخبر بالحقيقة ، فأضمر الشّرّ لبني سلامان ، وحلف أن يقتل منهم مائة رجل وقد فعل[23].
إنّ ما تقدّم من روايات – وإن اختلفت في سردها- تُجمع على أنّ للشّنفرى ذاتا قد تمّردتْ ، يمكنْ تسميتُها بـ ( الذّات المتمرّدة ) وهي التي رفضتْ ما كانت ترتضيه ذاتُه الأولى التي يمكنْ تسميتُها بـ ( الذّات الولاديّة ) ، ومن هنا نشبَ صراعُ الوجود بين هاتين الذاتين ، إذ عاش الشنفرى حالة صراع الوجود في بداياته مع ذاته ، فكان بين خيارين لا ثالث لهما ، إمّا التوافق مع ما أرادتْ ذاتّه الأولى التي تُبيح له فعل أيّ شيء ( بغضّ النّظر عن كونه سلبيا أو إيجابيا في منظورنا الحداثويّ القيميّ ) ، فهذه الذّات تُخبره بفعالية وقوة ما يصدر منه من أفعال بغضّ النظر عما تؤول إليه ، وإمّا التفاعل والذهاب مع ذاته الأُخرى الراغبة في السّير على ما خطّته له القبيلة ، والظّروف المحيطة به .
وليس من باب المغالاة القول بأنّه كان يعيش حالة صدام وصراع وجُوديّ مع ذاته، محاولة منه لبناء شخصيّة جديدة تتبنى إحدى الذاتين ، وتماشيا مع الرّواية الأولى التي ترى بأنّ قومه قد أغاظوه فهجرهم تكون بذلك الذّات المتمرّدة قد انتصرتْ على الواقع الذي يعيشه الشاعر ،وما يحيط به من ظروف قاهرة، ولا شكّ في أنّ هذا الانتصار كان على حساب ذاته الرّافضة لخروجه من ذلك الواقع المهيمن عليه .
وبعد هذا الصّراع الوجوديّ للشّنفرى ، وحسم معركة الوجود الحسيّ ، يحقّ للقارئ أنْ يتساءل هل أنّ الشّنفرى هو من حسم هذه المعركة لذاته المتمرّدة؟ .
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على صحة ما وصل إلينا من روايات ، فإن كانت القبيلة هي من خلعته ، فلا دخل لذات الشّنفرى بنوعيها بالانتصار ، وإن كان هو من ترك قبيلته ، فلابدّ من تسجيل الانتصار لذاته المتمرّدة .
لقد وصفَ الشّنفرى حالته الوجودية في أصعب المواقف _ من أجل المخاطب_ فلم يقبل أن يصف شجاعته وصولاته ،وإنّما وصف إرادته وثقته القوية بنفسه ، فكان أنّ تمرّد على الموت المخيف، مُتحدّثا عن مواجهة ذلك الموت ؛ لأنّه يؤمن بحتميّته ، وأنّ هذه الحتميّة هي التي جعلته يأبى القعود في بيته ( ليموت حتف أنفه ) ففضّل المواجهة ، قائلا [24]:
فالشاعر لا يبالي بالموت، ولا ببكاء خالاته وعمّته، ولا يريد من أحد زيارته في مرضه ؛ لأنّه لن يشكو ذلك لأحد، فهو حلو لمن أراد حلاوته ، ومرّ عند الخلاف عليه ، أبيّ لما يأباه العزوف ، ولاسيما أنّ الموت آتٍ لا محالة ،ولو كان جالسا في خيمته( بين العمودين ) . وهذا يؤكد عدم مبالاته بالموت ، فهو قد يلاقيه مع المجموعة ( القبيلة ) ، وقد يكون في الصحراء القاحلة ( الذّات) .
ويبدو أنّ الشّنفرى ، قد أفصح عن خلجاته النفسية بشكل واضح ، فهذه الذّات التي حاول مواراتها بعد انتصار إختها المتمرّدة ، تظهر من حين لآخر ، فهو لا يستطيع إخفاء تجلياتها الشّعوريّة دائما ، فلا يمكن التسليم بحرفّية النّصّ الشعريّ ، وعلينا التساؤل من خلال عرضه لهذا النّسج الشعري مجموعة من الأسئلة التي قد تكشف أجوبتها عن حالة صراع الذّات مع الذّات عند الشنفرى منها:
*- ما سبب ذكر خالاته وعمّته للبكاء ، وهو شاعر لا يخاف الموت؟
*- لماذا طلب أن لا يزوره أحد في حال مرضه؟
*- لماذا هو حلو لمنْ أراد حلاوته ، ولا يكون حلو المعاشرة دائما ، لمنْ أراد ولمنْ لم يُرِد؟
*- لماذا وصف الموت المفاجئ في الخيمة ، ولم يصفه في الصحراء مثلا أو في أيّ مكان آخر؟
*- ما سبب شيوع ألفاظ أسلوب الاستثناء الظاهر بالأدوات أو الضمنيّ المقدر؟
يبدو أن من يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، قادر على أن يكشف بوضوح أنّ الشاعر يعيش حالة نزاع واضحة مع ذاتّه الأم أو( الأصل ) _ إنْ صحّ إطلاق هذه التسمية _ من أجل التفريق بينها وبين الذّات المتمرّدة التي انتصرت ، وأخرجته من قومه، وصورته بأنّه لا يخاف من الموت ، إلّا أّن الذّات الأُم تستفيق في بعض الأحيان ، فتجد لها مكانا في نفسه محاولة منها لإثبات الوجود ، فيمكن أن نتصورها وهي تقول له _ فعلا _ إنّك ستموت ، وقد لا تخاف الموت ، وأنّك تتحلى بالشجاعة ولكن، لن يؤثر موتك هذا في أحد ؛ لأنّ قرابتك الحقيقية مفقودة ، فلن يزورك أحد، حتى وإن رغبت في ذلك ، ولن تنفعك حلاوة أخلاقك ؛ لأنّك لم تُذِبْها في القبيلة التي احتضنتك ، وقد يصح أن نقول بأنّ الشّنفرى قد أذعن لهذه الذّات ، وأظهر رغبته في الموت بين عمودي الخيمة حيث الأهل والأحبة ، ولكنّ الذّات المتمرّدة حجّمت تلك الرغبة ، فأعاد الشاعر صياغتها على ما تحبه هي فيقول[25]:
وقد يوضح هذا الأسلوب الشّرطيّ حالة انقياد الشاعر لهذا الصراع الوجوديّ المتلاطم ، فتارة مع ذاته المتمرّدة ، وأخرى مع ذاته الأصل ، فهو في حالة صراع دائم مع ذاتينِ مُتصارعَتينِ تشترط كلّ منهما حالة نقيضة للأخرى فيكون:
الموت في الصحراء مرضٍ الموت وسط الأحبة والأقارب أفضل
مريض في الصحراء مرضٍ مريض ويزورك الأقارب أفضل
حلو المعاشرة مع الصعاليك مرّ المعاشرة مع قبيلته
الموت أمر محقق مكانيا مع الأحبة أجمل
ويبدو أنّ أسلوب الشّرط ، بما ينماز به من سمات تعبيرية ثنائيّة ، يتقارب أو يتباعد بها فعل الشّرط وجوابه قد استحسنه الشاعر ، استجابة لما يمليه عليه الصّراع الوجوديّ مع ذاته ، فراح يوظفه في شعره قائلا[26]:
على أنّ هذا التوظيف قد برز بشكل لافت في لاميته ، ليكشف عن ذاته المتصارعة قائلا[27]:
وفي موضع آخر يقول[28]:
ويقول أيضا[29]:
ويقول أيضا[30]:
ويقول أيضا[31]:
لقد درس مجموعة من الباحثين ظاهرة الثنائية في لامية الشّنفرى ، من خلال الفن التقابليّ فتوصلوا إلى ( )أنّ الثنائيات الضدية التي توجد في لامية العرب تشكل منظومة دلالية تكشف في كثير من الأحيان عن الثّنائية الذاتية المنطوية في نفسية الشاعر، وهي ثنائية الإيجاب – السلب المتجسدة في تقابل الخير – الشر، والتي يستخدمها الصعلوك غالباً لإبراز مواقفه الفكرية حيال الكون والحياة)([32] التي يعيشها بمختلف تفصيلاتها .
والحقّ أنّ حالة الرصد في هذا البحث كانت موفقة ، ولكنّها حصرت هذه الثنائية النفسية في لاميته فقط ، ولو عُمّمَت على شعره لكان أجدى . ولعل من حقّ قارئ هذا البحث أن يتساءل، ما نتائج هذا الصّراع الذي كشفت عنه تلك الأساليب ، وهل استمر انتصار الذّات المتمرّدة على منافستها الذّات الأم ؟
يبدو أن الشّنفرى نفسه قد أجاب عن هذا التساؤل في آخر أبيات لاميته قائلا [33]:
فهو يعلن صراحة بأنّ صراعه مع الوجود قد حُسِمَ لصالح الذّات المتمرّدة على واقعها الذي تأبى أنْ تستكين إليه ، مهما كلّفها الأمر ، فَتَحتّم على الشّنفرى أن يتّخذ من ( الأراوي الصحم )[34] رفقة بديلة له ، بعيدا عن ما أرادته الذّات الأخرى .
ومن يتتبع شعر الشّنفرى ، يجد أنّ هذه السّمة قد كانت حاضرة في أبياته الشعرية ؛ لما كابده وجود الشاعر المجهول بين القبائل ، وذاته المتمردة[35]، ولا يمكن القول بأنّ هذا الصّراع كان خاليا من مقومات شخصية الشّنفرى ، فمن دون شكّ هو يحمل من السّمات ما تجعله يعيش هذا الشعور ، وإلّا عاش كما عاش كثير من الأفراد الذين مرّوا بمثل هذه الظروف ، أو أشدّ منها ، وهذا ما يؤكده لنا صاحب ديوان الشّنفرى الذي وصف الشاعر (( بالشجاعة ، وقوة الإرادة ، والاعتزاز بالنفس ، وبالثقة التي ترافق الرجولة ، وبحب الحرية ، وإن أدت إلى الجوع والمخاطر والأهوال ))[36] التي يمكن أنْ تجابهه .
ولكن هذا لا يعني أنّ فكرة صراع الوجود كانت فكرة مقتصرة على الشّنفرى فقط، بل هي سمة إنسانية فرضتْ نفسها ـ في الأعمّ الأغلب ـ على النصّ الشعريّ في القصيدة العربية القديمة ، فمصاديقها حاضرة في شعر الشّنفرى وسواه من الشعراء[37] .
المبحث الثاني
( صراع الذّات مع القبيلة )
من يتتبع لامية الشّنفرى ، لن يجد صعوبة كبيرة في تشخيص الصّراع بين ذات الشاعر وقبيلته ، فهو يكشف _ وبوضوح _ حالة الصراع معها، معلنا انفصاله عنها قائلا [38]:
فالشاعر من الانطلاقة الأولى يرفض القبيلة ، ولا يميل إليها ، في سابقة جديدة تقوم على أساس أنّ الرحيل سيكون منه هو ، لا من القبيلة التي تتخلى هي _ في الأعمّ الأغلب _ عن أفرادها ، فهنا يبحث عن مكان يجد نفسه فيه ، فهو كريم وشجاع ، ويرفض أن يكون ذليلا خانعا فلا يحتاج إلا لذاته قائلا[39]:
والقصيدة طويلة تقع في تسعة وستين بيتا، في مجملها تحدٍّ وتمرّد على القبيلة ، مقابل الاعتزاز بما اختارته الذّات من بديل في الصحراء ومن اعتزاز بالنفس ، وعدم ربطها قسرا بالقبيلة، فهذه الأرض مفتوحة واسعة . ولعل القارئ يشاطرني الرّأي المنطلق من منظور نظرية التّلقي القائم على أساس صعوبة الفصل بين ما حدده النّصّ الشّعريّ الذي بين أيدينا ،وبين ما يمكن أن نتصوّره نحن من خلال القراءة والتحليل[40]، إلّا أنّنا نعمل بما نملكه من أدوات قراءة بسيطة قد تمكنّنا من فكّ شفرات هذا الصراع المتشابك في عمق المنشئ ، فحين يصرحّ بسعة هذه الأرض قائلا [41]:
فهل إنّ الشاعر كان فعلا يحسّ بهذه السّعة ، أم هو شعور متناقص قد فرضته الظروف المحيطة به وذاتيّته المتمرّدة على واقعها المرير؟
إنّ وضع حدود دقيقة بين ما يفرضه الواقع ، وبين ما نتأوّله في التحليل ، ليس بالأمر الهيّن[42] ، إلّا أنّ واقعية التحليل ، وعمق الرؤية ، هما من يسمحان برسم حدود تلك القراءة . ومن أجل وضع تحليلات قريبة لابدّ من التركيز على تحديات الصّراع الوجوديّ في ذاته مع القبيلة ، فهل وجد الشاعر في ذاته المتمرّدة بديلا عن تلك القبيلة التي تحيطه بالأمان ، وتعمل على رعايته من الأخطار في الأزمات ؟
يبدو أنّه قد وجد ضالته الجمعيّة في رفقته لمجموعة من الحيوانات ،وأجاب عن سؤالنا من خلال شعره قائلا [43]:
ولكنْ هذا لا يعني بأيّة حال من الأحوال أنّ الصّراع مع الذات من أجل القبيلة قد انتهى من خلال نجاح ذاته المتمرّدة في إيجاد بديل عن تلك القبيلة ، وهذا ما تكشف عنه لفظة ( لأَميَل ) في بيته الأول من اللّامية [44]:
إنّ من ينعم النظر في دلالة اسم التفضيل في اللفظة السابقة، يجد أنّها تحمل أبعادا نفسية عميقة ، فهو لم ينْفِ الميلَ إلى قومه ، ولم يتنكّر لهم تنكّرا تاما ، على الرغم مما فعلوه به ، ولعل هذا الانفعال يوحي بصراع تقابليّ بين شعور الذّات المتمرّدة ، والحاجة للقبيلة[45] .
ويبدو أنّ فلسفة الذّات قد تولّدت عند الشّنفرى ؛ نتيجة لما عاشه أو شاهده بصورة جليّة في (( حياة الفقراء من الناس ، الذين أطلقوا عليهم لقب الصعاليك ؛ لشعورهم بالبؤس ، ونقمتهم على البخلاء ورغبتهم في توزيع المال بين الناس بالقوة إذا اقتضى الحال ، وتتجلى قوة نفوس هذه الطائفة من الناس في استهانتهم بالحياة في سبيل الوصول الى الغاية التي يسعون إليها ))[46] بشتى الوسائل المتاحة .فسه فتوحة واسعة ه الجود دراسة فلسفية ظاهراتية
إنّ جزئية التحول في قوله : ( فإنّي إلى قومٍ سواكم لأمْيَلُ ) لم تنف الجماعيّة جملة وتفصيلا ، وتقترح الفردية من دون مبالاة بالجماعة ، وإنّما اقترحت أنْ تكون هناك جماعيّة ولكن من نمط آخر ، كما أفصح عنها الشاعر؛ لأنّه يُدرك تماما أنّ هناك خطرا داهما من دون الجماعة ، وهذا ما دفع أحد الباحثين إلى أنّ يصف الشعراء الصعاليك بالاشتراكيّة ، فرأى أنّ عُروة بن الورد ـ مثلا ـ تتحقّق فيه هذه الصفة [47]، والحقّ أنّ هؤلاء الشعراء ـ ولا سيما الشّنفرى ـ لم تكن لديهم مثل هذه المفاهيم المؤسّساتيّة القائمة على نظام متكامل ، وإنّما هي صراع وجوديّ قد انتابهم ، فلم تكن مشاركتهم للجماعة من الفقراء (( مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي ولا نظاما للإنتاج والتوزيع ، وإنما هي إدراك عميق للظروف الإنسانية الملحة التي كانت تعانيها فئة من الناس ، وهي بالتالي وسيلة من الوسائل التي سلكتها هذه الفئة ، لحض الجهود الفردية للعمل ، والدعوة إلى التخفيف عما تعانيه هذه الفئة ، وهذا تقييم للمعاني الإنسانية الإبداعية التي تجلت واضحة في الذهن العربي ))[48] في تلك الحقبة .
ويبدو أنّ هذا التحول من القبلية الى الذّاتيّة ، هو نتيجة طبيعية في سلوك الشاعر ؛ لفقده الإحساس بالعصبية القبلية ؛ لأن الشاعر قد انقطع اجتماعيّا عن القبيلة ، وتصور قدرته على بناء نظام جديد[49] ، ومن ثم انقطع فنيّا عنها، فلم يَعُد الشّنفرى لسان عشيرته ؛لأنّ ما بينه وبين عشيرته قد انقطع ومن هنا يتضح جلياّ أنّ (( أساس حركة الصعلكة الاعتداد بالشخصية الفردية واعتزاز بمقدرة الفرد على الوقوف بوجه المجتمع ، ومن هنا كان لكل شاعر صعلوك ( إلى جانب شخصيته الجماعية) شخصية فردية خاصة يتفرد بها بين جماعته ، ولكنهم ( مع اعتدادهم بشخصياتهم الفردية ) كانوا حريصين على شخصيتهم الجماعيّة ؛ لأنهم أقدر جماعة على تحقيق مذهبهم في الحياة منهم أفرادا ))[50] متفرقين هنا وهناك .
وأخيرا يمكن القول إنّ ذاتيةّ الشّنفرى التي خرجت من وسط زحامات القبلية ، وشدّها اللصيق لم تكن إلّا نتيجة النّزعة الذّاتيّة القائمة على أساس اعتداده بنفسه ، وأنّه لا يقلّ شأنا عن أسياد القوم ، فهو يمتلك مقومات النّبل والشجاعة ، فإن لم تحصل المساواة ، فلن تسمح له نفسه أنّ يستمر على هذا المنوال ، وتفرض عليه التحلل من القبيلة والبحث عن بديل ، وهذا كله لم يكن لولا الصّراع الوجوديّ .
الخاتمة :
لقد بدت خلال رحلة البحث هذه جملة من النتائج يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:
1- إنّ فكرة صراع الوجود لدى الشّنفرى ليست خاصة بالشاعر نفسه ، وإنما هي سمة إنسانية قد فرضت نفسها على النّصّ الشعريّ في القصيدة العربية القديمة .
2- إنّ الفصل بين الذّاتيّة والقبليّة ، هو فصل على أساس الدراسة والبحث لا على أساس انفصال الشاعر عن ذاتيّته تماما أو عن قبليّته تماما.
3- لا يمكن أن نُخفي ظاهرتي الالتزام والتّمرد على ( الذّاتيّة والقبليّة ) في أغلب الشعر العربي ، ولكن تبقى الذّاتيّة التي هي سمة الذّات المتمرّدة في شعر الشّنفرى واضحة بشكل جليّ .
4- إنّ الشّنفرى في صراع الوجود ، لم يتجرد تماما عن قبيلته ، ولم يشعر بانتماء كامل لها ، بل جمع هاتين السمتين خيط قويّ ، يرتخي في موضع ، ويقوى في موضع آخر فيتأرجح بين هاتين السّمتين .
5- عندما يمدح الشّنفرى القبيلة فهو يمدحها بما تمليه عليه قريحته وذوقه ، بمعنى أنّه قد لا يكون له وجود أصلا ، أو قد يكون موجودا فعلا ولكنه أظهره بشكل فنيّ مؤثر ، وهنا تمتزج الذّاتيّة بالقبليّة مضمونا لا شكلا في الواقع اللفظي للمفردات .
ـ المصادر والمراجع:
– القرآن الكريم.
– الأصمعيّات ، الأصمعي ( أبو سعيد عبد الملك بن قُريب ت 216ه ) ، شرحها وحققها ،د. سعدي ضناوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1424ه ـ 2004م .
– الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني، تح لجنة من الأدباء، الدار التونسية للنشر ، بيروت ، ط6، 1983م.
– الإنسان في الشعر الجاهلي، د. عبد الغني أحمد زيتوني ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، الإمارات ، ط1، 2001م.
– البنية السردية في شعر الصعاليك ،د. ضياء غني لفتة، دار الحامد ، عمان – الأردن، ط1، 2010م.
– خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، البغدادي ( عبد القادر بن عمر ت 1093ه ) ،تحقيق وشرح ، عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1418ه ـ 1997م .
– دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة 1981م .
– ديوان دريد بن الصّمة، تحقيق ، د. عمر عبد الرسول ، دار المعارف ( د . ت ) .
– ديوان الشنفرى ( عمرو بن مالك 70ق.ه ) ، جمعه وحققه وشرحه ، اميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي، بيروت ، ط2، 1417ه ـ 1996م .
– ديوان الهذليين ، السّكريّ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط1 ، 1948م .
– الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهراتية ، باسم إدريس عباس ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط1 ، 2014م.
– شرح أشعار الهذليين ، صنعة ، السّكريّ ( أبي سعيد الحسن بن الحسين ت 275ه ) ، ضبطه وصححه ، خالد عبد الغني محفوظ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط1 ،1427ه ـ 2006م .
– الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، د. يوسف خليف ، دار المعارف، مصر، ط2، (د.ت).
– شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، د.عبد الحليم حفني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1987م .
– شعرنا القديم رؤية عصرية ، أحمد سويلم ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ، 1979م .
– الشعر وطوابعه الشعبية على مرّ العصور ، د. شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر ، ط2 ، (د.ت).
– الفروسية في الشعر الجاهلي ، د. نوري حمودي القيسي، عالم الكتب ، بيروت – لبنان، ط1، 2004م.
– مجمع الأمثال ، الميداني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، ط2 1987م .
– مختارات من النصوص الشعرية ، د. محمد ربيع ود. صادق خريوش ، دار الفكر ، عمان، ط1، 1999م .
– المفضليات ، الضّبي ( المفضل محمد بن يعلى بن عامر ت 168ه ) ، تحقيق ،د. قصي الحسين ، منشورات دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ط1 ، 1998م .
– المقامات والتلقي، نادر كاظم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، ط1، 2003م.
– الميزان في تفسير القرآن ، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية ، بيروت – لبنان ، ط2 ، 1985م .
– نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، أحمد بو حسن، ضمن كتاب نظرية التلقي ، إشكالات وتطبيقات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ، 1993م.
ـ الرسائل والأطاريح :
– القيم الإجتماعية والفنية في شعر الصعاليك ( رسالة ماجستير ) ، الأمين محمد عبد القادر ، بإشراف البروفيسور أحمد الحاردلو ، جامعة الخرطوم ، كلية الآداب ، 2008م .
– لامية العرب ( دراسة تاريخية نقدية ) ،( رسالة ماجستير ) ،محمد مشعل الطويرقي ، بإشراف د. لطفي عبد البديع ،جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، المملكة العربية السعودية ،1406-1407ه .
ـ المجلات :
– الشّنفرى من خلال الثنائيات الضدية في لامية العرب ( دراسة في ضوء القراءة النثروبولوجية) ، علي أكبر نور سيده و شاكر العامري و مليحة يعقوب زادة ، بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، 2016م.
– قراءة في أنساق الصراع الوجودي في نصوص من شعر المثقب العبدي ، د. غيثاء قادرة ، بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها ، العدد 21، 1394ه – 2015م .
[1] كانت للشاعر في قبيلته منزلة رفيعة ، وأهمية كبيرة ، فكان أنْ نشأ بينهما (عقد اجتماعي) تطور الى ما يمكن أنْ يُسمى( العقد الفني ) الذي يفرض عليه ألاّ يتحدث عن نفسه ، وإنما يتحدث عن قبيلته، بوصفه لسانها المعبر عنها ، ويغدو شعره صحيفة لها ، على أنّ ذلك لا يعني اضمحلال شخصية الشاعر وانتفاء وجودها. ينظر : دراسات في الشعر الجاهلي : 174 ، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور : 21 . كبيرةقيلته منزلة كبيرةا
[2] – مجمع الأمثال : 3/ 375 .
[3] – الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 91.
[4] – المصدر نفسه : 92.
[5] – ديوان دريد بن الصمة: 61- 62.
[6] – الإنسان في الشعر الجاهلي : 85.
[7] – ينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، القيم الاجتماعية والفنية في شعر الصعاليك ( رسالة ماجستير).
[8] – الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 33 ، وظ : شعرنا القديم رؤية عصرية : 21 .
[9] – الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 155.
[10] ـ ينظر : الأغاني : 13 / 3 ـ 10 .
[11] ـ ينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الأموي : 12 .
[12] ـ ينظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 58
[13]ـ على الرغم مما أثير من اختلاف حول نسبة القصيدة الى الشّنفرى وأنّها تُنسبُ الى خلف الأحمر وهو ما شاع لدى بعض القدماء منهم القالي ، ومن المستشرقين كرنكو وبلاشير ، ومن العرب المحدثين د. يوسف خليف مستندين في ذلك الى جملة من الأمور منها عدم إشارة ابن قتيبة لها فضلا عن إغفال صاحب الأغاني لذكرها في أثناء ترجمته للشّنفرى وغير ذلك ، إلّا أنّها في مجملها أدلة لا يمكن الركون اليها لنفي هذه النسبة ، وقد نوقشت هذه الآراء مناقشة علميّة مستفيضة وفُندت جميعا ، ومن ثمّ فلا ضرورة إلى إعادة ما قيل فيها . ينظر: ديوان الشّنفرى : 15 ـ 18 ، لامية العرب دراسة تاريخية نقدية ( رسالة ماجستير ) : 19 ـ 42 .
[14] – ينظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 181.
[15]ـ ينظر : الأغاني : 21/ 201 ـ 218 ، خزانة الأدب : 3 / 343 ـ 345 .
[16] ـ ينظر : ديوان الهذليين : 2 / 127 ، 169 ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه : 378 ـ 391 .
[17] ـ ينظر : المفضليات : 135 ، الأصمعيات : 36 ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه : 392 ـ 394 ، وهناك سمات أخرى انمازت بها أشعارهم منها : الحديث عن الموت ، والفرار وسرعة العدو ، والمراقب ، واتخاذهم الصحراء ملاذا آمنا ، فضلا عن وصف الجوع وغير ذلك . ينظر : المفضليات : 7 ـ 11 ، شرح أشعار الهذليين : 1 / 65 ـ 66 ، 237 ، الأغاني : 18 / 215 ـ 217 .
[18] – ينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 276 ـ 277 ، وينظر : مختارات من النصوص الشعرية :21.
[19] – المائدة : 80.
[20] – آل عمران : 154.
[21] – آل عمران : 135.
[22] – الميزان في تفسير القرآن : 3 / 295 .
[23] – ينظر : الأغاني : 21/201 .
[24] – الديوان : 38.
[25] – الديوان : 38.
[26] – المصدر نفسه : 44.
[27] – الديوان : 59.
[28] – المصدر نفسه : 60.
[29] – المصدر نفسه : 62.
[30] – المصدر نفسه : 67
[31] – المصدر نفسه : 71.
[32] – الشنفرى من خلال الثنائيات الضدية في لامية العرب ( بحث ) : 1 .
[33] – الديوان: 72.
[34] – الأراوي : هي أنثى التَيس البري ، والصّحم : جمع أصحم للمذكر ، وصحماء للمؤنث ، وهي السوداء الضارب لونها إلى الصفرة .
[35] _ ينظر : الديوان : 28 ، 44.
[36] – الديوان : 22.
[37] _ ينظر : الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهراتية ، قراءة في أنساق الصراع الوجودي في نصوص من شعر الثقب العبدي ( بحث ) .
[38] – الديوان : 58.
[39] – المصدر نفسه : 58.
[40] – المقامات والتلقي : 23.
[41] – الديوان : 59.
[42] – نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث : 23 .
[43] – الديوان : 59.
[44] – المصدر نفسه : 58.
[45] – الشنفرى من خلال الثنائيات الضدية في لامية العرب : 7.
[46] – الفروسية في الشعر الجاهلي: 223.
[47] – ينظر: المصدر نفسه : 221.
[48] – المصدر نفسه : 222.
[49] – البنية السردية في شعر الصعاليك : 18.
[50] – – الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 267.