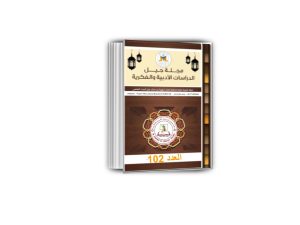منهج رصد الأخطاء اللغوية وتصنيفها ومعالجتها:
مقاربة بين الدراسات العربية القديمة والدراسات الغربية الحديثة
The Methodology of Monitoring Linguistic Errors and its Clasification and Treatment:
A Comparative Approach between Ancient Arabic Studies and Modern Western Studies
الأستاذ الدكتور/ أحمد قريش – جامعة أبي بكر بلقايد / تلمسان / الجزائر
Doctor. Ahmed Guerriche
Aboubekre Belkaid University of Tlemcen – Algeria
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 51 الصفحة 25.
Abstract:
This article tackles the method of monitoring errors and identifying them in ancient Arabic studies, and the way of addressing them according to the method adopted by the Arab scientists. The article also clarifies the scientific foresight of Arabs in dealing with such topics of great importance, and shows their firm position regarding the protection of Arabic through this lesson which explores the justified and unjustified errors and the strive to correct them in accordance with the measurement. This stance reflects an acumen and authenticity that allowed Arabic to preserve its entity to date.
Arab scientists are, without a doubt, the pioneers of this scientific field. They preceded their western counterparts who followed their approach in the study of errors. Some Arab applied linguists linked the phenomenon of linguistic errors to a psychological factor following in that Stephen Pit Corder who claims to be the founder of the theory of error analysis in linguistic studies during the second half of the past century. However, Al Jahiz (255 Hijri) has previously explained the learning methodology, such as ‘ease and rigidity’ in the middle and intermediate language of the ‘Aajim’, and the westerners followed Al Jahiz’s methodology which they claimed to be the core of their thinking and the fruit of their efforts.
الملخص
تتناول هذه المقالة طريقة رصد الأخطاء وتحديدها في الدراسات اللغوية العربية القديمة، وكيفية معالجتها وفق المنهج الذي تبنّاه القدامى من علماء العرب. وتبرز لنا أيضاً السبق العلمي للعرب في تناول هكذا موضوعات ذات أهمية كبيرة، وبيان موقفهم الحازم في حماية العربية من خلال هذا الدرس الذي ينقّب عن الأخطاء المبررة وغير المبررة، والسعي إلى تصويبها بما يوافق القياس. وهو موفق ينمّ عن فطنة وأصالة، حافظت بفضلهما العربية ولا تزال على كيانها.
وعلماء العربية – من دون شك – هم الرواد في هذا الحقل العلمي، فسبقوا نظرائهم الغربيين الذين اهتدوا في دراسة الأخطاء إلى اتّباع منهجهم.
ربط بعض اللغويين العرب التطبيقيين في تفسير ظاهرة الأخطاء اللغوية بعامل نفسي، متّبعين في ذلك (Stephen Pit Corder) الذي يزعم أنه مؤسس نظرية تحليل الأخطاء في الدراسات اللغوية في النصف الثاني من القرن الماضي، على حين أن الجاحظ (تـ 255هـ) سبق له وأن شرح منهجية التعلم – كالسهولة والتَّحَجُّر- في اللغة الوسطى أو المرحلية عند الأعاجم، وقلّده في ذلك الغربيون الذين زعم بعضهم أنّها من صلب تفكيرهم، وثمرات جهودهم.
مفاتيح المقالة: اللغة، الخطأ، وصف، أسباب، الصواب.
1- المقدمة
تحتلّ اللّغة البشرية المكانة المرموقة في حياة الإنسان الفكرية ومختلف نشاطاته الحياتية، ذلك لأنّه عاجز- تمام العجز- إجراء أي تواصل بين الأفراد والمجتمعات من دون اللّجوء إلى اللّغة، كما لا يتسنّى له سبر أغوار المنظومة الفكرية الإنسانية دون امتلاك ناصيتها، وما يحكمها من أنظمة متكاملة ومتفاعلة فيما بينها ضمن إطار النّظام اللّغوي الشّامل الّذي بواسطته يعبّر الفكر الإنساني عن كيانه، أي أنّ هذا الإنسان في الوقت الّذي اقتدر فيه على الاصطلاح و وضع الألفاظ، اهتدى بحكم تفكيره إلى وضع قواعد لضبط اللّفظ، وتحديد المعنى، وتنسيق العبارة، وتحسينها وتجميلها، فكانت اللّغة، ولعلّ ما كان يطلقون عليه “اللغة” كان يقابله مصطلح اللّسان([1]).
وبمقدار رقيّ الجماعة وتحضرها يكون حظّ لغاتها أيضا من وضع القواعد، وطرق التّنسيق والتجميل، لأنّها إضافة إلى كونها عبارة عن “أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم”([2]). فهي محكومة أيضا بجملة من النواميس اللّغوية تلزم المتكلّم احترامها في كلّ عملية تواصل. فعلى المستوى الصوتي فهي مقيّدة بمدرجه الممتد من الشّفتين إلى أقصى الحلق. وعلى مستوى الاستعمال ما تقدر هذه الأصوات صنعه في أثناء تقلبها وتركبها من ألفاظ مستعملة وألفاظ يمكن استعمالها في المستقبل، وكلا المستويين لـهما مقدار محسوب لا تقوى اللّغة على مجاوزته.
وفي إثر ذلك أصبح لكل لغة مستوى صوابي خاص، يقوم على أساسه الحكم بالصواب أو الخطأ، وهو مقياس تفرضه الجماعة اللغوية على الأفراد. و المستوى الصوابي للغة العربية ليس أمرا جامدا محددا، فكثير من مسائل الخلاف بين العلماء القدماء حول ما يجوز وما لا يجوز، سببها الاختلاف في تحديد المستوى الصوابي.
وما لا تختلف حوله الدراسات أنّ العربية أقدم اللّغات السامية، ومن أقدم لغات العالم، فلم تبرح في جاهليتها عن عقر بيئتها، ولم تتعدّ جغرافية الجزيرة، وخروجها في الإسلام كان للجهاد ونشر العقيدة. ولم يتواصل العرب بغير لغتهم، ولم يكتبوا بغير ألف بائهم طوال مراحل تاريخهم، على خلاف كثير من الأمم([3]). وقد أشار أحد علماء العربية إلى هذه الميزة، بقوله: “كانت العرب في جاهليتها على إرثٍ من إرْث آبائهم في لغاتهم وآدابهم…”([4]) ولهذا حافظت العربية ولا تزال على كيانها وأصالتها، “إنما انقادت واستوت واطردت وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة”.([5])
هذا ما يترجم بجلاء ارتباط حياة الأمة العربية منذ التاريخ القديم بحياة لغتها ارتباطا لا نظير له على خلاف غيرها من الأمم، وعزّز هذا الارتباط وقوّى أواصره القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي، ﴿إنّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون﴾.([6]) ﴿إنّا جعلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون﴾.([7]) ﴿وإنّه لتنزيل ربّ العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين﴾.([8])
وكانت هذه العوامل في جملتها الحافز الأساس في انطلاق الدرس اللغوي، الذي نال قدرا كبيرا من اهتمام العلماء منذ عصر الخلفاء الراشدين في إنشائه و تطويره وتأصيله حتى انفرد بمرحلة متقدمة من الوضوح المنهجي عن بقية العلوم الأخرى. وما معالجة الأخطاء اللغوية إلا جزءا من هذا الاهتمام.
والهدف المتوخى في هذه المقالة هو التطرق إلى نظـرية تحـليل الأخطاء وبسطها، بحكم أنّها فرع من فروع اللسانيات التطبيقية في الدرس اللغوي العربي القديم. والتي اعتمدتها الدراسات الغربية الحديثة بشيء من التوسع والتنوع، من دون الإشارة الصريحة سواء عن قصد أو عن غير قصد إلى المصادر الأصلية التي نهلت منها([9]).
يرى علماء اللغة الغربيين: أن اللسانيات التطبيقية ولا سيما نظرية تحليل الأخطاء وليدة تطورهم العلمي الحديث، ويزعمون أن هذه النظرية ظهرت للوجود مع نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن العشرين. وأنّ باعجها هو العالم اللغوي الأمريكي من أصول فرنسية: كوردر (Corder) في كتاباته عن تحليل الأخطاء([10]).
وما كان ظهور هذه النظرية إلا لمعارضة نظرية التحليل التقابلي، التي أرجعت سبب الأخطاء إلى التداخل، والنقل من اللغة الأم إلى اللغة الهدف. بيد أنّ مجموعة من اللغويين الغربيين وعلى رأسهم العالم ” كوردر” عارضوا هذه النظرية، معتقدين أن دواعي الأخطاء لا تقتصر على التدخل من اللغة الأم فحسب، بل توالت أسباب أخرى تطورية داخل اللغة الهدف، كطريقة التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو اللغوي، وطبيعة اللغة المدروسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب، والافتراض الخاطئ، وغيرها. وهي عوامل تأثر من دون شك فيما يواجه الدارسون من مشكلات. بغض النظر عن أوجه التقاطع والاختلاف بين لغة الدارسين، واللغة الثانية التي يتلقنونها “([11]).
على حين يرى متبنو نظرية تحليل الأخطاء: أن التعرف على حقيقة المشكلات التي تواجه الدارسين أثناء تلقنهم للغة لا يتأتى إلا عن طريق تحليل الأخطاء. ومن خلال نسبة ورود الخطأ نتمكن من معرفة مدى صعوبة المشكلات أو سهولتها، هذ ما يغنينا عن التحليل التقابلي([12]).
وفّر الأوائل من العرب أسباب التطوّر لحماية لغتهم من العوامل المؤثّرة فيها، سواء أكانت داخلية ناجمة عن مؤثّرات طبيعية مرتبطة بتطوّر اللّغة ذاتها، أم خارجية أفرزها امتزاج ثقافة العرب وحضارتهم بثقافة وحضارة من حتّمت الظّروف الاجتماعية والتّاريخية([13]) الاحتكاك والاتصال بهم. فلم يكن بدّ أن يكون لهذا الاتّصال أثره المحتوم، إلى جانب مظاهر الحياة المختلفة في لغة الفئتين، لذلك شاع في اللّغة ما أطلق عليه اللّغويون والنّحويون اللّحن، الذي يعرف على أنّه الخطأ اللّغوي في التّراكيب والكلمات ذات الأصول العربية. وقد عبّر الزبيدي (تـ989هـ) عن ظروف هذه الظاهرة بقوله: “لم تزل العرب على سجيتها في صدر إسلامها، وماضي جاهليتها، حتّى أظهر الله الإسلام على سائر النّاس، فدخلوا فيه أفواجا، وأقبلوا عليه أرسالا، واجتمعت فيهم الألسنة المتفرّقة واللّغات المختلفة، ففشا الفساد في اللّغة العربية، واستبان منها في الإعراب الّذي هو حليها والموضّح لمعانيها، فتفطّن لذلك من نافر بطباعه سوء إفهام النّاطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب، فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته في تقييدها لمن ضاعت، وتثقيفها لمن زاغت عنه”([14]).
والتراث اللغوي يكشف لنا أنّ اللغويين العرب القدامى كانوا السباقين في مجال تقويم اللسان، وتصحيح الخطأ، بحيث أنهم خاضوا منذ القرن الثاني للهجرة ميدان معالجة الأخطاء الشفوية خاصة والكتابية عامة بشيء من التفصيل في التصنيف والوصف. ويعدّ كتاب “ما تلحن فيه العامة” للكسائي(تـ189ه)([15]) – وبإجماع بعض اللغويين- باكورة الأعمال اللغوية التطبيقية في اللغة العربية على خلاف من يرى بأن ابن قتيبة (تـ276هـ)، هو من تمثل أبحاثه إرهاصات هذا المجال([16]). ثم توالى التأليف والتصنيف في هذه الظاهرة اللغوية بشكل علمي دقيق.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن دراسة القدامى من علماء العرب في هذا المجال اقتضت استعمال مصطلحات كثيرة للدلالة على الأخطاء، نحو: اللحن، والتصحيف، والتحريف، والتصحيف، والغلط، والرطانة، والسهو، والهفوة، وزلة اللسان، وعثرات الأقلام، والأوهام, والـهَـنَة، وسقطات العلماء، وغيرها من المصطلحات، ولم يلاحظ على العلماء استعمال مصطلح “خطأ” في مصنفاتهم، إلا في وصف الخطأ؛ نحو: “قد أَرَيْتَ فُلاناً مَوضع زيد”، بغير واو. ولا يقال أَوْرَيْتُ، فإنه خطأ([17]).
والمبتغى الرئيس في هذا النوع من الدراسة عند العرب، يرمي في المقام الأول إلى حماية الفصحى خدمتها، وصون لسان العامة، وتصحيح أخطائهم. فكثرت فيه المصنفات التي وسمت بما ينسجم والهدف الذي من أجله ألّفت، على نحو: درة الغواص في أوهام الخواص، ولحن العامة، وما تلحن فيه العامة، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، وإصلاح المنطق، وتثقيف اللسان وتلقيح الجَنان، وتقويم اللسان، والجمانة في إزالة الرطانة، والتنبيه على حدوث التصحيف، والتنبيه على غلط الجاهل والنبيه، والإبدال، والفصيح، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وغير ذلك. وما كثرة المصنفات إلا دلالة واضحة على كثرة انغماس الناس في الأخطاء الشفوية أو الكتابية؛ وإن لم تستعمل كلمة خطأ فيها.
2- تعريف الأخطاء
من المصطلحات التي شاعت في هذا المجال: اللحن، والتصحيف، والتحريف، وغيرها لتشير إلى الأخطاء التي تجري على ألسنة الناس. وأبان علماء اللغة([18]) الفروق بين الخطأ، وزلة اللسان، والغلط. فالخطأ: هو ذلك النوع الذي يخالف فيه المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة. أو هو: “انحراف عن القواعد النحوية التي يستخدمها الكبار في لغتهم الأم”([19]). وزلة اللسان: يقصد بها الخطأ الناجم عن تردد المتكلم وما شابهه. أما الغلط فيقصد به: إتيان المتكلم بكلام غير مناسب للموقف.
تعريف اللحن
اللحن: “خلاف الصواب في الكلام والقراءة والنشيد”([20]).
وظهر اللّحن أوّل ما ظهر في القضايا ذات الصّلة بالإعراب، فهذه ابنة أبي الأسود الدؤلي(تـ69هـ) تنغمس فيه فتقول لأبيها: ما أشدُّ الحرِّ”، قال لها: “الحصباءُ بالرمضاءِ. قالت: إنّما تعجبتُ من شدّته. قال: أوقد لحن الناس؟”([21]).
ولم يخف الرسول – صلى الله عليه و سلم- و بعض الخلفاء والعلماء والأعراب على حدّ السواء قلقهم من فشوه – ولا سيّما في قراءة القرآن الكريم – إذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ فيلحن، فقال:” أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ”.([22]) و هذا ما خشاه أبو بكر على نفسه في قوله: “لأن أقرأ و أسقط أحبّ إليّ من أن أقرأ و ألحن” ([23]). وارتاب منه عبد الملك بن مروان، حين قيل له: أسرع إليك الشيب، فقال: “شيّبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن”. وفي رواية أخرى:” شيّبني ارتقاء المنابر وتوقُّع اللّحن”([24]). والتزم الحجاج بعدم الوقوع فيه بعد أن قوّم يحيى بن يعمر (تـ129هـ) لسانه في استشارة له: أتسمعني ألحن على المنبر؟ قال: تقول: الأمير أفصح من ذلك، فألح عليه، فقال: حرفاً، قال: أيّاً؟ قال: في القرآن، قال الحجاج ذلك أشنع له، فما هو؟ قال: في قوله جلّ وعزّ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.([25]) فتقرأها (أحَبُّ) بالرفع، والوجه أن تقرأ بالنصب (أحَبَّ) على أنه خبر كان، قال: لا جرم لا تسمع لي لحناً أبداً فألحقه بخراسان([26]). كما دفع – اللّحن – عبد العزيز بن مروان على تعلّم اللّغة في رواية أطلعنا عليها ابن كثير(تـ774هـ) في مؤلفه البداية والنهاية في أثناء ترجمته له: كان يلحن في الحديث وفي كلامه، ثمّ تعلّم العربية فأتقنها وأحسنها، فكان من أفصح الناس، سبب ذلك أنّه دخل عليه رجل يشكو ختنه، فقال له عبد العزيز: من خَتَنَكَ؟ فقال الرجل: ختنني الخاتن الذي يختن الناس، فقال لكاتبه ويحك بماذا أجابني؟ فقال الكاتب: “يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول من خَتَنُكَ؟ فوقع في نفسه ألاّ يخرج من منزله حتّى يتعلّم العربية”([27]).
وأظهر الكشف المبكّر لهذا الدّاء اللّساني مواقف حازمة لتقويضه واحتوائه قبل استفحاله، ولعلّ أوّل موقف كان ذاك الذي أبداه الرسول – صلى الله عليه و سلم – حين أحسّ بمسؤولية الوقاية منه، داعيا في ذلك الله أن يشمل برحمته من يصلح نفسه منه في قوله: “رحم الله امرأ أصلح من لسانه”([28]). كما أبدى بعضهم الشدّة في معالجة الظاهرة، منهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ذكر عنه أنّه ردّ كتاب أبي موسى الأشعري عامل الكوفة في عهده للحن ورد فيه موقّعا أسفله: أقسم عليك ألا ما قنعت كاتبك سوطا، فلما جاء الكتاب إلى الكاتب وسأل عن خطئه فيه، قيل له في عنوانه([29])، فأصلح عنوانه وأرسله إلى الخليفة فقبله منه. كما ورد في الأخبار أنّ عمر بن الخطاب قد أدّب أولاده بسبب اللّحن([30]).
ولم يقوَ الخليفة هارون الرشيد على كتم امتعاضه من لحن وقع من الفراء (تـ207هـ) في حضرته، وخاصة أنّه كان من علماء اللّغة، فقال له ملتمسا منه العذر لما بدر منه لأنّه لم يكن من البداة المطبوعين على الفصاحة: “إنّ طباع أهل البدو الإعراب، وطباع أهل الحضر اللّحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الطّبع لحنت”([31]). فلا المكانة التي حظي بها الفراء عند الخليفة شفعت له، ولا المقام سمح بغضّ الطّرف عن اللّحن، لأنّ قناعة الاستعمال السليم للغة مبدأ تشبّع به العرب، وقد أشارت إلى ذلك بعض القصص التي أوردها الجاحظ (تـ225هـ) في مؤلفه البيان والتّبيين، أنّ العرب إذا أرادت أن تستمع إلى نادرة أوصت بالحفاظ على إعرابها ومخارج ألفاظها، لأنّ تغييرها يؤدي بها للخروج عن غايتها” ويردف – الجاحظ- قائلا موضحا بأنّه: “إذا التقطت أيّ نادرة من كلام العرب، فاحذر أن تسردها إلا مع إعرابها، بمعنى محاولة ضبط مخارج ألفظها، فإن غيّرت نطقها مثلما هو عند المولّدين والبلديين لم يعد لهذه الحكاية معنى”([32]).
كما نقل نفس الكاتب رواية في ذات المؤلَّف من باب التندر في اللّحن الذي كان محلّ الفكاهة بين الأعراب والنّحاة، أنّ نحويا تقدّم بين يدي السلطان يشكو رجلا في دين له عليه، قال: “أصلح الله الأمير لي عليه درهمان، فقال خصمه: لا والله أيّها الأمير إنّ هي ثلاثة دراهم، لكنّه لظهور الإعراب ترك من حقه درهما”([33]). وظهور الإعراب الذي أشار إليه الخصم كان في لفظة ثلاثة، فالعدد يذكّر مع المعدود المؤنث، ويؤنث مع العدد المذكر في قواعد اللغة العربية، هذا ما أثار مخاوف المتكلم أن يقع في اللحن، فاستبدل لفظة ثلاثة بلفظة درهمان متنازلا في ذلك عن درهم من حقّه. ما كان لهذا الشاكي أن يضيّع حقه لو أصلح لسانه.
تعريف التصحيف
نكتفي في هذه المقالة بتعريفين، أولهما للأصفهاني يُحدده بقوله([34]): “هو أن يُقْرَأَ الشيءُ بخلاف ما أرادَه كاتِـبُـهُ، وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته”.
وثانيهما لابن سيده([35]) الذي يرى أنّ “والمصَحِّف والصَّحَفِي: الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف”.
ويذكر أن للتصحيف نتائج، فهي إما مزايا نافعة أو مثالب ضارة. وفي مجال من نفعه التصحيفُ، يروى أن “محمد بن الحسن” لما حضرَ إلى العراق اجتمع الناسُ عليه يسألونه ويسمعون كلامَه، فرفع خبره الوشاة إلى الرشيد وقيل: إن هذا يفتي بعدم وقوع الأعيان وعدم الحنث وربما يفسد عقولَ جندِك الذين حلفوا لك، فبعث بمن كبس مكانه وحمل كتبه معه، فحضر إليه من فتش كتبَه، قال محمد: “فخشيتُ على نفسي من كُتُبِ الحِـيـَل”، وقلتُ بهذا تروح روحي، فأخذت القلم ونقطتُ نقطةً، فلما وصل إليه قال: ما هذا؟ قلت: كتاب الـخَـيْل يُذْكَرُ فيه شياتُها وأعضاؤها، فرمى به ولم ينظر إليه”. قلت: فتخلّص بنقطة صَحَّـفَت الحاء المهملة بالخاء المعجمة([36]).
ومن التحريف الذي نفع ونجَّى من الهلاك أيضاً، قولُ أبي نواس وقد استطرد يهجو “خالصة” حظية الرشيد، فقال:
لقد ضَـاعَ شِـعْرِي عَـلى بَـابِكُمْ ** كمَا ضَـاعَ حَـلْـيٌ على خَـالِصةْ
عندما سمعت ذلك غضبت، وشكته إلى الرشيد، فأمر بإحضاره، وقال له: يا ابن الزانية تُعَرِّض بحظيتي، فقال: وما هو يا أميرَ المؤمنين، قال: قولك: “لقد ضاع شعري…” البيت، فاستدرك الفارطُ أبو نواس وقال: يا أميرَ المؤمنين لم أقل هذا وإنما قلت:
لقد ضَـاءَ شِـعْرِي عـلى بَـابِكُم ** كـمَا ضَـاءَ حَـلْيٌ عَـلَى خَـالصَة
فسكن غضبُ الرشيدِ ووصلَهُ، ويقال: إن هذه الواقعة ذكرت في حضرة القاضي الفاضل، فقال: بيتٌ قُلِعَتْ عينه فأبصر([37]).
ومن مثالبه أنه قد يجني على فاعله ويهدر دمه. وقد يكون نافعاً فَـيُـنْـجِـي أصحابه من الموت. ولقد سجل التاريخ العربي القديم مثل هذه الحوادث. ومن الذين جنى عليهم التصحيف وقتلهم الشاعر المشهور ابن الرومي؛ عندما سئل عن “الجرامض”، على سبيل التصحيف والتهكم، فقال ابن الرومي:
سـأَلتَ عن خبرِ الجرامض طالباً علم الجرامضْ
فهو الجرامض حين يُقْلَبُ ضارج فيقال جـارض
إلى قوله:
والصفع يحتاج إلى قرع يكون له مقابض
ومن الِّلحَى مـا فيه فعـل للمـواسي والمقـارض
وهجا الجماعة وأكثر من هجائهم، فشكاه الجلساءُ إلى القاسم بن عبيدالله، فتقدم إلى ابن فراس فسمَّه في خشكنانجة كانت منيته فيها([38]).
تعريف التحريف
“التحريف في الكلام: تغييرُه عن معناه. كأنه مِيل به إلى غيره، وانحُرِفَ به نحوه”([39]). كما قال تعالى في صفة اليهود: ﴿يُحَرِّفون الكَلِمَ عن مواضِعِه﴾([40]). أي يغيرون معاني التوراة بالتمويهات والتشبيهات.
ملحوظة: فالتصحيف يكون خاصاً بتغيير نقط أو حركة الحرف دون تغيير صورته، والتحريف خاص بتغيير صورة الحرف.
3– منهج اللغويين العرب القدامى في دراسة الأخطاء اللغوية
اقتضت مني المنهجية التعرض- ولو بإيجاز- إلى طريقة تحليل الأخطاء عند الغربيين أولاً، ومن ثم نردها إلى أصولها الأولى عند اللغويين العرب القدامى.
يستند معالجو الأخطاء في بحوثهم اللغوية التطبيقية على ست مراحل أساسية نجملها فيما يلي:
أولاً: جمع المادة
ترتبط هذه المرحلة بمنهجية البحث، وطريقة جمع المادة اللغوية، وعدد المتعلمين، وما يفيد هذه المرحلة من معلومات ([41]). وقد سنّ علماء العرب القدامى في جمع الأخطاء طريقين: أولهما شفوي، وثانيهما كتابي. وهي السنة التي اتبعها ابن مكي مثلاً، الذي دلّنا عليها في جمعه للمادة اللغوية بقوله ([42]): ولقد وقفت على كتاب، بخط رجل من خاصة الناس وأفاضلهم فيه: وأحب أن تَشْتَهِدَ لي في كذا وكذا بالشين يريد تجتهد. ورأيت بِخَطِّ آخَرَ أكبَر منه وأعلى منزلةً، بيتَ شعر على ظهر كتاب، وهو قول الشاعر:
زوَامِـلُ لـلأسـفارِ لا عِلْم عِندهمْ ** بجَـيِّـدِهَا إلَّا كـعـلم الأبـاعرِ
كتبه للأصفار بالصَّاد. وأكثر الرواية فيه للأشعار.
وكتب إليَّ آخرُ من أهل العلم رُقعة فيها: وقد عزمت على الإتيان إليك، بزيادة ياء.
وشهدت يوماً رجلاً قِـبَـلَـهُ تخصصٌ وفِقْه، وحِفظ للأخبار والأشعار، وقد سمع كلاماً فيه ذكر الشِدْق, فلما سمعه بالدال – غير المعجمة – أنكره، وتعجب من أن يجوز ذلك، وليس يجوز سواه، ثم سألني، ورغَّبَ إليَّ أن أجمع له مما يصحف الناس في ألفاظهم، وما يغلط فيه أهل الفقه، وما قدرت على جمعه. فأجبته عما سأل، وأضفت على ذلك غيره من الأغاليط التي سمعتها من الناس، على اختلاف طبقاتهم، مما لا يوجد في كتب المتقدمين التنبيهُ على أكثره… فجمعت من غلط أهل بلدنا ما سمعتُه من أفواههم، مما لا يجوز في لسان العرب، أو مما غيرُه أفصحُ منه وهم لا يعرفون سواه، ونبهت على جواز ما أنكر قوم جوازه، وإن كان غيرُه أفصحَ منه، لأن إنكار الجائز غلط.
وفي ما يخص الموضوعات التي عالجوها فهي متنوعة ومتعددة. وتشمل الموضوعات النحوية، والصرفية، والصوتية، والمعجمية، والبلاغية، والأسلوبية، والإملائية، وغيرها، على غرار ما قام به كلّ من: ابن مكي، والزبيدي، وسيبويه، والجاحظ، والسيوطي، وابن هشام الإشبيلي، وأبو الطيب اللغوي، والزجاجي، والقالي، وثعلب، وابن جني، وغيرهم.
أما من حيث الكمّ، وأعني به تلك العينات التي اختارها العلماء في دراساتهم، فهو ذو حجم كبير، فقد جمعوا المادة اللغوية من جمهور الناس: عامتهم وخاصتهم، على غرار ما قام به كل من: ابن مكي، ابن السكيت، والحريري، والصفدي، والعسكري، وغيرهم.
ثانيا رصد الأخطاء وإحصائها
ندرت هذه العملية في مصنفات القدامى، فمن باب الحرص على صحة المادة التي يَدْرُسُونَها، والتأكيد على أهميتها لم يغفلوها، فجاء تعرضهم إلى جمع الأخطاء وإحصائها بشكل دقيق. يقول العسكري في هذا الشأن([43]): “لقد جاءني رجلٌ وبيده ورقةٌ مكتوبةٌ، وتحتوي على كثير من الأخطاء. ولقد جمعت الأخطاءَ فيها، فوجدت فيها سبعين خطأً”. ويقول أيضاً([44]): وقد ادَّعى خلف الأحمرُ على العُتْبِيِّ أنه صَحَّفَ هذا فقال في قصيدة عَدَّدَ فيها تَصْحِيْفَاتِه:
وفـي يَـوْم صِـفِّـينَ تَـصْحِيفَةٌ ** وأُخـرَى لـه فـي حـديثِ الـكُلاب
ثالثاً: تحديد الخطأ
إن عملية تحديد الأخطاء ليست بالأمر الهيّن، كما هو ساري في اعتقاد بعض علماء اللغة([45]). ولذلك يجب على الباحث في تحليل الأخطاء و معالجتها، أن يكون عالماً باللغة التي يَبحثُ فيها، ملمّا بنواميسها وضوابطها، لكي لا يُخَطِّئ الصواب، ويُصوِّب الخطأ، على غرار الطريقة التي اهتدى إليها العرب في تحديد الأخطاء منهجا و دراسة. نحو:
قال الراجز([46]):
يـا قَـبَّـحَ اللهُ بـني السعلات ** عـمْرو بـن يـربوع شِـرار الناتِ
لـيسوا بسـاداتٍ ولا أكـياتِ
وقال أيضاً:
يـا ابن الـزُّبـير طـال ما عصَيْكا ** وطـال مـا عنَّـيْـكنا إليكـا
لنضربنْ بسيـفِنَا قَـفَيْكا
من المؤكد أنّ هذه الأمثلة تضمنت أخطاء، أوجبت في بداية الأمر تحديدها وتمييزها بوضع خط مثلا تحتها، أو تلوينها بلون مغاير للون الكتابة، أو جمعها وتدوينها على ورقة أخرى. ومن ثمّ الانتقال إلى المرحلة الموالية.
رابعا: تصنيف الخطأ
تقتضي عملية تصنيف الأخطاء فطنة كبيرة ومرونة فائقة، تنطلق من تحديد المجموعة التي يندرج فيها الخطأ([47])، وتنتهي بتصحيحه، لأنه بالإمكان وصف الأخطاء ضمن مجموعات مختلفة، مثل: الأخطاء النحوية، والصرفية، والصوتية، والبلاغية، والأسلوبية، والمعجمية، والإملائية، والأسلوبية، والأخطاء الكلية، والجزئية، وغيرها. ويمكن أيضا أن يُصنف الخطأ الواحد في مجموعتين أو أكثر.
وقد أشار الزبيدي إلى هذا المنهج في تصنيف الأخطاء([48]) بقوله: “كنا قد أَلَّـفْـنَا فيما أفسده عَوَامُّنا وكثير من خَوَاصِّنا، كتباً قَسَّمناها على ثلاثة أقسام: قسم غُـيِّـرَ بناؤه وأُحِيل عن هيئته، وقسم وُضِع في غير موضعه وأُرِيد به غيرُ معناه، وقسم خُصَّ به الشيءُ وقد يَشْرَكهُ فيه ما سواه”.
وتبنّى ابن مكي المنهج ذاته كما يجليه قوله([49]): “فجمعت من غلط أهل بلدنا ما سمعتُه من أفواههم… وعلقتُ بذلك ما تعلق به الأوزان، والأبنية، والتصريف، والاشتقاق، وشواهد الشعر، والأمثال، والأخبار، ثم أضفت إليه أبواباً مُستطرفة، ونُتفاً مستملحة، وأصولاً يُقاس عليها. ليكون الكتابُ تثقيفاً للسان، وتلقيحاً للجَنان، ولينشط إلى قراءته العالِمُ والجاهِلُ، ويَشتركَ في مطالعته الحالي والعاطلُ. وجعلته خمسين باباً، هذا ثَبـتُها؛ منها مثلاً: باب التصحيف، وباب ما غيَّروه من الأسماء بالزيادة، وباب ما غيَّروه من الأفعال بالنقص، وباب غلطهم في التصغير، وباب ما وضعوه غير موضعه… وإنما ابتدأت بالتصحيف، لأن ذلك كان سَببَ تأليف الكتاب، ومفتاحَ النظر في تصنيفه، ثم أتبعته كلاماً يَليق به أو يُقاربه”.
خامسا: وصف الخطأ
لم تخرج عملية وصف الأخطاء عند محلليها عن أربع فـئات، وهي: الحذف، والإضافة، والإبدال، وسوء الترتيب([50]). أما الحذف، فيكون بحذف حرفً أو أكثر من الكلمة؛ أو كلمة أو أكثر من الجملة. أما الإضافة، فتكون بإضافة حرفً أو أكثر إلى الكلمة؛ أو كلمة أو أكثر إلى الجملة. أما الإبدال، فيكون بإبدال حرفً مكان آخر؛ أو كلمة مكان أخرى. وأما سوء الترتيب فيكون بترتيب حروف الكلمة خطأً في الجملة، وذلك بالتقديم والتأخير وغيرها.
وميّز ابن الجوزي الخطأ ووصفه بقوله([51]): “واعلم أن غلط العامة يتنوع: فتارة يضمون المكسور، وتارة يكسرون المضموم، وتارة يمدون المقصور، وتارة يقصرون الممدود، وتارة يشددون المخفف، وتارة يخففون المشدد، وتارة يزيدون في الكلمة وتارة ينقصون منها وتارة يضعونها في غير موضعها، إلى غير ذلك من الأقسام. وإن وُجِد لشيء مما نَهيتُ عنه وجه فهو بعيد، أو كان لغةً فهي مهجورة وقد قال الفراء: وكثيرٌ مما أنهاك عنه قد سمعتُه. ولو تجوزتُ لرخصتُ لكَ أن تقول: “(رأيت) رجلان” في لهجة من يلزم المثنى الألف، ولقلت: “أردت عن تقول ذلك”. إلى عنعنة تميم أي قلب الهمزة المبدوء بها عيناً. والله الموفق”.
سادسا: شرح الأخطاء
وهي عملية في غاية الصعوبة، عبّر عن كنهها كـوردر([52]) بقوله: “إن شرح الأخطاء هي عملية صعبة جداً وإنها الهدف النهائي والأخير من تحليل الأخطاء”. ويُقْصَدُ بشرح الأخطاء بيان أسبابَها. هل هي بسبب اللغة الأم أَمْ بفعل اللغة الثانية المكتسبة؟ أم أن هناك أسباباً أخرى لا بد من إبرازها.
لقد أولى القدامى اهتماما كبيرا لهذه القضية، فالجاحظ تضمن موسومه: البيان والتبيين، بعض أسباب الأخطاء الهامة جداً، التي يرتكبها المتعلمون للغة. وأفرد العسكري(تـ382هـ): مصنّفه “شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف” لهذا الغرض.
ومن جملة الأسباب المُجرة للأخطاء، منها ما هو عائد إلى الجانب اللغوي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي، ومنها ما هو مقرون بالجانب النفسي.
أولاً: الأسباب اللغوية
1) أخذ العلم من الصُحُف
مما رواه الكوفيون أن حَمَّاداً الراوية كان حَفِظَ القرآن من المُصحف، فكان يُصَحِّفُ نَيِّفَاً وثلاثين حرفاً. ويقول العسكري([53]) إنه كان يقال قديماً: لا تأخذوا القرآنَ من مُصْحَفِيّ، ولا العِلْم من صَحَفِيّ. ويَروي أعداءُ حمزةَ الزيات، أنه كان يتعلم القرآن من المُصْحف، فقرأ يوماً، وأبوه يسمع: “آلم. ذلك الكتابُ لا زيتَ فيه” فقال له أبوه: دع المصحف وتَلَقَّن من أفواه الرجال.
2) عدم نَقْط المصاحف والإعجام والترقين والشَّكل
إن السبب في نَقْط المصاحف حسب ما رواه العسكري([54]) هو: أن الناس غَبَروا يقرؤون في مصاحف عثمانَ رضي الله عنه، نيفاً وأربعين سنة، إلى أيام عبد الملك بن مروان. ثم كثر التصحيف، وانتشر في العراق ففزع الحَجَّاجُ إلى كُتَّابه، وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف الـمُشْـتَبِهَةِ علامات. فيقال: إن نصرَ بن عاصم قام بذلك، فوضع النَّقْـطَ أفراداً وأزواجاً. وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف، وبعضها تحت الحروف. فَـغَـبَـرَ الناسُ بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً. فكان مع استعمال النَّـقْطِ أيضاً يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام، فكانوا يُـتْـبِـعون النَّقْطَ بالإعجام. فإذا أُغفِل الاستقصاءُ على الكلمة فلم تُوَفَّ حقوقَها اعترى هذا التصحيفُ، فالتمسوا حيلةً، فلم يقْدِروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال. وكان من نتيجة هذا السبب وضع علم النحو. عندما سَمِعَ أبو الأسود الدؤليُّ رجلاً يقرأ: “إن اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولِه” بالجر، فقال: لا يَسعني إلا أن أَضَعَ شيئاً أُصْلِحُ به نحوَ هذا. فوضع النحو، وكان أَوَّلَ من رسمه.
3) نقص كفاءة الراوي باللغة أو عدمها
يروي العسكري في هذا الشأن([55]): أن مَنْ حَدَّثَ وهو لا يُفَرِّق بين الخطأ والصواب، فليس بأهل أن يُحمل عنه. حدثنا عبدُ الله بن الحارث عن يونس عن شهاب، أخبرني عبدُ الله بن ثعلبة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مَسَحَ وجهه “من القُبْح”([56]). قال أحمد: أخطأ وصحَّف، إنما هو “زَمن الفتح”. ومن مناقب خلف الأحمر أنه من أفضل ما عدد من مناقبه أن قال:
لا يَـهـِم الـحـاءَ في القـراءة بالـخا ** ء ولا يـأخـذ إسـنـادَه عـن الصُّـحف
4) الخط والهجاء
يُروى أنّ الأصفهاني([57]) سئل عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة؟ فأجاب قائلا: “إذا اعتدلت أقسامه، وطالت ألفهُ ولامهُ، واستقامت سطوره، وضاهى صعودَه حدورُه، وتَفَتَّحَتْ عيونُه، ولم تشتبه راؤه ونونُه، وأشرق قرطاسُه وأظلمت أنقاسُه (المداد)، ولم تختلف أجناسُه، وأسرع إلى العيون تصوُّره…”
يقول الأصفهاني([58]): إن مُـحَـدِّثـاً يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب العَسَل في يوم الجمعة، وإنما كان يستحب الغُسْل فيه…
5) التصحيف والتحريف
يذكر الأصفهاني([59]) دائما أنّ سبب وقوع التصحيف في كتابة العرب: “هو أن الذي أبدع صور حروفها لم يضعها على حكمةٍ, ولا احتاط لمن يجيء بعده، وذلك أن وضع لخمسة أحرف صورة واحدة وهي: الباء، والتاء، والثاء، والياء، والنون. وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة للأخرى حتى يؤمن عليه التبديل.
ثانياً: أسباب اجتماعية
- الصَّمْتُ والوَحْدَة (العُزْلَة):
يذكر الجاحظ([60])، أن أبا عبيدة قال: إذا أدخلَ الرَّجلُ بعضَ كلامه في بعض فهو أَلفُّ، وقيل بلسانه لَفَفٌ([61]). ويفسر الجاحظ السبب في هذا اللفف أن الإنسان إذا جلس وَحْدَهُ ولم يكن له من يكلِّمه، وطال عليه ذلك، أصابه لفَف في لسانه. وأنشد الراجز:
كـأنَّ فيـه لَفَـفَاً إذا نَـطَقْ ** من طُـولِ تـحبـيسٍ وهَـمٍّ وأَرَقْ
وكان يقال ليزيد بن جابر، قاضي الأزارقة الصَّموت؛ لأنه لما طال صمتُه ثَقُلَ عليه الكلام، فكان لسانُه يلتوي، ولا يكادُ يُبين، من طول التفكر ولزوم الصَّمت. ويرشدنا الجاحظ هنا إلى أنه من أراد أن يكون فصيحاً بليغاً، بعيداً عن الخطأ والانحراف في الكلام، عليه أن يتحلَّى بالخطابة، وعمودُها الدُّربة، وجناحاها رواية الكلام. ويؤكد الجاحظ هنا على أهمية الدربة في الكلام، لأن العرب كانوا يُروُّون صبيانهم الأرجاز، ويعلمونهم المناقلات ويأمرونهم برفع اللسان، وتحقيق الإعراب لأن ذلك يفتق اللهاة ويفتح الجرم. ثم يقول: “واللسان إذا كثر تقليبه رق ولان وإذا أقللت تقليبه وأطلت إسكاته جسا وغلظ”([62]).
ثالثاً: أسباب نفسية من أهمّها: العِيُّ والحَصَر.
وقف الجاحظ([63]) عند أهم أسباب الخطأ: العِـيَّ والـحَصَر. وقديماً ما تَعَوَّذُوا بالله من شرهما، وتضرَّعوا إلى الله في السلامة منهما. وقال النَّمْر بن تولب:
أعِـذْنِـي ربِّ من حَـصَـرٍ وعِـيٍّ ** ومـن نَـفْـسٍ أُعالـجـها عِـلاجا
وقال مَكِّيُّ بن سَوادة:
حصِـرٌ مسْـهَبٌ جـرِيءٌ جـبانٌ ** خيْـرُ عِيِّ الرجال عِيّ السُّـكـوتِ
وسأل الله عز وجل موسى بن عمران، عليه السلام، حين بعثه إلى فرعونَ بإبلاغ رسالته، والإبانةِ عن حجَّته، والإفصاحِ عن أدلَّته، فقال حين ذكر العُقْدة التي كانت في لسانه، والـحُبْسَة التي كانت في بيانه: ﴿واحْلُلْ عُقْدَةً من لساني يَفقَهُوا قولي﴾([64]). وقال موسى عليه السلام: ﴿وأخي هَارونُ هُو أفصحُ مني لساناً فأرسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُني﴾([65])، رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجّة، والمبالغة في وضوح الدَلالة؛ لتكون الأعناقُ إليه أَمْيَلَ، والعقولُ عنه أفهمَ، والنفوسُ إليه أسرعَ، وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة، ويَبْلغ أفهامهم على بعض المشقة([66]).
وضرب الله عز وجل مثلاً لِعِيِّ اللسان ورداءة البيان، حين شبّه أهله بالنساء والولدان([67]): فقال تعالى: ﴿أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ في الْحِلْيَةِ وهوَ في الخِصَام غَيْرُ مَبين﴾([68]) أي في مخاصمة أعدائه لا يكاد يُفهم قوله.
الخاتمة
اتضح لنا من خلال هذه المقالة أن اللغويين العرب القدامى هم الذين بعجوا هذا الموضوع بالدراسة بلا منازع منذ القرن الثاني للهجرة ، وأنّ الدراسات الحديثة لم تأت بجديد. وما كتاب “ما تلحن فيه العامة” للكسائي(تـ189هـ)، إلا باكورة الأعمال اللغوية التطبيقية في تحليل الأخطاء في اللغة العربية.
أما من حيث المنهجية فقد جمع العلماء العرب القدامى المادة اللغوية من عامة الناس وخاصتهم، وصنفوا الأخطاء من وجهتين: شفوي، وكتابي.. بعد إحصائها بشكل دقيق. ودرسوا الأخطاء التي حددوها بشكل واضح ودقيق.
كما تحرّى اللغويون العرب القدامى الدقة في تصنيف الأخطاءَ في مصنفاتهم على النحو الذي ارتضاه الزبيدي لمنهجه، حيث يقول في “لحن العوام”: “كنا قد أَلَّـفْـنَا فيما أفسده عَوَامُّنا وكثير من خَوَاصِّنا، كتباً قَسَّمناها على ثلاثة أقسام: قسم غُـيِّـرَ بناؤه وأُحِيل عن هيئته، وقسم وُضِع في غير موضعه وأُرِيد به غيرُ معناه، وقسم خُصَّ به الشيءُ وقد يَشْرَكهُ فيه ما سواه”.
واستحقت الأخطاء عندهم الوصف العلمي الدقيق على نحو وصف ابن الجوزي الوارد في قوله: “واعلم أن غلط العامة يتنوع: فتارة يضمون المكسور، وتارة يكسرون المضموم، وتارة يمدون المقصور، وتارة يقصرون الممدود، وتارة يشددون المخفف، وتارة يخففون المشدد، وتارة يزيدون في الكلمة وتارة ينقصون منها وتارة يضعونها في غير موضعها، إلى غير ذلك من الأقسام.
وعملوا على شرح الأخطاء مبرزين في ذلك أسبابها، هل هي بسبب اللغة الأم أَمْ بسبب اللغة الثانية المكتسبة؟ أم أن هناك أسباباً أخرى التي ذكر الجاحظ بعضا منها. وأفرد العسكري كتاباً مستقلاً لشرح الأخطاء، الموسوم بـ: “شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف”. ومن خلال ما تمّ عرضه من مصنفات اتّضح أن أسباب الأخطاء كثيرة ومتنوعة. ويمكن أن تعود إلى عدة أسباب: لغوية؛ مثل: أخذ العلم من الصُحُف، وعدم نَقْط المصاحف والإعجام والترقين والشَّكل، ونقص كفاءة الراوي باللغة أو عدمها، والخط والهجاء، والتصحيف والتحريف. واجتماعية؛ مثل: الصَّمْتُ والوَحْدَة (العُزْلَة). ونفسية؛ مثل: العِيّ والحَصَر…
وآية ذلك كله أن اللغويين العرب القدامى كانوا رواد هذا العلم اللساني([69])، درسوا الأخطاء اللغوية بشكل علمي ومنهجي دقيق.
قائمة المصادر و المراجع
1) الإبدال و المعاقبة و النظائر: الزجاجي(أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحق، تـ337هـ)، تحقيق و دراسة: فوزي يوسف الهابط، دار الولاء للطبع و التوزيع، شبين الكوم: مصر، 1993م.
2) أسس تعلم اللغة وتعليمها: براون، هـ دوغلاس، ترجمة: عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان، بيروت: دار النهضة العربية، 1994.
3) البداية والنهاية: ابن كثير(إسماعيل بن عمر الدمشقي، تـ774هـ)، 1348هـ، القاهرة.
4) البيان والتبيين: الجاحظ (أبو عثمان بن عمرو بن بحر محبوب الكناني، تـ225هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1368هـ، 1949م.
5) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: ابن مكي(أبو حفص عمر بن خلف الصقلي،تـ501هـ)، قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م.
6) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي(صلاح الدين خليل بن أيبك)، حققه وعلّق عليه ووضع فهارسه: السيد الشرقاوي، راجعه: رمضان عبد التواب، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1987م.
7) التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلالي: آل خليفة، فاطمة إبراهيم، دولة الكويت، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت، الرسالة 233، الحولية 26، 2005م.
8) تصحيفات المحدثين، العسكري: دراسة وتحقيق: محمود أحمد مِيَره، الطبعة1، المطبعة العربية الحديثة: القاهرة، 1982م.
9) التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء: صيني، محمود إسماعيل والأمين، إسحاق محمد، تعريب وتحرير، الطبعة1، عمادة شؤون المكتبات، جامعـة الملك سعود، الـرياض: السعودية، 1982م.
10) تقويم اللسان: ابن الجوزي(أبو الفرج عبد الرحمان، تـ597هـ)، حققه و قدمه: عبد العزيز مطر، ط1، دار المعرفة: القاهرة، 1966م.
11) التنبيه على حدوث التصحيف: الأصفهاني(حمزة بن الحسن، تـ360هـ)، تح: محمد أسعد طلس، راجعه: أسماء الحمصي، و عبد المعين الملوحي، ط2، دار صادر، بيروت، 1992هـ.
12) تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: محمد علي سلطاني، إعداد فئة من المدرسين، دار العلماء دمشق: سورية.
13) الخصائص: ابن جني(أبو الفتح عثمان، تـ392هـ)، تحقيق عبد الوهاب النجار، القاهرة، 1374م.
14) سر صناعة الإعراب: ابن جني(أبو الفتح عثمان بن جني)، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، و أحمد رشدي شحاتة عامر،ط1، دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان، 2000م.
15) الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد(أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر تـ286هـ)، دار المعارف.
16) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس،تـ395ه)، 1964م، حققه وقدم له مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت.
17) طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن، تـ989هـ)، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة،1373هـ، 1954م.
18) العربية، دراسة في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك، 1951م، ترجمة عبد الحليم النجار، طبعة الخانجي، القاهرة.
19) فقه اللغة و سر العربية: الثعالبي(أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، تـ430هـ)، تح: فائز محمد، مراجعة إميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتاب العربيك بيروت، 1993م.
20) في اللهجات العربية: إبراهيم أنيس، 1952م، ط2، القاهرة: مطلعة لجان البيان العربي.
21) لحن الخاصة: العسكري(أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد،تـ382هـ)، تحقيق: عبد العزيز أحمد، لا طبعة، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، د تاريخ.
22) لحن العوام: أبو بكر الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله تـ989هـ)، 1964م، تحقيق رمضان عبد التواب، المطبعة الكمالية، القاهرة.
23) المستتر في القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادي(تـ496هـ)، 1426هـ،2005م، ط(1)، تحقيق ودراسة عمار أمين الردو، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث.
24) المعرب و الدخيل في اللغة العربية و آدابها: محمد ألتنوخي، ط1، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، 1426ه،2005م.
25) ما تلحن فيه العامة: الكسائي(أبو الحسن علي بن حمزة، تـ189هـ)، حققها وقدم لها وصنع فهارسها: رمضان عبد التواب، الطبعة الأولـى، مكتبة الخانجي بالقاهـرة ودار الرفاعي بالريـاض، 1982م.
26) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ابن سيده(أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي)، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق، دار القلم، 1986م.
27) المخصص: ابن سيده، المكتب التجاري، بيروت، د تاريخ.
28) المستتر في القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادي، تـ496هـ)، 1426هـ،2005م، ط1، تحقيق ودراسة عمار أمين الردو، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث.
29) معجم الأدباء- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ياقوت الحموي(تـ626هـ)، 1414هـ، 1993م، تحقيق إحسان عباس، دار العرب الإسلامي: بيروت.
30) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: أ. ي. ونسنك، و ي. ب. منسنج، ليدن: مطبعة، 1969م.
31) المزهر في علوم اللغة العربية و أنواعها: السيوطي(عبد الرحمان جلال الدين، تـ911هـ)، تحقيق ج: جاد المولى وزميله، القاهرة، د ت.
32) المعرب و الدخيل في اللغة العربية و آدابها: محمد أتنوخي،1426ه 2005م، ط1، دار المعرفة للطباعة و النشر والتوزيع،
المراجع الأجنبية:
33– Anwar, M, S, The Legitimate Fathers of Speech Errors, In Versteegh, C, H, M, et al, The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1983.
34– Jassem, J, A, Study on Second Language Learners of Arabic: An Error Analysis Approach, 1st Edition, Kuala Lumpur: A, S,Noordeen, 2000. Pp. 108-126.
35 – Corder, S, P, The Significance of Learners’ Error, IRAL 5: 161-170, 1967.
([1]) العربية، دراسة في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك، 1951م، ترجمة عبد الحليم النجار، طبعة الخانجي، القاهرة، ص2.
([2]) الخصائص: ابن جني(أبو الفتح عثمان تـ 392هـ)، 1374م، تحقيق عبد الوهاب النجار، القاهرة، ج1، ص33.
([3]) المعرب و الدخيل في اللغة العربية و آدابها: محمد أتنوخي،1426ه، 2005م، ط1، دار المعرفة للطباعة و النشر والتوزيع، ص6.
([4]) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس(ت 395 ه)، 1964م، حققه وقدم له مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت، ص78.
([5]) البيان والتبيين: الجاحظ (أبو عثمان بن عمرو بن بحر محبوب الكناني، تـ225هـ)، 1368هـ، 1949م، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، ج1/163.
([8]) الشعراء الآيات: 193، 194، 195.
([9]) Jassem, J, A, Study on Second Language Learners of Arabic: An Error Analysis Approach, 1st Edition, Kuala Lumpur: A, S,Noordeen, 2000. Pp. 108-126.
([10]) Corder, S, P, The Significance of Learners’ Error, IRAL 5: 161-170, 1967.
(1) التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، صيني، محمود إسماعيل والأمين، إسحاق محمد، تعريب وتحرير، 1982م، الطبعة1، عمادة شؤون المكتبات، جامعـة الملك سعود، الـرياض: السعودية، المقدمة: ص: هـ.
([13]) أقصد بالظروف الاجتماعية المعاملات المصلحية التجارية، وبالتاريخية الفتوحات الإسلامية.
([14]) لحن العوام: أبو بكر الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله تـ989هـ)، 1964م، تحقيق رمضان عبد التواب، المطبعة الكمالية، القاهرة، ص4.
(1) ما تلحن فيه العامة، الكسائي(أبو الحسن علي بن حمزة)، حققها وقدم لها وصنع فهارسها: رمضان عبد التواب، 1982م، الطبعة الأولـى، مكتبة الخانجي بالقاهـرة ودار الرفاعي بالريـاض.
(2) التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلالي، آل خليفة، فاطمة إبراهيم، دولة الكويت، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت، الرسالة 233، الحولية 26، 2005م.
(3) ما تلحن فيه العامة، الكسائي، السابق، ص103.
(4) ينظر صيني والأمين، 1982، ص 140.
(1) ينظر أسس تعلم اللغة وتعليمها، براون، هـ دوغلاس، ترجمة: عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان،1994م، بيروت: دار النهضة العربية، ص204.
(2) المخصص، ابن سيده، المكتب التجاري، بيروت، د تاريخ، ج 2، ص127.
([21]) الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد(أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر تـ286هـ)، دار المعارف، ص729.
([22]) الخصائص: ابن جني(أبو الفتح عثمان، تـ392هـ)، 1374م، تحقيق عبد الوهاب النجار، القاهرة، ج2، ص8.
([23]) المستتر في القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادي(تـ496هـ)، 1426هـ،2005م، ط(1)، تحقيق ودراسة عمار أمين الردو، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، 1، ص188. وينظر المزهر في علوم اللغة العربية و أنواعها: السيوطي(عبد الرحمان جلال الدين تـ911هـ)، تحقيق ج: جاد المولى وزميله، القاهرة، د ت، ج2، ص397.
([24]) تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: محمد علي سلطاني، إعداد فئة من المدرسين، دار العلماء دمشق: سورية، ج1، ص14.
([26]) طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله تـ989هـ)، 1373هـ، 1954م، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ص28.
([27]) البداية والنهاية: ابن كثير(إسماعيل بن عمر الدمشقي، تـ774هـ)، 1348هـ، القاهرة، ج9، ص61.
([28]) الخصائص، المصدر السابق، ج3، ص245.
([29]) وهو” من أبو موسى إلى الخليفة الثاني عمر… ” وقيل أنّه أول خطأ في الكتابة، ينظر لحن العوام المصدر السابق، ص4.
([30]) معجم الأدباء- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ياقوت الحموي (تـ626هـ)، 1414هـ، 1993م، تحقيق إحسان عباس، دار العرب الإسلامي: بيروت، ج1، ص20. وينظر الخصائص لابن جني، المصدر السابق، ج2، ص8.
([31]) طبقات النحويين واللغويين، المصدر السابق، ص41.
([32]) البيان والتبيين: الجاحظ (أبو عثمان بن بحر محبوب الكناني، تـ225هـ)، 1368هـ، 1949م، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، ج1، ص91.
(3) التنبيه على حدوث التصحيف، الأصفهاني( حمزة بن الحسن)، حققه: محمد أسعد طلس، راجعه: أسماء الحمصي وعبد المعين الملوحي، 1992م، الطبعة2، دار صادر بيروت، ، ص 26.
(4) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ابن سيده(أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي)، تحقيق: أحمد محمد الخراط، 1986م، دمشق، دار القلم، مادة: صحف.
(2) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، الصفدي(صلاح الدين خليل بن أيبك)، حققه وعلّق عليه ووضع فهارسه: السيد الشرقاوي، راجعه: رمضان عبد التواب، 1987م، الطبعة1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص57.
(1) ينظر سر صناعة الإعراب، ابن جني(أبو الفتح عثمان بن جني)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر، 2000م، الطبعة1، دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان، مجلد 1، ص 31.
Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 53. ([41])
(2) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ابن مكي(أبو حفص عمر بن خلف الصقلي،تـ501هـ)، قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه: مصطفى عبد القادر عطا،1990م، الطبعة1 ، بيروت: دار الكتب العلمية، ص16-18.
(1) لحن الخاصة، العسكري(أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد)، تحقيق: عبد العزيز أحمد، لا طبعة، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، د تاريخ, ص 195.
(2) تصحيفات المحدثين،العسكري، دراسة وتحقيق: محمود أحمد مِيَره،1982م، الطبعة1، المطبعة العربية الحديثة: القاهرة، ج1، ص17.
([45]) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:55.
(4) الإبدال والمعاقبة والنظائر، الزجاجي(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق)، تحقيق ودراسة: فوزي يوسف الهابط،1993م، دار الولاء للطبع والتوزيع، شبين الكوم: مصر، ص74، 75، 105.
Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:56. ([47])
(2) لحن العوام، الزبيدي، السابق، ص66.
(3) ينظر تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ابن مكي، السابق، ص18-21.
([50]) Jassem, J, A. 2000. Ibid. Pp:56-7.
(2) تقويم اللسان، ابن الجوزي(أبو الفرج عبد الرحمن)، حققه وقدم له: عبد العزيز مطر، 1966م، الطبعة 1، دار المعرفة: القاهرة، ص74-76.
([52]) Corder, S, P, Error Analysis and Interlanguage, Oxford: Oxford University Press, 1981 (:24.
(2) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، العسكري، السابق، ص12-13.
(1) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، العسكري، السابق، ص17-18.
(2) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، أ. ي. ونسنك، و ي. ب. منسنج، ليدن: مطبعة، 1969م، ج5، ص54.
(3) التنبيه على حدوث التصحيف، الأصفهاني(حمزة بن الحسن تـ360 هـ)، ققه: محمد أسعد طلس، راجعه: أسماء الحمصي وعبد المعين الملوحي،1992م، الطبعة 2، دار صادر، بيروت، ص45 .
(1) البيان والتبيين: الجاحظ، السابق، ج1، ص 38.
(2) فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي(أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)، تحقيق: فائز محمد، مراجعة إميل بديع يعقوب، 1993م، الطبعة 1، دار الكتاب العربي: بيروت، ص110.
(3) البيان والتبيين، الجاحظ، السابق، ج1، ص 62.
(3) البيان والتبيين، الجاحظ، المصدر السابق، ج1، ص7.
([69] (Anwar, M, S, The Legitimate Fathers of Speech Errors, In Versteegh, C, H, M, et al, The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1983.