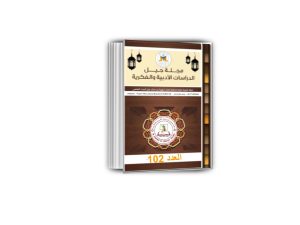حجاج البلاغة وبلاغة الحجاج
د.ناعوس بن يحيى/ المركز الجامعي بغليزان ـ الجزائر .
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 47 الصفحة 9.
الملخص:
تحاول هذه الدراسة ،بعد التدقيق العلمي ، طرح قضية التداخل بين الحجاج و البلاغة عن طريق طرح السؤال التالي: هل العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة تداخل أم علاقة تكامل أم علاقة احتواء؟ تلك هي الأسئلة التي سيَبني عليها البحث طريقه محاولا إيجاد الإجابة العلمية وفق ما تمليه المنهجية العلمية الجادة مستندا على ما طرح على بساط البحث العلمي في المدرستين العربية والغربية.
الكلمات المفتاحية: حجاج -اقناع -اقتناع-بلاغة-الخطاب
يحاول هذا البحث طرح قضية التداخل بين الحجاج و البلاغة عن طريق طرح السؤال التالي : هل العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة تداخل أم علاقة تكامل أم علاقة احتواء؟ تلك هي الأسئلة التي سيَبني عليها البحث طريقه محاولا إيجاد الإجابة العلمية وفق ما تمليه المنهجية العلمية الجادة مستندا على ما طرح على بساط البحث العلمي في المدرستين العربية والغربية .
ماهية الحجاج : كثيرا ما نجد من البحوث التي عرفت الحجاج من الناحية اللغوية إلا إن هدفنا ههنا هو الربط بين التعريف اللغوي و التعريف الاصطلاحي للحجاج حتى يتسنى الخروج بمعنى جامع بين الوظيفة التي يقوم بها الحجاج داخل الخطاب ،و الأصل اللغوي لمعناه الاصطلاحي، فنقول:”حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي :غلبته بالحجج التي أدليتها[…] وحاجه محاجة وحجاجا: نازعه الحجة و الحجة :الدليل والبرهان”[1].
و الذي يهمنا من ذلك المعنى الأخير ، أي منازعة الحجة و هذا الذي نجده في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾[2] .
ومعنى حاج في هذا السياق: “خاصم،وهو فعل جاء على زنة المفاعلة،ولا يعرف ل(حاج) في الاستعمال فعل مجّرد دال على وقوع الخصام،ولا تعرف المادة التي اشتق منها”[3]، فنلاحظ التلازم بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي بحيث أن “الحجاج هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها”[4].
و على هذا الأساس يُعرف الحجاج بأنه “فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية إنشاءًا موجها بقدر الحاجة، وهو أيضا جدلي، لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة”[5] .
هذه الثنائية التي تميز الحجاج جعلته أكثر حضورا في العملية التواصلية مما ساعد المُرسِل على إيصال أفكاره إلى المتلقي، و تجعله يذعن إلى ما طرح عليه من رسائل ، و أفكار ،و ذلك لأن الحجاج ” عملية استدلال عقلي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم ، وتعتبر أن موضوعه درس تقنيات الخطاب التي تمكن المتكلم من تغيير نظام المعتقدات والتصورات لدى مخاطبه بواسطة الوسائل اللغوية”[6].
وزيادة على ما سبق ،فإن الخطاب الحجاجي يُعرف ،أيضا ،بأنه خطاب يستنفر كل الطاقات الإقناعية لدى المرسِل من أجل الدفاع عن وجهة نظر ليجعل المتلقي يذعن لها ، ومن هنا كان لزاما أن يُبنى الخطاب الحجاجي على جملة من العناصر يلخصها الجدول التالي:
| العنصر الحجاجي | وظيفته |
| القضية | عرض الفكرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة |
| الأطراف | المتحاورون حول القضية / المرسل و المتلقي ( فردا واحد أو جمهور ..) |
| الحجج | عرض أدلة نقلية أو شواهد داعمة أو أمثلة من التاريخ أو الواقع |
وزيادة على ما سبق ،فإن لغة الخطاب الحجاجي ،بما تتسم به من خصائص منطقية ، تتعالق مع ما يدعى بالمنطق الطبيعي (Logique naturelle) الذي ليس سوى “نسق من العمليات الذهنية التي تمكن فاعلا / متكلما في سياق ما من اقتراح تمثيلاته على متكلَّمٍ له بواسطة الخطاب “[7].
من أجل ذلك و غيره ،جعل كثير من الباحثين يُدْخلون الحجاج في اللغة ، حُصر مفهوم الحجاج في التداولية المدمجة في التلازم بين الحجة و النتيجة ،فقد عرفه ديكرو في كتابه “الحجاج في اللغة” على النحو التالي: «يقوم متكلم ما بفعل الحجاج عندما يقدم قولا (ق1) (أو مجموعة أقوال ) يفضي إلى التسليم بقول أخر (ق2) أو (مجموعة اقوال أخرى )”[8].
و على هذا ،فإن الحجاج عند ديكرو و أنسكومبر :” هو إنجاز لعملين هما: عمل التصريح بالحجة من ناحية و عمل الاستنتاج من ناحية أخرى سواء أكانت النتيجة مصرحا بها أم ضمنية “[9].
و مما سبق نستنتج ، و انطلاقا من تعريفه في التداولية المدمجة،بأن الحجاج ما هو إلا”علاقة دلالية تربط بين الأقوال في الخطاب ،تَنْتج عن عمل المحاجة ، ولكن هذا العمل محكوم بقيود لغوية فلابد أن تتوفر في الحجة (ق1) شروط محددة حتى تؤدي إلى (ق2)،لذلك فإن الحجاج مسجل في بنية اللغة ذاتها ،و ليس مرتبطا بالمحتوى الخبري للأقوال و لا بمعطيات بلاغية مقامية”[10].
و نأسيسا على ما سبق ؛حصرت التداولية المدمجة دراسة الجوانب التداولية في اللغة وحصرت أيضا الحجاج ،كما بيَّنا،داخل بنية اللغة ،و ذلك لما تتصف به اللغة من وظائف حجاجية تيسر توصيل الرسالة إلى المتلقي، لهذا يعتبر الحجاج ،كما أسلفنا ، “فعـالية تـداوليـة جـدليـة ؛ فهـو تـداولي لان طـابعه الفكـري مقامي واجتمـاعي، وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلـوغه على التـزام صـور استدلالية أوسع وأغـــنى من البنيات البرهانية الضيقة “[11].
و انطلاقا من ذلك ، وجدنا ديكرو و أنسكومبر يميزان بين نوعين من الأفعال فعل المحاجة ،و فعل الاستدلال ، و ذلك لأن” الاستدلال و الحجاج ظاهرتان من مستويين مختلفين فأساس الاستدلال هو علاقة اعتقادات المتكلم بحالة الأشياء ،أي ترابط الأحداث و الوقائع في الكون ،أما الحجاج فهو موجود في الخطاب، و في الخطاب فحسب”[12].
فإذا كان فعل المحاجة مرتبط بالخطاب يجعله يختلف عن فعل الاستدلال ،و ذلك لأنَّ “عمل المحاجة باعتباره علاقة بين الحجة و نتيجة مختلف عن عمل الاستدلال ،فالمحاجة علاقة بين عملين لغويين لا بين قضيتين و هذه الخاصية التي تجعله مرتبطا باللغة الطبيعية “[13].
و في المخطط التالي تلخيص لما سبق ذكره عن تعريف الحجاج و إدماجه في اللغة:
مقدمات الحجاج و منطلقاته: إن التغيرات التي تشهدها حياتنا اليوم من توفر وسائل التواصل المختلفة حتى استطاع الإنسان أن يخاطب غيره ،البعيد عنه، خلال ثواني رغم أن الآخر موجود في أمريكا و الأول في إفريقيا ،مثلا ،بل يستطيع أن يرى صورته و يلاحظ حركاته و انطبعات وجهه فكأن “الحياة اليومية والعائلية والسياسية توفر لنا كماَ هائلا من أمثلة الحجاج البلاغي. إن أهمية هذه الأمثلة المنتمية إلى الحياة اليومية تكمن في التقارب الذي تسمح به مع الأمثلة التي يوفرها الحجاج الأكثر سموا عند الفلاسفة والقانونيين” [14].
وهذا ما جعل المختصون في الحجاج و البلاغة على رأسهم بيرلمان الذي وسع من حدود الخطابة، حيث دمج الفلسفة والعلوم الإنسانية عامة، والتحاور اليومي، في نموذجه الموحد الذي أطلق عليه: البلاغة الجديدة “والواقع أن بيرلمان بهذا قد وقف على آليات مشتركة بين كل أشكال الكلام سواء النفسي الشخصي، أو الثنائي، أو الجماهيري، أو الشعري، أو خطاب المختصين في مجال القانون والعلوم الإنسانية “[15]. فلم تعد البلاغة ، بذلك، محصورة عنده في مخاطبة العوام والدهماء، بل اكتسحت جميع أنواع المخاطبين المختصين، الذين لا يمكنهم فهم الخطاب وتكوين رأي عن مضامينه: “دون التمهيد لذلك بتحمل عناء البحث الجاد”.[16]
و مما سبق أضحت الخطط الحجاجية تستمد خصائصها وسماتها “من الحقل الذي تتحقق فيه و يمنحها الشرعية ،و قد يكون هذا الحقل هو الحياة اليومية للناس ،و قيمهم أوالفكر و التفكير من أبسط درجاته إلى أكثرها تعقيدا و تجريدا”[17] .
و من هنا وجب أن نبين بأن الحجاج لا يقصر توظيفه في خطابات ظرفية محددة،و إنما “هو بعد ملازم لكل خطاب على وجه الإطلاق ، والسبب في ذلك أن كل خطاب حال في اللغة تمنحه هذه الأخيرة العناصر الأولية و القاعدية لكل حجاج ،أي عناصر الاستدلال و التدليل…حتى إن العديد من حقول المعرفة الإنسانية يسعى كل منها إلى ضم الحجاج إلى حظيرته الخاصة والاستفادة من إمكاناته .و هذا ما جعل مفهوم الحجاج يُطعم بمفاهيم ووظائف و تنظيرات مختلفة مازالت في تجديد مستمر”[18].
و لكن لا بأس في سبيل توضيح مقدمات الحجاج و منطلقاته ،أن نبين بجلاء أكثر أهم المراحل التي يمر بها انتاج الحجاج حتى تتضح صورة ميلاد الخطاب الحجاجي عند المتكلم / المخاطِب حتى يبلغ صورته النهائية على شكل خطاب متكامل العناصر ،و منسحمة فيما بينها ،و قد أشار أرسطو إلى مراحل انتاج القول الحجاجي [19] و التي سنجملها في المخطط التالي:
و كأن هذه المراحل تشير من ناحية أخرى إلى أهم الأطر الحجاجية التي تتحكم في بناء الخطاب الحجاجي ،و توجهه توجيها يجعله يؤدي وظيفته الإبلاغية ،و ذلك أن الحجاج لا يزدهر إلا حين تُفْتقد الأدوات اليقينية. هذا ما أشار إليه بارت لتحديد الأسباب التي دفعت إلى انهيار البلاغة[20].
استنتاجا مما سبق ، نفهم دور الخطيب في ضرورة الاهتمام بجمهوره حتى يختار لهم الحجج التي تجعلهم يؤيدون الفكرة أو ينفي عنهم ما كان في ذهنهم من أوهام حول الموضوع المطروح للنقاش الذي بفضله جاء الحجاج ،وعليه فإن “الخطيب الذي لا يلتفت إلى مطالب المستمع هو شخص أناني أو أنه لا يتحدث إلا مع نفسه ويتنصت إلى هلا وسه”[21].
وهذه الخاصية الحجاجية للخطاب جعلت كثيرا من الباحثين، المهتمين بتحليل العلمية التواصلية ، يعرفون البلاغة الجديدة بأنها:” حقل يُعنى بدراسة الخطاب الموجه نحو المخاطَب/المتلقي/الجمهور بمختلف أشكاله المتعددة، سواء كان حشدا متجمِعا في ساحة عامة، أو في اجتماع لمختصين، أو كان خطابا موجها نحو فرد واحد أو نحو البشرية جمعاء؛ انه حقل يفحص حتى الحجج التي نوجهها إلى ذاتنا خلال حوار خاص بيننا وبين أنفسنا”[22].
البلاغة الجديدة و الحجاج:
ثمة تداخل كبير في التعريفات بينهما عند كثير من الباحثين ،و ذلك لأن المجددين للبلاغة الغربية، أمثال رولان بارت[23] وغيره، أرادوا أن تنتعش البلاغة بما تحويه من خاصية إقناعية التي يتسم بها الخطاب الحجاجي ،فلا يكون النص حجاجيا ، من وجهة نظر البلاغة الجديدة،إلا حين يحمل بذرة خلاف، تتضمن قصدا تأثيريا، مضمرا أو معلنا، بنية تحويل أو تعديل وجهة تفكير المخاطب، أو حمله على مزيد من موافقة داخل مسار تواصلي غير إلزامي”[24].
هذا المنحى الذي بني عليه الحجاج جعله يقتحم جميع العلوم بمختلف مشاربها المعرفية و المنهجية، لهذا فإن بلاغة الحجاج تتصف بالبينية إذ إننا نجدها في الأدب، بجميع أنواعه، و في الفن ، بجميع تمظهراته الجمالية، مثلما نجدها في علم النفس والاجتماع و القانون و التجارة و الاقتصاد و السياسة و الإعلام بكل فروعه،لأنها بما تتسم به من إقناعية استطاعت أن تتوغل إلى جميع العلوم و المعارف.
وهذه الخاصية الإقناعية في البلاغة الجديدة جعلت اختيار الحجج يتحدد بعنصرين اثنين هما:
أولا:الانطلاق من المعطيات التي يمتلكها المتلقي حتى يتسنى إقناعه بشكل تراكمي للحجج.
ثانيا: مراعاة المقام، وذلك لأن المحاجة لا تؤتي أكلها إلا إذا اعتمدنا على حجج مضادة لحجج التي يُركز عليها الخصم في بناء خطابه.
و من هنا ،كان موضوع نظرية الحجاج ، كما بين منظروها،”هو دراسة التقنيات الخطابية لإثارة أو زيادة الالتزام من العقول إلى الأطروحات المقدمة إلى اعتمادهم “[25]، و على هذا ارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطا لا انفصام له ، و ذلك باعتماد تقنيات البلاغة في عملية الإقناع ،التي ذكرناها آنفا، حيث ركّز في ذلك بيرلمان على مبدأين أساسين في العملية التواصلية هما :القصد و المقام .
وهذان المبدءان يمكن الارتكاز عليهما، باعتبارهما معينا على تكوين كوثر منهجي، فيما يخص “تحليل نصوص ذات طبيعة حجاجية قوية كالنصوص القضائية والسياسية والفلسفية، بناء على تصور تفاعلي بين الذات المتكلمة والمخاطبين. وعلى الرغم من مميزات هذا التصور، فإنه يقصر الحجاج على بعض التقنيات والآليات البلاغية والمنطقية، وهو ما يدفعه إلى تقسيم الخطابات إلى خطابات حجاجية ذات طبيعة إقناعية، كالمناظرات والمجادلات الدينية والفلسفية والسياسية والقانونية، وأخرى غير حجاجية. بينما يتبنى التصور التقني للحجاج تقسيما آخر تصير بمقتضاه كل الخطابات المختلفة التي تستعمل لسانا طبيعيا خطابات حجاجية بدرجات مختلفة.[26]“
ولا يخفى على أحد، بأن الحجاج حصر في جملة من الأهداف هي:
- الإقناع أي رصد كل الوسائل المسعفة والمعينة على جعل المتلقي يقبل الرسالة كمرحلة أولى.
- والتأثير أي جعل المتلقي في المرتبة الثانية ينساق وراء مضامين الرسالة.
- والتداول أي جعل اللغة وسيلة من وسائل ترابط بين طرفي العملية التواصلية.
- والتواصل أي أن الحجاج وسيلة أساسية في ربط العلاقة بين المرسِل والمتلقي، علاقتها هدفها الأساسي هو التفاهم والتعاون والاشتراك.
- والتخاطب أي أن اللغة بهذا تصبح تمارس وظيفتها الأساسية التي من أجلها وجدت عند الإنسان عموما.
إلا إننا وجدنا بأن بيرلمان انتقل من الإقناع الذي ركز عليه أرسطو إلى الاقتناع حيث إن المجتمعات المعاصرة التي تبنت الديمقراطية منهجا في حياتها الشاملة تؤمن بالحرية لهذا وجدناها تميل إلى الاقتناع بدل الإقناع الجبري، فكأنها تجعل من بناء الخطاب يميل ميلا عظيما نحو مراعاة ظروف و وأحوال المتلقي حتى يقتنع بالرسالة ،و لهذا اهتم بيرلمان بالمتلقي بدل الملقي الذي كان يركز عليه أرسطو و البلاغة الغربية الكلاسيكية .
العوامل والروابط الحجاجية : تعتبر العوامل و الروابط في نظرية الحجاج و البلاغة الجديدة عنصران من عناصر التي تساعد على انسجام الخطاب حتى يصل إلى مبتغاه من توجيه المتلقي إلى النتيجة المرادة أو ما يسمى بالوجهة الحجاجية التي هي “محددة بالبنية اللغوية فإنها تبرز في مكونات متنوعة و مستويات مختلفة من هذه البنية فبعض هذه المكونات يتعلق بمجموع الجملة ،أي عامل حجاجي في عبارة ديكرو ،فيقيدها بعد أن يتم الإسناد فيها و من هذا النوع نجد:النفي و الاستثناء المفرع و الشرط و الجزاء. و نجد مكونات أخرى ذات خصائص معجمية محددة، تؤثر في التعليق النحوي و تتوزع في مواضع متنوعة من الجملة ،و من هذه الوحدات المعجمية جروف الاستئناف بمختلف معانيها و الأسوار (بعض،كل ،جميع) و ما اتصل بوظائف نحوية مخصوصة ،كحروف التعليل أو تمحض لوظيفة من الوظائف قط و أبدا”[27].
و إذا أردنا أكثر تفصيلا فيما يخص تعريف العوامل و الروابط فإن كل “ما يربط بين الأقوال من عناصر نحوية مثل أدوات الاستثناء (الواو ، الفاء لكن إذن) ويسميه روابط حجاجية ،وأما النوع الثاني فهو ما يكون داخل القول الواحد من عناصر،تدخل مثل الحصر و النفي ، أو مكونات معجمية تحيل في الغالب غير مباشرة مثل منذ الظرفية و تقريبا و على القل و يسميه عوامل حجاجية”[28].
وعلى هذا فإن الروابط الحجاجية تختص بالربط بين عناصر الكلام ، وأما العوامل الحجاجية تختص بالجملة كله
وهذا يستدعي منا الحديث منهجيا عن نظرية السلالم الحجاجية حتى تكون النظرة كاملة متكاملة في هذا البحث ،وذلك بأنَّ نظرية السلالم الحجاجية تنطلق “من إقرار التلازم في عمل المحاجة بين القول الحجة(ق) ونتيجة (ن) ومعنى التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة للمتكلم ،إلا بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة إلى أن النتيجة قد يصرح بها و قد تبقى ضمنية”[29].
الحجج تُبنى وفق سلم ينطلق من الحجة الأضعف إلى الأقوى مثلما يوضحه هذا المخطط:
وعلى هذا تُبنى السلالم الحجاجية في الخطاب من مجموعة من الأقسام الحجاجية علما بأن كل قسم
حجاجي يتكون من : ق+ق’ ن.
يقول ديكرو في ذلك :”تكون جملة (ق’) أقوى من (ق) إذا كان كل قسم حجاجي يتضمن (ق) متضمنا أيضا (ق’)” [30]، وإذا لم يتوفر هذا الشرط هناك شرط أخر” يكفي أن (ق’) يؤدي إلى نتيجة (ن’) أقوى من(ن)”[31].
و بما أن المجال ههنا لا يسمح بالتوسع أكثر في نظرية السلالم إلا إننا سنتحدث عن الموضع باعتباره شرطا أساسيا من شروط الحجاج إذ إنه “يمثل “مبدأ حجاجيا عاما من المبادئ التي يستعملها المتخاطبون ضمنيا للحمل على قبول النتيجة ما ، فالموضع فكرة مشتركة مقبولة لدى جمهور واسع ،و عليها يرتكز الاستدلال في اللغة”[32].
وفي تحديد ديكرو لمفهوم المواضع يمكن أن نستنتج ما يلي :
- أن العلاقة الحجاجية تتطلب وجود موضع بين الحجة و النتيجة.
- أن للمواضع اشكالا تتحدد ب”أكثر” و “أقل” ضمن منطقة قوة محددة.
- أن أضكال المواضع من خلال التأليف بين أكثر و(و رمزه+) زأقل (ورمز-) ألربعة هي : (+،+) (-،-)و (+،-)و(-،+)[33].
الخيال و الحجاج:
بعد الحديث عن كل ما يتعلق بالحجاج وشروط نجاحه ، ولو بصورة مقتضبة حسب أملته علينا طبيعة البحث، إلا إن ثمة سؤال يفرض نفسه ههنا مفاده هل هناك من علاقة بين الحجاج و الخيال ؟ أو بصورة أوضح إذا كان الحجاج يستند على المعطيات و الحجج اليقينية لإزاحة الخلاف أو اللبس الموجود بين المرسل و المرسل إليه فهل معنى ذلك أن نغفل الخيال في عملية المحاجة ؟
و نحن نعلم ،إجابة عن السؤال السابق ،بأن الخيال لا ينفك عن طبيعة الإنسان الفكرية حيث إنه” لا تفكر النفس بدون صور” [34] ،و قد وجدنا ابن سينا يظهر هذه القضية بجلاء في كتابه التعليقات حيث ذكر بأن “كل ما تعقله النفس مشوب بتخيل”[35] ،و هذا يجعل الحجاج يقبل التخييل حتى يتلائم مع طبيعة الإنسان التي هي مزيج مما هو منطقي و ما هو خيالي تصويري ،و ما الصور الشعرية التي نجدها في النصوص التي انتجها الإنسان عبر العصور و سيظل ينتجها ؛ بل إن النصوص السردية التي غزت الساحة الأدبية انتاجا كما ونوعا في زماننا هذا لخير دليل على العلاقة المتينة بين الحجاج و التخييل .
و لذلك كان الشعراء في الجاهلية،مثلا، ينظمون القصائد ،و يعلمون بأن لها تأثيرا ًكبيراً في حياة المتلقين “و من غير أن يكون الغرض بالمقول إيقاع اعتقاد البتة” [36] بينما الخطيب لا يلقي خطبته على المخاطبين إلا إذا كان الخطب الجلل يستدعي شحذ الهمم ،و كسب التأييد لهذا يعمل على إقناعهم بما هو « تصديق بالشيء مع اعتقاد أنه يمكن أن يكون له عناد وخلاف .”[37]
وعلى ما سبق، يمكن أن نثبت قاعدة مهمة في مجال العلاقة بين الحجاج والتخييل هي أن« العمل المترتب على الحجاج ليس متوسلا إليه بالمغالطة والتلاعب بالأهواء والمناورة، وإنما هو عمل هيأ له العقل والتدبر والنظر.”[38]
وقوة التخييل الحجاجية تطرق إليها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه مبينا أهم خصائصها الفنية والإبداعية ، بل ذكر قوتها الإيحائية في بنائها الجمالي المحكم في شبكة من الصور الخيالية المنسجمة فيما بينها انسجاما جعلها تبدو كلوحة فنية رسمها رسام حاذق ، ومما التفت إليه عبد القاهر وحلله قصيدة ابن الرومي التي يقول فيها :
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد
لم يخجل الورد المورّد لونه إلا وناحِلُه الفضيلةَ عاندُ
فصْلُ القضية أن هذا قائد زهرَ الرياض وأن هذا طاردُ
شتَّان بين اثنين هذا مُوعدٌ بتسلب الدنيا وهذا واعدُ
وإذا احْتَفَظْتَ به فأمتَعُ صاحبٍ بحياته لو أن حيَّاً خالدُ
للنرجس الفضلُ المبينُ وإن أبى آبٍ وحاد عن الطريقة حائدُ
من فضله عند الحِجَاج بأنه زهر ونَوْر وهو نبت واحدُ
يحكي مصابيحَ السماء وتارةً يحكي مصابيح الوجوه تَراصَدُ.[39]
ومما قاله عبد القاهر عن هذه القصيدة هو أن “ترتيب الصنعة في هذه القطعة، أنه عمل أولا على قلب طرفي التشبيه(…) فشبه حمرة الورد بحمرة الخجل، ثم تناسى ذلك وخدع عنه نفسه، وحملها على أن تعتقد أنه خجل على الحقيقة، ثم لما اطمأن ذلك في قلبه واستحكمت صورته، طلب لذلك الخجل علة، فجعل علته أن فضل على النرجس، ووضع في منزلة ليس يرى نفسه أهلا لها، فصار يتشور من ذلك، ويتخوف عيب العائب، وغميزة المستهزئ. ويجد ما يجد من مدح مدحة يظهر الكذب فيها ويفرط، حتى تصير كالهزء بمن قصد بها. ثم زادته الفطنة الثاقبة والطبع المثمر في سحر البيان، ما رأيت من وضع حجاج في شأن النرجس، وجهة استحقاقه الفضل على الورد، فجاء بحسن وإحسان لا تكاد تجد مثله إلا له»”[40].
و نلاحظ من خلال تحليل عبد القاهر لهذه القصيدة، وقد حلل شواهد كثيرة [41]، أنه تتبع الخاصية الحجاجية للصور التخييلية التي زخرت بها القصيدة ،و بين أنها تبنى على “الخطوات الثلاث التي تميز السلم الحجاجي، والتي تصوغ مقولاته في علاقة تراتبية”[42].
و يمكن أن نوضح هذه التراتبية الحجاجية لأسلوب التخييل في المخطط البياني التالي[43] :
و قد بيّن ذلك من خلال تعليقه على بعض الأبيات الشعرية حيث يقول[44]: «كل واحد من هؤلاء قد خدع نفسه عن التشبيه وغالطها، وأوهم أن الذي جرى العرف بأن يؤخذ منه الشبه قد حضر ،وحصل بحضرتهم على الحقيقة، ولم يقتصر على دعوى حصوله حتى نصب له علة، و اقام عليها شاهدا(…)»[45].
استنباطا مما سبق، يمكن القول بأن الخطاب الأدبي ، سواء جاء في صورة خطاب شعري كما رأينا أو غيره،لا يستطيع أن يبنى بعيدا عن الحجاج الذي يرتكز على التخييل لأنه خاصية من خصائص التفكير البشري بكل مستوياته لأنها:” لا تتخلص أبدا من الهالة التخييلية بالكامل. كما أن كل عقلانية وكل نظام منطقي يحملان في ذاتهما أوهامهما الخاصة”[46].
و خلاصة الأمر فإن عملية التفاعل الإيجابي مع الخطابات ،ذات الخصوصية المشار إليه سابقا، فإنها تستغرق و تتطلب أربع مراحل متتالية هي:[47]
و هذه المراحل الأربع، كما بينها المخطط، تستهدف كل مرحلة منها إحداث تغير جزئي تدريجي فكل مرحلة توصلك إلى المرحلة التي بعدها حتى تبلغ غايتها،إذ إن المرحلة الأولى تركز أن يعي الجمهور المستهدف نوعية الخدمة وما يمكن أن نقدمه له، وأما المرحلة الثانية أن يفهم الجمهور المستهدف نوعية الخدمة.و أما المرحلة الثالثة أن يقنع الجمهور المستهدف بهذه الخدمة.و أما المرحلة الرابعة والأخيرة أن يتجه الجمهور المستهدف إلى التحرك نحو الخدمة.
و في ختام هذا المبحث فإن دراسات الحجاج في الخطاب تحصر في أمرين أثنين هما:
- القدرة البلاغية للحجاج في رسم وجهة نظر محددة و كذا في البنية المنطقية للخطاب الحجاجي التي تجعل المتلقي يصل إلى مرحلة الإقتناع بما يطرحه المرسل عليه من أفكار ووجهات نظر حتى تجعله يؤيده.
- إن الحجاج يبني وفق منهجية منطقية مما يتطلب حدوث ثلاث عمليات هي:القبول و الحكم و المنطق.
حجاج البلاغة
الحديث عن البلاغة و حجاجيتها خاصة بعد انتقالها من لغة موضوع إلى لغة واصفة، يجعلنا ننظر إليها أنها أضحت”تلتقي مع مجموعة من المصطلحات الحديثة كتحليل الخطاب و الأسلوبية و القراءة”[48] وغيرها،و هذا يجعلنا ننظر إلى البلاغة أنها “ليست محصورة في البعد الجمالي بشكل صارم ،بل تنزع إلى أن تصبح علما واسعا للمجتمع”[49].
و من هنا تعددت وظائفها و مساهماتها[50]؛بل هي “الأفق المنشود و الملتقى الضروري للتداولية و علم النص و السيميولوجيا ، و هي النموذج المؤمّل عليه للعمل الإنساني في إطاره الشامل الجديد”[51].
و على هذا فإن البلاغة بما تمتلكه من قوة إقناعية تأثيرية ، كما سنفصل في ذلك ،جعل كثيرا من الباحثين المحدثين يرون بأنه يجب أن نعطي للبلاغة المكانة التي هي أهل لها بل عليها أن تحتل المقام الأول “لتأخذ مكانها بين العلوم القديمة ،و ربما كانت هي التي تستحق أن تسترد وصف العلمية”[52] .
لهذا كثيرا ما نخطئ عندما نحصر البلاغة في “دراسة لجماليات اللغة فحسب، لأنها، فضلا عن هذا، هي فلسفة تفكير و ثقافة للمجتمع و أسلوبية للحوار، و هذا سر اكتسابها تلك الطبيعة المزدوجة التي تجمع الآليتين الحجاجية و التفكيرية التأويلية على مستوى الملفوظ و المكتوب، إذ لم تعد تحليل النصوص فحسب، بل انتاجها أيضا”[53].
كل ذلك و غيره، يجعل الحديث عن البلاغة و وظائفها المتعددة التي سيظل الإنسان يكتشفها مرة بعد أخرى حديثا تفرضه العودة الجديدة للبلاغة في ظل ما تشهده المجتمعات من حراك فكري ،و إيديولوجي ،طلبا للحرية في إبداء الرأي و الرأي المضاد ،علما بأنه “على الرغم من التنوع في الوظائف و المشاغل البلاغية ،إلا إن المظهر الحجاجي( l’aspect argumentatif) يظل من ابرز خصائص الفكر البلاغي عبر مراحله القديمة و الوسيطة و الحديثة، وبالأخص المعاصرة”[54].
و كأن هذه المجتمعات ،بما استحدثت من آليات في التواصل ،و تقنيات متعددة متنوعة تيسر العملية التواصلية إن على مستوى المجتمع الواحد ،و بين مجتمعات متعددة متباعدة، “فتحت الأبواب أمام عودة الخطابة و رجوع وظيفة الإقناع و التأثير في صيغة لم تعرفها من قبل ،و أصبح الخطاب يعتمد في إنجاز تلك الوظيفة ،و إحداث التأثير ،و أساليب متنوعة ، منها ما يقوم على بلاغة الصورة ، ومنها ما يقوم على قدرة الخطاب الفائقة على التأثير ،لا بمنطوقه ،إنما بمفهومه و مُتضمنه،كما قوَّت المناقشة القائمة بين المستفيدين من استهلاك الآليات المرصودة لذلك،و أصبحت البلاغة قادرة ،لا فقط على التأثير و تحويل القول و الصورة فعلا و ممارسة،و إنما أصبحت متحكمة في أذواق الناس ،تساعد على صياغتها و إعطائها الوجهة التي تهيئها لقبول ما يُقترح عليها”[55].
هذه التهيئة لقبول ما يقترح على المتلقي إنما يُسِّرت بهذه القوة التأثيرية التي تحملها الوظيفة الحجاجية للبلاغة، التي جعلت “تمرير الأفكار و التصورات و الأخيلة التي نريد تمريرها على حساب ما هو قائم في ذهن المتلقي،و الغاية هي إبعاده عما كان يعمر ذهنه و إحلال ما نريد نحن مكانه،بتحريك الإعجاب، بما نعرض عليه،أو نخلق الصدمة أو الفتنة أو الإقناع”[56].
إذن نحن نتكلم ، باستغلال تقنيات الحجاج الكامنة في البلاغة، بقصد “دفع المخاطب إلى القيام بمناورات أو تمثلات مختلفة متعلقة بموضوع معين لكسب أو مضاعفة تعاطف المستمع بشأن الأطروحات المقترحة للحصول على موافقته”[57] .
و على هذا، كما أشار إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني، كأن فنون البلاغة تستدعيها الملابسات المحيطة بالخطاب وشروط نجاحه، فإنك على الجملة “لا تجد تجنيسا مقبولا ، ولا سجعا حسنا ،حتى يكون المعنى هو الذي طلبه و استدعاه و ساق نحوه و حتى تجده لا تبتغي به بدلا، و لا تجد عنه حولا، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه و أعلاه، و أحقه بالحسن و أولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه ، وتأهب لطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته ،و إن كان مطلوبا، بهذه المنزلة و في هذه الصورة “[58].
و كأن عبد القاهر الجرجاني يبيِّن بأن للبلاغة وظائفاً متعددةً لا نستطيع أن نحصرها فقط في الجانب الجمالي التزييني ،و إنما جعلها تتسع لتشمل الجانب الحجاجي و غيره حتى يقول :”إن كان مدحًا كان أبهى وأفخم ، وأنبل في النفوس وأعظم ، وأهزّ للعطف ،وأسرع للإلف ، وأجلب للفرح ، وأغلب على الممتدح ، وأوجب شفاعة للمادح ،وأقضى له بغُرّ المواهب و المنائح ، وأَسْيَر على الألسن وأذكر ، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر”[59].
و إن كان الأسلوب أو الفن البلاغي ” ذمًّا كان مسُّهُ أوجع ، وميسه ألذع ، ووقعه أشد ، وحدُّه أحدّ ،وإن كان حجاجًا كان برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبيانه أبهر وإن كان افتخارًا كان شأوه أبعد ، وشرفه أجد ، ولسانه ألدّ وإن كان اعتذارًا كان إلى القبول أقرب ، وللقلوب أخلب ، وللسخائم أسلّ ،ولغرب الغضب أفل ، وفي عقدالعقود أنفث ، وعلى حسن الرجوع أبعث” [60]. وإن كان هذا الأسلوب البلاغي “وعظًا كان أشفى للصدر ، وأدعى إلى الفكر ، وأبلغ في التنبيه والزجر ، وأجدر بأن يجلّي الغياية ، ويبصّر الغاية ، ويبرئ العليل ، ويشفي الغليل “[61].
ومن هنا نفهم مما ذكره عبد القاهر ،بأن القوة الحجاجية للبيان تجعله “وسيلة أساسية من وسائل الإقناع، ولعل في اختلاف مستويات التلقي ما يؤكد هذه الصفة الحجاجية للخطاب البلاغي، وذلك يجعل أي قول مدعم صالحا أو مقبولا بمختلف الوسائل، ومن خلال مختلف الصيغ اللغوية، على اعتبار أن هذه الصيغ هي أفعال كلام تمارس وظيفة التأثير من خلال قوتها الكلامية التي تتجلى بدورها من خلال طرائق منطقية في البناء وترابط العلاقات الاستدلالية التي يمثل الحجاج أبرز مظاهرها”[62].
الخاتمة:
إن النتيجية التي نخلص إليها في هذا البحث ، أن الحجاج ما هو إلا وظيفة من وظائف البلاغة ، وعليه فليس “الحجاج علما/فنا يوازي البلاغة:بل هو ترسانة من الأساليب والأصوات يتم افتراضها من البلاغة(ومن غيرها،كالمنطق واللغة العادية…) ولذلك فمن اليسير اندماج الحجاج مع البلاغة في كثير من الأساليب”[63].
و في هذا الإطار وجدنا البلاغة الجديدة في علاقتها بالحجاج «تهدف إلى التقنيات الخطابية ،وتسعى إلى إثارة النفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج ،كما تهتم البلاغة الجديدة أيضا بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب ،ثم يتطور كما تفحص الآثار الناجمة عن ذلك التطور”[64].
وخلاصة الخلاصة ،من خلال الآليات المبتكرة في زماننا هذا في تقنيات التواصل ،و هي في حركة مستمرة نحو التجديد و التطور ؛بل إننا نَتَعرَّض لهجمات (استفزازات) مستمرة و متكررة للتواصل بطرق متعددة، و متنافسة من أجل ربط عدد كبير من المتلقين بالعملية التواصلية لأهداف مختلفة و متنوعة ،كعرض بضاعة أو فكرة …، و على هذا نستطيع أن نجزم أنه “لا تواصل من غير حجاج ولا حجاج من غير تواصل”.[65]
قائمة المصادر و المراجع
- أبو بكر العزاوي، حوار حول الحجاج، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2010
- أبو بكر العزاوي ،”نحو مقاربة، حجاجية الاستعارة”، ص 79. ضمن مجلة المناظرة، الرباط، س 2، ع 4، 1991.
- أرسطو : في النفس، تر: إسحق بن حنين، مرا: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية،ط1، 1954 .
- أرسطو ،الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي،بغداد :دار الشؤون الثقافية،1986م.
- أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي،مجلة عالم الفكر، الكويت، عدد يوليو 2001م .
- ابن الرومي: الديوان،تح: د. حسين نصار، الهيئة العامة المصرية للكتاب، د.ت
- ابن سينا: التعليقات، تح: د. عبد الرحمن بدوي،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973م.
- ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر، تح: د. محمد سليم سالم، دار الكتب، الجمهورية العربية المتحدة، 1969م.
- ابن منظور، لسان العرب،دار صادر،بيروت،لبنان:ط 28- 1997 م.
- ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر والتوزيع والإعلان،دت
- حمادي صمود،تجليات الخطاب البلاغي ،تونس:دار قرطاج للنشؤ،ط1، 1999م.
- رولان بارت قراءة جديدة البلاغة القديمة ترجمة عمر أوكان المغرب إفريقيا الشرق ط1.
- شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة , ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود،كلية الآداب ، منونة،د.ت.
- صابر الحباشة،التداولية والحجاج،مداخل ونصوص ،صفحات للدراسات والنشر ،الطبعة الأولى، 2008 م.
- صلاح فضل ،بلاغة الخطاب و علم النص،سلسلة عالم المعرفة،الكويت ، العدد 164،سنة 1992طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،ط 1،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، 1998
- طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، البيضاء ، المغرب، [ط.3] ، 2007م
- عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،تحقيق السيد محمد رشيد رضا،دار المعلرفة،بيروت-لبنان،ط1، 2002م،
- عبد السلام عشير،إشكالات التواصل والحجاج، مقاربة تداولية معرفية”، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، المغرب، 2000
- علي عجوة، (وأخرون): مقدمة ورسائل الاتصال،( القاهرة: مكتبة مصباح، ط2، 1991)،
- عبد النبي ذاكر، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، مجلة عالم الفكر، المجلد 40، العدد 02، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2011
- محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،بحث في بلاغة النقد المعاصر،دار الكتاب الجديد المتحدة،ط1، 2008م،
- هنريش بليت، البلاغة و الأسلوبية،ترجمة و تقديم محمد العمري ، المغرب ،إفريقيا الشرق ،1999م،
الدوريات:
- من المنطق إلى الحجاج، حوار أجراه مع د.أبو بكر العزاوي حافيظ اسماعيلي علوي ، فكر ونقد، [ع.61] ن السنة السابعة ، سبتمبر 2004م
المراجع الأجنبية:
- Chaïm Perelman : Rhétorique et philosophie, avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Paris, Presses Universitaires de France, 1952.
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de l’argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958-Oswald Ducrot,1980,Les échelles argumentatives, Les éditions de minuit, PARIS
- Chaïm Perelman : Droit, morale et philosophie, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968.
- DURAND : Les structures Anthropologique de l’IMAGINAIRE, éd DUNOD, Paris,
- 11éme éd,1992
- Jean-Claude Ascombre et Oswald Ducrot, L’argumentation dans la langue, Pierre mardaga, éditeur, Bruxelles, 1983
- Michel Meyer : Qu’est-ce que l’argumentation?, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2005.
- AMOSSY :L’argumentation dans le discours, éd NATHAN, Paris, 2000
المواقع الإلكترونية
- http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
- http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36802/#ixzz52vU1m800
[1] -. ابن منظور، لسان العرب،دار صادر،بيروت،لبنان:ط 28- 1997 م،مج 2،مادة حجج،ص 27 ،
[2] -سورة البقرة الآية 258.
[3] -ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر والتوزيع والإعلان،دت،ج 3،ص 31/32.
[4] -طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،ط 1،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، 1998 ،ص 226.
[5] – د.طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، البيضاء ، المغرب، [ط.3] ، 2007م ، ص.65 .
[6] – شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة ،ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود،كلية الآداب ، منونة،د.ت، ص 59 .
[7] – من المنطق إلى الحجاج ، حوار أجراه مع د.أبو بكر العزاوي حافيظ اسماعيلي علوي ، فكر ونقد، [ع.61] ن السنة السابعة ، سبتمبر 2004م ، ص.37
[8] – Jean-Claude Ascombre et Oswald Ducrot, L’argumentation dans la langue, Pierre mardaga, éditeur, Bruxelles, 1983, p8
[9]-Jean-Claude Ascombre et Oswald Ducrot, L’argumentation dans la langue, Pierre mardaga, éditeur, Bruxelles, 1983, p11
[10] -شكري المبخوت، الحجاج في اللغة ،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم إشراف حمادي صمود، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانية 1،كلية الآداب منوبة،ص360-361.
[11] – د.طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، البيضاء ، المغرب، [ط.3] ، 2007م ، ص.65 .
[12] -شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص362.
[13] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص363.
[14] – http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
[15] — http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
[16] – http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
[17] – أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي،مجلة عالم الفكر، الكويت، عدد يوليو 2001م ،ص 100.
[18] -المرجع نفسه، ص نفسها.
[19] -أرسطو ،الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي،بغداد :دار الشؤون الثقافية،1986م،ص193.
[20] – http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
[21] – http://balagharachid.blogspot.com/2014/04/blog-post_4540.html
[22] — Chaïm Perelman : Rhétorique et philosophie, avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Paris, Presses Universitaires de France, 1952.
[23] -لقد كتب سنةَ 1963 قائلاً: “ينبغي إعادة التفكير في البلاغة الكلاسيكيَّة بمفاهيم بنيويَّة، وسيكون – حينئذٍ – من الممكن وضْعُ بلاغةٍ عامَّة، أو لسانيَّة لدوالِّ التضمين، صالحة للصَّوت المنطوق، والصورة والإيماء..” http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36802/#ixzz52vU1m800
[24] — Michel Meyer : Qu’est-ce que l’argumentation?, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2005.
[25] – “L’objet de la théorie de l’argumentation est l’étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment” (Perelman et Olbrechts-Tyteca 1970).
[26] — Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de l’argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958.
[27] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص377.
[28] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص376-377.
[29] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص363.
[30] -Oswald Ducrot,1980,Les échelles argumentatives, Les éditions de minuit, PARIS ,P 20 .
[31] – Oswald Ducrot, 1980, Les échelles argumentatives, Les éditions de minuit, PARIS, P 26.
[32] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص380.
[33] – شكري المبخوت ،الحجاج في اللغة ،ص380.
[34] – أرسطو : في النفس، تر: إسحق بن حنين، مرا: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية،ط1، 1954،ص75.
[35] – ابن سينا: التعليقات، تح: د. عبد الرحمن بدوي،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973،ص 109.
[36] – ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر، تح: د. محمد سليم سالم، دار الكتب، الجمهورية العربية المتحدة، 1969، ص 15.
[37] – ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب ريطوريقا، تح: د.محمد سليم سالم،مكتبة النهضة المصرية،ط1، 1950، ص 15.
[38] – R.AMOSSY :L’argumentation dans le discours, éd NATHAN, Paris, 2000 , P62.
[39] – ابن الرومي: الديوان، تح: د. حسين نصار، الهيئة العامة المصرية للكتاب، د.ت، 2/643.
[40] – عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ، ص 285.
[41] – ينظر تلك الشواهد بالمصدر نفسه، ص 286-295.
[42] – أبو بكر العزاوي ،”نحو مقاربة، حجاجية الاستعارة”، ص 79. ضمن مجلة المناظرة، الرباط، س 2، ع 4، 1991.
[43] – المرجع نفسه،ص ن.
[44] – أنظر تلك الأبيات لدى عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 289-290.
[45] – المصدر نفسه، ص 290.
[46]– G.DURAND : Les structures Anthropologique de l’IMAGINAIRE, éd DUNOD, Paris,
11éme éd,1992, p 64-65.
[47] علي عجوة، (وأخرون): مقدمة ورسائل الاتصال،( القاهرة: مكتبة مصباح، ط2، 1991)،ص.ص.96.95.
[48] -رولان بارت قراءة جديدة البلاغة القديمة ترجمة عمر أوكان المغرب إفريقيا الشرق ط1 1994مص7-8.
[49] -هنريش بليت، البلاغة و الأسلوبية،ترجمة و تقديم محمد العمري ، المغرب ،إفريقيا الشرق ،1999م،ص92.
[50] – صلاح فضل ،بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة،الكويت ، العدد 164،سنة 1992،ص250.
[51] – صلاح فضل ،بلاغة الخطاب و علم النص،ص251.
[52] -صلاح فضل ،بلاغة الخطاب و علم النص، ص179.
[53] -د.محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،بحث في بلاغة النقد المعاصر،دار الكتاب الجديد المتحدة،ط1، 2008م،ص09.
[54] – د.محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص11.
[55] -حمادي صمود،تجليات الخطاب البلاغي ،تونس:دار قرطاج للنشؤ،ط1، 1999م،ض133-135.
[56] – حمادي صمود،تجليات الخطاب البلاغي،ص 134.
[57] -Chaïm Perelman : Droit, morale et philosophie, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968.
[58] -عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،تحقيق السيد محمد رشيد رضا،دار المعلرفة،بيروت-لبنان،ط1، 2002م، ص 18.
[59] -عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،ص 97.
[60] –عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،98.
[61] –عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،99.
[62] – عبد السلام عشير،:إشكالات التواصل والحجاج، مقاربة تداولية معرفية”، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، المغرب، 2000، ص69.
[63] -صابر الحباشة،التداولية والحجاج،مداخل ونصوص ،صفحات للدراسات والنشر ،الطبعة الأولى، 2008 ،ص50.
[64] -صابر الحباشة،التداولية والحجاج،مداخل ونصوص ،صفحات للدراسات والنشر ،الطبعة الأولى، 2008 ،ص 17
[65] – عبد النبي ذاكر، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، مجلة عالم الفكر، المجلد 40، العدد 02، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2011، ص: 07، وينظر كذلك: حوار حول الحجاج، أبو بكر العزاوي، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2010، ص: 108