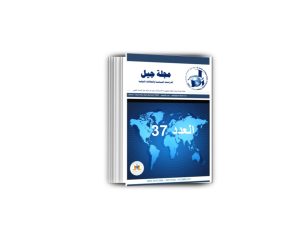أثر الليبرالية الجديدة في التغير السياسي من منظور “الحرمان النسبي”
نايف حماد العصيمي باحث في العلوم السياسية المملكة السعوية
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 20 الصفحة 41.
ملخص الدراسة
بعد أحداث ما سُمي بالربيع العربي في منطقتنا العربية عاد البريق إلى النظريات التي تتناول التغير السياسي الذي طابعه العنف، وعلى رأس هذه النظريات نظرية “الحرمان النسبي”. ومن المعلوم أن أُولى الدول التي اندلعت فيها التظاهرات – والتي كانت بمثابة الشرارة لما حل بالمنطقة بعد ذلك (تونس ومصر) – كانت دولًا تعتمد في اقتصادها على حرية السوق، وكانت وتخضع لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر الليبرالية الجديدة كأيديولوجيا تدعو إلى السوق الحرة في التغير السياسي الذي طابعه العنف، وذلك من منظور “الحرمان النسبي”. إذ أن نظرية “الحرمان النسبي” لصاحبها “تيد جير” ترى أن هناك عمليات اجتماعية تؤثر على توقعات وقدرات القيم وبالتالي التسبب في مشاعر “الحرمان النسبي” عند اختلال التوازن بين توقعات وقدرات تلك القيم. وفي قمة تلك العمليات الاجتماعية التعرض للأيديولوجيات الجديدة ونمط الحياة الغربي، والتي تتمثل في وقتنا المعاصر في الليبرالية الجديدة.
Study Abstract
The theory of Relative Deprivation began to shine once again after the events of the Arabic Spring, as a theory, that interests in violent political change. It is well known that the first two countries out (Tunisia and Egypt) in which the demonstrations broke – which were the spark of what happened in the region afterwards – were countries that depended on market freedom and were subject to economic stabilization and structural adjustment programs. Hence, this study highlights the impact of neo-liberalism as an ideology calling for a free market in political change characterized by violence, from a perspective of “relative deprivation”. The theory of “relative deprivation” developed by “Ted Gurr” says that there are social processes affect the expectations and capabilities of values and thus cause feelings of “relative deprivation” in the case of imbalance between the expectations and capabilities of those values. At the height of these social processes is the exposure to new ideologies and Western lifestyles, which in our contemporary time is neo-liberalism.
مقدمة
بما أن مفهوم “التغير الاجتماعي” مفهومٌ شاملٌ يتضمن في طياته مفهوم “التغير السياسي”، وهو يتعلق بكل تغير يعتري البنى الاجتماعية والثقافية للمجتمع أو وظائفه، كما أنه يشمل كل تغير يحدث في النظم، والأنساق والأجهزة الاجتماعية[1]، وبما أن النسق السياسي يمثل بحد ذاته نسقاً وبناءً اجتماعيًا لأي مجتمع، بحيث إنه لا ينفصل عن وظائف بنى وثقافة المجتمعات الإنسانية بصفته بناء يعمل على توزيع وممارسة السلطة داخل تلك المجتمعات، فيمكن تعريف مفهوم “التغير السياسي”على أنه ذلك التغير الذي يصيب البنى، والسلوكيات، والغايات السياسية التي تؤثر في توزيع، وممارسة السلطة في كل تجلياتها.
إلا أن هذا التغير السياسي انقسم حوله الباحثون هل هو تغير لمتغيرات غير سياسية أم لمتغيرات السياسة؟ الماركسيون يرون أنه خاضع لعامل الاقتصاد. والوظيفيون يرون أنه أشمل بحيث يخضع للمحيط الاجتماعي ككل والاتساق معه، فالتغير الاجتماعي يفرز مطالب تضغط على البنية السياسية مجبرة إياها على التكيف معها. وهناك من يرى أن التغير السياسي خاضع للمتغير السياسي نفسه الذي يحدث بدوره التغيير في المجتمع ولو لفترة بسيطة من الزمن. ويظهر هذا جلياً في المجتمعات النامية التي أخذت عند استقلالها تنظيمات جديدة للحياة السياسية عن الدول الغربية، ونظريات التنمية السياسية تدعم هذا الاتجاه الذي يؤمن بالتغير السياسي عن طريق ما يفرضه النظام السياسي نفسه.
ومن خلال النظريات التي تؤمن بنظرية النسق والمتغير السياسي في التغيير يمكن الاستنتاج أن التغير السياسي لا يحدث إلا مع الاستقرار كما يرى بعض الوظيفيين وأنصار نظريات التحديث والتنمية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول التغير السياسي الناجم عن الثورات أو الاضطرابات أو الصراع على السلطة، أليس ذلك التغير صادراً عن ظروف غير مستقرة تشتمل على متغيرات تتجاوز ما هو سياسي؟[2]
يرى “تيد جير” إن ظاهرة العنف السياسي ليست حتمية مترتبة على وجود الجماعة السياسية، لكنها استجابة لظروف محددة للوجود الاجتماعي. هذه الظروف هي خليط، من العوامل النفسية والاجتماعية. على رأس تلك العوامل النفسية مشاعر “الحرمان النسبي”، والتي يُعدها العمود الفقري لأي عملية عنف سياسي، ويحدد نطاقها وأثرها، مجموعة من العوامل المجتمعية[3] تتمثل في حجم العنف السياسي الناجم عن نطاق الحرمان النسبي، ونطاق مبررات العنف السياسي، وتوازن سيطرة المنشقين القسرية إلى سيطرة النظام القسرية، وتوازن الدعم المؤسسي للمنشقين مع الدعم المؤسسي للنظام[4].
هذه المتغيرات النفسية والمجتمعية تتغذى عن طريق عمليات اجتماعية هي بمثابة الجذور، وعلى رأسها التعرض لنمط حياة جديد أو إيديولوجيا جديدة كالليبرالية الجديدة تؤثر على قيم المجتمع من ناحية صعود التوقعات وهبوط القدرات المرتبطة بها[5].
لقد تسبب فشل مشاريع التنمية الاشتراكية في دول العالم الثالث، وكذلك انهيار الاتحاد السوفييتي في عودة البريق للأيديولوجية الليبرالية، بحيث أخذت الرأسمالية كمنظومة عالمية منفردة بقيادة العالم تبشر بدمج دول الأطراف في دول المركز؛ بمعنى تعميق ودمج اقتصادياتها بالسوق العالمية[6].
وقد روجت الأيديولوجيا الليبرالية – خاصة في فترة العولمة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي وسيادة النمط الرأسمالي عالميا – للديمقراطية. فالديمقراطية، كفكرة سياسية لآلية الحكم أخذت من الزخم في نهاية القرن العشرين ما لم تأخذه في أي وقت مضى، لدرجة أن التنمية أصبحت تُربط بها[7].
وروجت كذلك لحقوق الإنسان، وهو ما ألقى الضوء على الانتهاكات التي تقع ضد الناس في البلدان النامية، خاصة مع انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يدعم الأنظمة السياسية في تلك البلدان، مما مهد الطريق للولايات المتحدة للتدخل بذريعة حماية حقوق الإنسان. وكان ذلك انطلاقاً من مبادئ اعتمدت للتدخل، كمبدأ التدخل الإنساني الذي تمخض عن مؤتمر برلين للأمن والتعاون الأوروبي عام 1991، والذي يسمح للدول الأعضاء في المؤتمر بأن تتدخل من أجل وضع حد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ومبدأ الأمن الجماعي، والذي صاغه ميثاق الأمم المتحدة من أجل الأمن الجماعي، وعهد به إلى مجلس الأمن بموجب المادة (24) لحفظ السلام والأمن الدوليين، بل وبالتدخل بالقوة بمقتضى الفصلين السادس والسابع في حالات تهديد السلم أو وقوع العدوان[8].
لقد كان للأيديولوجيا الليبرالية ممثلة في الليبرالية الجديدة – والتي هي عبارة عن إيديولوجيا ونموذج سياسي يركز على قيمة المنافسة في السوق الحرة[9] أثراً بالغاً في التأثير على أوضاع القيم لدى شعوب العالم الثالث، وذلك من خلال الترويج للديمقراطية والتدخل باسم حقوق الإنسان، ولو بالقوة. ومن هذا المنطلق ستناول هذه الورقة أثر الليبرالية الجديدة في التغير السياسي في دول العالم الثالث بصفتها عملية اجتماعية مؤثرًة في أوضاع القيم. وسيكون هذا التناول من منظور الحرمان النسبي كعامل نفسي تغذيه هذه العملية الاجتماعية.
الإطار النظري للدراسة
يعرف “تيد جير” “الحرمان النسبي” بأنه: “إدراك الأطراف الفاعلين للتناقض بين توقعاتهم وقدراتهم المتعلقة بالقيم. تتمثل توقعات القيم بالسلع وظروف الحياة التي يعتقد البشر أن لهم حقاً فيها. أما قدرات القيم فهي السلع والظروف التي يظنون أنهم قادرون على الحصول عليها والاحتفاظ بها”[10]. ولمعرفة شدة “الحرمان النسبي” ونطاقه، حدد “تيد جير” أربعة محددات سيكولوجية، وثقافية مرتبطة بشدة السخط. هذه المحددات هي: ازدياد التناقض بين توقعات وقدرات القيم، حيث أنه كلما زاد التناقض زادت شدة الحرمان. وازدياد أهمية القيم المتأثرة وقلة إشباع الحاجات المرتبطة بها، فبقدر أهمية القيم المتأثرة، وكذلك إشباعها يكون قدر شدة الحرمان. وقلة البدائل لتحقيق الأهداف؛ أي قلة الفرص. وحرمان الناس من مجرد التعبير عن غضبهم على المدى القصير، بحيث أنه سيتعمق غضبهم على المدى الطويل، بل أن معاناة الآباء تُورث للأبناء[11].
إن توقعات وقدرات الناس المتعلقة بالقيم تصعد وتهبط نتيجة لمجموعة العمليات الاجتماعية المذوكورة آنفًا، والتي سنأتي عليها، ولكن لابد من الإتيان أولًا على أنواع القيم المتعلقة بالتوقعات والقدرات وكذلك الفرص المتعلقة بتلك القيم حتى يتسنى لنا تسليط الضوء على تأثير الليبرالية الجديدة على قيم المجتمع ومن ثم التسبب في مشاعر الحرمان النسبي.
أولًا: القيم، يُقصد بالقيم “مجموعة الأحداث والأشياء والأوضاع المرغوبة التي يناضل البشر من أجل الحصول عليها”. وتنقسم هذه القيم إلى ثلاث فئات: قيم الرفاه، وهي تلك القيم التي تؤدي مباشرة إلى الرفاه المادي وتحقيق الذات. وتنقسم قيم الرفاه إلى قسمين: قيم اقتصادية وقيم محددة للذات. تشمل القيم الاقتصادية سلع الحياة المادية، مثل السكن، والصحة، والتعليم، والترفيه. أما القيم المحددة للذات فتشمل تطوير واستخدام القدرات الجسدية والعقلية. وتأتي بعد قيم الرفاه قيم القوة، وهي القيم التي تحدد المدى الذي يستطيع فيه الناس التأثير في أفعال الآخرين، وتجنب التدخل غير المرغوب به من جانب الآخرين في أفعالهم. تحتوي قيم القوة على طبقتين من القيم، هي قيم المشاركة (أي المشاركة في صنع القرار الجماعي)، وقيم الأمن، وهي ذات صلة بتعزيز المصير والأمن. والفئة الثالثة هي القيم بين الأشخاص، وهي حالات الرضا النفسي التي نسعى إليها في التفاعل غير السلطوي مع الأفراد، أو المجموعات الأخرى. وتنقسم هذه القيم إلى ثلاث فئات هي: قيم المركز، والتي تعني القيام بدور هام نحصل في مقابله على الاعتبار ممن نتفاعل معهم. وقيم التضامن الاجتماعي، وتعني الحاجة إلى المشاركة في ظل مجموعة مستقرة ومساندة، حيث الرفقة والمحبة. وأخيراً قيم التماسك التصوري، أي الالتزام المشترك بمجموعة القيم والمعتقدات بشأن طبيعة المجتمع ومكان الفرد فيه[12].
ثانياً: فرص القيم، من أجل تحقيق القيم، لا بد من توفر فرص القيم، وهي السبل المتاحة للناس من أجل تحقيق القيم التي يرغبونها، أو مجرد المحافظة عليها. وتنقسم تلك الفرص إلى ثلاثة أنواع: الفرص الشخصية، وتتمثل في قدرات الأفراد الموروثة والمكتسبة للقيام بأعمال تعزز القيم. والفرص المجتمعية، وهي سبل العمل المتاحة لأفراد جماعة ما من أجل العمل المباشر لتعزيز القيم. وأخيرًا الفرص السياسية، وتتمثل في سبل الأفعال الاعتيادية المتاحة لأفراد جماعة ما لحث الآخرين على تزويدهم بتعويضات القيم، كالمساومة الجماعية لتحقيق مزايا الرفاه[13].
كان ذلك ما يتعلق بالقيم وفرص القيم التي عندما تتعرض إلى عملية اجتماعية كتبني الليبرالية الجديدة من قبل النظام السياسي إلى صعود التوقعات أو هبوط القدرات المتعلقة بها. أما العمليات الاجتماعية التي تؤدي إلى صعود توقعات القيم، والعمليات الاجتماعية التي تؤدي إلى هبوط قدرات القيم فقد حددها “جير” كما يلي:
أولًا: العمليات الاجتماعية المؤدي إلى صعود توقعات القيم:
- التعرض لأنماط جديدة للحياة، وأكثر الأنماط الحديثة تأثيراً في حياة الشعوب – في الوقت المعاصر – هو نمط الحياة الغربي، بما يحويه من ثقافة مادية كانت نتاج الحداثة التي مرت بها أوروبا، والتي جعلت دول العالم الثالث تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الغربية، مما ولد توقعات متصاعدة يقابلها عجز في القدرات، سرعان ما خيب الآمال[14].
- التعرض لأيديولوجيات جديدة. كما أن التعرض لنمط حياة جديد يؤثر في رفع سقف توقعات القيم، فإن التعرض لأيديولوجيا جديدة يحدث نفس الأثر على التوقعات
- المكاسب المتعلقة بالقيم لدى الجماعات المرجعية. عندما تقوم جماعة ما بمقارنة نفسها بجماعة أخرى – ذات وضع أفضل تتخذها مرجعية لها لتقييم وضع القيم الخاصة بها – فإن سقف توقعاتها للقيم يرتفع. وبقدر الاختلاف بين وضع القيم لكلا الجماعتين، بقدر ما يزيد الحرمان النسبي بالنسبة للجماعة ذات الوضع الأسوأ. إن هناك محركاً لرفع سقف توقعات القيم في حالة محدودية الجماعات المرجعية ذات الوضع الأفضل. فحتى يستوعب الناس الذين يعانون من وضع أسوأ، وضع من يتمتعون بمزايا أفضل، لابد من وجود مؤثر خارجي. قد تتمثل في المعايير الاجتماعية الجديدة، كأيديولوجيا جديدة –الليبرالية الجدية – وقد تتمثل في التغيير الاقتصادي، كنمط الاقتصاد الرأسمالي[15].
- اختلال توازن القيم. يعني اختلال توازن القيم أثر وضع معين للقيم يكون مرتفعاً بالنسبة لجماعة أو طبقة على القيم الأخرى التي تكون منخفضة. وهذا الأثر قد أكد عليه “أرسطو”، فالأثر السلبي لاختلال التوازن بين القيم الاقتصادية وقيم المشاركة لإحدى الجماعات قد يؤدي إلى الفوضى، أو التمرد، أو الحرب. وذلك يقتضي ضرورة توازن مراتب الأفراد مع القيم التي يرون أنهم يستحقونها، لأن أي شريحة أو طبقة حققت قدراً من التفوق الاقتصادي أو حصلت على تعليم عالي، ستتعرض “للحرمان النسبي” إذا ما أدركت أن هناك من يماثلها في الوضع، ومع ذلك قد حققت قيماً أعلى من المشاركة السياسية[16].
ثانيًا العمليات الاجتماعية المؤدية إلى هبوط قدرات القيم:
- منظورات محصلة الصفر بشأن القيم. تنطلق منظورات محصلة الصفر من نظرية الألعاب، والتي تميز بين ظروف الحصيلة الثابتة أو ما يُطلق عليها بمحصلة الصفر، والمحصلة المتحولة بالنسبة لظروف الحصيلة الثابتة، فيما يتعلق بقدرات القيم في مجتمع ما، إذ يكون هناك كمية ثابتة من السلع والأوضاع المطلوبة، وهو ما يعني ثباتاً وسكوناً للقدرات المتعلقة بالقيم داخل ذلك المجتمع. وأي مكسب لجماعة ما يتعلق بالقيم سيقابله تقلص في مواقف القيم الخاصة بالجماعات الأخرى. وهذا الأمر يكون أقل احتمالاً في المجتمعات التي تعيش في ظروف المحصلة المتحولة بسبب مخزونات القيم المرنة (التي يمكن تعويضها) نسبياً[17].
- حالات عدم المرونة البنيوية التي تقلص مخرجات القيم أو فرص تلك القيم.
- هبوط قدرات قيم الرفاه. تُعد قيم الرفاه أكثر القيم المرنة التي يؤدي هبوطها إلى العنف السياسي، وذلك بسبب بروز القيم الاقتصادية أكثر من غيرها في كافة المجتمعات، على عكس قيم القوة بما تحتويه من قيم المشاركة، والتي تكون في بعض المجتمعات ثابتة وغير مرنة، لأن الحد الأدنى من القيم الاقتصادية يعد ضرورة للبقاء[18].
- هبوط قدرات قيم العلاقات بين الأشخاص. إن لقيم التماسك التصوري – والتي تعني مجموعة من الاعتقادات والمعايير المفسرة للحياة، والرابطة لسلوك الناس بذلك التفسير – انعكاسات خطيرة على وضع القيم في حالة فَقْد الناس للتماسك التصوري أو عدم توافقهم بشأنه. وبمقدار ما يفقد الناس إيمانهم بتصوراتهم للحياة بمقدار ما يهبط وضع القيم، وبمقدار ما يؤمنون بتلك التصورات بمقدار ما يكون تصورهم عالياً بالنسبة للقيم. لذلك فإن التماسك التصوري يُعد غاية بحد ذاته، إضافة إلى أنه وسيلة لتحقيق الأهداف. وهذا الأمر ينعكس على الفرص المتعلقة بالقيم، فكلما كانت المعايير الخاصة بتحقيق الأهداف ملائمة للواقع، فإن فرص القيم تكون كافية وإن لم تكن بالضرورة متعددة ومتنوعة، وكلما كانت غير ملائمة للواقع كلما هبطت قدرات القيم.
إن ما يؤثر على التماسك التصوري عادة ما يكون إيديولوجيا جديدة، خاصة مع وجود مشاكل بنيوية في منظومة المعتقدات والمعايير، وتغيرات بيئية تجعلها غير ملائمة. وهنا يبدأ الناس بالبحث عن رموز جديدة، بدلاً من الرموز القديمة التي طالما احترموها[19].
ج- هبوط قدرات قيم القوة. إن توزيع قيم القوة، من خلال زيادة فرص المشاركة السياسية تجعل قدرات السلطة لدى المواطنين مرتفعة. وفي حال عدم توزيع قدرات القيم بشكل واسع فإن “الحرمان النسبي” المتعلق بالمشاركة يكون شديداً. أما في حالة استخدام قيم السلطة (القوة) من أجل زيادة الفرص سواء بالمشاركة السياسية، أو بتوزيع قدرات القيم بشكل واسع فإن قدرات الأفراد ستكون مرتفعة، والعكس صحيح[20].
كان ما تقدم استعراضًا للإطار النظري المستمد من نظرية الحرمان النسبي، والتي ستسلط الضوء على كيفية تأثير العمليات الاجتماعية – الليبرالية الجديدة هنا – على أوضاع القيم. وفيما يلي سنتناول أثر الليبرالية الجديدة في صعود التوقعات وهبوط القدرات المتعلقة بالقيم من منظور “الحرمان النسبي”.
أولًا أثر الليبرالية الجديدة في صعود التوقعات المتعلقة بالقيم
أولاً: التعرض لنمط الحياة الغربي الذي تدعو إليه الليبرالية الجديدة، وأثره في التوقعات الصاعدة:
إن نمط الحياة الغربي – بما يحويه من ثقافة مادية كانت نتاج الحداثة التي مرت بها أوروبا – هو أكثر الأنماط الحديثة تأثيراً في حياة الشعوب في الوقت المعاصر. هذا النمط جعل حكومات دول العالم الثالث تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الغربية وتبشر بالازدهار مما ولد توقعات متصاعدة قابلها عجز في القدرات، مما خيب الآمال[21].
وهذا الأمر تعززه المراكز الحضرية بمظاهرها الغربية لدى أبناء القرى المحيطة بها، وكذلك التعليم الغربي، بحيث ترتفع توقعات الأفراد بمجرد الانتقال إلى المدينة أو الانخراط في التعليم، وفي نهاية المطاف يصطدمون بالواقع المر، من ندرة العمل، أو مواجهة مجتمع عدائي، أو قلة الفرص الشخصية أو المجتمعية أو السياسية[22].
عندما نلقي نظرة تاريخية على حياة الشعوب العربية مثلاً، نجد أنها تختلف عن وضعها قبل مائتين عاماً مضت, وذلك لاتصالها بالاقتصاد الغربي، بحيث أصبحت تعيش نمطاً مختلفاً من الحياة عن نمطها السابق، فأكلها مختلف، وأزياءها مختلفة، وطموحها كذلك مختلف[23].
ثانياً: التحولات الأيديولوجية الناجمة عن تبني تعاليم الليبرالية الجديدة، وأثرها في التوقعات الصاعدة:
إن التعرض لأنماط الثقافة الغربية لا يكون مؤثراً بشكل كبير، إلا في حالة اقترانه بتحول أيديولوجي للجماعة البشرية بأسرها، ولابد أن يسبق التأثر بالثقافة الجديدة رفض تام لما هو قديم من معتقدات وقيم.
إن التحول إلى معتقدات وأفكار جديدة عوضاً عن المعتقدات والأفكار الراهنة، والتي لم تعد تلبي الاحتياجات ستسهم في صعود التوقعات. وهذا لا يكون إلا بوجود درجة معينة سابقًا من “الحرمان النسبي” حتى يكون التعرض لنمط حياة جديد مؤثراً. ويمكن التماس ذلك في استعراض التحولات الاقتصادية والأيديولوجية التي مرت بها الدول العربية. فقد مرت الاقتصاديات العربية منذ استقلالها بثلاث مراحل مختلفة: المرحلة الأولى، تبنت فيها معظم البلدان العربية التوجه الاشتراكي – بداية من الستينيات وحتى منتصف السبعينيات – عندما فشلت التوجهات الاشتراكية. المرحلة الثانية، مرحلة الانفتاح الاقتصادي بعد مديونية الدول العربية ذات التوجه الاشتراكي، وزيادة أسعار النفط في الدول النفطية. المرحلة الثالثة، هي مرحلة الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي قادته تعاليم الليبرالية الجديدة بداية التسعينيات[24].
إلا أن التحول إلى نمط حياة جديد مشروط أيضاً بوجود الفرص لبلوغ التوقعات، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من سخط شديد. لأنه من غير المحتمل أن يتخلى مجتمع ما عن نمط حياته التقليدي وإن كان لا يرضاه بسهولة[25]. وقد قدمت الليبرالية الجديدة فرصاً سياسية تتمثل في توسيع المشاركة السياسية واجتماعية تتمثل في دور السوق الحرة في تحقيق التنمية كما سيتبين لاحقاً.
كانت المراحل الأولى للتنمية في دول العالم غير الصناعي مرتبطة ارتباطاً شديداً بأيديولوجيا تحركها، وتدعم التغييرات الجديدة في المجتمع[26] على كل مستويات القيم التي ستتبدل في ترتيبها وأولوياتها وأهميتها. ولاعتناق الأيديولوجيا الليبرالية أو حتى غيرها من الأيديولوجيات، فعادة ما تكون هناك مجموعة من الظروف الاجتماعية والسياسية التي وصلت بالمجتمع إلى مرحلة من الأزمة الثقافية تستوجب منظومة فكرية جديدة، تحفظ المصالح وتحقق الطموحات للجماعات والشرائح التي عانت من تلك الأزمة. فالأيديولوجيا في النهاية تحتوي على منظومة قيم أساسية وتصورات عامة عن المجتمع المثالي والقوى الحاكمة لحركته وتطوره، وكذلك تحتوي على مجموعة من القواعد التي تحقق شروط القيم المتفق عليها، ومجموعة من التوجيهات والوسائل لتحديد الأهداف وتحقيقها[27].
اشتملت الأيديولوجيا الليبرالية، سواء نظريات التحديث أو الليبرالية الجديدة، على التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فبالنسبة للتحديث السياسي فإنه يقوم على المأسسة، والتي تنظم قوى المجتمع السياسية وترتب وظائفها وأدوارها من خلال عمليات فنية وبيروقراطية تدار من قبل موظفين تكنوقراط، وكذلك يقوم على المشاركة الجماهيرية عن طريق الديمقراطية. أما التحديث الاقتصادي فكان يقوم على استبدال وسائل الإنتاج التقليدية بوسائل حديثة قائمة على التكنولوجيا، تضمن التنوع في الإنتاج، وإشباع الحاجات المتعددة للمستهلكين، إضافة إلى اكتساب المهارات الفنية والإدارية من أجل ذلك. وطبقاً لكل من التحديث السياسي والاقتصادي ينبغي أن تتجاوب التنظيمات الاجتماعية معها لتتقبل القيم الجديدة[28]. ويتمثل التحديث الاجتماعي في الهجرة من الريف إلى المدن، والتي تعد من أهم عوامل التحديث والتعاطي التكنولوجي، للتحرر من سطوة العائلة والعشيرة في حرية اتخاذ القرارات، والارتهان لقيود القانون المدني، وتغيير أنماطهم السلوكية، كجعل الأولوية للمهارات المكتسبة بدلاً من الوراثة والعلاقات القرابية، والأخذبالتكنولوجيا التي يوفرها جو المدن[29].
ومن هذا يمكن الخروج بنتيجة أن الليبرالية الجديدة كوصفة تنموية، تحتوي على ثلاثة أبعاد رئيسة تؤثر على أوضاع القيم الثلاث عند “تيد جير”، هي البعد السياسي والبعد السيكولوجي وأخير البعد الأيديولوجي.
يتمثل البعد السياسي لليبرالية الجديدة في قيام نظام اجتماعي يحقق متطلبات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات الأمن والاستقرار، والمشاركة في صنع القرار. ويتمثل البعد السيكولوجي لها في تغيير القيم والسلوكيات والاتجاهات التقليدية، إلى قيم حديثة تدفع إلى الإنجاز والإبداع والتجديد، وذلك بالتحرر من قيم الأسرة والعشيرة[30]. بينما يتمثل البعد الأيديولوجي في تبني الثقافة الغربية في مجال الفكر علاوة على تبنيها في البناءات السياسية[31].
ولإعطاء مثال على ذلك كان المصريون قبل عام 1945 يلقون مشاكلهم الاقتصادية، على الفقر والجهل والمرض؛ أي أن رفع هذه الآفات يعني التقدم الاقتصادي. لكن في نهاية القرن العشرين أصبحوا يعبرون عن المشاكل الاقتصادي بمقولة (انخفاض معدل الدخل) أي؛ انخفاضه مقارنة بالدخل العام للدولة، مهما كان هذا الدخل مرتفعاً أو منخفضاً[32]. وهذا بسبب التغير الذي أصاب قيم التماسك التصوري، والذي يؤثر على وضع القيم الأخرى من ناحية الكم والنوع نتيجة لتبني القيم الليبرالية الاقتصادية.
وقد ظل نصيب الاستهلاك لدى الفرد المصري من الناتج المحلي الإجمالي – طوال ثلاثين عاماً (1955-1985) – ثابتاً تقريباً عند نسبة تقرب من الثلثين، لكن هذه النسبة تزايدت حتى وصلت إلى 81% عام 1994، والسبب في ذلك هو الانفتاح الاقتصادي على سلع الرفاه الذي بدأً من منتصف الثمانينيات، خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية اتجهت إلى إنتاج السلع الاستهلاكية وسلع الخدمات، واقترنت هذه الاستثمارات بالحملات الدعائية لترويج هذه السلع، في زمن تميز بثورة تكنولوجية في عالم الاتصالات والبث المباشر، والذي أصبح ينقل نمط الحياة الغربي عبر الأطباق اللاقطة إلى الأسر غنية كانت أم فقيرة، فتفتحت شهيتها للاستهلاك والمحاكاة، وإن كان ذلك يزيد عن معدل القدرة الشرائية[33]. وأصبحت السلع رمزاً من رموز الصعود الاجتماعي، فبعد أن كانت بعض السلع، كالتلفزيون والغسالة الكهربائية من الكماليات، أصبحت السيارة الخاصة، بل من طراز معين، شكل من أشكال الرقي الاجتماعي، وينطبق ذلك على نوع المسكن والأثاث، ووسائل الترفيه المقتبسة عن الغرب[34].
أما فيما يخص قيم القوة والمشاركة فيمكن تلمس صعود التوقعات المتعلقة بها، في الجانب السياسي للتنمية، والذي رافق الجانب الاقتصادي، خاصة مع تبني تعاليم الليبرالية الجديدة، من دعوة إلى تبني الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية.
ومن ناحية أخرى أدت العولمة خاصة، مع انهيار الكتلة الشيوعية إلى هيمنة القوى الرأسمالية وفرض حزمها الإصلاحية على الاقتصاديات الوطنية في العالم الثالث، وإلغاء البعد القومي، وتبني شعارات الليبرالية وقيمها، وانتهاك السيادة الوطنية تحت ذرائع حفظ حقوق الإنسان وحماية الأقليات[35]. تعتمد حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية على مرجعية فكرية تتمثل في أطروحات الليبرالية الجديدة، وتسعى هذه الحزمة من الإجراءات إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام، في إطار تحفيز وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. وقد تولى صندوق النقد الدولي عمليات التثبيت الاقتصادي، بينما تبنى البنك الدولي عمليات التغير الهيكلي[36].
إن القبول بسياسات الليبرالية الجديدة، بسبب الديون وضعف التمويل، جعلت من تعاليم الليبرالية الجديدة هي المسيطرة على مؤسسات الدولة الاقتصادية، وأصبحت وسائل الإعلام تروج بين ليلة وضحاها للرجل العامل الناجح، بدلاً من الترويج للدولة المستقلة[37].
لقد وعد متبنو الليبرالية الجديدة في الدول العربية بالرخاء، والعدل، وتحقيق المساواة بفعل اليد الخفية للسوق، وإن كان ذلك يتطلب في البداية ربكة في عدم المساواة عند التخلص من القطاع العام، لكنها سرعان ما تنجلي[38]. إلا أن فشل هذه المشاريع التنموية أو حتى عدم لمس نتائجها بالنسبة للطبقة الفقيرة تؤدي إلى “الحرمان النسبي” الناجم عن الوعود بالنسبة للمجتمعات التي تمر بمرحلة ركود اقتصادي، أو التي تمر بمرحلة جمود بنيوي يمنعها من توسيع مخرجات القيم مع طرح أيديولوجية تحديث فيها. وهي حالة من الحرمان تنشأ بعد فترة من الزمن يكون فيها وضع القيم جيداً، ثم تأخذ فيها قدرات القيم في الاستقرار أو الانحدار، في مقابل ارتفاع توقعات القيم، ويمكن التماس هذا في الدول التي تبنت النهج الاشتراكي والذي نجح في بداياته، ثم ما لبث أن فشل مما اضطر الحكومات إلى تبني الليبرالية، فانخفضت قدرات القيم مقابل ارتفاع التوقعات، بسبب التبشير بالفرص الاقتصادية التي سيوفرها الانفتاح على السوق العالمية الحرة.
ثالثاً: الليبرالية الجديدة والجماعات المرجعية وأثرها في التوقعات الصاعدة:
في الوقت الذي كانت تتزايد فيه، أعباء الانفاق على التعليم والصحة، على كاهل فئات الدخل المحدود في دول العالم الثالث، خلال الثمانينيات والتسعينيات؛ بسبب تبني برامج الإصلاح والتكيف الهيكلي، كانت تستورد فئة قليلة من المجتمع طعامها الجاهز من أوروبا في المناسبات الخاصة، وتعتمد على الأكل في المطاعم أو توصيل الطلبات منها. وفي الوقت الذي تراجع قطاع الصحة عن تقديم الخدمات الضرورية؛ بسبب الزيادة السكانية وتراجع الميزانية،كانت تزدهر المراكز الصحية الخاصة التي تستقبل أبناء الطبقات الغنية لتقدم لهم الخدمات الصحية بأحدث أجهزة الرعاية الصحية. وينطبق هذا الأمر على قطاع التعليم، ففي مقابل التراجع في نوعية التعليم المقدم لعامة فئات الشعب، كانت هناك مراكز وجامعات ومؤسسات أجنبية، تقدم مواداً تعليمية باللغات الأجنبية للمقتدرين مادياً دون باقي فئات الشعب[39].
إن عدم قدرة أغلب فئات الشعب في الدول النامية على الاستجابة للإغراءات الاستهلاكية؛ بسبب انخفاض القدرة الشرائية أو التمسك بالتقاليد يتسبب في تخلق مشاعر المرارة إزاء تلك الشرائح الموسرة[40].
إن انفتاح الأسواق المحلية أمام السوق العالمي – في ظل العولمة – يجعل الأسواق المحلية تتسم بقدر كبير من التفاوت في أنواع السلع. فهناك حزمتان من السلع، إحداهما تضم السلع الرئيسة الموجهة نحو الحاجات الأساسية، كالغذاء والصحة والتعليم، وهي موجهة لأصحاب الدخل المنخفض، والأخرى تضم سلع الرفاهية، وهي موجهة لأصحاب الدخل المرتفع[41]. هذا التفاوت الطبقي يجعل من الفئات الدنيا تتخذ من الفئات العليا جماعات مرجعية، لتقييم وضع قيم الرفاه، و كذلك قيم القوة بحكم أن تلك الفئات باتت تؤثر على القرار السياسي.
رابعاً: علاقة اختلال توازن القيم بالليبرالية الجديدة، وأثرها على توقعات القيم الصاعدة:
أدت تعاليم الليبرالية الجديدة إلى ظهور مشكلة بنوية في دول العالم الثالث، عند الرغبة في التوسع في التعليم من أجل التحديث، وهي النزعة نحو العلم النظري بدلاً من العلوم التطبيقية[42]. وهو ما أد في النهاية إلى خلق طبقة مثقفة لا يقبلها سوق العمل، لكنها تشعر بالحرمان؛ بسبب البطالة أو بسبب عدم توافق المهن التي حصلت عليها مع تطلعاتها التي تخلقها الدراسة النظرية، خاصة تلك التي ينمو لديها الحس الطبقي والوعي بالاستغلال والاستبداد. ومع تضاؤل الفرص المجتمعية والسياسية أمام هذه الفئة، فإن توقعاتها الصاعدة بسبب التعليم يصطدم مع واقع قدراتها الهابطة، وهذا نتيجة لعدم توازن مراتب الأفراد مع القيم التي يعتقدون أنهم يستحقونها.
ثانيًا: أثر الليبرالية الجديدة في هبوط قدرات القيم
بحسب نظرية “الحرمان النسبي” فإن أكثر القيم تعرضاً للبروز هي قيم الرفاه؛ بسبب ارتباطها بالحد الأدنى من العيش. وباستعراض نظريات الليبرالية الجديدة يتضح أن أكثر ما تركز عليه هي الأمور المتعلقة بقيم الرفاه من نمو، وازدهار، وارتفاع متوسط الدخل ونحوه. ومن هذا يتضح أن “الحرمان النسبي” المرتبط بهبوط قدرات الرفاه هو الأبرز.
يرى ” جير” أن تمرد الناس من أجل المزيد من الطعام، هو الخوف من الوصول إلى المجاعة، وليس بسبب المجاعة نفسها[43]. وهذا ما كان موجوداً في الثورات التي حلت في فرنسا وانجلترا في القرن الثامن عشر؛ بسبب ارتفاع أسعار الخبز[44]. وكذلك في حالات الهبوط الاقتصادي، بسبب العصرنة للدول الآخذة في الانخراط في السوق العالمية[45].
ويمكن لمس ذلك في سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، حيث تسببت شروط البنك الدولي والصندوق الدولي للإنشاء والتعمير في انسحاب الدول المستدينة تدريجيًا من دعم الخدمات الاجتماعية – خاصة التعليم والصحة والإسكان- والعمل على خفض الإعانات. وهو ما تزامن مع تضاؤل فرص العمل؛ بسبب الخصخصة وما تتطلب من عمالة مدربة ومؤهلة، فكانت النتيجة على غير التوقعات المتصاعدة، نتيجة لزيادة السكان، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتآكل الطبقة الوسطى، وانتشار الفقر[46].
إن من آثار التوجهات الليبرالية الجديدة العدالة في عدم التوزيع، وهي آثار يمكن تلافيها من خلال منظومة من القيم والمعايير[47]. لكن الدول العربية على سبيل المثال أهملت معالجة الآثار السلبية لسياسات الانفتاح الاقتصادي ولم تغتنم الأثار الإيجابية، فأخذت أسوأ ما فيها، من زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتشويه الاقتصاد. ولكي تتحايل الحكومات على شعوبها، شغلتهم بانتخابات وديمقراطية شكلية ولجأت إلى القمع عند الضرورة[48].
إن قمع المتظاهرين بسبب شكلية الانتخابات يتسبب في هبوط قيم المشاركة السياسية، والتي طالما بشرت بها الليبرالية مما أدى إلى الوعي السياسي وبالتالي صعود توقعات المشاركة. لكن بعد الانخراط في العمل السياسي عن طريق الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني سرعان ما يكتشف الناشطون السياسيون بعد سلسلات التزوير في الانتخابات، وممارسات القمع السياسية، أن قدرات القوة لديهم في هبوط، وهو ما ينعكس أيضاً على الرأي العام كله.
في النظم الاستبدادية تكون القيود المفروضة على توفير قيم المشاركة كبيرة، لأن عملية توسيع قيم المشاركة تعني تخلي أعضاء النخب في تلك النظم عن مناصبهم بعكس النظم الديمقراطية، وذلك بسبب توسع البنى السياسية فيها. إلا أن التعقيد في عملية المشاركة بالنسبة للنظم الديمقراطية يجعل في النهاية من محصلة قيم المشاركة محدودة لمن هم خارج النخب السياسية، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء للمظاهرات للتأثير في السياسات الحكومية[49].
ويمكن عزو الثورات في العصر الحديث إلى المطالبة بالحرية والمشاركة السياسية، وهذا كان شعار الثورتين الفرنسية والأمريكية.
ولهذا يفسر “تانينباوم Tannenbaum” الاستقرار السياسي، بمدى تشتيت القوة السياسية من عدمها، فكلما كانت السلطة مركزة في يد النخبة كلما زاد السخط، خاصة من الطامحين في المشاركة، وكلما تشتتت بشكل يُشعر الناس بأنهم منخرطون في المشاركة كلما قل السخط[50].
ومن هنا يرتبط “الحرمان النسبي” بالنظرية الليبرالية من ناحية ترويجها للديمقراطية كنظام سياسي يدعم حرية السوق مما يتسبب في “الحرمان النسبي” الناتج عن هبوط قدرات القيم؛ بسبب انعدام أو ضعف المرونة البنيوية لتركيبة مجتمعات لعالم الثالث عن استيعاب التجربة الغربية مما يتسبب في تقلص مخرجات القيم أو فرص تلك القيم كما يقول “تيد جير”[51].
فالدول النامية تواجه مشكلة في تقبل التحديث بسبب تعقيد بُناها الاجتماعية، بحيث يتبادر سؤال من أين البدء في التغيير ومن يتولى التغيير. فلو تم اقتراح البدء في التنمية البشرية فمن يتولى ذلك؟ هل هي الأجهزة البيروقراطية؟ التي هي بحد ذاتها بحاجة إلى التغيير بل وربما الاجتثاث. فهذا المطلب يتطلب جهازاً سياسياً غير مرتبط بجهات أو قوى أو بيروقراطيات، فمن أين يمكن إيجاد هذا النظام السياسي؟[52] ويؤدي كلاً من هبوط قيم الرفاه والقوة إلى الشك في النهج الليبرالي مما يقود إلى انهيار قيم التماسك التصوري بشأنه وهو ما يكرس هبوط القيم جميعها.
الخاتمة:
في هذا البحث اتضح لنا أثر الليبرالية الجديدة في إعادة تشكيل القيم، وكذلك الفرص المرتبطة بها. وعند تناول علاقة الليبرالية الجديدة بصعود توقعات القيم في نظرية “الحرمان النسبي”، اتضح أثر التعرض لنمط الحياة الغربي بسبب الليبرالية الجديدة في صعود توقعات القيم، إضافة إلى أثر التعاليم الليبرالية كأيديولوجيا أسهمت في تعزيز أثر التعرض لنمط الحياة الغربي، خاصة مع وجود “حرمان نسبي سابق في مجتمعات دول العالم الثالث يدعو إلى تبني قيم ثقافية وفكرية جديدة. وهذا ما يتقاطع مع نظرية “الحرمان النسبي” التي تقول أن التحول إلى نماذج ثقافية جديدة يقتضي توفير تلك النماذج لفرص سياسية واجتماعية, وهي التي بشرت بها الليبرالية الجديدة. كذلك تبين لنا ارتباط “الحرمان النسبي” بفشل المشاريع التنموية بالليبرالية الجديدة في دول العالم الثالث. وتناولنا أثر سياسات الانفتاح على السوق في رفع التوقعات نتيجة لمقارنة الجماعات المهمشة نفسها بالجماعات الموسرة كجماعات مرجعية. وأخيراً رأينا كيف أن تنفيذ سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في ظل العولمة قد ساهم في اختلال التوازن المتعلق بالقيم، وذلك من خلال اصطدام التوقعات الصاعدة للقيم بتضاؤل الفرص السياسية والاجتماعية. وفيما يخص بأثر الليبرالية الجديدة في هبوط قدرات القيم، فقد تبين معنا تنامي مشاعر “الحرمان النسبي”؛ لكون قيم الرفاه هي القيم الأكثر تأثراً عند الشعوب، وذلك بسبب الآثار السلبية لليبرالية الجديدة، والتي أولت السوق أهمية بالغة. كذلك تبين لنا الأثر السلبي لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي على الفئات الدنيا، في هبوط قدرات قيم الرفاه، وكذلك قيم القوة؛ بسبب الاستبداد وعدم التحول الديمقراطي والاكتفاء بالانتخابات الشكلية. واتضح لنا تسبب الليبرالية الجديدة “بالحرمان النسبي” انطلاقًا من أثر حالات عدم المرونة البنيوية لدول العالم الثالث؛ بسبب عدم قدرة مجتمعات تلك الدول عن استيعاب التجربة الغربية، وهو ما قلص مخرجات القيم والفرص المتعلقة بها. وفي نهاية المطاف رأينا كيف أن فشل الليبرالية الجديدة – كنموذج واعد في دول العالم الثالث – يؤدي إلى تراجع أو انهيار قيم التماسك التصوري المتعلقة بها، انطلاقاً من أثر عدم المرونة البنيوية في هبوط القدرات المتعلقة بالقيم.
قائمة المراجع
المراجع العربية:
أولًا – الكتب
- أمين،جلال،العولمة والتنمية العربية: من حملة نابليون إلى جولة الأوروغواي (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1999).
- بدوي، أحمد موسى، تحولات الطبقى الوسطى في الوطن العربي (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013).
- التابعي، كمال، تغريب العالم الثالث: دارسة نقدية في علم اجتماع التنمية (دار المعارف، القاهرة، 1993).
- جير، تيد روبرت، لماذا يتمرد البشر (ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، دبي، 2004 الطبعة1).
- الزيات، السيد عبد الحليم، التنمية السياسية: دراسة في الاجتماع السياسي، الجزء الثاني: البنية والأهداف (دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2002).
- طاشمة، بو مدين، دراسة في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وإشكالات (ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011).
- عثمان، إبراهيم، النوري، قبس، التغير الاجتماعي (الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة،2008).
- كريشان، مازن منصور محمد، أيديولوجية العولمة (آمنة للنشر والتوزيع، عمان، 2012).
- المقرمي، عبدالملك، الاتجاهات النظرية لتراث التنمية والتخلف في نهاية القرن العشرين (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1991).
- النجفي، سالم توفيق، فتحي، أحمد عبد المجيد، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي ( مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، الطبعة 1، 2008).
ثانيًا – الدوريات
- “ المجلة العربية للعلوم السياسية، كولفرني محمد، التغيير الاجتماعي والسياسي: دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم”، ع (20)، (10/2008). ص ص139-146.
ثالثًا – المواقع الإلكترونية
- https://www.britannica.com/topic/neoliberalism
المراجع الأجنبية
Books:
- George Rude, The Crowd in History, 1730-1848 (New York: Wiley, 1964).
- Scientific Periodicals:
- Frank Tannenbaum, “On Political Stability“, )Political Science Quarterly“, LXXV Jun 1960), 161-180
[1]عثمان، إبراهيم، النوري، قبس، التغير الاجتماعي (الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، 2008). ص7.
[2] “ المجلة العربية للعلوم السياسية، كولفرني محمد، التغيير الاجتماعي والسياسي: دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم”، ع (20)، (10/2008). ص ص139-146.
[3]جير، تيد روبرت، لماذا يتمرد البشر (ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، دبي، 2004 الطبعة1). ص45.
[4]المرجع نفسه، ص45.
[5]المرجع نفسه. ص160-161.
[6]كريشان، مازن منصور محمد، أيديولوجية العولمة (آمنة للنشر والتوزيع، عمان، 2012). ص 119.
[7]المرجع نفسه. ص129.
[8]المرجع نفسه. ص133-136.
[9] الموسوعة البريطانية، مقالة للكاتبة نيكولا سميث (Nicola Smith)، تاريخ زيارة الموقع 29 يوليو 2018، انظر الرابط التالي: https://www.britannica.com/topic/neoliberalism
[10]المرجع نفسه. ص66-68.
[11]المرجع نفسه. ص 117.
[12]المرجع نفسه. ص69-70.
[13]المرجع نفسه. ص72-74.
[14]المرجع نفسه. ص160-161.
[15]المرجع نفسه. ص176-179.
[16]المرجع سابق. ص180-186.
[17]المرجع نفسه. ص207-210.
[18]المرجع نفسه. ص 212.
[19]المرجع نفسه. ص219- 220.
[20]المرجع نفسه. ص230.
[21]المرجع نفسه. ص160-161.
[22]المرجع نفسه. ص163.
[23]أمين،جلال،العولمة والتنمية العربية: من حملة نابليون إلى جولة الأوروغواي (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1999). ص30.
[24]بدوي، أحمد موسى، تحولات الطبقى الوسطى في الوطن العربي (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013)، ص318.
[25]جير، مرجع سابق. ص171-173.
[26]الزيات، السيد عبد الحليم، التنمية السياسية: دراسة في الاجتماع السياسي، الجزء الثاني: البنية والأهداف (دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2002)، ص14.
[27]المرجع نفسه. ص29.
[28]التابعي، كمال، تغريب العالم الثالث: دارسة نقدية في علم اجتماع التنمية (دار المعارف، القاهرة، 1993). ص31.
[29]المرجع نفسه. ص32.
[30]المرجع نفسه. ص36، 39.
[31]طاشمة، بو مدين، دراسة في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وإشكالات (ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011). ص35.
[32]أمين، 1999، مرجع سابق. ص37.
[33]المرجع نفسه. ص94، 96.
[34]المرجع نفسه. ص106.
[35]كريشان، مرجع سابق. ص138.
[36]النجفي، سالم توفيق، فتحي، أحمد عبد المجيد، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي ( مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، الطبعة 1، 2008). ص105.
[37]بدوي، مرجع سابق. ص321.
[38]المرجع نفسه. ص322.
[39]أمين، 1999، مرجع سابق. ص112-113.
[40]المرجع نفسه. ص121.
[41]النجفي، مرجع سابق. ص256.
[42]المقرمي، عبدالملك، الاتجاهات النظرية لتراث التنمية والتخلف في نهاية القرن العشرين (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1991). ص96.
[43]جير، مرجع سابق. ص 214.
[44]انظر George Rude, The Crowd in History, 1730-1848 (New York: Wiley, 1964). 47-65.
[45]جير، مرجع سابق. ص216.
[46]بدوي، مرجع سابق. ص322.
[47]المرجع نفسه. ص329.
[48]المرجع نفسه. ص324.
[49]جير، مرجع سابق. ص232، 233.
[50]انظر Frank Tannenbaum, “On Political Stability“, )Political Science Quarterly“, LXXV Jun 1960), 161-180.
[51]جير، مرجع سابق. ص212.
[52]المقرمي، مرجع سابق. ص96.