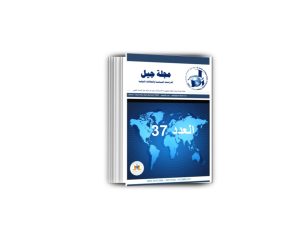التوظيف السياسي للموت في تونس خلال العهد الحسيني 1881 – 1705
إعداد : د ، عبدالقادر سوداني
دكتور في التاريخ السياسي الحديث/ جامعة صفاقس ، تونس
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 19 الصفحة 93.
الكلمات المفاتيح: الموت ، القتل، التنّفذ، الشرعية، المراقبة .
تلخيص :
لم تتوانى كل سلطة سياسية عن استثمار كل الظواهر الإنسانية من أجل إحكام سيطرتها على الجماهير من ذلك إشهار القتل حتى تمنع كل محاولة للتمرد أو للاحتجاج، وكذلك من أجل تأكيد شرعية النظام الحاكم، ولم يشذ البلاط الحسيني في تونس عن هذه القاعدة إذ عمل البايات على استثمار ظاهرة الموت والقتل من أجل ضرب الخصوم، والزيادة من وتيرة الاعتصار الضريبي وخاصة من أجل تدعيم الشرعية ومزيد مراقبة السكان وخلق لفيف من الحلفاء .وقد لامست هذه الإستراتيجية بعض النجاح إذ تمكن البلاط من استقطاب مريدي الزوايا وفي المقابل فقد مثل القتل والتنكيل وسيلة لإخافة أعوانها وخاصة النافذين منهم من مغبة الخروج على الركب السلطاني.
Key words: death, murder, execution, legitimacy, surveillance.
Abstract
No political authority has resorted to investing all human phenomena in order to tighten its control over the masses, such as spreading the murder to prevent any attempt at rebellion or protest, and to assert the legitimacy of the ruling regime. The exploitation of the phenomenon of death and murder in order to beat opponents and increase the frequency of tax evasion, especially in order to strengthen the legitimacy and more control of the population and the creation of a group of allies. This strategy has touched some success as the tiles managed to attract the corners of the corner, Murder and abuse is a means of intimidating its agents, especially The most influential of them are the consequences of going out on the royal throne.
المقدمةإن الموت هو من المشتركات الإنسانية و دراسة الموت تجعل الباحث أمام وضعية معرفية مضطربة تتجاذبه مرجعيات متنافرة، وتغامر هذه الدراسة بالبحث في تاريخانية الموت والقتل، طارحة على نفسها الإسهام في الإجابة عن دلالات الموت في الفترة الحسينية.
إن دراسة الموت ومعرفة دلالاته على الفرد والمجتمع يأخذ اليوم مكانا واسعا في الوعي الجمعي، وذلك بسبب تفاقم أعمال القتل نتيجة الصراعات والحروب وقمع الأنظمة الشمولية لجماهيرها، مما أنتج حواضن بشرية مهيأة لتقبل فكرة الموت والقتل، بل أمسى القتل من المشاهد المألوفة والمعتادة. إن اتساع ظاهرة العنف على الصعيدين المحلي والعالمي وتطوّر أساليب القتل وأدواته دفعت الكثير من المؤرخين إلى دراسة هذه الإشكالية المعقّدة، هذا التعقيد انعكس كذلك على كتابات الباحثين مما أنتج حالة من الاختلاف في رؤية الموت من قبل المؤرخين و علماء الاجتماع [1].
كما تنوعت زوايا التعاطي مع الموت بين مختلف الشعوب والحضارات فلدى المجتمع القبلي في الشرق شاعت عبارات غسل الدم والثأر والتي تعني مجابهة القتل بالقتل، أما بعض شعوب إفريقيا فتفرق بين الموت الطبيعي والموت المفاجئ، ففي الحالة الأخيرة يسود الاعتقاد أن الروح قد تتخلى عن الجسد فيموت الإنسان ولا تموت الروح إلا بعد نسيانه من قبل أهله وأصحابه[2]، فالموت كان عصارة تراكمات عميقة في الذهنية الجماعية لأي شعب من الشعوب.
إن الاختلاف بين جمهور الباحثين في تناول القتل السياسي، سواء أكان تصفية أو اغتيال أو إبادة، كان القادح الذي دفعنا لندلي بدلونا في هذا الموضوع محاولين أن نبرز خاصة كيفية استثمار المخزن لظاهرة الموت والطرق المتنوعة التي ركنت إليها السلطة لتغييب منافريها .
يمكن اعتبار القتل هو آلية دفاعية أو هجومية سواء في ممارسة السلطة لمشروعية احتكارها للعنف أو في إرهاب الخصوم. ومن دوافع إقدام السلطة على القتل هو الرغبة في تبيان القوة والسيطرة والعدوانية والتي تتبدى في القابلية للاستخدام غير المشروع للقوة والضغط على الآخر، أو حتى قتله، وكانت السلطة المركزية المسؤول الأكبر على عمليات القتل الفردي و الجماعي باعتبار أن الدولة المركزية الكلاسيكية لبثت عرضا إيمائيا للخضوع. كما أن السلطة العدمية تصّفي كل من يتعارض مع نهجها وتغرس لدى أعوانها عقلية طاغوتية. وعندما يغلب على سياسات السلطان طابع العنف في مواجهة حركات الرفض القبلي تبرز دور روابط الاجتماع الثقافية والسياسية التي تنهض بها شبكة واسعة من العلاقات والمؤسسات الدافعة والضامنة لعملية استيعاب عالم البداوة، في المقابل تأرجحت علاقات المخزن مع التجمعات الحضرية بين حدي التجاذب والتكامل أو التنابذ والصراع . هذا التناقض انسحب بدوره على مسألة استثمار الموت واختلاف دوافع القتل وغاياته بين فئتي “الفضلاء والأراذل “، هذا التنضيد الاجتماعي للموت مرده تنوع الإستراتيجيات السياسية في استثمار القتل والموت.
تراث حضاري عنيف ؟ (I
1) الموت في الأثر الديني
هل من المساءة الحديث عن السلوك العنفي لأصحاب الإسلام الرسولي منذ أن باتت ممارسة السلطة السياسية والدينية تتم كفعل لا كقيمة ؟
لا بدمن التعريج في البداية على الأصول الذي نبت منه العنف، والذي كان لصيق الصلة بالتراث التيولوجي، من ذلك عنفية شعيرة الجهاد وقتال المشركين وكذا سنّ شعيرة “الأضحية”التي تعود إلى عزم إبراهيم ذبح لإسماعيل إذ قام بتوثيقه ثم شحذ شفرته ثم أدخل الشفرة لحلقه ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه[3]، قبل أن يفتدى بذبح عظيم. فمبدأ قتل المخالفين في العقيدة يجعل السيف هو الفيصل في حل النزاعات الفكرية، فالدين رغم أنه جعل القتل خالصا لوجه الله إلا أنه لم يستطع دفع جموع المؤمنين إلى عدم المغالاة والإسراف في تحكيم السيف .
لا ريب إن الإسلام في أقنومه يمجّد الموت ويراه مرحلة تحول من الحياة الدنيا الوضيعة إلى الحياة الأخروية السرمدية، فقد حضّ الدين على الإقبال على الموت كبرهان على صدق الخضوع للإلاه “تمنوا الموت إن كنتم صادقين” [4]، كما تمتع ذلك المؤمن الذي يموت في سبيل الله بجزيل الثواب في دار الحق.
تجسّد ذلك الجانب العنيف في تراثنا كذلك من خلال سلوكيات سدنة الدين والقائمين بأمره، فأبو عفك اليهودي وكعب بن الأشرف وزعماء بني النضير من اليهود كانوا من حلفاء قريش اغتالهم الرسول حتى لا يبعد اليهود من دائرة أعداءه لا سيما بعد معركة بدر[5]، فبقاء اليهود كعدو للمسلمين من شأنه أن يبقي جذوة الإسلام متّقدة، ويساهم في رصّ صفوف المسلمين في مواجهة عدو المشركين، وبالتالي تصدير الأزمات الداخلية نحو العدو الخارجي.
كما نجد أن النبي محمد كان يراوح في نشر دينه الجديد بين العنف والسلم، ففي حلف الفضول وفي دستور المدينة وفي فتح مكة طغت الحسابات السياسية في معاملاته مع المشركين، في حين مال إلى نشر الدين بحد السيف في جملة من الغزوات ( بني قريضة ) وكذلك أثناء الحروب ( بدر ، أحد…) .
إن الترسانة الدينية المكثّفة للحدود والجنايات [6] تشي بسياسة ضرب العنف عن طريق العنف ذاته، ولم يكن لأحد أن يتساءل عن حقيقة ارتباط القتل بتعاليم السماء.
تواصلت تلك الجدلية المتداخلة بين النص الديني الخالص وبين تنزيل هذا النص إلى الممارسة الإجرائية، ومن أبرز أشكال هذا التداخل هو تواصل ديالكتيك الدين والسياسة، إذ غالبا ما يتخفى السلوك السياسي الزمني وراء سطوة الرمزي المتعالي، وكان هذا الأمر سببا في تواصل القتل طوال تاريخنا الإسلامي، فالدولة التيوقراطية لبثت مستودعا حضاريا يسعف السلطات السياسية بوسائل البقاء ومنها تسويغ الفتك ” بالمنافقين وأهل الفتنة”.
بالعودة إلى جل محطات التاريخ الإسلامي نجد أن جل الاختلافات الفكرية والانشقاقات الاجتماعية والتوترات السياسية وقع حسمها بحد السيف ومحاولة تغييب هذه التناقضات عن طريق القتل، من ذلك في عهد معاوية تفنن واليه زياد بن أبيه والي الكوفة والبصرة في القتل على الظن و أخذ البريء لإخافة المذنب، حتى أن أحد أعوان زياد وهو الصحابي سمرة بن جندب قتل ثمانية آلاف من البصرة. كما أن الحرق أستخدم كوسيلة للقتل في خلافة هشام في إعدام الداعية الشيعي المغيرة بن سعيد العجلي، أما أبو مسلم الخراساني فقد أعدم ستمائة ألف بين رجل و إمرأة حتى أنه أمر بقتل كل غلام بلغ خمسة أشبار إذا شكّ في ولاءه[7] .
2) الموت في التاريخ العربي الإسلامي
في أغلب الأحيان انتقل الحكم من دولة لأخرى عن طريق الانقلاب و الاستحواذ على الملك غصبا، كما سعت كل سلالة إلى التخلص من أسلافه عن طريق القتل .
انعكس ذلك على فكر وسلوك الكثير من المسلمين إذ وقع الزهد في الدنيا وترجّي الآخرة، مثال ذلك أن الصوفية باعتبارها التطبيق الحرفي للإسلام، ترى أن المجذوب لا يمكن الإطلاع على موته وحياته، من ذلك أن الشيخ الجزائري أحمد العلوي الذي ذكر أن شيخه توفي حين ولد لكنه واصل العيش، فالصلحاء عابرين للزمن لأنهم أفاقوا من غفلة الحياة نحو نور الموت[8]، فالدنيا سجن المؤمن والموت هو الخلاص منه.
في مقابل احتفاء التراث الشرقي بالموت فقد برزت فكرة موت الإلاه لدى الأنقلوسكسونيين مما ساهم في انحسار تأثيرات الدين والعقيدة[9]، هذه الثورة الفكرية ساهمت في أنسنة الفعل السلطوي والنزول به من الرمزية السلطانية إلى الإجرائية الواقعية، وبالتالي باتت للسلطتين السياسية و الدينية ضوابط سلوكية لا يمكن لهما أن تحيدا عنها.
فهل سينسحب هذا التحول الغربي في شأن علاقة الفرد بالمقدس على تاريخ تونس الحديث، خاصة أن البلاد التونسية بحكم موقعها الجغرافي بقيت تتجاذبها تأثيرات الشرق و الغرب؟
إستهلّ الأتراك حضورهم في تونس بتعذيب موظف حتى الموت ومصادرة أملاكه [10]، مما أثار حفيظة الفقهاء وقتئذ ومنهم إبن عظوم. ثم عرفت البلاد التونسية الكثير من زهق الأرواح أثناء الصراع الإسباني التركي في بر تونس. فقد قام أهل باب سويقة على خيرالدين و كانت بينهم دماء كثيرة إذ مات فيها خلق كثير، و لما نزلت النصارى قابلهم الأتراك بخربة الكلخ وكانت مقتلة عظيمة، ثم هجم النصارى على مدينة تونس ومات منهم الثلث في عهد الحسن الحفصي [11] .
وهنا تعترضنا إشكالية تعداد القتلى في هذه الفترة التاريخية، إذ نجد أن أغلب الكتابات الإسلامية لا تحصر أعداد القتلى في عدد محدد بل نجد الحصر بالكمية ” خلق كثير، جموع وافرة، مات فيها الكثير، مات فيها ثلث سكان الحاضرة ، كثر فيها الموتان….” وهو ما يحيل على تقبل فكرة القتل من خلال عدم الاهتمام بعدد القتلى الذين غالبا ما يكونوا من العوام.
في مقابل ذلك وقع تأريخ الحوادث الكبرى في البلاد كالآفات الطبيعية بأسماء من مات فيها من أعلام البلاد، ففي أيام يوسف داي وفي سنة 1620 وقع طاعون في البلاد والمعروف بوباء سيدي أبي الغيث القشاش لأنه توفي به.
في الفترة المرادية تواصلت الصدامات بين الحكم المركزي وبين فئات واسعة من سكان البلاد، فمحمد باي المرادي حاصر أولاد سعيد بالحامة ومات خلالها من الفريقين خلق كثير[12]،أما مراد باي فقد حاصر جبل وسلات عند نفاق أهله الذين آوا أبي القاسم الشوك ودخل الجبل عنوة وقتل الثائر وجيء برأسه إلى الحاضرة.
وفي عهد رمضان باي 1696 اختص بالملك مغنيه مزهود الذي قام بتعذيب رجب خزندار شر عذاب حتى قتل نفسه، أما مراد باي الثالث ( بوبالة) فقد أتى على أصحاب عمه بشتى ألوان التعذيب، ثم قام بقتلهم والأكل من لحمهم وأجبر علماء الدين على شرب الخمر. ونتيجة لإسرافه في القتل انقلب عليه إبراهيم الشريف الذي سريعا ما استأنف سيرة سلفه في القتل، وخاصة استهداف البدو ورجال القبائل وكان يسعى للقضاء عليهم و اجتثاثهم من البلاد، وفي عهده أسرف الجند في قتل العرب.
في مقابل تجاهل موت العامة لقي أصحاب الحظوة كل التبجيل، مثل مراد باي باني البيت المرادي، فعند وفاته دفن بجوار مقام الولي سيدي أحمد بن عروس ثم خصص له ابنه تربة في الجامع الذي بناه مراد باي ونقل إليه جثمانه.
(IIالموت و الإستراتيجيات السياسية الحسينية
- استثمار الموت؛ الموت الميري وموت العامة
يمكن القول إن القتل مرتبط بظاهرة الصراع الطبقي الذي تتولى الدولة إدارته من خلال دورها المباشر في سيرورة الإنتاج الاجتماعي، ومن خلال التعبير عن حاجات الطبقة المسيطرة في المجتمع. وغني عن الإيضاح أن البلاط الحسيني كان يعمل على استثمار كل التحولات السوسيولوجية وظواهرها بتسخيرها لخدمة إستراتيجياتها، ومن هذه الظواهر هي شيوع القتل والموت الطبيعي في المجتمع التونسي الحديث .
كانت أولى ملامح استعمال السلطة الحسينية للموت من أجل تشكيل لوحة اجتماعية تناسب شبكة تحالفات المخزن، فقد إهتم البايليك بموت الصلحاء لإبراز مدى قوة ارتباط السلطة برموز الإسلام الشعبي، والحرص على ظهور البايات أثناء المآتم الخاصة بالأولياء.
ففي سنة 1710 توفي الولي الصالح سيدي علي عزوز وهرع لجنازته أهل تونس وبعث الباي أخاه لحضور جنازته، وطلب الناس نقله إلى تونس غير أن أهل زغوان أبوا إلا دفنه في موضع منيته. فمكان دفن الولي تكتسي أهمية بالغة لأن موضع الدفن قد يجلب البركة والشرف لسكان التخوم، لذلك عدت وفاة الولي سيدي علي عزوز مناسبة لانبثاق صراع بين أهل زغوان باعتبارهم أولي أمر الولي والاولى ببركته وبين أهل الحاضرة باعتبارهم الحاضنة الرمزية لمجد صاحب الخطوة.
عند موت إبراهيم الجمني سنة 1721 بنى الباي على ضريحه قبة حتى تمثّل فضاء للتنفذ وحضور المركز في المجالات القصيّة، فلا ريب أن الاهتمام بالقبة من شأنه جذب مريدي الولي إلى تحالفات المخزن.
من جانبه حزن حمودة باشا على موت إمامه الفقيه حمودة باكير ومشى في جنازته راجلا باكيا، في زمن كان البلاط الحسيني يسعى إلى حشد الدعم اللازم لحرب الجزائر، لذلك أبدى الباي تأثره لفقدان حمودة باكير أمام صفوة الحاضرة.
في نوفمبر 1823 توفي الولي المجذوب يوسف عريفات ودفن بمقام الولي سيدي مصطفى الجزيري وهرع أهل الحاضرة للتبرك بماء غسله، هذا الفعل يشي بأن موت صاحب الكرامة من شأنه أن يكون مناسبة لاستفادة العامة من بركة موته .
إلى جانب أحباب الله فقد أولى البلاط الحسيني اهتماما بالغا بموت الدائرين في فلك البلاط واغتنام موت فرد من الخاصة من أجل إظهار تقدير البايليك لأعوانه وتخصيص جنازة تليق بخدمتهم للسلطة المركزية.
يمكن أن نذكر في هذا الصدد محاولة اغتيال الوزير حمودة بن عبدالعزيز بعد أن سنّ قانون المشارطة المالية، فقام عامل باجة بتدبير محاولة قتله في سياق صراع الدائرين في فلك البلاط بالدفاع عن مصالح باتت ترتج تحت وطأة قرارات هذا الوزير، فالتجرؤ على محاولة اغتيال أحد أعوان السلطة من شأنه تعريض صاحبه للقتل لأن للحاكم وحده حق الإماتة والإحياء.
سعى البايليك إلى استثمار الموت الجماعي والفردي من خلال تسليط الخطايا على الجناة، هذه الخطايا التي مثّلت موردا أساسيا لخزينة الدولة، لذلك كلما زادت عمليات القتل كلما زادت الشروخ الاجتماعية، وإنكفأت المجاميع إلى صراعاتها الداخلية مم يسمح للمركز بتجزئة الفضاء من جهة ومزيد اعتصار السكان ضريبيا من جهة أخرى.
خطية على أولاد زيد من المثاليث ب 101 رأس إبل و 100 رأس غنم على السواسي لفسادهم بعد موت المرحوم محمد باي[13]، إن الفراغ المؤقت في السلطة من شأنه ان يكون سببا في اندلاع أعمال رفض ، وهو تقليد تليد يقوم على اغتنام موت الحاكم لإعلان الثورة على الحكم المركزي.
عدّ الموت من العوامل الدافعة لمسار التفكك و الالتحام في المجتمع، فالسلطة المحلية كانت كثيرا ما تتعرض للقتل نتيجة السياسة الجائرة التي يقوم بها المشايخ والقياد بدعم من الهواديق وبتواطؤ من البايليك، دونك في ذلك أن دية الشيخ مثلت ضعف الدية العادية،ألف ريال دية الشيخ علي بن حسن النيجاوي الذي قتله سليم الحافضي وأخبر بها الطيب بن مبارك وتعيين خلاصها على يد قايدهم محمد بن محمد بن عثمان[14]، فإذا علمنا أن القايد والشيخ والهواديق ينالون نصيبهم من هذه الخطايا تأكدنا من أهمية القتل كمورد للأعوان المحليين، فكلما زاد القتل كلما تنامت مواردهم المالية.
أدى تواصل اللقاحية لدى أغلب المجتمعات الشرقية إلى حساسية إشكالية الشرف لدى المجموعات الأولية، مما جعل عمليات القتل المرتبطة بالشرف في تزايد مستمر، من ذلك هجوم نفرين من الطرابلسية على أحد الرعايا وتهجمهما على إبنته بالعيب وهروبهما ومطالبة مجلس الجنايات والأحكام العرفية بالحاضرة بضرورة معرفة أي قبيلة من القبائل هما والقبض عليهما والإتيان بهما من الساحل إلى الحاضرة[15]، و قد تنوعت عمليات القتل المستهدفة للنساء سواء كانت من قبل العائلة أو من خارجها.
دية زوجت (كذا) بلقاسم الشارني ضربها بومنيجل الشارني الرحالي بفاس فماتت بسبب ذلك ،أخبر بها علي بن عبدالله قايد شارن وتقرر خلاصها على يد القايد المذكور [16] .
في ذات السياق بدت ظاهرة الإغارة من أكثر السلوكيات المسببة للقتل بعد عنف السلطة، إذ أن بعض أعمال الإغارة تخلّف أحيانا بعض الخسائر البشرية . من ذلك إغارة الهمامة على الفراشيش وإلحاق الموت بعروش الفكة، فلم يشعروا إلا والجيوش أحاطت بهم من كل جانب ومكان وهجموا عليهم هجمة واحدة وبادروهم بضرب الرصاص فمنهم من مات ومنهم من انجرح ثم أخذوا في نهب بيوتهم واستخرجوا جميع ما فيها من اختلاف أنواعه حتى استفرغوها وسلبوا نساءهم و تركوهم مكاشيف العورات[17]. وقد تكرر هذه المثال طوال التاريخ الحديث للبلاد التونسية، إذ قد زادت عمليات القتل زمن الآفات الطبيعية نتيجة تنامي أعمال التكدية واللصوصية .
ففي سنة 1819 اندلعت ثورة عارمة بغرب البلاد قضى عليها سليمان كاهية رغم أنها فترة أوبئة ومجاعات وقحط حتى وصل الحال إلى حرق اليهود[18]، وقد انطلق الطاعون منذ 1818 في الحاضرة ووصل عدد الموتى إلى الألف في اليوم و دام حتى 1820 .
إلى جانب اسثمار الموت فقد رام البلاط الحسيني ترسيخ الشرعية من خلال إشهار قتل المناؤوين.
2) الموت السياسي وسياسة الرؤوس المقطوعة
في الفترة العثمانية ساد قانون قتل الأخوة والذي اختطه السلطان بيازيد الأول ثم بات قانونا ثابتا مع محمد الفاتح، وذلك بتصفية الأمراء المنافسين بالإتفاق مع هيئة العلماء [19]، تواصلت هذه السياسة خلال الفترة اللاحقة في أغلب أرجاء السلطنة العثمانية ومنها تونس.
من أجل ترسيخ شرعية الحكم والدفاع عن العرش لجأ البايات إلى سياسة قصّ الرؤوس، فحسين بن علي لم يدخل إلى الحاضرة أثناء صراعه مع الداي محمد خوجة الأصفر سنة 1706 إلا بعد أن أتوه برأس الداي، ثم سارع الباي إلى قص رؤوس معارضيه امثال إبراهيم الشريف وإبن فطيمة وأحمد بن متيشة.
كما تجسمت سياسة إشهار القتل خلال الفتنة الباشية الحسينية، ففي ثورة علي باشا سنة 1728 وعندما تم القبض على عضده أحمد بن متيشة وتم قصّ رأسه مما عجّل بانحلال الثورة ” فما راع الباشا إلا بالناس قدامه هاربة حتى وصلوه بهذا الخبر الموجع أخبروه فما صدّق بنجاة نفسه حتى ركب على ظهر فرسه وسار على وجهه لا يدري أين يذهب وهرب عنه كثير من أصحابه[20]، فمجرد قص رأس أحمد بن متيشة من شأنه إنهاء ثورة عارمة. نفس هذا الصنيع نجده يتكرر مع يونس باي الذي قام بحزّ رأس حسين بن علي وإرساله للحاضرة معلنا بذلك نهاية المعركة بين الصفين الباشي والحسيني لفائدة علي باشا بمجرد قص رأس حسين بن علي وبعثه إلى الحاضرة ليتحقق الناس قتله. كما قام علي باشا بقتل سيد الحنانشة علي الصغير وأخيه سلطان وكذلك بوعزيز بن نصر، وطيف بشلوهم في أسواق الحاضرة كإشارة إلى نهاية تهديد قبيلة الحنانشة ذات السطوة التليدة في تهديد استقرار الحكم المركزي.
وفي سنة 1840 توجه أحمد باي إلى جنوب الإيالة لإستخلاص الجباية ولتأمين السابلة والقضاء على أحد كبار” الباندية ” الهمامة، وسنة 1844 أمر الباي أحمد زروق بالقضاء على كل فسايدية الهمامة [21]“le plus terrible des bandits”، مما يعني أن البلاط الحسيني مرّ من استهداف الجماعات المتنطعة إلى رموز الرفض والخروج على الطاعة، سواء من مارس الإغارة أو حتى من لم ينسجم مع إستراتيجيات الحكم.
أما في شأن الموت السياسي فقد تعددت أوجهه وحيثياته ، لكنها تشابهت في رغبة كل حاكم في تصفية خصومه والاستئثار بعلامات الملك. فبعد أن تشكلت ملامح صراع بين الباي والداي أمر حمودة باشا الحسيني الحاج أحمد بن عمار باش حانبة بقتل الداي محمد قاره برغلي فسقاه السم وجلس حذوه حتى فاضت روحه، ولم يقم له ما يستحق من جنازة في سعي لتغييب ذكره ولتحذير من سيخلفه بضرورة الانصياع لتوجهات الباي.
كما يمكن ذكر ما تعرض له الوزير يوسف صاحب الطابع سنة 1815 من القتل والتنكيل حتى أن العامة قامت بشي لحمه وأكله وقطع عورته وجرّت جثته إلى الكنسية ليعبث بها اليهود، بعد أن تزايدات تدخلات الوزير في شأن تصريف الحكم وعزمه على إجبار أبناء الباي على كبح جماح شهواتهما، كما أن دوره في صرف الملك من محمود باي لفائدة عثمان باي جعل أبناء محمود باي يعوّلون عليه لتطويع البلاد ثم قاموا بقتله والتمثيل بجثّته في محاولة للقضاء على كل أعوان سلفهم .
دونكم في ذلك كذلك أن حامد بن شريفة ومساعده رجب بونمرة كانا من أشدّ أعوان المخزن الحسيني حتى أن البايليك كان يناديه ب “ولدنا”[22]، و بعد أن رفع راية العصيان في وجه البايليك وقع التنكيل به من خلال نقله إلى باردو عاريا ثم قتله في السجن، في مسعى لإخافة عرشه وغيره من أعوان السلطة .
في سنة 1863 تعرضت السلطة الحسينية لأزمة مالية فضاعفت في الضرائب ورفض البدو الاستجابة لهذه الزيادة والتف العامة حول علي بن غذاهم كباي للأمة والذي انتهى به الحال سجينا ثم الموت مسموما .
في مقابل تلك العناصر التي تعرضت للقتل فقد برز من داخل رحم السلطة قطاعات بشرية واسعة تمكنت من استثمار هذه السياسة و توجيه آلة القتل وفق مصالحها. في هذا الإطار برز دور الهواديق في معاضدة عمل المحلة مثل استخلاص الدوايا والخطايا فقد ورد في زمام البايليك أن والد الميت وهو من الهواديق كان يستخلص الدية من عدة عروش في باجة “دية ولد علي بن مبروك اليونسي الشعيبي طاح في قلتة ماء وخلّص ديته الهواديق وهم علي بن مبروك و يوسف التومي”[23]. دية كنتّ (كذا) هلال الفرشيشي البعصوصي قتلها زوجها ولد هلال المذكور أخبر بها طاهر بن منصور وتعيين خلاصها على يد الباش حانبة 500 دينار[24] .
ما من بد أن غالبية أعوان السلطة تمكنوا من التأثل بفضل شيوع تجارة الموت التي سمحت لهم بإمداد المركز بما يحتاجه من الأموال ولعل ارتفاع أعداد عزيب البايليك نتيجة تزايد الخطايا والدوايا، ويتكون العزيب من دوايا بعض القبائل التي بقيت تتعهد بتربية الماشية مثل الهمامة وورغمة ودريد، خير مثال على استفادة السلطة المركزية والمحلية من عمليات القتل. مثّلت هذه الثروة التي تحصل عليها أعوان السلطة هدفا للغوارة والخنّابة، ففي سنة 1860 قام أولاد أحمد من عمدون بمهاجمة هنشير شيخ من تبرسق وغنموا 280 من البقر و116 من الماعز كما هاجموا هنشير الشيخ وغنموا منه الذهب [25]، كان جبالية الشمال الغربي كثيرا ما يهاجمون الأثرياء خاصة زمن الأزمات الطبيعية.
4 ألاف دية الشيخ مراد الغياثي قتلوه العطيات ودية الشيخ إبراهيم بن بوقرة قتله حسين بن الحاج بعشرة آلاف دينار وألف وخمسمائة دينار دية الشيخ جامع المرزوقي الذي قتله أولاد مرزوق إخوته وأخبر بها عبدالله المناعي[26]، كانت السلطة تحاول في كل مرة الاستفادة من الاضطرابات الاجتماعية إذ أنها غالبا ما تقوم ببيلكة أموال الضحايا وتخطئة الجناة.
الخاتمة
لا مندوحة أن الحركة التكتونية للسلطة التقليدية الشرقية تقوم أساسا على الإخافة والترهيب، ولعل القتل هو أبرز تعبيرة على هذه السياسة، فالقتل هو فعل عقابي، وهو استثمار للجسد، وخلق للانضباط الذي يعني السيطرة والرقابة على السكان انطلاقا من الجسد الفردي إلى الجسد الاجتماعي. وقد عجّل هذا الأمر بانتهاء الدورة البيولوجية للدولة الشرقية بمجرد فقدانها لأدوات القوة واليات الضغط والضبط، وأدى تهاوي المثال الدولوي في منطقتنا إلى اصطناع نخبة عالمة تكفلت بإخفاء عيوب الحكم من ذلك التشديد على الفنطازيا التاريخية والكتابات الاستعراضية التي سعت لخلق واقع سياسي واجتماعي وقع إعداد سلفا .
في أروبا ومنذ القرن 18 بدأت مراجعة جذرية لقوانين العقاب وبات للجسد حرمته وقدسيته[27]، ووقع تقنين القتل والتضييق على ممارسته الرسمية، مما جعل السلطة السياسية تميل إلى سياسة الاستبداد الناعم من أجل تمرير إستراتيجياتها.
Febvre ( Lucien), La mort dans l’histoire, in Annales, 7 eme année , N 2, 1952, pp 223-225. [1]
Thomas ( Louis- Vincent) , Remarque sur quelques attitudes négro-africain devant la mort , in revue française de sociologie , 1963, N 4, p 405. [2]
الطبري ( أبي جعفر محمد بن جرير)، تاريخ الطبري في تاريخ الرسل و الملوك ، ج1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف مصر، ص 275.[3]
القرآن، السورة 2، الآية 94.[4]
في شأن دور النبي محمد في الاغتيال السياسي راجع: العلوي (الهادي)، الاغتيال السياسي في الإسلام، دار المدى للنشر، الطبعة الرابعة، دمشق 2004.[5]
الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع، وفي الشرع هي عقوبة مقدرة حقا لله تعالى، أما الجنايات فهي ما يجني البشر، أي يحدث ويكسب وهي في الأصل مصدر جنى عليه شرا، والجناية القصاص في النفوس والأطراف، وفي حدود إبن عرفة هو فعل يوجب عقوبة فاعلة بحد أو قتل أو قطع أو نفي. لحمر (حميد بن محمد )، فتاوى مالك الصغير: الشيخ أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني ، دار اللطائف لنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، القاهرة 2012، ص 391. [6]
العلوي ( الهادي)، من تاريخ التعذيب في الإسلام، نفس المرجع، ص ص 9-12.[7]
Geoffroy ( Eric), La mort du saint en islam , in revue de l’histoire des religions : les voies de la sainteté dans l’islam et le christianisme , tome 215, N 1, 1998, p 21.[8]
Le bœuf ( Eric), La mort du saint en islam ,ibidem , p p 17-34.[9]
قاسم ( أحمد)، أوضاع إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظوم، إشراف عبدالجليل التميمي، شهادة التعمق في البحث ، كلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة التونسية، السنة الجامعية 1982-1983، ص 310. [10]
الرعيني القيرواني ( محمد بن أبي القاسم) المعروف بإبن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية و تونس ، مؤسسة سعيدان و دار المسيرة للطباعة و النشر ، الطبعة الثالثة ، بيروت 1993، ص ص 185-186. [11]
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس …،المصدر نفسه، ص 271.[12]
أ و ت، نفس المصدر، دج ، دفتر عدد 92، ت مارس 1759.[13]
المصدر نفسه ، دج، دفتر عدد 67، ص 32، ت 1757.[14]
المصدر نفسه، س ت ، ص 24، م 273، و 24506، ت 1860-1868، مراسلة صادرة عن عمال الطرابلسية إلى الوزير الأكبر تعلقت باستخلاص مال الإعانة والنظر في بعض مطالب الأهالي ونزاعاتهم . [15]
أوت، المصدر نفسه ، دج ، دفتر عدد 165، ص 65.[16]
أوت ، المصدر نفسه ، دج، دفتر عدد 2384، مراسلة القايد محمد قعيد إلى الوزير مصطفى خزندار.[17]
Abel clarim de la rive , Histoire général de la Tunisie depuis l’an 1590 avant jésus – christ ,introduction par p mignard , librairie E, démoflys ,paris 1883, p 333. [18]
الضيقة (حسن)، الدولة العثمانية: الثقافة ، المجتمع والسلطة، دار المنتخب العربي، الطبعة الأولى ، بيروت 1987، ص 76.[19]
بن يوسف ( محمد الصغير)، المشرّع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي، المجلد الأول، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي ، المطبعة العصرية ، الطبعة الأولى ، تونس 1998، ص 212.[20]
Chérif ( MH), Les Mouvements paysans dans la Tunisie du 19 eme siècle, in revue de l’occident musulman et méditerranée, N 30, 1980, p 27.[21]
دية بوبكر بن عمارة الشريف المساهلي من أولاد يعقوب قتله نصر بن أحمد السهيلي من أولاد القصوري وقريبه مبارك بن الحاج إبراهيم من القبيل ضربوه بالرصاص والحديد فمات من سبب ذلك، أخبر بذلك ولدنا الشيخ حامد بن شريفة في شوال 1203 . الأرشيف الوطني التونسي ، الدفاتر الجباءية، دفتر عدد 274، ص 100. [22]
أوت، نفس المصدر ، دج، دفتر عدد 165، ص 53.[23]
Cherif ( MH), les mouvements des paysans …., op.cit, p 29.[25]
أ و ت ، نفس المصدر، دج، دفتر عدد 67، ص 3، ت ديسمبر 1773.[26]
فوكو (ميشال)، المراقبة والمعاقبة ولادة السجن، ترجمة علي مقلدى ، مراجعة وتقديم مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، الطبعة الأولى، بيروت 1990، ص 51.[27]