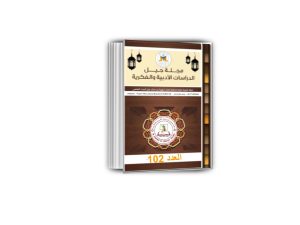قراءة في الأدب النسوي الجزائري المعاصر (جميلة زنير وفاطمة العقون أنموذجا)
أ.خالدي وليد. جامعة طاهري محمد بشار. الجزائر
Reading in the contemporary algerian feminine literature for djamila Zenir and Fatima Al Agoun Khaldi walid/ Tahri Mohamed University, Béchar, Algeria
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد 53 الصفحة 45.
Abstract
Feminist discourse constitutes an identifying mark between past and current Arabic contemporary scientific letters. Such a phenomenon, nowadays, is a universal stamp established widely by post-modernist trends, starting from Nietzsche’s criticism to Jacques Derrida’s deconstruction. It has reshaped human culture patterns through discussion, interaction, elevating values of pluralism and difference by way of emphasizing the marginalized, ostracized, excluded and neglected, and restoring all these as conscious essences that have their own shares in molding human history. This has been eased by means of altering the pyramidal hierarchy based on antagonist dichotomies which live on superiority principles.
In the light of this situation, the developed ideas and discourses brought with them new insights for creative works which facilitated the emergence and diffusion of new models of Algerian literature dealing with profound issues of form and content hitherto banned and forbidden. Amidst these conditions, the so-called “feminist literature” stood in front of patriarchal authority.
This research paper aims at surveying main appearances of post-modernist aspects in novels written by three Algerian women authors: Jamila Zenir’s ” Asabi’ Al Itiham ”, Fatima Al Agoun’s ” Aziza ”. These authors took the woman as a main corner stone of their novels’ architecture which built its details out of stripping off actual living world, yelling the unsaid and revealing all forms of injustice, repression, oppression, suffer and tragedy endured by women in our modern world.
Key Words:
feminist literature, Post-modernism, post-modernist feminine literature, male dominance.
الملخص:
يشكل الخطاب النسوي في أدبيات العلم المعاصر العربي علامة فارقة بين الماضي والحاضر، حيث اكتست هذه الظاهرة في وقتنا الراهن طابعا كونيا ساهمت في تأكيده وبروزه على نطاق واسع أفكار ما بعد الحداثة (post-Modernité ) بداية مع النقد النيتشوي، ومرورا بتفكيكية جاك دريدا، لعيدا تشكيل أنساق الثقافة الإنسانية عبر خاصية الحوار والتفاعل، والإعلاء من قيم التعدد والاختلاف؛ بالتركيز على المهمش والمنبوذ والمبعد والمهمل، وإعادة الاعتبار له كذات واعية لها سهمها في رسم التاريخ الإنساني، عن طريق قلب التراتب الهرمي، المبني على تلك الثنائيات الضدية المنطوية على مبدأ المفاضلة، ومن هذا المنطلق، حملت هذه الأفكار والمقولات معها رؤية جديدة للإبداع، سمحت بانتشار وذيوع نماذج أدبية جزائرية جديدة تمس جوهر الشكل والمضمون،كانت فيما مضى تأخذ سمات المحظور والممنوع؛ ليقف هذا الذي اصطلح على تسميته ” بالأدب النسوي ” في وجه سلطة الذات البطريكية الأبوية.
وعلى هذا الأساس، نسعى من خلال هذه الورقة البحثية -العمل على- رصد أهم تجليات ما بعد الحداثة انطلاقا من استعراض روايات لكاتبات جزائريات، رواية ” أصابع الاتهام ” لجميلة زنير و ” عزيزة ” لفاطمة العقون، حيث اتخذن من موضوع المرأة اللبنة الرئيسة في بناء معمار رواياتهن المجترحة لتفاصيلها من خلال تعرية الواقع المعيش، وفضح المسكوت عنه؛ بإبراز كل أشكال الظلم والقمع والقهر والمعاناة والمأساة التي تواجهها المرأة في هذه الحياة.
الكلمات المفتاحية: الأدب النسوي- ما بعد الحداثة- تجلياتها في الكتابة النسوية- الهيمنة الذكورية.
مقدمة:
إن من بين الدوافع التي أفرزت في وقتنا الراهن ما يسمى بالأدب النسوي مرحلة ما بعد الحداثة (post-Modernité )، حيث شكلت هذه الأخيرة انزياحا دلاليا، وثورة معرفية عن المعايير والقيم المكرسة، والأنماط الثقافية السائدة التي تعالج الفن والأدب، والتي أرسى دعائمها المشروع الحداثي القائم على مركزية الذات، والمتمثل في الوحدة والانسجام والتطابق والهوية والحقيقة، ومن هذا المنطلق، فإن ما بعد الحداثة بهذا التصور تنضوي على ذلك النقيض الذي ينزع نحو التعددية والاختلاف ذي الطابع الانفتاحي المتحرر من كل قيد أو نسق مغلق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مطية لتوجيه مجموعة من الأسئلة التي هي بمثابة مراجعة حضارية ومساءلة شمولية، تروم إعادة النظر في كل المسلمات والتصورات الذهنية، والمقولات المركزية التي نهضت على أساسها قيم ومبادئ الحداثة، مما يسمح بشكل أو بآخر إلى ظهور كتابة مختلفة مضادة، وأدب مناهض تبرز ملامحه على صعيد الشكل والمضمون، استجابة للمتطلبات الراهنة.
وانطلاقا من هذا الاعتراف، فقد استوعبت الكتابة النسوية الجزائرية هذا التحول والذوق الفني المختلف، الذي طال موجة الفكر الغربي المعاصر، واستطاعت من جرائه التعاطي مع إشكالياته وأطروحاته مانحة حضورها بشكل لافت للنظر، ضمن خارطة الإبداع الأدبي العربي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مفضية بذلك إلى تحقيق طفرة نوعية متجاوزة أمام الوضع الثقافي البطريكي ذي النزعة الأبوية المتعالية، لذا أضحت مهمتها منوطة بكسر جدار الصمت واختراق حواجزه، متخذة من الكلمة سلاحا، بالحفر في النواة الأصيلة التي تمارس فعل الاستبداد والقهر الإنساني، وهو ما يجعل من هذه الكتابة جسرا يساهم في فضح وتعرية النظم الثقافية السائدة وخطاباتها الرسمية المتسلطة التي تقيم تمايزا بين المركزي والهامشي من خلال البناء الهرمي التراتبي، لكي تعيد للتجربة الإنسانية توازنها عبر ممارسة براغماتية تتيح للطرف الآخر (الأنثوي) الدخول في سلم الحضارة أو التاريخ البشري، برسم صورة واعدة للمستقبل، وبمنظورات جديدة، تقوض صرح النموذج والمعيار المعتاد.
وعلى هذا الأساس، فالإشكالية المطروحة تتجلى على النحو التالي: التساؤل عن ماهية الأدب النسوي (المصطلح والمفهوم)، وأين تكمن علاقة ما بعد الحداثة بالأدب النسوي في الفكر العربي المعاصر ؟ وما هي تجلياته في السرد النسوي الجزائري المعاصر ؟.
1-ماهية الأدب النسوي ( المصطلح والمفهوم):
مصطلح الأدب النسوي من المصطلحات التي ما فتئت تستأثر باهتمام الباحثين والدارسين في أدبيات الخطاب النقدي العربي المعاصر، وقد شكل هذا التعاطي في إطاره العلمي مجالا معرفيا خصبا يطرح على طاولة النقاش والحوار، مما ساهم بشكل أو بآخر إلى صعوبة الإمساك بتلابيبه كونه مفهوما أضحى من أكثر المفاهيم شيوعا ودورانا على الألسن، بين المهتمين والمنخرطين في ميدان النقد والأدب والفكر بصفة عامة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وانتهت في آخر المطاف السجالات إلى تعدد المسميات هذا من جهة، ومن جهة ثانية بين مؤيد ورافض، ويمكننا تلمس هذه الحقيقة انطلاقا من الكتابات المتعددة والمختلفة للنقاد، التي ملأت الساحة الثقافية.
وفي ذروة هذا النشاط، فقد دأب بعض الباحثين والدارسين العرب إلى استخدام كلمة ” الأدب النسوي ” والبعض الآخر فضل تسمية ” أدب المرأة ” وفريق قرر أن يرسو على ” أدب الأنثى ” إلا أننا في هذا السياق، لا تهمنا المسميات بقدر ما نروم استخلاص المعنى العام للمفهوم، واستنادا إلى ذلك، حري بنا في هذا المقام أولا استعراض جملة من الآراء ووجهات النظر كنافذة نطل من خلالها على المفهوم في حد ذاته بغض النظر عن الجدل الدائر حول التسمية، للتعرف على فحواه وتبيان معانيه ودلالاته، وفي هذا الصدد، نحن إذن إزاء منظورات وتصورات نقدية متعددة، وسنكتفي هنا برصد بعض النماذج التي تعرضت له. وفي هذا السياق تشير يمنى العيد إلى ” أن مصطلح الأدب النسائي يفيد معنى الاهتمام وإعادة الاعتبار إلى نتاج المرأة العربية الأدبية وليس عن مفهوم ثنائي أنثوي ذكوري”[1] وعليه فالمبرر الذي تقدمه الناقدة يمنى العيد في هذا الطرح، ضرورة الالتفاف والاهتمام بالنتاج الأدبي للمرأة العربية بعيدا عن كل توصيف وتصنيف، الذي يصعد من حجم المعاناة، ويزيد من وتيرة الصدامات وبؤر التوتر، والمسوغ في ذلك العمل على تفكيك هذه الثنائية الضاربة بجذورها من منظورها في عمق الميتافيزيقا، والأمر لا يختلف بصورة أكبر إذا ما عرجنا على الناقدة غادة السمان، حيث تقول في هذا الشأن ” حينما يولد العمل الأدبي لا نسأل: ولد أم بنت، وإنما نسأل: مبدع أم غير مبدع…”[2] وهي بهذا الرفض المبني على التمايز والاختلاف تناقض الفكرة المجترحة للعنصرية بشتى أشكالها، وتحررها من هذه الدونية والرؤية الضيقة من خلال تبيان مواطن الاختلاف والتمايز.
كما أن هذا الفهم السابق يتماشى وينساق ضمنيا مع ما ذهبت إليه بعض الكاتبات بلا هوادة في مختلف أنحاء الوطن العربي، عندما أظهرن عدم رغبتهن في المسائل التي خاض فيها الدارسون في الأوساط الثقافية، الرامية إلى معادلة التصنيف وموضعتها في صيغتها المكتملة، وذلك بما لا يتناسب مع أرائهن في الموضوع، وحاولن مصادرة هذه الفكرة بنبرة واحدة تشي بالرفض وعدم قبولها، وفي هذا الشأن نستحضر ما قاله الناقد يوسف وغليسي ” وعلى الضفة الجزائرية، نسمع أصداء للصرخة ( السمانية ) ( نسبة إلى غادة السمان ) تردد الرفض لهذه القسمة الأدبية الضيزى رفضا بالإجماع الذي لا أدل عليه من تلكم الندوة الأدبية التي عقدها عبد العالي رزاقي مع خمسة أصوات أدبية نسوية من الجزائر ( زينب الأعوج، ربيعة جلطي، إلهام بورابة، حياة غمري، نصيرة بن ساسي) …وقد أجمعت المشاركات فيها على أن ليس هناك أدب رجالي وآخر نسائي )”[3] إلا أن يوسف وغليسي في هذا الصدد لم يكتف بهذا العرض فقط، وقدم تبريرا مفاده أن أغلب الأصداء الصارخة الرافضة لهذا التصنيف، يمكن إرجاعه إلى الوضع المفارق بين الحاضر والماضي، ومنشأ هذه الإشكالية يرجع بصورة عامة إلى العامل التاريخي الضارب بجذوره في القدم، وعلى حسب قوله” يمكننا أن نلتمس أعذارا شتى للأجيال السابقة من الكاتبات في رفضهن للمصطلح، إذا أخذنا ذلك الرفض في سياقه التاريخي؛ ذلك أن المرأة في غمرة سعيها الجارف إلى المساواة مع الرجل، يتعين عليها أن تزيل كل العقبات والحواجز التي تعينها وتعرفها وتصنفها في سياق اجتماعي استثنائي، ومن تلك العقبات مصطلح ( الأدب النسوي ) الذي بدا لبعضهن خطوة تصنيفية أولى على درب التصفية الفكرية الذكورية والوأد الثقافي “[4].
ومن زاوية أخرى، ولعل ما يسترعي الاهتمام، تلك الأصوات الرجالية والنسائية التي لم تول التسمية أية أهمية وراحت تخوض في قضايا المرأة وتقف إلى جنبها، وتعايش همومها وتقر بأحقيتها في ممارسة نشاطها بكل حرية، من خلال الإطاحة بالعقلانية الشاذة بكل قيمها ورموزها وتصوراتها المتجسدة في النزعة المحافظة، والمستمدة من العادات والتقاليد الراسخة التي كونها النموذج البطريكي الأبوي، وتجلت هذه الظاهرة الثقافية المنافحة في العديد من المواقف والصور، وتمثلت في أشكال إبداعية وسعت من دائرة الاهتمام سواء على مستوى الذكورة أو الأنوثة، وعلى هذا الأساس، يقول صالح مفقودة ” ولا تزال الأقلام الداعية إلى تحرير النساء تؤكد نفس النداء، نجد ذلك فيما تكتبه نوال السعداوي من مصر، وفاطمة المرنيسي من المغرب، وزينب الأعوج في الجزائر وفاطمة أحمد إبراهيم من السودان. كما نجد أصواتا رجالية تساند قضية حرية المرأة وتتبناها كمحمد بنيس في المغرب، والأعرج واسيني في الجزائر “[5].
وتماشيا مع هذا التصور، نجد محمد طرشونة يعرف الرواية النسوية بالتعريف الآتي ” الرواية النسوية هي رواية ملتزمة تحمل رسالة تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة، وقد تتجاوز المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى إثبات التفوق والامتياز، وفيها لهجة نضالية في أسلوب خطابي في أغلب الأحيان “[6].
أما الخالد كورنيليا فيرى في مفهوم النسوية ذلك الأدب الحامل لقيم التعدد والاختلاف في بعده الحضاري، وخاصيته الإنسانية في صورتها المتكاملة ضمن نسق فكري، يغير من نظام الأشياء، ويؤثث لمواقف تحيلنا لا محالة إلى نظرة تنقلنا من الرؤيا الأحادية الدغمائية إلى نظرة أكثر شمولية بمعناها الجذري و العميق، وهي رؤيا تعود في مجملها إلى مساءلة الأنظمة المغلقة المؤسسة على الهويات المكتملة، والتي نستشف من ملامحها إعادة تفسير العالم، وبهذا تجعلها أقدر على تخطي الحدود وتجاوزها، في ظل انهيار القيم المكرسة، ومن هنا فإن منحى هذه الرسالية كما يؤكد ” لا تقتصر على كونه مجرد خطاب يلتزم بالنضال ضد التمييز الجنسي، ويسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما هي أيضا فكر يعمد إلى دراسة تاريخ المرأة، وإلى تأكيد حقها في الاختلاف، وإبراز صوتها وخصوصياتها، وبشكل خاص إلى المطالبة بإعادة التفكير جذريا في جميع بنيات المجتمع السائدة، بناء على الشروط الاجتماعية والطبقية والثقافية والعرقية المختلفة “[7].
وبخلاف هذا الرأي، وردا على المطارحات السابقة، فإن مصطلح الأدب النسوي منهم من يراه يكتسب مشروعيته النقدية عندما يتعلق الأمر بأسس المواضيع أو المضامين التي يطرحها ويثيرها داخل بنيات الواقع المعيش، والتي تدور محاورها حول موضوعة المرأة والمشكلات التي تعترض سبيلها، ولا سيما في حيز الثقافة الكلاسيكية، ولا أدل على ذلك ما أشار إليه الباحث حسام الخطيب، وفي هذا يقول ” تثير المصطلحات الدراجة مثل ” الأدب النسائي “، و ” أدب المرأة ” كثيرا من التساؤلات حول مضمونها وحدودها، وفي الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه المصطلحات إلى حصر حدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه المرأة، أي بتحديده من خلال التصنيف الجنسي لكاتبه لا من خلال المضمون وطريقة المعالجة ويترتب على ذلك أن تكون الأهمية النقدية لمثل هذا المصطلح ضئيلة جدا، اللهم إذا نطوى مفهومه على الاعتقاد بأن الإنتاج الأدبي للمرأة يعكس بالضرورة مشكلاتها الخاصة، وهذا هو المسوغ الوحيد الذي يمكن أن يكسب مصطلح ” الأدب النسائي ” مشروعيته النقدية “[8].
كما يتفق الناقد جميل حمداوي ضمنيا مع هذا الرأي قائلا ” يتميز الإبداع الأنثوي – الذي يتخصص النقد النسائي في رصده قضية وفنا ومقصدية- بحضور الأنا، والاسترسال في استعراض تجارب الذات في صراعها مع نفسها أو مع الموضوع، والإغراق في العواطف الانسيابية، والميل إلى التخييل الذاتي، واستحضار المذكر باعتباره طرفا نقيضا يمكن التعايش معه من جهة أو الصراع معه من جهة أخرى، واللجوء إلى اللاشعور وتيار اللاوعي لتفتيق الأحاسيس الداخلية، والاهتمام بالعواطف والمشاعر الذاتية الشعورية واللاشعورية، والحديث عن الأسرة والزواج والطلاق والظلم الاجتماعي، والثورة على الظلم السياسي والاقتصادي والثقافي والعرقي والتاريخي الذي يمارس ضد المرأة “[9] فإن مثل هذه الرؤيا للإبداع الأنثوي من قبله، يجعلها كتابة تبحث عن مقاسها وشكلها المناسب، ومضمونها المرتقب، وهو أول باعث يضعها في خارطة المشهد النقدي ويكسبها مشروعية في الحقل التداولي المعرفي، بما تكابده من صعاب، ومهام تضطلع باستزراع الوعي، يشي بنزعة وجدانية تبرز من خلاله الأنا المتمردة، التي تقف في وجه الآخر اللامتساوي من وجهة نظر تفاعلية، تتوخى إقامة واقع يمنحها خصوصية وفرادة، توسع من سلطة النموذج الجاهز، بل وتتعداه إلى آفاق جديدة كانت فيما مضى مقفلة، وأكثر من ذلك تجعلها تسير جنبا إل جنب مع إبداع الرجل، بوصفها تجربة تؤسس لواقع إنساني يوسع من مناطق ومجالات التفكير.
2-علاقة ما بعد الحداثة بالأدب النسوي في الفكر العربي المعاصر:
لا شك أن عامل المثاقفة يلعب دورا بارزا في تطور مجالات المعرفة المتنوعة، باعتبارها النواة الأساسية التي من جرائها تتحرر الأمم من تخلفها وجهلها، وتساهم في مد جسور الحوار، والانفتاح على الآخر، ويمكن رصد هذه التحولات عن طريق إفراز أعمال ذي مضامين جديدة، يتم بموجبها التخلص من التقاليد البالية والعادات الراسخة والهويات الجامدة؛ وتدخلها ضمن روح الحضارة الإنسانية بمظاهرها المعرفية والثقافية، أو المعنوية والمادية، وعلى ضوء هذا، فإن الملامح الحاسمة لظهور فكر ما بعد الحداثة، يعود في الأصل إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه(Nietzche)، حينما قلب موازين الفكر الفلسفي رأسا على عقب، متجاوزا الطرح الإبستمولوجي الكلاسيكي للحداثة، وبهذا التصور الجديد الذي ينظر للمعرفة من وجهة نظر مختلفة، ساهم في إنتاج ثقافة مغايرة، أفضت إلى تشكيل انعطافة حقيقية، داخل النظم المعرفية السائدة، وأضحت في الوقت ذاته علامة فارقة في تاريخ الثقافة الأوربية، ومن هنا ” فقد شهدت فلسفة نيتشه، إعادة بعث وتنشيط، خصوصا في الفكر الفلسفي المعاصر، الذي عمل على هدم وتقويض مجمل طوباويات الأنوار، ومشاريع الحداثة بعناوينها المختلفة: كالعقلانية، التقدم، التنوير، وهو ما جعل منها أرضا معرفية خصبة للدرس والتحليل، أو المساءلة والتشخيص “[10] وقد مثل هذا التوجه سمة بارزة في الكتابة النسوية الجزائرية المعاصرة، فأضحت أفكارا لها قابلية التنزيل على أرض الواقع، عبر قراءة منتجة تتميز بطابعها السجالي في ساحة الثقافة العربية، ولا شك في أن هذا الانتقال يؤسس لوعي أنثوي يساهم في تحديث الفكر نحو الأشياء والمواقف والذوات، وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول ” أصبحت الجينيالوجيا المعاصرة، جينيالوجيا الأفكار والقيم والمذاهب والتيارات الفكرية، لا تكتفي أثناء دراستها للخطاب وتفكيكها إياه، بالنفاذ إلى مضامينه ومعانيه، بل تتجاوز ذلك، إلى محاولة القبض على شروط وجوده على ما هو عليه، أي على ما يكمن وراء إنتاجه من حوافز وملابسات وظروف خاصة… وشروط خارجية سواء نظر إلى تلك الشروط الخارجية على أنها بنية اجتماعية واقتصادية وتاريخية، أو على أنها تجليات للاشعور نفسي تعبر عن دوافع غريزية…”[11] كما لا يمكننا في هذا السياق أن نغفل عن الدور الذي اضطلعت به فلسفة الاختلاف في توجيه الفكر الغربي، وقد كشف عن هذا التصور الأساسي في إطاره العام الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا j.Derrida))، ، وقد كان لهذه الأفكار بالغ الأثر في الحركة الأدبية النسوية في الجزائر، حيث أفادت هذه الأخيرة بشكل كبير، من النقد التفكيكي الدريدي في سياق نقده للميتافيزيقا الغربية المبني على تلك الثنائيات الضدية التي تعلي من الأول وتمنحه الأفضلية على حساب الثاني، مثل: خير/شر، ذكر/أنثى، حضور/غياب… وهذه ” الأقطاب المتضادة لا تقف ككيانات متساوية ومستقلة ولكن ينظر دائما إلى الكلمة الثانية في كل زوج من هذه النقائض على أنها سلبية وفاسدة وأنها غير مرغوب فيها وذلك بوصفها انحدارا وسقوطا من الكلمة الأولى “[12] وانطلاقا من هذا النص الذي بين أيدينا، يؤكد هذه الفكرة الجوهرية في عموميتها بشكل فاعل، ويتجلى في انعكاس تلك العلاقة الحميمية بينهما، التي ولدت اهتماما متزايدا إلى درجة شكلت دافعا وحافزا أساسيا لأن تخوض الكتابة النسوية معتركا جديدا في المجال التداولي الأدبي المعاصر، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ورافق هذا الانقلاب نبذ ورفض كل أشكال القهر والظلم المنبثقة عن التصورات السابقة بأبعادها التداولية، لتتعرف أخيرا على ذاتها عبر ولوجها عالم التجريب من أوسع أبوابه، والتي أخذت في إطارها العام كرؤيا للعالم، تؤصل للوعي الأنثوي، بغية اجتثاث النظرة التجزيئية، والقضاء على المقولات ذات المضامين الاختزالية، والدخول ضمن التركيبة التكاملية التي تؤسس لوعي حضاري متوازن، يتماشى مع الأطر المنهجية العملية، والتي تلامس كافة المجالات المعرفية المتنوعة.
وداخل هذا السياق، نستطيع القول ” إن إسهامات فلاسفة الاختلاف والتي أثرت وأنعشت الفكر النسوي الما بعد حداثي، ركزت على مفهوم الاختلاف بين الجنسين، فبفضل العمل الجبار الذي بدأه نيتشه في مجال مجاوزة الميتافيزيقا، والذي واصله فيما بعد هايدغر ودولوز ودريدا…لذا كان حري أن يحدث انجذابا بين ما بعد النسوية وفلاسفة ما بعد الحداثة، باعتبارهم يتشاركن نفس القضايا، فاتخذت النسوية من فلاسفة الاختلاف مرجعية فكرية ونظرية للتفكير في واقع المرأة، وإشكالية الهوية من خلال الاختلاف الجنسي “[13].
وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الكتابة النسوية الجزائرية اليوم لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات والتطورات التي لامست دوائر المشهد الثقافي المعاصر، وجاء هذا الرفض أصلا لاعتبارات جوهرية، وكرؤيا أنطولوجية متجاوزة للفكر الذكوري اللامتناهي، هدفها هدم ميتافيزيقا الحضور التي يتمتع بها الطرف الأول /الرجل وتجلياتها في المتخيل السوسيو-ثقافي، الأمر الذي استدعى قلب معادلة التفكير الأحادي ذي النظام المغلق، وبناء استراتيجية تنزع نحو التعدد والاختلاف، وقد أثارت تلك المرجعيات أفكارا جريئة، تحولت فيه المرأة من موضوع تتداوله الأقلام الرجالية إلى امرأة تشهر قلمها لتكتب عن نفسها بكل حيوية ونشاط برؤى متباينة إذا قورنت بمثيلاتها من الكتابات الرجالية، من حيث تناولها ومعالجتها لقضايا المرأة الجزائرية والعربية معا بدون استثناء.
وقد أثمر هذا الانفتاح بشكل أو بآخر إلى إفراز أشكال تعبيرية جديدة متمردة، سمحت في أساسها ” تفكيك وهدم النظام الأبوي البطريكي، والسعي وراء تغيير صورة المرأة “[14] كمنطلق أساسي تمارس فيه الذات حريتها، من أجل أن توصل صوتها للآخر، أمثال: أحلام مستغانمي، جميلة زنير، فضيلة فاروق، جميلة طلباوي، ربيعة جلطي، فاطمة العقون، وعائشة بنور، وزينب الأعوج وغيرهم.
3- تجليات ما بعد الحداثة في السرد النسوي الجزائري المعاصر:
- أفق الكتابة وانبثاق الهامش/مفارقة الاسم:
تراهن الرواية الحديثة في تشكيل عوالم موضوعاتها انطلاقا من توظيف بعض التقنيات التي تؤثث معمارها وبناءها، وبنسب متفاوتة بين المبدعين والكتاب، ومن هنا، يمكن عد تقنية المفارقة إحدى التقنيات الفنية البارزة في الكتابة المعاصرة، ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الكاتبة جميلة زنير من خلال روايتها الموسومة بـ : (أصابع الاتهام) وجدت في ( المفارقة) الملاذ الحقيقي للبوح فيه عن تطلعات المرأة الجزائرية التي لطالما ما أعرض عنها المجتمع ونأى بجانبه إزاءها، بكسر حاجز الممنوع والطابو، وهو ما شكل في كليته العمل الإبداعي حقلا لتوجيه انتقادات شديدة ولاذعة لنظم المجتمعات القائمة على السلطة البطريكية الأبوية، وفي هذا الشأن تستهل الكاتبة روايتها بما يلي ” يكفيك أن تلفظ اسمها عند مدخل البلدة لتتجه أصابع الاتهام نحوها ” زيزي ” الاسم المصغر لـ ” زينة ” إن أي أحد لم يدللها ولكن صغر الاسم لتحقيرها والتصغير من شأنها وحسب، يراها الناس كأرنب مذعورة تقطع الدرب الطويل، طريقها الوحيد بين البيت والمدرسة حيث تعمل، فلا يحييها أحد ولا يكلمها أحد ومن يكلمها وهي المتهمة قبل أن تأثم؟ المذنبة قبل أن تخطئ..”[15] ويبدو واضحا أن هذا التصور يأتي في سياق نقدي يتعارض مع الرؤية الحالية، حيث نشتم من وراء المقطع السردي هجوما عنيفا، عملت الكتابة على طرقه كموقف ورؤيا للعالم، من أجل موضعته داخل النسق الثقافي كموضوع قابل للمراجعة الحضارية، وحركة احتجاجية مضادة، بتمرد الأنا عن كل أنماط التفكير السائد، وأنساقه التعبيرية عن طريق القبض على الدلالات والمعاني أو البنى المترسبة، التي تمارس على الوعي فعل الاستبداد، تستجيب لمقتضيات إيديولوجية تأخذ في جوهرها حكم قيمة، قوامها الدونية والاستصغار، على اعتبار أن ” مفارقة الموقف تميل إلى أن تكون ذات صفة أكثر سخرية أو مأساوية أو فلسفية “[16] وتجلت هذه الصورة عبر التساؤل الذي يعكس الملامح المأساوية للذات الساردة، ويظهر ذلك بجلاء عن طريق الاتهام الذي يمارسه المجتمع الذكوري، وهو خطاب تراه الكاتبة خطابا تحريضيا، طوق من حركية المرأة، وعمل على تشويه صورتها، وزعزعة كيانها، إلى درجة فقدت فيه الشعور بالانتماء لهذا المجتمع، الذي ظل يضطهدها أينما حلت وارتحلت، والشاهد على ذلك قولها ” رمقته بعينين كسيرتين تغالب دمعها ما استطاعت: لم فعلت بي هذا؟ لم حطمتني؟ اتخذ وجهه هيئة الصرامة والوجاهة: أنا أعرفك جيدا، فلا داعي للتمثيل. لملمت شتات عزيمتها وقد اشتعلت غضبا: ماذا تعرف عني؟ لا داعي للنبش في القبور إني أخشى فضحك. بل قل ما تعرفه؟ رمقها بنظرة ازدراء واستخفاف وقال: عرفت أنك وضعت لقيطا، وأن أباك خان الوطن وأن أمك تخلت عنك وهربت مع عشيقها “[17] .
وعود على بدء، صحيح أن المعنى الظاهر للنص الذي ذكرناه آنفا يعالج قضية واقعية، فلقب “زيزي” من حيث الشحنة الدلالية يقزم من قيمة الشخص، ويجعل منه ذاتا ليست جديرة بالاهتمام والتقدير، بل يذهب إلى أبعد من ذلك حينما يصبح هذا اللقب مدعاة للنظرة الدونية الهابطة من على سلم الترتيب الاجتماعي، ولكن إذا ما أمعنا النظر تراءى لنا المعنى الخفي والمستور، الذي يقع في موضع التنافر، ويتجلى ذلك من خلال كسر أفق التوقع للقارئ، الناجم عن تحطيم المعيار السائد، فتغدو التسمية هنا كآلية ناجعة في إنتاجية المعنى، وكملفوظ مفجر للخطاب، إذ يولد حالة من حالات صراع الذات مع الآخر/ الرجل، وهو ما يحيلنا في المقام الأول إلى نقيض الدلالة المتوخاة من النص، لهذا جاء التوظيف من كونه وسيلة للمواجهة أمام الأفكار والتصورات والممارسات والأحكام المسبقة التي تنتظم في إطارها الأشياء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إدخال العقل في مناطق جديدة، بالاحتكام إلى بنية التوازي من خلال ترقية الوضع الإنساني.
وهكذا فالروائية تعمل على استنطاق الأعراف والتقاليد البالية التي تحدد أشكال الوعي كبنية تحتية تشتغل بطريقة لا مرئية، إذ تلقى رواجا تحت مظلة التسليم والانقياد والتبعية “وهي تتشكل حسب فوكو من شبكة مفهومية تؤسس ما يسميه بالأوليات التاريخية A prioi historique أو الشروط القبلية “[18] ولكن ما يلفت انتباهنا في هذه المفارقة أيضا بوصفها شكلا من أشكال القول الخاضعة لحركية القراءة، التي تنفتح على أفق دلالي مغاير، يعمل على جذب المتلقي؛ بهدف التنقيب عن بؤر التوتر المبثوثة في ثنايا المجتمع والتي تتجاذبه نزعتان متضادتان، تمكن القارئ من رؤية المجتمع كلمة زينة، حيث أن هذه الأخيرة بمعناها الواسع توحي إلى كل أشكال الجمال والكمال، والحسن والإعجاب، حتى النفس تهفو إليه وتكون في حالة تطلع واشتياق لرؤية صاحبه، لذلك بمجرد سماع هذه الحروف المتكونة من أربعة حروف ( زينة)، تقرع الآذان قرعا، وتهز الوجدان هزا، فاسم زينة يصرف الذهن من أول وهلة إلى تلك الفتاة المدللة التي تحظى بمكانة سامية وسط عائلتها تصل إلى درجة العيش الكريم بمعانيه الحقيقية، والكاتبة في هذا الموضع تصور لنا حياة الفتاة زينة بطريقة مقلوبة تنم عن تلك الأوضاع البائسة التي تعيشها، والأزمات الخانقة التي تمر بها، نتيجة فقدانها لأبويها، مما تسبب لها بشكل أو بآخر إلى توجيه أصابع الاتهام لها كونها وحيدة في هذا الوجود، حيث تقول ” وحدها في الدنيا بلا أهل ولا سند..وحيدة على درب الحياة الموحش..لا أحد يخرجها من الدوامة التي تغوص فيها، لقد ودعت عالم الأحياء وصارت تسبح بأفكارها في عالم سكانه أطياف رحماء كخالتها”[19] فيكون التشظي على هذا النحو يشكل محورا أساسيا في الخطاب مشحونا بدلالات القهر والضياع والاغتراب والإحباط والتشرد والتمزق الذي لا تحده تضاريس الواقع.
وعلى هذا الأساس، جاءت المفارقة في قالب فني لكي تدحض الوظيفة التمييزية بين الرجل والأنثى لتضعها في إطار الإدانة بهدم تلك الهوة بينهما، تنكشف آثارها في جملة من الممارسات والمقاصد التي تحقق فعل الانسجام والتكامل والتطابق بين الاسم والمسمى أي بين الاسم والدلالة المتداولة بإفراغها من مضامينها البالية، ومحاولة تعميقها في الجسم الثقافي العام في شكله الإيجابي، عبر تفاعل ديالكتيكي متناغم، بإرفاق الجزء المهمش بالكل الذكوري، ليمتزجا في خط مستقيم واحد يطيح بالفوارق وينزلها من على العرش، وفي الوقت نفسه يغذي الإحساس بقيم العدل والمساواة، ويجنب صور التعسف والجور، وهذا من خلال تجسيد مشاعر الإنسانية في أسمى معانيها.
ب-التعالق النصي/ استدعاء الشخصيات الدينية:
أضحى استلهام المصادر التراثية يمثل سمة بارزة في أدبيات الخطاب الروائي ولاسيما الشخصيات الدينية، كوسيلة فنية تحمل في طياتها دلالات وطاقات إيحائية تتيح للكاتب رؤية الواقع الراهن، وذلك بما ينسجم مع مضمون تجربته وأبعاده المعاصرة، يتجاوز فيها الكاتب الأشكال التقليدية المتعارف عليها، وهو في الحقيقة استدعاء يشكل في جوهره محاكمة للعصر برصد مجمل تجلياته السلبية والإيجابية، في صورة فوتوغرافية حرفية، ومن هنا يمكن القول إن استدعاء الشخصيات ” لا تبقى أسيرة مرجعيتها التاريخية، بل تتصرف بالطريقة التي يمليها عليها السرد الروائي، ومنطق الأحداث. وهكذا، تتحول الشخصية التاريخية إلى شخصية روائية، وتخضع لمنطق جديد، يمليه عليها الخطاب الروائي.”[20].
وانطلاقا من هذه المعاينة، نجد الروائية فاطمة العقون قد استثمرت هذه التقنية في عملها الإبداعي الموسوم بـ ” عزيزة ” حيث عملت على استدعاء شخصية النبي سليمان عليه السلام بحركية تنأى عن المحاكاة المكرورة الجامدة التي لا حياة فيها، و هو ما يقع تحت مسمى التناص الحواري حسب محمد بنيس، بخروجها عن النسيج المألوف والمعهود في الخطاب، وبهذا المنطق الحداثي ” انهارت أسطورة الحلم الرومانسي التي كانت تصور النص على أنه خلق من عدم، وأصبح النص عبارة عن نسيج من نصوص سابقة، يقوم بامتصاصها وتحويلها، لذلك سيتركز الاهتمام على البحث في درجة التعالقات والتحويلات ووظيفتها، خاصة على صعيد إنتاج الدلالة “[21] ويتجلى ذلك في تلك الدينامية التي تشتغل في حقل الاقتباسات والإحالات والنقول التي تتقاطع وتتضافر فيما بينها، ويتعلق الأمر بصورة واضحة من خلال خرق وتفجير حرفية النص الغائب وماهيته، وانتهاك معانيه وصيغه وتراكيبه تحويرا وتغييرا في عملية جدلية متجاوزة تنفيانه عن مقاصده الأصلية في اللحظة الزمنية التاريخية التي كتب أو ظهر فيها، وفق رؤية جديدة تواكب روح العصر، من أجل تعريته والبوح عن المستور والمسكوت عنه، الذي ظل ردحا من الزمن تحت عباءة التعتيم، وهي الغاية التي يتطلع إليها كل مبدع من خلال عمله الأدبي.
ويمكن تلمس مظاهر هذا النوع ما جاء في معرض حديثها ” لقد شهدت موكب تلك الملكة السبئية بلقيس حين قطعت وأرباب دولتها الصحراء بطولها لتصل إلى سليمان راكعة وتقول إني آمنت برب سليمان.. كان منظرها يثير الشفقة مثلما يثير الإعجاب.. وبعد زيارتي لقصر الملك أبي المكارم تأكد لي أني كدت أغفل عن تعلم أحكم الدروس.. فلا شفقة على النساء، وعزيزة ليست بأحسن من بلقيس “[22]ولعل التساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المقطع السردي، كأني بالكاتبة تريد أن تقول بأن التاريخ يعيد نفسه من زاوية التداول الحضاري حول موضوعة المرأة، بتصوراته الشمولية الثابتة، والذي تخلق في رحم المركزية الذكورية، من خلال التعاطي الاستعلائي معها، فيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى شعورها دائما بالتهميش والضعف والعجز في إبراز شخصيتها، ومن التساؤل السابق تسعى الروائية جاهدة إلى مساءلة الحاضر من خلال الانفتاح على الماضي، سمته الأساسية قائمة على بنية صراعية، بدافع التغيير والتجديد، تقتضي في عمومها استهداف الوعي الثقافي في طرائق تعامله مع الآخر المختلف، ومن جهة يحيل إلى بعد آخر ويبرز بشكل جلي حينما تملك الأنا حيزا مركزيا، يقوض عناصر التراتب القيمي، وفق رؤية الذات لذاتها، ودورها الفاعل في الحياة، وعليه يتبين من خلال هذا الاشتغال الفني في ” أن السرد الروائي يتميز بأن الزمن فيه منفتح على الحاضر، أي أن الماضي يصبح ماضيا مستمرا. ويتحقق استمرار الماضي في الحاضر من خلال ربط الماضي بالحاضر، والحاضر بالماضي، في إطار علاقة جدلية تجمع بين الزمنين “[23] إلا أن طبيعة العلاقة في البناء السردي هنا ليست علاقة تابع بمتبوع، وإنما هو نوع من القفز على قيمه الجمالية والمضمونية، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك، طرائق تشكله ومستوياته التعبيرية المتباينة، ويتبدى هذا حينما يفقد فيها النص السابق بريقه على المستويين الدلالي والتداولي واللبنات الأساسية المشكلة لعوالمه، ومن هنا يتضح لنا الفرق بين النص اللاحق والسابق، وعلى هذا الصعيد، فالقصة القرآنية تتحدد غايتها الجوهرية حول قضية التوحيد، ولهذا فملك سليمان كان يحمل وظيفة دعوية لكل ملك يعرض عن عبادة الله، ويقدم على عبادة الأوثان، وهكذا كان الشأن مع بلقيس حين تخلت عن طقوس عبادة الشمس، وجاءت رفقة جندها مستجيبة لدعوته في كامل مظاهر الخضوع والتذلل معتنقة الإسلام، وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن طبيعة الاعتناق تحيل إلى قيمة الذات استنادا إلى بنية التحرر الداعية في عمومها لعناصر ومظاهر العبودية التي تندرج تحت لواء ونسق واحد، تتحدد غايته الإدراكية أو الذهنية من كونها عبودية لا تنبع من الداخل كمخيال تراتبي يخضع لأنماط التفكير الاجتماعي؛ ولكنها في الأصل تسطر من خلفية مفارقة للذات الإنسانية، بحيث ترتد إلى مصدر خارجي متعال ينبئ عن قصدية دلالته ” بما يتلاءم وظروف التخاطب. ولذلك لا يمكن معرفة الدلالة المقصودة إلا بإعادة النظر في شروط إنتاج الخطاب والإطلاع على العلة الخفية التي جعلت هذا الدال يرتبط بهذا المدلول “[24] أما الكاتبة فهي تعالج موضوعا يتعارض مع النص الديني من حيث المضمون، وتكمن خصوصية هذه المغايرة في كونها تعاين وضعا اجتماعيا، يتمثل أساسا في عملية بعث وإحياء، تبث في نفسية المرأة الحركية والنشاط، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تحقق بعدا سوسيولوجيا ذا منحى إيجابي، يضمن للطرفين التعايش أنطولوجيا، يضم في جنباته الاعتبارات المنطقية الموضوعية، وتأتي قيمة هذا الأمر وأهميته انطلاقا من التحرر من عقال التصورات المشروطة تحت مظلة التفاضل والتمايز، وهو بلا شك يطالعنا ” في شكل فلسفة اجتماعية، وسياسية، تحكمها منظومة أخلاقية تؤمن بالفوارق الطبيعية، وترى بأن ذلك جزء من الطبيعة “[25] والذي يكون فيه الطرف الثاني دائما سلبيا مهمشا يرزح تحت نير العبودية والخضوع للمركزية الذكورية، كما فعل تماما المنتصر بالله مع عزيزة، وهذا يندرج في تصورها تحت شعار العدالة الاجتماعية التي عجزت عن تحقيقه باسم الذكورة القائمة على مبدأ الأفضلية، هذه الأفضلية التي لا تزال ترى من خلالها سوى العزلة و المعاناة والضغوطات بشتى أشكالها وأنواعها.
ج- المحاكاة الساخرة/الباروديا:
لا تكتسب المحاكاة الساخرة أو الباروديا وفق تعبير باختين قيمتها من العناصر الفنية والخصائص الجمالية فحسب، بل كذلك من محتواها الأخلاقي، والاجتماعي، والثقافي، والنفسي… ويعني هذا أن المحاكاة الساخرة هي طريقة أسلوبية قائمة على إيراد أساليب الآخرين تضمينا وتناصا وحوارا، ومحاكاتها بطريقة ساخرة قوامها: التناقض، والتضاد، والسخرية، والكروستيك، والروح الكرنفالية[26] ويتمثل هذا بشكل واضح في شخصية المنتصر بالله وعزيزة عندما أقدم على تبديد أحلامها وأمانيها، وإزاحتها من طريقه، وصلت إلى درجة حرمانها من ممارسة عملها، وسلبها متعة الحياة التي كانت تطمح إليها منذ الصغر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من منظور الروائية، بل حين ننتقل إلى مستوى آخر من التهميش والنفي والإبعاد، ويتضح ذلك عندما أخفاها حتى على الظهور أمام العوام والمقربين، وإن ما يعطي لهذا الكلام مبرراته، اللهجة الساخرة التي تدفقت من على طرف لسان الكاتبة نفسها، والتي تحاول بواسطتها القبض على تجربة إنسانية تعاني الإحباط والتمزق والاغتراب العقلي، وفي هذا الشأن تقول ” قررت أن أرجع لحبي الأول، لحبي الوحيد، لعزيزتي، إلى الزمن الذي كان، علي أولا أن أتحرر منها، أن أكسر أنفها، يجب أن تكون امرأتي فقط ولا شيء آخر، كيف تجسر على عصياني عندما أمرتها بخلع ثيابها، أنا السيد ولا سيد غيري، هكذا سأحبها بكل حرية. ألغيت كل ما قامت به من إنجاز في عهدها، ونهرت وهددت بالقتل كل من يذكر اسمها أمامي، وأولهم ربيع الذي كثيرا ما شعرت بعاطفته الكبيرة نحوها، اشتممت فيها رائحة الحب الغادر، وحبستها داخل جناحها وحرمت عليها الخروج حتى إلى حديقة القصر، وقلت لها أني أغار عليك من عيون الحرس والخدم من الرجال الذين ينظرون إليك أكثر من اللازم فهل أطلب منهم إغماض أعينهم وهم يؤدون أعمالهم أم أحجبك عن كل الأنظار ولا يرى شؤونك من الخدم إلا النساء؟”[27] ولقد بات من الواضح أن نبرة الخطاب الساخر، تكشف جانبا مهما من خلال المعنى الطالع من النص الظاهر، وهذا تبعا للوضعية والحالة السيكولوجية للساردة، باعتبارها رؤيا وموقفا من الذات والعالم، مناهضة في الوقت ذاته للمعايير الثابتة للقيم المكرسة، بتبني منطق التفكيك والتشتيت واللايقين في الحقائق المطلقة، إضافة إلى تمجيد النظرة الاستقلالية في الحياة، ويبدو أن أحد الأسباب الأولى من هذه المحاكاة الساخرة محاكمة الإيديولوجيات، وهذا باختراق طبقاتها انطلاقا من ” تحريك أرضيتها الصلبة وتحويل موادها الفكرية ومعارفها الأصلية وهي تمهيد لمجاوزة نقدية تفتح الآفاق بقدر ما تجدد الأعماق وتبدد الأوهام بقدر ما تستأصل الأورام…وتشخيص جواني لنظم هذا الواقع ومؤسساته وآلياته “[28] وبهذا المعنى تهيئ الكاتبة نفسها لمحاربة النظرة الدونية التي استشرت في أوساط المجتمعات بفعل الخطابات التي تنتجها العادات والتقاليد التي تجعل من المرأة موضوعا ينظر إليه من خلال بعد واحد، وهي في تصورها رؤية تجزيئية تعمل ضمن مقتضيات التصوير المخل بالحقيقة التي يكرسها المعتقد الذكوري المتعالي، ومن أجل تحقيق ذلك المسعى، ترى أنه لابد من الارتباط بالتجربة الإنسانية في كليتها وشموليتها من حيث تناولها للموضوعات، حتى تعيد للحياة دفئها، وتحل محلها علاقات تستند إلى حذف مبدأ المسافة الهوياتي؛ بإلغاء ثوابته، وأدواره الفاعلة.
ولا شك أن هذا التصور يضع الزواج في معرض الذم والقدح؛ لأنه يذيب الطموح ويصفد الأماني، ويجعل لها حدودا وقيودا بسبب الأعراف والعادات والتقاليد المتوارثة، وليس أدل على هذا إلا قول الكاتبة في معرض حديثها عن الزواج بنبرة استخفافية ” لقد قررت بعدها أن أصبح امرأة.. ولأضحي بكل شيء في سبيل نيل هذا الهدف ولا أتعرض لكلام إخوتي الجارح، سأبرهن أني أقدر على الأنوثة منهن ويكفيني أني سأترك عالمي الحر لأصبح امرأة بقرار أصنعه بإرادتي الخالصة “[29] ويبدو واضحا من المقطع السردي أن العزوبية تشكل لديها ملمحا إيجابيا في أوساط المجتمعات العربية، كضرورة ملحة لممارسة الحرية في الأقوال والأفعال. لهذا فهي ترى في الطفولة الجوهر الضامن للحرية والانعتاق، والطفولة الحقيقية المقصودة هنا تتجاوز السن و العمر إلى الطفولة كعلامة فارقة بينها وبين الزواج، لتخلق واقعا آخر، وعالما مختلفا، يعبر بعمق عن تفاصيل الحياة، وتتجلى أهمية هذا الاختيار في روح احتجاجية تروم ” النبش في جينالوجيا الهوية والوجود، والعلائق مع المجتمع والآخر…واستطاعت أن تتغلغل إلى هذه المناطق المحرمة لتبرز التناقضات والمفارقات القائمة بين المعلن عنه المعتمد على اللغة الآمرة، والمسكوت عنه المهمش الضارب بجذوره في أعماق المعيش “[30]ويتحدد الفارق هنا في كون العزوبية التي أضحت مطية للازدراء والاحتقار في ظل منظومة قيم المجتمع العربي بمختلف عاداته وتقاليده، تحول لدى الكاتبة أداة تؤشر على بداية الحرية بمعناها الذي ارتضته، يكشف في جوهره عن أبعاد سيكولوجية، تخضع لحركة انفعالية تنعكس إيجابا على تحقيق الاستقرار النفسي، والقضاء على التوترات الاجتماعية، وفقا لمقتضى الصورة المرتسمة في كيانها، عن طريق استعادة تلك اللحظات المشرقة في حياتها، تجنبها نكبات الواقع وانتكاساته، تقول ” طفولتي فيها الحياة الرائعة، فيها الحرية..حتى الشمس الحارقة وقت القيلولة أحب اللعب تحتها في متعة كبيرة، ولا يهمني وهجها الذي يصبغ بشرة وجهي حمرة تجعلني كلما نظرت إليها وإلى بشرة أخواتي إلا وأحسست أنها تحمل اختلافي عنهن وأن هذه الشمس تعطيني نعمة ذلك الاختلاف حين أتذكر أنني صديقة حميمة لتلك الأشعة التي لا تهب صداقتها إلا للقليل ممن يشبهونها في انطلاقها عبر الفضاء الرحب. هل شرط أن أترك كل هذا لأكون امرأة؟ “[31].
وعليه فإن الصورة التي تطالعنا به هذه الرؤية؛ إنما نتجت عن مخاض ضارب في عمق التاريخ، من خلال الجدل والصراع الدائر عن سؤال الهوية، في حركيتها الثنائية بين الرجل والمرأة أو الذكورة والأنوثة، وهو سجال يؤهلها للانخراط في بوتقة التفاعل المفضي إلى منطق الحس المشترك، كرؤيا ناهضة ينجر عنها إزالة تلك الفوارق المبثوثة في كيان المجتمعات، واستنادا للمفارقة الدائرة بين الجنسين؛ جاءت الكتابة النسوية تمارس فعل المحو، ويتعلق الأمر نحو إعادة النظر في إنتاجية الخطاب الذكوري عبر صياغة فاعلة تخلق دلالات وإشارات تحقق الأنا مرادها في رسم صورة للواقع تتخطى المتخيل السابق.
وبناء على سبق، يمكننا الخروج بخلاصة عقب هذه الجولة أو الإطلالة التي كانت تدور حول موضوعة المرأة، أن هذه الرؤيا المتطلعة من قبلهن مكنت العديد من الباحثين العرب الالتفاف حولها، وتحديدا في الحقل الأدبي والنقدي، وتحت وقع هذا الإحساس الطافح بالعزيمة والإرادة؛ وجدت هذه الأفكار طريقها بأقلام جادة وجريئة، تمخض على أساسها كسر أقانيم مركزية الذكورة بأنساقها الثقافية السائدة، انطلاقا من طرق مواضيع جديدة فقست بيضة التجربة الإنسانية على ممارسات خطابية فاعلة،كانت في السابق تحمل سمات المحظور والممنوع، وفي ظل هذه الاعتبارات، حقق الأدب النسوي العربي بصفة عامة، والجزائري بصفة خاصة ضمن جنس الرواية، قفزة نوعية على نطاق واسع داخل المشهد الثقافي الأدبي العربي المعاصر، والتي تعد في سياقها العام مفصلا واضح المعالم بين نسقين متباينين على صعيد الشكل والمضمون.
قائمة المصادر والمراجع:
أ- المصادر:
1- جميلة زنير، أصابع الاتهام، موفم للنشر- الجزائر، 2008م.
2– فاطمة العقون، عزيزة، منشورات أرتيستيك، القبة- الجزائر، ط1، 2009م.
ب- المراجع:
1- الخالد كورنيليا:( الكفاح النسوي حتى الآن. لمحة عن النظريتين النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية). مجلة الطريق، بيروت، لبنان، العدد:2، السنة 1996م. نقلا عن جميل حمداوي، المرجع نفسه.
2- جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، ط1، 2015م، 25/05/2015 www.alukah.net
3- حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، وزارة الثقافة- دمشق، 1915م.
4- صالح مفقوده، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى للطباعة والنشر- الجزائر، ط1، 2003م
5- عبد القادر بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة ( قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة )، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2010م.
6- عبد المنعم عجب الفيا، في نقد التفكيك، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة-الجزائر، ط1، 2015م.
7- عبد الرزاق الدواي، فلسفة موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر- بيروت، 2000م.
8- عبد الجليل منقور، النص والتأويل ( دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي )، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية- بن عكنون الجزائر، 2010م.
9- عبد السلام حيمير، في سوسيولوجيا الخطاب ( من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل )، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2008م.
10- غادة السمان، القبيلة تستوجب القتيلة، منشورات غادة السمان– بيروت، 1981م.
11- محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سوريا، 2002م.
12- محمود طرشونة، نقد الرواية النسائية في تونس، مركز النشر الجامعي-تونس، ط1، 2004م.
13- مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة ( الذات- الوطن- الهوية)، الوراق للنشر والتوزيع، ط1، 2011م.
14- محمد شوقي الزين، إزاحات فكرية ( مقاربات في الحداثة والمثقف )، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة-الجزائر، ط1، 2008م.
15- محمد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، دار الصدى، دبي، الإصدار 49 مايو، ط1، 2011م.
16- محمد بوعزة، استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2001م.
17- نبيل محمد صغير وليندا كدير، إشكالية الهوية والمساواة في ما بعد النسوية، ضمن مؤلف جماعي (خطابات ال ” ما بعد” في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية)، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2013م.
18- يمنى العيد، الرواية العربية (المتخيل وبنيته الفنية)، دار الفارابي، بيروت- لبنان، ط1، 2011م.
19- يوسف وغليسي، خطاب التأنيث ( دراسة في الشعر النسوي الجزائري )، جسور للنشر والتوزيع- الجزائر، ط1،2013م.
[1]– يمنى العيد، الرواية العربية (المتخيل وبنيته الفنية)، دار الفارابي، بيروت- لبنان، ط1، 2011م، ص 137.
[2] – غادة السمان، القبيلة تستوجب القتيلة، منشورات غادة السمان– بيروت، 1981م، ص 317
[3]– يوسف وغليسي، خطاب التأنيث ( دراسة في الشعر النسوي الجزائري )، جسور للنشر والتوزيع- الجزائر، ط1،2013م، ص 31.
[4]– يوسف وغليسي، المرجع نفسه، ص 34.
[5] – صالح مفقوده، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى للطباعة والنشر- الجزائر، ط1، 2003م.ص 16.
[6]– محمود طرشونة، نقد الرواية النسائية في تونس، مركز النشر الجامعي-تونس، ط1، 2004م، ص 5.
[7]– الخالد كورنيليا:( الكفاح النسوي حتى الآن. لمحة عن النظريتين النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية). مجلة الطريق، بيروت، لبنان، العدد:2، السنة 1996م. نقلا عن جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ص 157.
[8] – حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، وزارة الثقافة- دمشق، 1915م، ص 79.
[9] – جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، ط1، 2015م، ص 158. 25/05/2015 www.alukah.net.
[10]– عبد القادر بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة ( قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة )، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2010م، ص 13.
[11] – عبد السلام حيمير، في سوسيولوجيا الخطاب ( من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل )، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2008م، ص 240.
[12] – عبد المنعم عجب الفيا، في نقد التفكيك، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة-الجزائر، ط1، 2015م، ص 84.
[13] – نبيل محمد صغير وليندا كدير، إشكالية الهوية والمساواة في ما بعد النسوية، ضمن مؤلف جماعي (خطابات ال ” ما بعد” في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية)، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2013م، ص 275.
[14] – المرجع نفسه، ص 264.
[15] – جميلة زنير، أصابع الاتهام، موفم للنشر- الجزائر، 2008م، ص 7.
[16] – مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة ( الذات- الوطن- الهوية)، الوراق للنشر والتوزيع، ط1، 2011م، ص 162.
[17]– جميلة زنير، الرواية نفسها، ص 78-79.
[18]– عبد الرزاق الدواي، فلسفة موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر- بيروت، 2000م، ص 144
[19] – جميلة زنير، الرواية نفسها، ص 8.
[20] – محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سوريا، 2002م، ص 105.
[21] – محمد بوعزة، استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة- الجزائر، ط1، 2001م، ص 35.
[22] – فاطمة العقون، عزيزة، منشورات أرتيستيك، القبة- الجزائر، ط1، 2009م، ص 27.
[23]– محمد رياض وتار، المرجع نفسه، ص 110.
[24] – عبد الجليل منقور، النص والتأويل ( دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي )، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية- بن عكنون الجزائر، 2010م، ص 36.
[25] – عبد الرزاق بلعقروز، المرجع نفسه، ص 41.
[26]– ينظر،جميل حمداوي، المرجع نفسه، ص 211.
[27] – فاطمة العقون، عزيزة، الرواية نفسها، ص 111.
[28] – محمد شوقي الزين، إزاحات فكرية ( مقاربات في الحداثة والمثقف )، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة-الجزائر، ط1، 2008م، ص 12.
[29] – فاطمة العقون، عزيزة، الرواية نفسها، ص 34.
[30] – محمد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، دار الصدى، دبي، الإصدار 49 مايو، ط1، 2011م، ص 37-57.
[31] – فاطمة العقون، عزيزة، الرواية نفسها، ص 34.