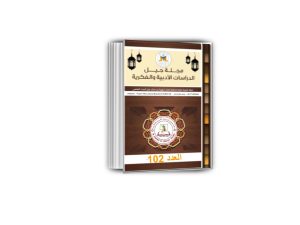ابن رشد ونظرية وجوب الفلسفة: مقاربة نقدية
Ibn Rushd and the Theory of the Philosophy Necessity: A Critical Approach
د. رواء محمود حسين، الولايات المتحدة الأمريكية Dr. Rawaa Mahmoud Hussain ـ USA
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد 53 الصفحة 9.
ملخص البحث
يعد البحث مقاربة نقدية لأفكار واحد من أشهر الفلاسفة الذي عرفهم تاريخ الفلسفة، لا بل تاريخ الحضارة الإنسانية، إنه الفيلسوف المسلم أبو الوليد ابن رشد، والذي يعد من أبرز المدافعين عن الفلسفة ومنهجها في الحضارة الإسلامية. يهدف البحث إلى إجراء حوار عقلاني، منطقي، نقدي مع ابن رشد، وتقديم مراجعة نقدية جديدة للمنهج الرشدي، خصوصاً في كتاب ابن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، من أجل الوقوف على الإشكال في الكتاب المذكور. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فقد ناقشنا ابن رشد في مسائل عدة، منها: هل الفلسفة واجبة شرعاً (كما يظن ابن رشد)، معرفة الله عن طريق الفلسفة، في النظر البرهاني: هل تتوافق الشريعة مع الفلسفة، منهج التوفيق بين الحكمة والشريعة، والنظر البرهاني: في الخطابي والجدلي والبرهاني.
الكلمات المفتاحية: ابن رشد، الفلسفة الإسلامية، الحكمة، الشريعة، نظرية المعرفة، المنهج.
Abstract:
The research is a critical dialogue with one of the most famous philosophers in the history of philosophy, and indeed the history of human civilization, the Muslim philosopher Abu Al-Walid Ibn Rushd, who is one of the most promin-ent defenders of philosophy and its methodology in Islamic civilization. The research aims to make a rational, logical and critical dialogue with Ibn Rushd on his curriculum in understating philosophy, especially in Ibn Rushd’s book, “Fasl Al-Maqal”, in order to identify the nature of the systematic dilemma in the book Mentioned. To achieve this, we have discussed Ibn Rushd on several issues, including: Is philosophy in Islam legally obligatory (as Ibn Rushd thinks), Knowing God through philosophy, (Al-Nadhar Al-Burhani), Does Sharia comply with philosophy, the method of reconciling wisdom and Sahria, and other issues.
Keywords: Ibn Rushd, Islamic Philosophy, Wisdom, Sharia, Theory of Knowledge, Method.
إشكالية البحث:
دخلت الفلسفة الحضارة الإسلامية منذ وقت مبكر وتسبب بردة فعل عنيفة، وأنتجت مواقف تباينت في الحدة وشمولية الطرح والنقد عقلانياً كان أم لا؟ في هذا البحث نقدم مراجعة نقدية لإشكالية تصور ابن رشد بوجوب البحث الفلسفي، وهو ما أسميناه (نظرية وجوب الفلسفة عند ابن رشد). ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فقد ناقشنا ابن رشد في مسائل عدة، منها: هل الفلسفة واجبة شرعاً (كما يظن ابن رشد)، معرفة الله عن طريق الفلسفة، في النظر البرهاني: هل تتوافق الشريعة مع الفلسفة، منهج التوفيق بين الحكمة والشريعة، والنظر البرهاني: في الخطابي والجدلي والبرهاني.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في تصورنا في أنه يعيد قراءة المشروع الرشدي برمته من خلال تقديم مقاربة نقدية جديدة لطبيعة الفلسفة الرشدية، ومحاولتها فهم الحكمة الواردة في الشريعة على أنها هي عينها الفلسفة اليونانية، وبالأخص الفلسفة الأرسطية. إن أهمية البحث تكمن في أنه يشتغل على تفكيك العلاقة بين المفهومين الحكمة والفلسفة، من خلال تقديم المفهوم الدقيق لكلا المصطلحين.
هدف البحث:
ولذلك، فالهدف الرئيس للبحث تبيان أن هناك فرقاً كبيراَ بين الحكمة والفلسفة، فالحكمة الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية شيء، ومفهوم الفلسفة الذي يريد ابن رشد أن يجعله في مصاف الحكمة شيء آخر.
خطة البحث: ومن أجل تحقيق الغاية التي يسعى إليها البحث فقد تم توزيعه إلى مبحثين، الأول بعنوان: “في الحكمة والفلسفة والشريعة: مقاربات مفهومية واصطلاحية”، والمبحث الثاني بعنوان: “نظرية وجوب الفلسفة(أو) مشروعية النظر الفلسفي”. وتضمن البحث مناقشات، مثل: هل الفلسفة واجبة شرعاً (كما يظن ابن رشد)، معرفة الله عن طريق الفلسفة، في النظر البرهاني: في معنى الحكمة لغوياً وشرعياً ورشدياً، هل تتوافق الشريعة مع الفلسفة، منهج التوفيق بين الحكمة والشريعة، والنظر البرهاني: في الخطابي والجدلي والبرهاني.
المبحث الأول: في الحكمة والفلسفة والشريعة مقاربات مفهومية واصطلاحية
في معنى الحكمة لغوياً:
الحكمة في اللغة كما يبين الرازي من العلم، و(الحكيم) العالم وصاحب الحكمة. والحكيم أيضاً المتقن للأمور. [1]
ويذكر ابن منظور أن الحَكَمَةُ حديدة في اللجام الذي يوضع على حنك الفرس وأنفه وذلك من أجل منع الفرس عن أن يخالف الراكب الذي يقوده. ولأن الحَكَمَةُ توضع على فم الفرس وبسبب اتصال الحنك برأس الدابة فهي تمنع من وضعت في رأسه بالطريقة ذاتها التي تمنع الحكمة الدابة. وحَكَمَ الفرس حَكَماً، وأحكَمهَ بالحَكَمَة: أي وضع الحَكَمَةُ على لجامه. [2]
وبهذا نفهم أن الحِكمة تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها الحَكَمَةُ في الفرس بأنها تمنع الإنسان من التهور وتدفعه إلى الانضباط بالطريقة ذاتها التي تفعلها الحَكَمَةُ في الفرس.
ويبين الجوهري أن الحَكيم معناه: المتقِن للأمور، وأيضاً من معاني الحَكيمُ: العالم، وصاحب الحكمة. [3]
الحكمة في الاصطلاح الشرعي:
يبين الطبري أـن من معاني “الحكمة” هي: القرآن والفقه به.[4]
ويذكر القرطبي أن أصل الحكمة ما يحول بين الإنسان من وبين أن يكون سفيهاً، ولذلك وضف العلم بأنه حكمة، لأنه يمنع السفاهة وكل فعل قبيح، ومثل ذلك القرآن والفهم والعقل. وي الحديث الصحيح: “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين”، وقال في القرآن: {يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ}، وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناءاً بها، وتنبيهاً على شرفها وفضلها، ويقال: إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين. قوله تعالى: {يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ } أي يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة، وقال ابن عباس: “هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره”. فقال السدي: “هي النبوة”. وقال قتادة ومجاهد: “الحكمة هي الفقه في القرآن”. وقال مجاهد: “الإصابة في القول والفعل”. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: “الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له”. وقال أيضاً: “الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به”. وقال الربيع بن أنس: “الحكمة الخشية”. وقال ابن زيد: “الحكمة العقل في الدين”. وقال مالك بن أنس: “الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له”. وقال إبراهيم النخعي: “الحكمة الفهم في القرآن”، وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: “الحكمة الورع”. يقول القرطبي: “وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض، للحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة”.[5]
وفي الآونة الأخيرة ظهرت محاولة جديدة لتحديد مفهوم الحكمة الإسلامية، انطلاقاً من المعنى الدقيق في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستناداً إلى الرؤية العامة للفكر الإسلامي، وتمت محاولة صياغتها بطريقة علمية، ووضعت الأسس والضوابط المنهجية لها.
وعلى هذا الأساس تم تحديد مفهوم (علم الحكمة الإسلامية) بأن هذا العلم يدعو إلى عبودية الله سبحانه، وتوحيده، والاخلاص له جل شأنه، وترك عبادة ما سواه. ويدعو هذا العلم إلى الايمان بالله سبحانه، والحذر والبعد من الطاغوت (الشيطان المريد) ومن هو في منضو جماعته وحزبه.ويعدهذا العلم القران الكريم بالفرقان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصادر الأساس له، كما يدعو إلى الايمان بالأنبياء واتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا العلم أن هذا هو المفهوم الحق للصراط المستقيم، وهو الذي يهدي الانسان إلى الحق والخير والقيم والجمال والعدل في هذه الحياة الدنيا، وينجيه في الآخرة، إذا بعث الناس ليوم عظيم ومن ثم فهو يعيد تهيئة الانسان ويدفعه باتجاه الاستعداد ليوم المعاد، ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى.[6]
ولعل من أهداف هذا العلم أن يكون بديلاً إسلامياً خالصاً عن الفلسفة التي أنتجها العقل الانساني غير المتبع للكتاب ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ينضم إلى باقي العلوم الاسلامية الأخرى من التفسير والحديث والفقه والاصول واللغة والتاريخ وغيرها. وأن يقيم الحجة على العقل الانساني، محتجاً بحجية الكتاب والسنة.[7]
مفهوم الحكمة عند ابن رشد:
يتضح من خلال فحص كتاب “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال” أن مراد ابن رشد بالحكمة هو الفلسفة، فيبين، وهو يتحدث عمن منع النظر في كتب الفلسفة بحجة أنها تشمل على ضرر من الممكن أن يصيب الإنسان في عقله، قائلاً ما نصه: ” بل نقول إن مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها، من اجل أن قوماً من أراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها، مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من العطش، لأن قوماً شرقوا به فماتوا. فإن الموت عن الماء بالشرق أمر عارض، وعن العطش أمر ذاتي وضروري”،[8] وهذا يعني أن مفهوم الحكمة والفلسفة عند ابن رشد واحد.
هل الفلسفة واجبة شرعاً؟
تراوحت المواقف الإسلامية من الفلسفة بين القبول والرفض، وكانت الفلسفة اليونانية التي دخلت الحضارة الإسلامية منذ وقت مبكر من أكثر منتجات الحضارة الإنسانية التي كثر الجدل حولها داخل الحاضرة الإسلامية بشكل عام، وفي أوساط العلماء والنخبة الإسلامية المثقفة بشكل خاص. [9]
يتساءل ابن رشد، من وجهة النظر الشرعية، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم مأمور به، إما على جهة الندب، وإما على جهة الوجوب.فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به، فذلك بين في غير ما آية من كتاب الله، تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّـهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾} (الأعراف: 185)، وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات، ومثل قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾} (الحشر: 2)، وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي والشرعي معاً.وممن خصه الله تعالى بهذا العلم وشرفه به، إبراهيم عليه السلام. فقال تعالى: {وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾} (الأنعام: 75).. فإن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أي من جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم، وكأن الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات، وحث على ذلك.فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم أما واجب بالشرع، واما مندوب اليه.[10]
أخذت الطبيعة حيزاً كبيراً في نقاشات الفلاسفة، ومثلت الفلسفة الطبيعية أحد أبرز علوم الفلسفة. ومن جملة ذلك رد أبو بكر الرازي على من زعم أن ارسطو طاليس ومَن فّسر كتبه في المقالة الثانية من السماع الطبيعي أنّ الطبيعة لا تحتاج دليل لظهورها. فقد زعم عدد من الفلاسفة أنّ الدليل على وجودها أفعالُها وقواها المنبثَّة في العالم الموجِبة للأفعال. كذهاب النار والهواء من المركز وذهاب الماء والأرض إليه، فيُعلم أنه لولا قُوى فيها أوجبت تلك الحركات وكانت مبدأ لها توجد فيها. وكذلك قالوا فيما يوجد في النبات والحيوان من قوة الغذاء وقوة النموّ فأما قولهم انهم لم يدلوا على وجود الطبيعة لإقرار الناس بها، فالشيء لا يصحّ لإقرار الناس به كما لا يفسد لاختلافهم فيه. ولو كان حقّاً لإقرار مَن أقرّ به لكان فاسداً باطلاً لامتناع مَن امتنع منه، فيكون الشيء فاسداً صحيحاً في حالٍ وباطلًا حقاً في حال وهذا محالٌ. ويقال لهم لِمَ زعمتم أنّ الطبيعة لا تحتاج إلى دليل وقد خالفكم في وجودها قوم من الفلاسفة القدماء وما رأيتم إن قال خصماؤكم انهم لا يحتاجون على قولهم انه لا طبيعة إلى دليل؟ وإنما لا تحتاج إلى دليل الأشياءُ المشاهَدة وأوائل البرهان العقليّة وليس الطبيعة بمحسوسة ولا العلم بها أوّل في العقل.[11]
وبالنسبة لماهية الموجودات، يرى ابن رشد أن تلازم الحركة والزمان صحيح. وأن الزمان شيء يفعله الذهن في الحركة. لكن الحركة ليست تبطل، ولا الزمان. لأنه لا يمتنع وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة. ولا بد أن يقترن الحادث بموضوع يقبل وجود الحادث، ويرتفع عند العدم، كما هو الحال في سائر الأضداد. [12]
لكن رأي ابن رشد في أن الفلسفة واجبة بالشرع لا ينسجم مع الاتجاه العام عند الفقهاء المسلمين في نقد المنهج الفلسفي، لا بل وتحريم الاشتغال بالفلسفة.
فقد ذهب ابن الصلاح أن الفلسفة مادة الْحيرَة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، وَمن تفلسف عميت بصيرته عَن محَاسِن الشَّرِيعَة المؤيدة بالحجج الظَّاهِرَة والبراهين الباهرة، وَمن تلبس بهَا تَعْلِيماً وتعلماً قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عَلَيْهِ الشَّيْطَان، وَأي فن أخزى من فن يعمي صَاحبه أظلم قلبه عَن نبوة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مَعَ انتشار آيَاته المستبينة ومعجزاته. أما الْمنطق فَهُوَ مدْخل الفلسفة ومدخل الشَّرّ شَرّ وَلَيْسَ الِاشْتِغَال بتعليمه وتعلمه مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّارِع وَلَا استباحه أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين وَالسَّلَف الصَّالِحين وَسَائِر من يَقْتَدِي بِهِ من أَعْلَام المسلمين. [13]
وذهب ابن الصلاح أن اسْتِعْمَال الاصطلاحات المنطقية فِي مبَاحث الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْمُنْكَرَات المستبشعة والأمور المستحدثة وَلَيْسَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة، فالافتقار إِلَى الْمنطق أصلاً وَمَا يزعمه المنطقي للمنطق من أَمر الْحَد والبرهان قد أغْنى الله عَنْهَا بِالطَّرِيقِ الأقوم والسبيل الأسلم، وَلَقَد تمت الشَّرِيعَة وعلومها وخاض فِي بحار الْحَقَائِق والدقائق علماؤها حَيْثُ لَا منطق وَلَا فلسفة وَلَا فلاسفة. وَمن زعم أَنه يشْتَغل مَعَ نَفسه بالْمَنْطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشَّيْطَان ومكر بِهِ، فَالْوَاجِب على السُّلْطَان أعزه الله وأعز بِهِ الْإِسْلَام وَأَهله أَن يدْفع عَن المسلمين شَرّ هَؤُلَاءِ المشائيم ويخرجهم من الْمدَارِس ويبعدهم ويعاقب على الِاشْتِغَال بفنهم ويعرض من ظهر مِنْهُ اعْتِقَاد عقائد الفلاسفة على السَّيْف أَو الاسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم يسر الله ذَلِك وعجله وَمن أوجب هَذَا الْوَاجِب عزل من كَانَ مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فِيهَا والإقراء لَهَا ثمَّ سجنه وإلزامه. [14]
وهذا يعني أنه لا يوجد اتفاق بين العلماء المسلمين على ما ذهب إليه ابن رشد في أن الفلسفة واجبة شرعاً، ويبقى رأيه في هذا الخصوص رأياً اجتهادياً. على أن لا ننسى أيضاَ أن ابن رشد فقيه كبير، وله إنجازات كبيرة في مجال الفقه الإسلامي، وهذا ما يفسح المجال لتقييم ابن رشد في وجوب الفلسفة بالشرع على أنه يصدر من عالم كبير في الفقه وله اجتهاداته في هذا الباب. [15]
معرفة الله عن طريق الفلسفة:
ولذلك يرى ابن رشد أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، إذ، كان المغزى الذي أرادوه في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه، وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها، وهو الذي جمع أمرين أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية، ولذلك فإن من نهى الناس عن النظر في كتب القدماء فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله، وباب النظر، المؤدي إلى معرفته حق المعرفة. وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى.[16]
والسؤال المهم هنا: هل البحث في كتب الفلاسفة القدماء (أي اليونان) كما ذهب ابن رشد يؤدي إلى معرفة الله؟ أي إذا أراد إنسان أن يعرف الله سبحانه فما الذي ستقدم له كتب الفلاسفة اليونان القدماء من المعرفة بالله؟
الجواب على هذا السؤال يقضي بأن نسأل السؤال الأهم: هل كان اليونان يعرفون الله سبحانه وتعالى أصلاً؟ أي بمعنى هل كانوا يعبدون الله سبحانه ويوحدونه على طريقة المسلمين لكي يتسنى لمن يريد معرفة الله سبحانه وتعالى أن ينظر في كتبهم؟
وفقاً لابن تيمية فقد كانت اليونان والروم مشركين، يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويبنون لها هياكل في الأرض ويصورون لها أصناماً يجعلون لها طلاسم من جنس شرك النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. وبقي هذا الشرك في بلاد الشرق، فكانوا يصنعون الأصنام على صورة النمرود ويكون الصنم كبيراً جداً ويعلقون السبح في أعناقهم ويسبحون باسم النمرود ويشتمون إبراهيم الخليل عليه السلام. ويؤكد ابن تيمية أن أرسطو وأصحابه كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وهكذا كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسيح عليه السلام فيهم، وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وكان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى التأريخ الرومي وكان قد ذهب إلى ارض الفرس واستولى عليها.وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الاسكندر ذي القرنين المذكور في القران وهذا جهل فان ذا القرنين كان مقدما على أرسطو بمدة عظيمة وكان مسلما يعبد الله وحده لم يكن مشركاً بخلاف المقدوني، وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج، كما ذكر الله في كتابه الكريم، والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا وصل إلى السد.وآخر ملوكهم كان بطليموس صاحب المجسطي وبعده صاروا نصارى. [17]
ولذلك، يبين ابن تيمية، أن مراد الله ورسوله بالعلم الذي يمدحه ليس هو العلم النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان، بل الحكمة: وهو الاسم الذي يجمع بين العلم والعمل، وسئل مالك عن الحكمة؟ فقال: “هو معرفة الدين والعمل به”، قال ابن قتيبة وغيره: “الحكمة عند العرب العلم والعمل به”. [18]
المبحث الثاني: نظرية وجوب الفلسفة (أو) مشروعية النظر الفلسفي
في النظر البرهاني: هل تتوافق الشريعة مع الفلسفة؟
يعرف ابن رشد البرهان بالقول: “والبرهان بالجملة هو قياس يقيني يفيد علم الشيء على ما هو عليه في الوجود بالعلة التي هو بها موجود، إذا كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع “. [19]
وإذا كانت هذه الشريعة، حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإنا معشر المسلمين، نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن الحق لا يضاد، الحق، بل يوافقه ويشهد له، ولأننا نعلم إن طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق، بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية.وذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل أنسأن، إلا من جحدها بلسانه، أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفاله ذلك من نفسه. ولذلك خص عليه السلام بالبعث إلى الأحمر والأسود، لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى. [20]
لكن أين يقع التوافق بين الشريعة والفلسفة وابن رشد نفسه ذهب في كتابه الذي لخص فيه كتاب “المستصفى ” للغزالي ذهب إلى أن النظر في الأصول التي تستند إليها الأحكام الشرعية، وعنها تستنبط.، وهي أربعة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ودليل العقل على النفي الأصلي، وتسمية مثل هذا أصلاً تجوز، إذ ليس يدل على الأحكام بل على نفيها. فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه.[21]
إذاً علوم الشريعة تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ودليل العقل، كما ذهب إلى ذلك إبن رشد نفسه، فكيف تتفق الشريعة من حيث ذلك مع الفلسفة اليونانية التي لم تكن تعرف شيئاً عن كتاب الله سبحانه ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أجل التوفيق بين الفلسفة والشريعة يتجه ابن رشد إلى التأويل، فيشير أن معنى التأويل ” هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازة من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء ….” فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كأن مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك، هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وأن كانت الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً. فإن كان موافقاً، فلا قول هنالك. وأن كان مخالفاً، طلب هنالك تأويله.[22]
الواقع، أن محاولة ابن رشد للتوفيق بين الشريعة والفلسفة لم تكن الوحيدة في هذا المجال، بل سبقتها ولحقتها العديد من المحاولات، مثل محاولة ابن سينا وابن عربي وابن سبعين، وغيرهم. [23]
يرى ابن رشد تحقق إجماع المسلمين في أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل. واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول فالأشعريون مثلاً يتأولون آية الاستواء وحديث النزول والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره. والعارف عنده قياس، يقيني. ومن ثم يمكن القطع أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه، وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول. فما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان، إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل.[24]
والسؤال النقدي الأهم في هذا السياق الذي يوجه إلى ابن رشد في مجال علاقة المنقول والمعقول، وارتباط الكل بالنظر البرهاني، كيف يمكن المقايسة بين المنقول الديني في الإسلام والمعقول الفلسفي عند اليونان؟ فمن الواضح جداً أن الإسلام، بحسب الاعتقاد الديني عند المسلمين أنه الدين الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذاً لابد من الأخذ بنظر الاعتبار، وهو ما كان يتعين على ابن رشد أن يأخذه، تحقق المقايسة بين المنقول الإسلامي والمعقول اليوناني. يشير ابن تيمية إلى اعتراف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأنأكثر الطرق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى العلم واليقين وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم. وأشار إلى مقالة أساطين الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا العلم الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق، ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة وأن الذي فيه من العلم ألحق قليل. [25]
أما بخصوص التأويل، فقد بين ابن تيمية أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه، وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك.ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقاً له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعني إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين فأما الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى، بل يريدون المعني الأول أو الثاني.ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالي {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾} [ آل عمران: 7]، أريد به هذا المعني الاصطلاحي الخاص، واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ ۗ } لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعني المراد بها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى…. [26]
وبين ابن تيمية بدقة وجه الإشكال، ورد دعوى ابن رشد في إمكان التوافق بين ما سميناه (بالمنقول الإسلامي) مع (المعقول اليوناني)، فذكر، أي ابن تيمية، أنه إنما ظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة المشهورين من جهة أرسطو وأتباعه، وهو المعلم الأول الذي وضع التعاليم التي يقرونها من المنطق والطبيعي والإلهي، وأما الإلهيات فكلام الرجل فيها وأتباعه قليل جداً، ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا كلامهم في الإلهيات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل، وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياء ويظهرون أن أصولهم لا تخالف الشرائع النبوية، وهم في الباطن يقولون أن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له في نفس الأمر وإنما هو تخييل وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم، وإن كان مخالفاً للحق في نفس الأمر، وقد يجعلون خاصة النبوة هي التخييل ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم وأكثر الناس لا يجمعون بين معرفة حقيقة ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء ولا يعقلون لوازم قولهم التي بها يتبين فساد قولهم بالعقل الصريح ثم إن كثيراً من الناس آخذ مذاهبهم فغير عباراتها، وربما عبر عنها بعبارات إسلامية حتى يظن المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التي بعثت بها الرسل ودلت عليها العقول كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا والباطنية حيث عبروا بالسابق والتالي عن العقل والنفس. [27]
منهج التوفيق بين الحكمة والشريعة:
يؤكد ابن رشد أنه يجب على من اراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة أن يعمد إلى الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء مما كلفنا اعتقاده، واجتهد في نظره ظاهراً ما امكنه من غير أن يتأول من ذلك شيئاً الا إذا كان التأويل ظاهراً بنفسه أعنى ظهوراً مشتركاً للجميع. فان الأقاويل الموضوعة في الشرع لتعليم الناس إذا تؤملت، يشبه أن يبلغ من نصرتها إلى حد لا يخرج عن ظاهرها ما هو منها ليس على ظاهره الا من كان من اهل البرهان. وهذه الخاصة ليست توجد لغيرها من الأقاويل.[28]
ويرى ابن رشد أن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، فالأذى ممن ينسب اليها اشد الأذى مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة، وهما المصطحبتان بالطبع المتحابان بالجوهر والغريزة. وقد آذاها ايضاً كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم إليها، وهي الفرق الموجودة فيها. فان الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت على الاعجاز أحداها أنه لا يوجد أتم اقناعاً وتصديقاً للجميع منها، والثانية انها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حد لا يقف على التأويل فيها – أن كانت مما فيها تأويل – الا أهل البرهان، والثالثة انها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق.وهذا ليس يوجد لا في مذاهب الأشعرية ولا في مذاهب المعتزلة: أي أن تأويلهم لا يقبل النصرة ولا يتضمن التنبيه على الحق ولا هو حق ولذلك كثرت البدع.[29]
مرة أخرى يخلط ابن رشد بين الحكمة والفلسفة، ويعدهما بمعنى واحد، والحق أنهما مختلفان.
وهذا ما يمكن إثباته من خلال العودة إلى نقاش ابن القيم في كتابه: ” مدارج السالكين ” مفهوم الحكمة، فقد ذكر حَقِيقَةُ الْحِكْمَةِ، وعدها من منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾} [الفاتحة: 5] منزلة الحكمة.. ويشير إلى ورودها في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾} [البقرة: 269]، وقوله سبحانه وتَعَالَى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113] وقوله عَنِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} [آل عمران: 48]. وبيبين أن الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. فالمفردة: فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. وأمثاله.. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل.. وقال الحسن: الورع في دين الله. كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها.. وأما الحكمة المقرونة بالكتاب: فهي السنة. وكذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة.. وقيل: هي القضاء بالوحي. وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر.. وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها.. وأحسن ما قيل في الحكمة. قول مجاهد، ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به. والإصابة في القول والعمل.. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه، في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان.[30]
ويبين ابن القيم أن الحكمة على ثلاث درجات، فالدرجة الأولى من الحكمة أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه. لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق، تقتضيها شرعاً وقدراً. ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها. ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر – كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله بشرعه وقدره. ولا تتعدى بها حدها. فتكون متعديا مخالفا للحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها.. وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا. وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة، وتعدي الحد المحتاج إليه، خروج عنها أيضا. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن وقته: إخلال بها.. فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض.. وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتها، بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد.. وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله.. فالحكمة إذا: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي.[31]
وأما الدرجة الثانية من الحكمة فهي أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله في حكمه. وتلحظ بره في منعه.. أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيد، وتشهد حكمه في قوله سبحانه وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] .فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه. فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فإنه الجواد الحكيم. وحكمته لا تناقض جوده. فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم في الكفار خيرا وقبولا لنعمة الإيمان، وشكرا له عليها، ومحبة له واعترافاً بها، لهداهم إلى الإيمان. فتشهد عدله سبحانه في وعيده، وإحسانه في وعده، وكل قائم بحكمته.. وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية، والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها، ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. ومن جرت على يديه هو الظالم.. وكذلك تعرف بره في منعه..[32]
أما الدرجة الثالثة من الحكمة أن تبلغ في استدلالك البصيرة. وفي إشارتك الغاية.. وفي إرشادك الحقيقة. يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. وهي أعلى درجات العلماء. قَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108].[33]
أقسام العلوم: في الخطابي والجدلي والبرهاني
يرى ابن رشد أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه، وبخاصة الشريفة منها، ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء. والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي.وهذه تنقسم قسمين: أحدهما أفعال ظاهرة بدنية، والعلم بهذه هو الذي يسمى الفقه، والقسم الثاني أفعال نفسانية، مثل الشكر والصبر، وغير ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها. والعلم بهذه هو الذي يسمى الزهد وعلوم الآخرة. وإلى هذا نحا أبو حامد في كتابه (يقصد كتاب الغزالي: ” إحياء علوم الدين”). [34] ويرى ابن رشد أيضاً أن من يريد أن يعرف الله حق معرفته فيتوجب عليه أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات. [35]
لما كان مقصود الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق، وكان التعليم صنفين: تصوراً وتصديقاً، وكانت طرق التصديق، الموجودة للناس ثلاثاً: البرهانية، والجدلية، والخطابية، وطرق التصور اثنين: إما الشيء نفسه وإما مثاله، وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين ولا الأقاويل الجدلية، فضلاً عن البرهانية، مع ما في تعلم الأقاويل البرهانية من العسر والحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلمه، وكان الشرع إنما مقصوده تعليم الجميع، وجب أن يكون الشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق وطرق التصور.[36]
والبرهان في (المفهوم الأرسطي – الرشدي): “هو قياس يقيني يفيد علم الشيء على ما هو عليه في الوجود بالعلة التي هو بها موجود، إذا كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع”. [37]
وطرق التصديق، بحسب ما يرى ابن رشد، أربعة أصناف:
أحدها أن تكون مع أنها مشتركة خاصة في الأمرين جميعاً، أي أن تكون في التصور والتصديق يقينية، مع أنها خطابية أو جدلية.
الثاني أن تكون المقدمات، مع كونها مشهورة أو مظنونة، يقينية، وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد انتاجها. وهذا يتطرق إليه التأويل، أي لنتائجه.
والثالث عكس كل هذا، وهو أن تكون النتائج هي الأمر التي قصد انتاجها نفسها، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها ان تكون يقينية. وهذا أيضاً لا يتطرق إليه تأويل، أي لنتائجه، وقد يتطرق لمقدماته.
والرابع أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية، وتكون نتائجه مثالات لما قصد انتاجه. هذه فرض الخواص فيها تأويل، وفرض الجمهور إمرارها على ظاهرها.[38]
ابن رشد والتوفيق بين الشريعة والفلسفة: الإشكال المنهجي:
وجه الإشكال الذي وقع فيه ابن رشد، في رأينا المتواضع، أنه قد عد أن لا فرق بين الإسلام كدين وبين الفلسفة اليونانية (خصوصاً فلسفة أرسطو)، أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة، وهذا مكمن الخطأ في تصوري. إذ كيف يمكن المماثلة بين الإسلام كدين موحى به من عند الله عز وجل وبين الفلسفة اليونانية بوصفها جهداً بشرياً خاضع لعوامل الخطأ والصواب، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار البعد الوثني في الفلسفة اليونانية.
كان على ابن رشد أن يميز بين الفلسفة والحكمة، فهما مسميان لمسمى مختلف، كما أوضحنا من قبل، بموجب النصوص الشرعية السابقة التي توضح المفهوم الدقيق لمصطلح الحكمة في الشريعة.
ويمكن أن نقول إن (إشكالية العقل عند ابن رشد) تتسع لتشمل مجموعة من الإشكالات الانطولوجية والابستيمولوجية والمعرفية، فضلاً عن النواحي الميتافيزيقية والإنسانية، فالإشكالية العقلية عند ابن رشد تتمثل في قوله بوحدة العقل المادي. [39]
يتمثل الجهد الذي قدمه ابن رشد حول فلسفة أرسطو بثلاثة أنواع من الشروح، وهي: الشروح والجوامع والتلخيصات. ومزج بين آرائه وآراء أرسطو في أحيان كثيرة، وأضاف إليها كثيراً، وضمنها تجربة عصره ومنجزاته، مما جعله شارحاً أكبر لأرسطو، ومنح رسمياً لقب: “روح أرسطو وعقله”. [40]
مشكلة ابن رشد تكمن في إعجابه الشديد بأرسطو إلى الحد الذي جعله يطابق بين فلسفة أرسطو وبين الإسلام. وراح ابن رشد يشغل حياته بإعداد التلخيصات والشروح على فلسفة أرسطو. وقد فضل أرسطو على جميع الفلاسفة، فيقول في مقدمة تفسيره لكتاب “الطبيعيات”: “مؤلف هذا الكتاب أكثر الناس عقلاً. وهو الذي ألف في علوم المنطق والطبيعيات، وما بعد الطبيعة، وأكملها. وسبب قولي هذا أن جميع الكتب التي ألفت في هذه العلوم قبل مجيء أرسطو لا تستحق جهد التحدث عنها”. ويقول ابن رشد في مقدمة تلخيصه لكتاب الحيوان لأرسطو: “نحمد الله كثيراً على اختياره ذلك الرجل – أي أرسطو – للكمال. فوضعه في أسمى درجات الفضل البشري، والتي لم يستطع أن يصل إليها أي رجل في أي عصر. فأرسطو هو الذي أشار إليه الله تعالى بقوله: {ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ } (المائدة:54). [41]
الخاتمة:
من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يأتي:
- يرى ابن رشد أن الفلسفة واجبة في الشرع، لكن هذا الرأي لا ينسجم مع الاتجاه العام عند الفقهاء المسلمين في نقد المنهج الفلسفي، لا بل وتحريم الاشتغال بالفلسفة، كما هو الحال عند ابن الصلاح.
- لا يوجد اتفاق بين العلماء المسلمين على ما ذهب إليه ابن رشد في أن الفلسفة واجبة شرعاً، ويبقى رأيه في هذا الخصوص رأياً اجتهادياً. لكن ينبغي الأخذ في الحسبان أن ابن رشد فقيه كبير، وله إنجازات كبيرة في مجال الفقه الإسلامي، ومن ثم فإن رأيه في وجوب الفلسفة بالشرع يصدر من عالم كبير في الفقه الإسلامي.
- لعل من أبرز الأسئلة النقدية التي وجهها البحث إلى أبن رشد سؤال: هل كان اليونان يعرفون الله سبحانه وتعالى أصلاً؟ أي بمعنى هل كانوا يعبدون الله سبحانه ويوحدونه على طريقة المسلمين لكي يتسنى لمن يريد معرفة الله سبحانه وتعالى أن ينظر في كتبهم؟ وهل البحث في كتب الفلاسفة القدماء (أي اليونان) كما ذهب ابن رشد يؤدي إلى معرفة الله؟ أي إذا أراد إنسان أن يعرف الله سبحانه فما الذي ستقدم له كتب الفلاسفة اليونان القدماء من المعرفة بالله؟
- إن علوم الشريعة تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ودليل العقل، كما ذهب إلى ذلك إبن رشد نفسه، كيف يمكن المقايسة بين المنقول الديني في الإسلام والمعقول الفلسفي عند اليونان؟ فمن الواضح جداً أن الإسلام، بحسب الاعتقاد الديني عند المسلمين أنه الدين الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تتفق الشريعة من حيث ذلك مع الفلسفة اليونانية التي لم تكن تعرف شيئاً عن كتاب الله سبحانه ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- بينا أن يخلط ابن رشد بين الحكمة والفلسفة، ويعدهما بمعنى واحد، والحق أنهما مختلفان.
- الخطأ في المنهج الرشدي يكمن في أنه قد عد أن لا فرق بين الإسلام كدين وبين الفلسفة اليونانية (خصوصاً فلسفة أرسطو)، أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة. إذ كيف يمكن المماثلة بين الإسلام كدين موحى به من عند الله عز وجل وبين الفلسفة اليونانية بوصفها جهداً بشرياً خاضع لعوامل الخطأ والصواب، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار البعد الوثني في الفلسفة اليونانية. كان على ابن رشد أن يميز بين الفلسفة والحكمة، ويوضح التباين الهائل بين الإثنين.
قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
أولاً: كتب ابن رشد:
- ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ): “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، دراسة وتحقيق: محمد عمارة، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ.
- _______________: “تهافت التهافت”، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ.
- ______________ “تهافت التهافت”، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع، د. محمد عابد الجابري، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998 م.
- ____________: “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، دار الحديث – القاهرة، 1425هـ – 2004 م.
- ________________: ” كتاب أنالوطيقي الثاني أو كتاب البرهان” (ابن رشد: “تلخيص منطق أرسطو)، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، دار الفكر اللبناني، 1992م، ص 373.
- _____________: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 31 – 32. وللتوسع في فهم (المنهج العقلي عند ابن رشد)، راجع: د. عاطف العراقي: “النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد”، ط4، دار المعارف، مصر، 1988م.
- _______________: “الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى”، تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي، تصدير: محمد علال سيناصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1994 م.
- ___________: ” كتاب أنالوطيقي الأول أو كتاب القياس” (نص تلخيص منطق أرسطو، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م.
- ___________: “تلخيص السياسة: محاورة الجمهورية لأفلاطون”، ترجمة د. حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 1998 م.
- ____________: ” مناهج الأدلة في عقائد الملة”، تحقيق الدكتور محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية، 1964 م.
- ____________: ” كتاب قاطيغورياس وباري أرميناس” (إبن رشد: (نص تلخيص منطق أرسطو)، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م.
- ___________: “تلخيص منطق أرسطو”، المجلد الخامس: “كتاب أنالوطيقي الثاني أو كتاب البرهان”، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م، ص 373.
- ___________: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 56 – 57. وينظر: د. محمود قاسم: “نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني”، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
المراجع العربية الأخرى:
- إبن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ): ” فتاوى ابن الصلاح”، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1407ه.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): ” الرد على المنطقيين”، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
- ____________: ” درء تعارض العقل والنقل”، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1411 هـ – 1991 م.
- _____________: “الصفدية”، المحقق: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الثانية، 1406ه.
- _____________: ” الاستقامة “، المحقق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود – المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1403ه.
- ابن قيم الجوزية،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (المتوفى: 751هـ): “مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين”، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ – 1996م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوفى: 711هـ): “لسان العرب”، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ.
- الجابري، د. محمد عابد: ” المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد”، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000 م.
- ____________: ” ابن رشد: سيرة وفكر: دراسة ونصوص”، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998.
- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوفى: 393هـ): “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ – 1987 م.
- الرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا (المتوفى: 313هـ): ” رسائل فلسفية”، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة: الخامسة، 1402 هـ – 1982 م.
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 666هـ): ” مختار الصحاح”، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (المتوفى: 310هـ): “جامع البيان في تأويل القرآن”، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م.
- العبيدي، د. حمادي: “ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية”، ط1، ط1، دار الفكر العربي، بيروت، 1991م.
- العراقي، عاطف: “ابن رشد فيلسوفاً عربياً بروح غربية”، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، بدون تاريخ.
- __________: “الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية: أربعون عاماً من ذكرياتي مع فكره التنويري”، ط2، دار الرشاد، القاهرة، 2005.
- المصباحي،د. محمد: “إشكالية العقل عند ابن رشد”، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، 1988 م.
- حسين، د. رواء محمود: “العروة الوثقى: مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية”، ط1، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت، 1434 – 2013 م، ص 6. على الرابط الاتي: http://www.nashiri.net/ebooks.html
- _____________: “شرعة ومنهاج: أصول المنهج العلمي في علم الحكمة الإسلامية، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت، 2014م، على الرابط الاتي: http://www.nashiri.net/ebooks.html.
- ______________: حكمة بالغة: الإعلان عن علم الحكمة في القرآن الكريم، دار الألوكة للنشر، 9/9/2014 ميلادي – 15/11/1435 هجري، على الرابط الآتي: http://www.alukah.net/sharia/0/75741/.
- _____________: الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية، الألوكة، تاريخ الإضافة: 12/10/2017 ميلادي – 21/1/1439 هجري. على الرابط الاتي: http://www.alukah.net/library/0/121547
- ______________: ” الملكوت في الحكمة القرآنية (1) حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر”، الألوكة، تاريخ الإضافة: 27/4/2015 ميلادي – 8/7/1436 هجري.
- _____________: ” الملكوت في الحكمة القرآنية (2)الرؤية الإبراهيمية للملكوت”، تاريخ الإضافة: 11/6/2015 ميلادي – 23/8/1436 هجري، على الرابط الاتي: http://www.alukah.net/sharia/0/87755/
- ______________: “إبن حزم ونقد المنطق: الكليات الخمس نموذجاً”، الألوكة، تاريخ الإضافة: 15/12/2014 ميلادي – 22/2/1436 هجري، على الرابط الآتيhttp://www.alukah.net/culture/0/79797/
- _____________: “الشاطبي ونقد الفلسفة”، تاريخ الإضافة: 13/1/2015 ميلادي – 22/3/1436 هجري، على الرابط الآتي: http://www.alukah.net/sharia/0/81175/
- ______________: “مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية: دراسات منتخبة”، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006 م.
- عمارة، د. محمد: ” ابن رشد: بين الغرب والإسلام”، نهضة مصر، القاهرة، 1997 م، ص 44 وما بعد.
- ____________: “المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد”، ط2، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص 17.
- قاسم، الدكتور محمود عن ابن رشد في كتابه: ” ابن رشد: الفيلسوف المفترى عليه”، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ..
المراجع الأجنبية:
- Averroes, Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics,” “Rhetoric,” and “Poetics,” edited and translated by Charles E. Butterworth (Albany: State University of New York Press, 1977).
- Endress, Gerhard, “Ibn Rushd,” in: Medieval Philosophy of Religion, edited by Graham Oppy and N. N. Trakakis (London and New York: Routledge, The History of Western Philosophy of Religion, 2009), Vol. 2: The History of Western Philosophy of Religion
- Fakhry, Majid, A History of Islamic Philosophy (New York: Columbia University Press, 2004).
- _____________, Averroes: His Life, Work and Influence (London: Oneworld Publications, 2014).
- Groff, Peter S., Oliver Leaman, Islamic Philosophy A-Z (Edinburg: Edinburgh University Press, 2007).
- HABTI, DRISS, “Reason and Revelation for an Averroist Pursuit of Convivencia and Intercultural Dialogue,” in: Policy Futures in Education 9: 1 (2011). https://doi.org/10.2304/pfie.2011.9.1.81
- Leaman, Oliver, An Introduction to Classical Islamic Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
- MILLER, ISAAC, “Idolatry and the Polemics of World-Formation from Philo to Augustine,” in: The Journal of Religious History 28, No. 2 (June 2004).
- Phillips, D. C., editor, Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C.: Sage Reference, 2014).
- Watt, W. Montgomery, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985).
- Sonneborn, Liz, Averroes (Ibn Rushd): Muslim Scholar, Philosopher, and Physician of the Twelfth Century (New York: The Rosen Publishing Group, Inc, 2006).
- Taliaferro, Karen, Ibn Rushd and Natural Law: Mediating Human and Divine Law,” In: Journal Of Islamic Studies 28:1 (2017). Doi:10.1093/Jis/Etw045
[1]زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ): ” مختار الصحاح”، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، ص 78.
[2]محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوفى: 711هـ): “لسان العرب”، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ.
[3]أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ): “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ – 1987 م، 5/ 1901.
[4]محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ): “جامع البيان في تأويل القرآن”، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م، 5/576.
[5]أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ): ” الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي”، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م، 3/330.
[6]د. رواء محمود حسين: “العروة الوثقى: مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية”، ط1، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت، 1434 – 2013 م، ص 6. على الرابط الاتي: http://www.nashiri.net/ebooks.html
[7]د. رواء محمود حسين: “العروة الوثقى: مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية”، ص 6 – 7. ولمزيد من التوسع في مجال توضيح ماهية ومفهوم ومنهج (علم الحكمة الإسلامية)، ينظر: د. رواء محمود حسين: “شرعة ومنهاج: أصول المنهج العلمي في علم الحكمة الإسلامية، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت،2014م، على الرابط الاتي: http://www.nashiri.net/ebooks.html ، د. رواء محمود حسين: “حكمة بالغة: الإعلان عن علم الحكمة في القرآن الكريم، دار الألوكة للنشر، 9/9/2014 ميلادي – 15/11/1435 هجري، على الرابط الآتي: http://www.alukah.net/sharia/0/75741/، د. رواء محمود حسين: “الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية”، الألوكة، تاريخ الإضافة: 12/10/2017 ميلادي – 21/1/1439 هجري. على الرابط الاتي: http://www.alukah.net/library/0/121547/
[8]أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ): “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، دراسة وتحقيق: محمد عمارة، الطبعة: الثانية، دار المعارف، بدون تاريخ، ص 29 – 30.
[9] حول الفلسفة في الحضارة الإسلامية، ينظر:
Oliver Leaman, An Introduction to Classical Islamic Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); Peter S. Groff, Oliver Leaman, Islamic Philosophy A-Z Edinburg: Edinburgh University Press, 2007); Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York: Columbia University Press, 2004); W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985).
[10]ابن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 22 – 23. ولمزيد من المتابعة حول فكر وفلسفة ابن رشد، ينظر:
Majid Fakhry, Averroes: His Life, Work and Influence (London: Oneworld Publications, 2014); Liz Sonneborn, Averroes (Ibn Rushd): Muslim Scholar, Philosopher, and Physician of the Twelfth Century (New York: The Rosen Publishing Group, Inc, 2006).
وحول الملكوت في القران الكريم، تابع: د. رواء محمود حسين: ” الملكوت في الحكمة القرآنية(1) حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر”، الألوكة، تاريخ الإضافة: 27/4/2015 ميلادي – 8/7/1436 هجري، على الرابط الاتي: http://www.alukah.net/sharia/0/85729/ ، وأيضاً: د. رواء محمود حسين: ” الملكوت في الحكمة القرآنية (2)الرؤية الإبراهيمية للملكوت”، تاريخ الإضافة: 11/6/2015 ميلادي – 23/8/1436 هجري، على الرابط الاتي: http://www.alukah.net/sharia/0/87755/
[11]أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي (المتوفى: 313هـ): ” رسائل فلسفية”، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة: الخامسة، 1402 هـ – 1982 م، ص 116.
[12] إبن رشد: “تهافت التهافت”، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص 150 – 151. وهناك نشرة أخرى لتهافت التهافت، ينظر: ابن رشد: “تهافت التهافت”، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع، د. محمد عابد الجابري، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م.
[13]عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ): ” فتاوى ابن الصلاح”، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، ، 1407م، ص 209 – 210.
[14]ابن الصلاح: ” فتاوى ابن الصلاح”، ص 210 – 211. ولمزيد من التوسع، يراجع: د. رواء محمود حسين: “إبن حزم ونقد المنطق: الكليات الخمس نموذجاً”، الألوكة، تاريخ الإضافة: 15/12/2014 ميلادي – 22/2/1436 هجري، على الرابط الآتي: http://www.alukah.net/culture/0/79797/ ، وأيضاً: د. رواء محمود حسين: “الشاطبي ونقد الفلسفة”، تاريخ الإضافة: 13/1/2015 ميلادي – 22/3/1436 هجري، على الرابط الآتي: http://www.alukah.net/sharia/0/81175/
[15] يبدو الاجتهاد الفقهي لابن رشد واضحاً في كتابه: “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، إذ يقول في مقدمة الكتاب: “إن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها, والتنبيه على نكت الخلاف فيها, ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع, وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع, أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا, وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها, أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة – رضي الله عنهم – إلى أن فشا التقليد”. ينظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ): “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، دار الحديث – القاهرة، 1425هـ – 2004 م، ص 9. وقد دافع الدكتور محمود قاسم عن ابن رشد في كتابه: ” ابن رشد: الفيلسوف المفترى عليه”، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، وانظر: د. محمد عابد الجابري: ” المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد”، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000 م، وللتوسع في علاقة ابن رشد بالعلوم الإسلامية، انظر: د. حمادي العبيدي: “ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية”، ط1، ط1، دار الفكر العربي، بيروت، 1991م.
[16] إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 28 – 29. وانظر:
Gerhard Endress, “Ibn Rushd,” in: Medieval Philosophy of Religion, edited by Graham Oppy and N. N. Trakakis (London and New York: Routledge, The History of Western Philosophy of Religion, 2009), Vol. 2: The History of Western Philosophy of Religion, p. 121.
[17]تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): ” الرد على المنطقيين”، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص 283 – 284.
[18] ابن تيمية: ” الرد على المنطقيين”، ص 447. حول الوثنية في الثقافة اليونانية: أنظر: د. رواء محمود حسين: “العروة الوثقى: مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية”، ط1، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت، 1434 – 2013 م، ص 102 – 119.
ISAAC MILLER, “Idolatry and the Polemics of World-Formation from Philo to Augustine,” in: The Journal of Religious History 28, No. 2 (June 2004): 126 – 145.
[19] ابن رشد: ” كتاب أنالوطيقي الثاني أو كتاب البرهان” (ابن رشد: “تلخيص منطق أرسطو)، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، دار الفكر اللبناني، 1992م، ص 373.
[20]إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 31 – 32. وللتوسع في فهم (المنهج العقلي عند ابن رشد)، راجع: د. عاطف العراقي: “النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد”، ط4، دار المعارف، مصر، 1988م.
وانظر أيضاً:
DRISS HABTI, “Reason and Revelation for an Averroist Pursuit of Convivencia and Intercultural Dialogue,” in: Policy Futures in Education 9: 1 (2011): 81 – 87. https://doi.org/10.2304/pfie.2011.9.1.81
[21] أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ): “الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى”، تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي، تصدير: محمد علال سيناصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1994 م، ص 63.
[22]إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 32. يعرف ابن رشد القياس بالقول: “هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد، لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة، بذاتها لا بالعرض، شيء ما آخر غيرها” (ينظر: ابن رشد: ” كتاب أنالوطيقي الأول أو كتاب القياس” (نص تلخيص منطق أرسطو، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م، ص 139).
[23]تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): “الصفدية”، المحقق: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الثانية، 1406ه، 1/ 160، ولمزيد من المتابعة راجع: رواء محمود: “مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية: دراسات منتخبة”، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006 م.
[24] ابن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 32- 33.
[25] تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): “الاستقامة “، المحقق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود – المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1403ه، 1 / 79. ومن أجل التوسع في إشكالات قضية العقل والنقل في الفكر الإسلامي، نحيل مرة أخرى إلى: رواء محمود: “مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية: دراسات منتخبة”، كل الكتاب.
[26]تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): ” درء تعارض العقل والنقل”، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1411 هـ – 1991 م، 1/ 14.
[27]إبن تيمية: “درء تعارض العقل والنقل”، 1 / 236 – 237.
[28] إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، 1 / 65.
[29]إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، 1 / 66 – 67. وانظر:
- C. Phillips, editor, Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C.: Sage Reference, 2014), p. 562.
[30] محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ): “مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين”، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ – 1996م، 2/ 247 – 248.
[31]ابن القيم: ” مدارج السالكين”، 2 / 248 – 249.
[32]ابن القيم: ” مدارج السالكين”، 2 / 450.
[33]ابن القيم: ” مدارج السالكين”، 2 / 451.
[34] إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 54 – 55. وللمقارنة، ينظر: ابن رشد: “تلخيص السياسة: محاورة الجمهورية لأفلاطون”، ترجمة د. حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 1998 م، ص 64 وما بعد.
[35] ابن رشد: ” مناهج الأدلة في عقائد الملة”، تحقيق الدكتور محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية، 1964 م، ص 151. والجوهر عند ابن رشد هو الذي يقال لا على موضوع ولا هو في موضوع، مثل الإنسان. ينظر: ابن رشد: ” كتاب قاطيغورياس وباري أرميناس” (إبن رشد: (نص تلخيص منطق أرسطو)، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م، ص 5. ولمزيد من المتابعة عن فكرة (القانون الطبيعي عند ابن رشد)، ينظر:
Karen Taliaferro, Ibn Rushd and Natural Law: Mediating Human and Divine Law,” In: Journal Of Islamic Studies 28:1 (2017), pp. 1–27 Doi:10.1093/Jis/Etw045
[36] إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 56. وانظر: د. محمد عمارة: ” ابن رشد: بين الغرب والإسلام”، نهضة مصر، القاهرة، 1997 م، ص 44 وما بعد.
[37] ابن رشد: “تلخيص منطق أرسطو”، المجلد الخامس: “كتاب أنالوطيقي الثاني أو كتاب البرهان”، دراسة وتحقيق د. جيرار تهامي، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992 م، ص 373.
[38]إبن رشد: “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، ص 56 – 57. وينظر: د. محمود قاسم: “نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني”، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
[39]د. محمد المصباحي: “إشكالية العقل عند ابن رشد”، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، 1988 م، ص 7.
[40] محمد عمارة: “المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد”، ط2، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص 17. وقارن:
Averroes, Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics,” “Rhetoric,” and “Poetics,” edited and translated by Charles E. Butterworth (Albany: State University of New York Press, 1977);
[41] عاطف العراقي: “ابن رشد فيلسوفاً عربياً بروح غربية”، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، بدون تاريخ، ص 16. وقارن مع: د. محمد عاطف العراقي: “الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية: أربعون عاماً من ذكرياتي مع فكره التنويري”، ط2، دار الرشاد، القاهرة، 2005 م، ص 51 وما بعد. وأيضاً مع د. محمد عابد الجابري: ” ابن رشد: سيرة وفكر: دراسة ونصوص”، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص 81 وما بعد.