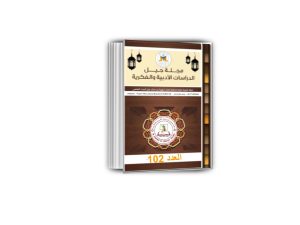واقع ترجمة المصطلح في العلوم الإنسانية وتحدياتها الراهنة المصطلح اللساني نموذجا
The Reality of Translating Terms in Human Sciences and Its Current Challenges The Linguistic Term As a Model
كريمة مزغيش/المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر
mezghiche karima ـ ENS Bouzareah ـ Algeria
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد 52 الصفحة 9.
ملخص:
تتناول هذه الدراسة أهم عائق يقف حائلا أمام ترجمة العلوم الإنسانية ألا وهو إشكالية المصطلح الذي لا يخلو الحديث عنه في الترجمة المتخصصة، والذي أرهق الباحثين العرب في معالجته والخوض في قضاياه ومشكلاته، فالمصطلح عنصر جوهري في نقل العلوم وتلقينها، لأن ترجمته تعد من أهم وسائل استنباط المعارف وتحديد المفاهيم. تطرقت الدراسة إلى مفهوم الترجمة والشروط التي يجب أن تتوفر في المترجم والمصطلح على حد سواء، كما سلطت الضوء على أهم التحديات التي تواجه ترجمة المصطلح اللساني إلى العربية على المستويين المحلي والدولي، كما قدمت بعض الحلول من أجل تنسيق جهود ترجمة المصطلح في الوطن العربي. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تساهم في ضبط عملية الترجمة وتوحيدها في العلوم الإنسانية عامة وفي الحقل اللساني خاصة.
الكلمات المفتاحية
الترجمة-المصطلح- العلوم الإنسانية- اللسانيات-المترجم.
Abstract
This study intends to explore the challenges in translating terms in human sciences into Arabic. The study also focuses on the translation of terms which specifically belong to the field of Linguistics as a sample to show different problems researchers encounter when dealing with specific terms in Arabic. Translation into Arabic is made individually consequently researchers find themselves in front of different equivalents to one term .In order to solve these problems, the study proposes to organize translation in the Arabic World and suggests the coordination of efforts directed at unifying translation of terms in human science and especially in linguistic field.
Keywords: Translation- human sciences-term- Linguistics- translator.
مقدمةتكمن أهمية ترجمة المصطلح العلمي في العلوم الإنسانية في كونها وسيلة للتقدم الحضاري وهي العتبة والأداة التي نستفيد بها من منجزات الآخر، من علوم ونظريات وتقنيات، فضلا عن كونها سببا قويا ومؤشرا بارزا على مدى التقدم العلمي والثقافي للأمم في هذا المجال. وليست الترجمة العلمية وليدة اليوم أو حتى مئات السنين بل هي صنعة ولدتها الحاجة لتلاقح الحضارات وتواصلها في الميدان العلمي. وقد أدرك العرب فعالية هذه الأداة واستغلوها في أوج عطائهم الفكري والعلمي وعليها اعتمدوا في إقامة حضارتهم وازدهار علومهم، وخير دليل على ذلك أن العرب ترجموا علوم اليونان والفرس والهنود، وترجم الأوروبيون ما أنجزه العرب في الطب والفلك والرياضيات، ولا تصح ترجمة العلوم دون التمكن من مصطلحاتها. وتكمن أهمية ترجمة المصطلح في العلوم الإنسانية عامة وفي الحقل اللساني خاصة في كونه حاجة ماسة وضرورة ملحة يفرضها التواصل العلمي بين الشعوب، فاللغة هي حلقة الوصل بين الشعوب وهي الوسيلة التي يستغلها الباحث للاطلاع على ما أنتجته العلوم الإنسانية الغربية من نظريات ومناهج ذات مصطلحات وألفاظ حضارية. وتتأكد أهمية هذه الدراسة حول ترجمة المصطلح في كونها تحقق قدرا من الأهداف، على غرار معرفة واقع ترجمة المصطلح العلمي العربي، وما يواجه الترجمة من تحديات تعيق مسار مواكبتها للتطورات الحديثة، كما تقترح الدراسة سبلا لتوحيد جهود ترجمة المصطلح في الوطن العربي، بغية سد الثغرات المصطلحية وتمكين الباحث من مواكبة المعارف الجديدة في العلوم الإنسانية عامة وفي الحقل اللساني خاصة.
- تعريف الترجمة
- تعريف الترجمة لغة:
يذكر ابن منظور في اللسان: أن التُرجمان والتًّرْجَمان: المفسِّر للّسان. وفي حديث هِرقل: قال لتُرْجُمانِهِ؛ التُّرْجُمانُ، بالضم والفتح: هو الذي يُتًرجِمُ الكلام، أي يًنْقُلُهُ من لغة إلى لغة أخرى، والجمع: التراجِمُ، والتاء والنون زائدتان[1].
أما في تاج العروس: « ترجم الترجمان قيل نقله من لغة إلى أخرى والفعل يدل على أصالة التاء، والتاء في
الكلمة أصلي ووزنها (تفعلان)، قال ابن قتيبة إن الترجمة تفعلة من الرجم»[2].
أما في المعجم الوسيط فجاء في تعريف كلمة (ترجم): «ترجم الكلام بينه وضحه، وترجم كلام غيره وعنه: نقله من لغة إلى أخرى، وترجمة لفلان: ذكر ترجمته، الترجمان هو المترجم، جمعه تراجم، وتراجمة»[3]
- الترجمة اصطلاحا:
يعرف جون دوبوا Jean Duboit في (معجم اللسانيات) مصطلح الترجمة traduction بقوله: «الترجمة هي «نقل» رسالة من لغة انطلاق (اللغة المصدر) إلى لغة وصول (اللغة الهدف)، ويطلق المصطلح ترجمة على الفعل ونتاجه (…) وبالمعنى الدقيق لا تتعلق الترجمة بالنصوص المكتوبة وحدها، فحين يتعلق الأمر باللغة المنطوقة نتكلم عن الترجمة الشفهية Interprétariat»[4].
والترجمة هي: «التعبير بلغة أخرى أو لغة الهدف عما عبر عنه بأخرى لغة المصدر مع الاحتفاظ بالتكافؤات الدلالية والأسلوبية»[5] وهو تعريف نجد نظيرا له في (المعجم الموحد) الذي وضعه مكتب تنسيق التعريب إذ جاء فيه: «الترجمة نقل نص من لغة مصدر إلى لغة هدف مع المحافظة على المدلول الدلالي والأسلوبي»[6].
والغاية من الترجمة هنا هي تحقيق التكافؤ -ما أمكن- بين نظامين لغويين مختلفين في معنى وشكل الكلمات وكذلك التعابير والأفكار، بحيث يؤدي النص المُترجم الرسالة نفسها في النص الأصل. ومن هاته التعريفات تظهر أهمية فهم نص الرسالة المُراد ترجمتها باللغة الأصل على أساس القواعد الحاكمة لهذه اللغة نفسها.
- تعريف المصطلح
2-1 المصطلح لغة
يقول ابن فارس في معجمه أن الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد[7]. ويعرف الشريف الجرجاني كلمة اصطلاح بأنه اتفاق قوم على تسمية شيء ما باسم بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما في وصف غيرهما.[8]
- المصطلح اصطلاحا
فكلمة الاصطلاح ومصطلح تعني العرف الخاص، أي اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص مثلا اصطلح العلماء على رموز الكيمياء أي اتفقوا عليها، وهذه الرموز هي مصطلحات أي مصطلح عليها[9] وهذا ما يؤكده عبد القادر الفاسي الفهري إذ يعرّف المصطلح بأنه:« لغة خاصة أو معجم قطاعي يسهم في تشييد بنائه ورواجه أهل الاختصاص في قطاع معرفي معين ولذلك استغلق فهمه واستعماله على من ليس له دراية بالعلم الذي هو أداة لإبلاغه. إلا أن هذه اللغة القطاعية تتصل باللغة “العامة” المشتركة باللغة “العامة” المشتركة ولا تكاد تخرج من الأصول التي تتحكم فيها«[10] فالاصطلاح يجعل إذن للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغوية أو الأصلية.
- شروط ترجمة المصطلح
إن ترجمة المصطلح العلمي تحتاج توفر مجموعة من الشروط في المترجم وفي المصطلح المترجَم على حدّ سواء:
- شروط مُترجم المصطلح
يشترط على مترجم المؤلفات العلمية أن يكون متقنا اللغة العربية واللغة الأجنبية المترجم منها، وأن يكون مختصا في المادة العلمية التي يتصدى إلى ترجمتها، إذا ما أريد الحصول على ترجمات علمية جيدة، فالترجمة العلمية لكي تكون عملا ناجحا مثمرا ونشاطا مجديا، لا بد من مترجم له الصلاحية التامة من الناحية اللغوية والفنية، والتكوين اللغوي يتنوع بتنوع المادة العلمية أو الأدبية، التي تتناولها الكتب أو تعالجها المقالات والبحوث، لذا توجد مؤهلات علمية، و مهارات لغوية، وبراعات فنية يتمكن بها المترجم من أداء مسئوليته المهنية حق الأداء. وكثيرا ما يجد المترجم نفسه من مجرد مستعمل للمصطلح إلى واضع للمصطلح في حدّ ذاته، فهو يساهم بشكل هام في ترويح المفاهيم والمعلومات العلمية المستجدة، خاصة عند ترجمته لنصوص خطاب التبسيط العلمي، فيلجأ إلى استحداث المصطلحات بنفسه، فدور المترجم – كما يقول محمد الديداوي– «…يشتمل ترويج المعلومات المتعلقة بالمفاهيم التقنية حسب استعمالها في التواصل عن طريق اللغات، لا بل ليصل إلى اختراع المصطلحات في تلك اللغات»[11] فيلجأ إلى البحث في الموضوع المترجم إضافة إلى استحضار خبراته الخاصة وسرعة بديهيته لإيجاد مقابل يساعد قارئ النص على فهم فحواه ومقصوده.
وينضاف إلى ما سبق عدد من الشروط الواجب توفرها في المترجم منها[12]:
- أن يكون بيانه في الترجمة في وزن علمه بالموضوع المترجم.
- أن يكون متقنا للغتي الترجمة قدر المستطاع.
- أن يكون عارفا بأسلوب المؤلف وعباراته وألفاظه وتأويلاته.
- أن يحافظ على المرامي الدقيقة للموضوع ولا يكون ذلك إلاّ بنقل مادة المضمون دون تأويل.
و ينبغي للمترجم أيضا أن يقبل على تجديد معلوماته وتوسيع مطالعاته، مستعينا بما تتيحه التكنولوجية الحديثة من مواقع وكتب ومعاجم الكترونية تسهل عليه مهمة البحث في النصوص العلمية الجديدة وبالتالي معرفة المصطلحات المستحدثة في اللغة الأجنبية.
- شروط المصطلح المُترجَم
تحتاج ترجمة المصطلح إلى معرفة واسعة وشاملة للغة العربية والنظريات اللسانية الحديثة، فليس من اليسر كما هو متداول ومتعارف عليه أن يتّفق الدارسون على تعريف دقيق لمصطلح من المصطلحات أو كلمة من الكلمات، وبخاصة إذا تعلّق الأمر بمفاهيم حديثة الظهور والاستعمال. لذلك ليس اتّفاق العلماء على تعبير لهذه اللفظة على ذلك المعنى كفيلا لأن يصبح مصطلحا، بل يجب توفره على شروط وضوابط تحكمه، ويمكن إجمالها فيما يلي[13]:
- تفادي تعدد الدلالات في ترجمة المصطلح الواحد في الحقل الواحد، وتفضيل اللفظ المختص على المشترك.
- وجود علاقة ومشاركة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي.
- أن يقرّه فريق من العلماء من أصل الاختصاص في اللغة المنقول إليها.
- يجب أن يكون المصطلح في غاية الوضوح، ووروده في سياق النظام الخاص بفرع محدد ومعيّن، أي أن يكون المصطلح محددا ودقيقا في تعبيره عن المفهوم الذي يشير إليه أي لا يتعدّى على مفهوم آخر لمصطلح ما.
- البحث في الكتب العربية القديمة عن اصطلاح متداول للدلالة على المعنى المقصود ترجمته، ويشترط في هذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقا للمعنى الجديد.
- ينبغي أن يكون مترجم المصطلح على قدر كبير من الاطلاع على القوانين المؤثرة في بناء المصطلح كمفهوم المصطلح، نشأته وارتباطه بغيره ومدى قدرة اللفظ على حمل ذلك.
- كما يجب النظر، خلال عملية الترجمة، إلى المدلول العلمي للمصطلح الأجنبي قبل معناه اللغوي، فكثيرا ما لا يكون واضع المصطلح الأجنبي موفقا كل التوفيق في اختياره، وعندئذ سيميّز المقابل العربي الغموض والإبهام.
نتبين مما سبق أن ترجمة المصطلحات من لغة إلى أخرى ليست بالأمر الهين، بل تحتاج معايير خاصة وشروطا يلتزم بها المترجم، كما يبذل لأجلها جهدا فكريا ويخصص لها بحثا علميا واسعا في اللغتين.
- واقع ترجمة المصطلح في العلوم الإنسانية إلى العربية
لا شك أن المهتم بالبحث في العلوم الإنسانية يصطدم بواقع الترجمة العربية والتحديات التي تواجهها حركة البحث العلمي في وطننا العربي، خاصة مع التقدم العلمي وتسارع ظهور النظريات في علم الاجتماع وعلم النفس واللسانيات وغيرها. ويعرف القرن الواحد والعشرون تطورات متلاحقة في العلوم الإنسانية نتج عنها تضخّم غير مسبوق في المصطلحات العلمية، فقد اتسع حجم هذه المصطلحات بما يفوق التصور، نتيجة للانفجار المعرفي في مجالات العلوم والفنون والآداب وغيرها، وهو أمر يتجلى لنا بصورة واضحة في الطبعات الجديدة من معجمات اللغات التي تواكب التطور المستمر والمتجدد للمصطلحات في مجمل فروع المعرفة، التي ينبغي أن تتصدى لها اللغة العربية. ولا يتحقق لها ذلك إلا بتكثيف جهود الترجمة واستغلال آليات توليد المصطلحات التي توفرها لغتنا.
والحقيقة أن الكثير من الجهود تبذلها المؤسسات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأفراد في الوطن العربي للتصدي لهذا الزخم الكبير من المعارف الوافدة من الغرب. غير أن هذه الجهود ما تزال قاصرة عن اللحاق بالركب العلمي نظرا للتقنيات المتطورة التي تسخرها الدول الغربية في البحث العلمي وكذلك في نشر المعلومة والتي تحتاج إلى جهود عربية متظافرة ومنسقة وموحدة تكفل نقل مصطلحات العلوم الإنسانية والاستفادة منها مع المحافظة على اللغة القومية وتنميتها وعدم استبدالها بلغة وافدة تقضي على الهوية وتشتت الوحدة.
- تحديات ترجمة المصطلح اللساني إلى العربية
ليس من اليسير الإقدام على القيام بأي عمل ترجمي كان؛ إذ يكتنف هذه التجربة الكثير من الصعاب والعقبات التي تجعل المترجم يمعن البحث والتفكير، خاصة إذا كانت في مجال علمي بعينه، إذ يجد المترجم نفسه أمام نص مقيد بمصطلحاته الدقيقة، التي ينبغي أن يتحرى الأمانة في نقلها إلى لغته الأصلية «ثم إن وضع المصطلحات العلمية أو تحقيقها من أشق الأمور وأدعاها إلى الجلد والصبر والأناة، والتخصص الواسع بعلم واحد، حتى بفرع من علم واحد[…]أما الكلمة العربية التي ستوضع أمام الأعجمية، فليس من السهل إيجادها أو اختيارها، فهناك تراث علمي قديم لنا يجب مراجعته بغية العثور على لفظ عربي سائغ، له معنى اللفظ الأعجمي، أو له معنى مقارب لمعناه[…]»[14]. ولا يتوقف الأمر هنا، بل تواجه المترجم مشكلات أخرى في نقل المصطلحات، نذكر بعضها فيما يلي:
- مشكلة مواكبة التطور المصطلحي الغربي
يصطدم أي مترجم لنص علمي في اللغات الغربية الحديثة بمشكلة التطور التكنولوجي السريع، والذي أدى إلى تفرع مجالات المعرفة وبالتالي كثرة المصطلحات العلمية الموظفة للتعبير عنها. وفي الوقت الذي يبحث فيه المترجم العربي عن مقابل مصطلح واحد، وما يتطلب ذلك من عناء البحث وبذل الجهد الفكري والسعي للحوز على رضا جمهور القراء، واتفاق المختصين عليه لتوطينه في المعاجم المتخصصة، حتى يجد أن الآلاف من المصطلحات قد استحدثت في الغرب واستقرت في معاجمهم وهي قيد الاستعمال الفعلي. والواقع أن مشكلة ترجمة المصطلح العلمي اللساني وأزمته مرتبطة بالسباق الزمني بين اللسانيات الغربية والتطورات التكنولوجية من جهة وبين مواكبة العرب لهذا السباق من جهة أخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى التقدم الهائل بفعل تطور وسائل البحث العلمي لدى الغرب ومجاراة المصطلحي له برصد كل جديد ومستحدث من مسميات علمية بمصطلحات تؤدي معناها الدقيق. وكمثال على ذلك تحصي اللغة الانجليزية ما يقارب من 9000 مصطلح مستحدث سنويا وفي الفرنسية حوالي 2000 مصطلح، أغلبها (حوالي 80% ) خاصة بالمفردات التقنية، بما فيها الحاسوب والإلكترونيات والشبكات المعلوماتية. ويطرح ذلك إشكالية إيجاد مقابلات لها باللغة العربية، ويوضح المجهود الذي يفصلنا عن مواكبة التطور الحاصل في هذا الإطار.
5-2 مشكلة غياب المصطلح المقابل في اللغة الهدف
من العقبات التي من شأنها تعقيد عملية ترجمة المصطلحات هو غياب المصطلح في ذاته، إلا أنه لا يجعلها مستحيلة، فالأصعب هو غياب المفهوم في اللغة المترجم إليها، فمتى انعدم المصطلح في اللغة المترجم إليها، شكلت الترجمة المصطلحية، أي ترجمة المفاهيم عنصرا رئيسيا في هذه العملية التي ينبغي ألا يتصدى لها سوى مترجم قادر على الإلمام بالموضوع ومتمرس في ترجمته، أو أخصائي له ركيزة لغوية متينة ومقدرة على النقل.
ويرى الديداوي أن ترجمة المصطلحات تحتاج الفهم الجيّد للمصطلح الذي يؤدي إلى إيجاد المقابل الصحيح له، حتى وإن غابت عنه المعاني المضمرة الأخرى، إلا أنه يوفّق في إيصال المعنى المقصود في النص الأصل باختياره المصطلح الصحيح، إذ يقول في ذلك: « المترجم متى استحكم فهمه لفحوى المصطلح وتمكن من إيجاد المقابل المناسب له، فإنه يُحتمل جدّا أن يوصل المعنى تدريجيا إلى القارئ المتخصص الذي له إلمام بالموضوع ودراية بخلفيته، حتى وإن خفي عليه هو البعد الكامل لما قيل وما ذُكِر وما أُضمِر، شريطة أن يُوفَّق في المصطلح ويبرع في الأداء»[15].
أما الحمزاوي فيؤكد على حتمية مفادها أن لكل مصطلح أجنبي مكافئ في اللغة المترجم إليها، إذ يرى أنه من المفروض أن يكون لكل مصطلح مقابلات في اللغات الأخرى، وهذا استنادا إلى قضية الترادف الكوني، لذلك « إن قضية الترجمة تضع قضية المعنى أي مشكلة التطابق بين المصطلح اللغوي والواقع، وكذلك مشكلة الترادف الكوني الذي يفترض وجوباَ أن لكل مصطلح في لغة ما، مرادف في لغة أخرى. وذلك من أعوص المشاكل التي لم يقر لها قرار لأن الترجمة من لغة إلى أخرى تفرض اعتبار ثقافة كل لغة وما يحيط بها من تضمينات لا تقر التلاصق والنسخ»[16]. لهذا يتوجب على من يترجم المصطلح أن يبحث عن مقابل له أو أن يبتكره بإحدى الوسائل التي تتيحها اللغة لتوليد ألفاظها ومصطلحاتها.
- مشكلة الترادف في ترجمة المصطلح
أنكر معظم اللغويين المحدثين الترادف الحاصل في المصطلحات اللسانيّة العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي، فمنهم من عدّه من صعوبات وضع مصطلحات اللسانيات. وهي حقيقة تفرض نفسها على واقع المصطلح العربي الذي يبين اضطراب بعض المؤلفين والمترجمين، فتُرجِم المصطلح الأوربي بلفظ معين مرّة، ثم تُرجِم المصطلح نفسه مرّة أُخرى في الكتاب نفسه بلفظ آخر. ويرجع ذلك إلى اختلاف ترجمات المصطلح باختلاف المترجمين ورؤاهم ومناهجهم في اختيار المصطلح الأنسب، غير أن ذلك كان له تداعياته بسبب ما آل إليه وضع وترجمة المصطلح في العربية؛ إذ يرى محمود فهمي حجازي أنّ استعمال كلمتين مختلفتين، أو عدة كلمات لمفهوم واحد من المشكلات المصطلحية التي تحتاج الحسم من طرف الهيئات والمختصين في مجال المصطلح.
وتبدو هذه المشكلة واضحة في الندوات والمؤتمرات والمؤسسات واللقاءات والتآليف اللسانية العربية. فكل مؤتمر أو لقاء أو تأليف له مصطلحاته، تلك المصطلحات التي هي عبارة عن جهود شخصية وتأويلات فردية، فبالنظر إلى مصطلح Linguistics الانجليزي أو Linguistique الفرنسي نجد أن المقابلات العربية تختلف بحسب المترجمين ومنهجهم في وضع المصطلح المقابل، ومن مقابلات المصطلح المذكور نجد: اللسانيات، الألسنية، علم الألسن، علم اللسان، علم اللغة، اللغويات…الخ. ومن ترجمات المصطلح synchronie نجد: المنهج المتزامن، والمتعاصر، و المتواقت، والآنية والسنكرونية، وكذلك مصطلح diachronie: المنهج التطوري، والمتعاقب، والتاريخي، والزماني، والدياكروني…الخ وهذا يبين الاختلاف الواسع بين الترجمات العربية خاصة في الحقل اللساني والتي توضع مقابلة لمصطلح أجنبي واحد.
- مشكلة الخلاف حول تأصيل المصطلح من التراث العربي
تبزر مشكلة تأصيل المصطلح العلمي في اختلاف اللغويين حوله وموقفهم منه؛ إذ انقسموا بين مؤيد للتأصيل ورافض له. دعا المؤيدون للفكرة من لغويين محدثين إلى العودة إلى التراث العربي للبحث عن المصطلحات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي، ومن بين هؤلاء مصطفى الشهابي الذي وضع شروطا عامة ينبغي مراعاتها عند النقل من اللغات الأخرى، ومن أهم هذه الشروط: « تحرِّي لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأجنبي، وهذا يقتضينا أن نكون مطّلعين اطلاعا واسعا على الألفاظ العلمية المبثوثة في المعاجم العربية، وفي مختلف كتبنا العلمية القديمة»[17]، إذن يحتاج البحث عن المصطلح في التراث التنقيب في الكتب العلمية القديمة وإيجاد المصطلحات التي تم إقرارها واستعمالها في ذلك الوقت، وإعادة توظيفها للدلالة على مفهوم يقابله في العصر الحديث. ومن المؤيدين كذلك محمود فهمي حجازي، إذ يقول: «[..] ولا يقتصر البحث في المصطلحات في التراث العربي على قطاعات معرفية محددة، بل يتناول بالضرورة كلّ فروع المعرفة المدونة باللّغة العربية على مدى عدّة قرون منذ بداية الحركة العلمية في إطار الاسلام، وحتى بداية الاتصال الحديث بالحضارة الغربية»[18]. وتأتي رغبة المؤيدين لتأصيل المصطلح من التراث العربي من كونه غنيا بمصطلحات من شأنها أن تفي بالغرض، ولا سيما أن هذه المصطلحات باتت معروفة عند المختصين بالحقل المعرفي. ويفضل مجمع اللغة العربية بالقاهرة اعتماد المصطلحات الموروثة عن القدماء، إلا أنه يشترط:
- اللفظ العربي على المُعرّب القديم إلا إذا اشتهر المُعرّب.
- المصطلح العربي القديم على الجديد إلا إذا شاع الجديد.
غير أن بعض اللغويين يرفضون فكرة العودة إلى التراث بدعوى إحياء الألفاظ القديمة وإطلاقها على مسميات حديثة، ومن بينهم عبد السلام المسدي إذ يقول: «كثيرا ما يتجاذب الميراث الاصطلاحي ذوي النظر فينزعون صوب إحياء اللّفظ في غير معناه الدقيق[…]فإذا بالمدلول اللساني يتوارى حينا خلف المفهوم النحوي، ويتسلل أحيانا أخرى وعليه مسحة من الضباب تعتم صورته الاصطلاحية، فتتلابس القضايا، ويعسر حسم الجدل بين المختصين»[19]،ذلك أن المعنى الذي وُضع له المصطلح القديم غير ما يدله عليه المصطلح الحديث لاختلاف ظروف وضع كل منهما وزمانه وسياقه. ومن الرافضين كذلك خليفة الميساوي الذي يراه أحد معيقات البحث اللساني الحديث؛ إذ أنّ البحث في التراث لإيجاد حلول لظواهر حديثة قد لا يجد سبيله في أغلب الأحيان، بل قد يكون سببا رئيسا في تعطيل الدّرس اللّساني الحديث.
وبين مؤيد ومعارض لا يمكن أن نجزم بانفصال العمل المصطلحي العربي الحديث التام عن نظيره القديم، والدليل على ذلك أن الكثير من هذه المصطلحات ما يزال قيد الاستعمال في العلوم الحديثة، كما أن الكثير من المصطلحات اللسانية لها ما يقابلها في العربية، لاهتمام العرب بدراسة لغتهم وتقنينها ووضع المصطلحات التي تصفها، وهي مدونة في ثنايا مؤلفاتهم القيمة التي مازالت مصادرا يرجع إليها اللغويون في العصر الحديث.
- مشكلة ثقافة الغير في ترجمة المصطلح
إضافة إلى ما سبق ذكره، يعاني مترجم المصطلح وواضعه من معوق آخر يتعلق بنقل المصطلحات الغربية إلى العربية وتقديمها بصورة مطلقة خالية من أي اعتراض أو نقد، والمشكلة هنا تكمن في الخصوصيات الثقافية لكلتا اللغتين المُترجم منها والمُترجم إليها، خاصة وأن بعض المصطلحات العربية التي يوظفها المترجم للتعبير عن مصطلح غربي حديث لها أصول في الموروث الثقافي العربي، والتي قد يتم تحويرها، أو أنها موجودة أصلا فيترجم العربي المصطلح الغربي بوضع لفظ آخر، فينتج تعددية مصطلحية تشتت قارئ النص العلمي والباحثين فيه. ويزداد الأمر تعقيدا حين يتعلق الأمر بالعلوم الإنسانية، فقد ينسى أو يتناسى المترجم ما تنطوي عليه تلك المفردات من عمق تاريخي وفكري وثقافي يستدعي التريث والتعامل معها بنوع من الحذر، وذلك لأنه ليس من السهل اقتلاعها من جذورها وإقحامها في نص ثقافة أخرى. ولقد تفطن الناقد الأمريكي ج. هلس ميلر G-H-Miller إلى ذلك في مقاله بعنوان “اجتياز حدود الترجمة النظرية” في كتابه الموسوم بـ “قابلية الثقافات للترجمة” قوله: «إن ثمة مفردات في الثقافة تستعصي على الترجمة[…]لأن تلك المفردات لها تاريخ طويل ضمن الثقافة الغربية ومن غير الممكن فصلها عن ذلك التاريخ»[20]، لذلك يجد المترجم نفسه إزاء نقل ثقافة، بكل ما تحمله من خصوصيات، بترجمته للمصطلح إلى اللغة الأخرى.
- حداثة البحث اللساني ومصطلحاته في الوطن العربي
اللسانيات حقل علمي حديث، ما يزال مجهولا نسبيا في الوطن العربي، إلا لمن خاض غمار البحث فيه أو في أحد فروعه، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه علم جديد مؤصل باللغات الغربية، وما دامت اللسانيات تتصف بالجدة ومازالت مناهجها ونظرياتها ومصطلحاتها قيد النقاش في البلدان التي أنتجتها، فكيف الحال في البلدان التي تستوردها، مما يفرض على درسنا تبعات أخرى تتصل بتداخل المصطلحات في لغتها الأصلية، وتعدد الاتجاهات، واختلاف المناهج لاختلاف طبيعة هذا العلم الفكري عن غيره من العلوم الطبيعية والرياضية ونحوها، فهذه الحالة ليست مقصورة على اللغة العربية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى اللغة الأجنبية التي نشأ منها المصطلح. وأن ما بين أيدينا من نتائج حققها هذا العلم (اللسانيات) لا يصلنا إلا عن طريق الترجمة، والتي غالبا ما تأتي متأخرة. لذلك يجد الباحث العربي نفسه واقعا بين خيارين:
الأول: إما أن ينهل من الأعمال اللسانية المترجمة إلى اللغة العربية.
والثاني: وإما أن ينهل من الأعمال اللسانية المكتوبة باللغات الأجنبية.
والمشكلة في الخيار الأول أن «الترجمات اللسانية هي ترجمات نابعة من اهتمامات شخصية، وليست مترجمة نتيجة لخطة منهجية أكاديمية»[21]، لذلك تتباين ترجمة مصطلحاتها التي لا تخضع لمعايير ثابتة خاصة تلك الترجمات التي يقوم بها الباحثون ارتجالا، دون الرجوع إلى ما اتفقت عليه الهيئات والمؤسسات القائمة على وضع المصطلحات وأصحاب الاختصاص. ما أنتج كمّا كبيرا من المصطلحات اللسانية التي يعوزها الأساس العلمي واحترام ضوابط وضع المصطلحات في العربية، والتي تجعل الاعتراف بها وتوطينها في معاجم الاختصاص غير ممكن.
وأما الخيار الثاني فيبقى حكرا على من يتقنون اللغات الأجنبية دون غيرهم، فالقراء العرب المهتمون بالبحث اللساني يتفاوت تمكنهم من اللغات الأجنبية «ذلك أنه لو أراد الانسان العربي أن ينظر إلى هذا العلم عن طريق اللغات الأجنبية فإنه سيقع في إطار ثقافة النخبة التي تبتعد عن ثقافة الجماهير الواسعة والعريضة»[22].
نستنتج من ذلك كله أن المشكلة تتعلق بترجمة هذا العلم كله إلى اللغة العربية ترجمة منسقة ومنهجية. ويعني هذا أننا بحاجة إلى متخصصين بهذا العلم حتى يتمكنوا من ترجمته على نحو علمي موضوعي مفهوم، منطلقين من معارف عربية أصيلة في النحو والبلاغة والكتابة العربية الواضحة، تقودها جهات رسمية ومؤهلة عبر كامل تراب الوطن العربي تتظافر جهودها في مواجهة قضية المصطلح.
- الحلول المقترحة لتوحيد المصطلحات وترجماتها
لقد بُذلت جهود كثيرة ومازالت تُبذل في قضية وضع وتوحيد المصطلح العلمي العربي، ولكن تلك الجهود ليست كافية نظرا لما تعرفه الساحة المصطلحية من فوضى وخلل في الطرق والوسائل المنهجية لوضع وترجمة المصطلحات. وتداركا لهذا الخلل الذي يشوب العمل المصطلحي في ربوع الوطن العربي يقترح اللغويون سياسات ومناهج وآراء تجدر العناية بها ودراستها للاستفادة منها لحل المشكلة، ومن بين هذه المقترحات:
- ضرورة توثيق المصطلحات
نظرا للانفجار المعرفي الذي يشهده العالم، وكثرة المصطلحات المستحدثة في حقول المعرفة المختلفة، أصبح توثيق هذه المصطلحات وجمعها ودراستها من الأهمية بمكان، لذلك اتجه الغرب إلى إنشاء بنوك ومؤسسات ووكالات وجمعيات لها الدور البارز في حقل المصطلحات وتوثيقها، فظهرت عندهم مؤسسة (ISO) في جنيف و(FIH) في فرصوفيا، و (SIMENS) في ميونخ و (C.I.L.F) في فرنسا، ووكالة الرابط الدولي في روما، وجمعية الجامعات في باريس والبنك الإقليمي للكلمات في كندا.
ولقد رأى المختصون أن عملية توحيد المصطلحات في الوطن العربي وإشاعتها تقتضي الأخذ بتوثيق المصطلحات العلمية. ومن ثم ظهر عند العرب بنك معهد الدراسات والأبحاث للتعريب (معربي) في الرباط، فهو أقدم بنوك المصطلحات العربية وأكبرها مادة، والبنك التابع لمكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية بالرباط، وبنك المصطلحات في مجمع اللغة العربية الأردني، والبنك السعودي للمصطلحات (باسم)، وبنك “قمم” (قاعدة المعطيات المصطلحية) لدى المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية في تونس.
فوائد البنوك:
يُجمل علي القاسمي فوائد البنوك المصطلحية المحوسبة في النقاط التالية[23]:
- حداثة المعلومات: حيث إنه بإمكاننا أن نجد المصطلح بعد لحظات من تخزينه في البنك، بينما قد يستغرق وصول المصطلحات الجديدة أعواما أحياناً من تاريخ وضع المصطلح إلى حين ظهوره مطبوعا في معجم تقليدي.
- سهولة تخزين المصطلحات وتجميعها: وذلك بالتعاون مع بنوك المصطلحات الأخرى المماثلة، كما يمكن إنشاء شبكة عربية للمعلومات المصطلحية بالتنسيق إداريا وتقنيا بين أطراف الشبكة، خاصة توحيد مواصفات البنوك ومعايير المعلومات المُدخلة.
- مساعدة المترجمين في عملهم وذلك من خلال تزويدهم بالمقابلات المطلوبة في لغة الهدف أو اللغة المترجم إليها بسرعة ودقة مع جميع المعلومات اللازمة عنها.
- وينتج من الميزات الأربع أعلاه ميزة هامة خامسة، وهي توحيد المصطلحات، فعندما ترتبط عدة هيئات وعدد كبير من الأفراد بمصدر واحد للمصطلحات (البنك) فإن هذا سيعينهم على عدم تكرار العمل ووضع مصطلحات جديدة لما تم وضعه من جهة أخرى، كما ينتج عن ذلك توفير الجهود المهدرة في قيام عدة أطراف بالعمل نفسه.
- التعرف على التكرار والتناقض في المصطلحات: عن طريق الاسترجاع الفوري للمعلومات عن أي مصطلح مخزون في ذاكرة الحاسب الآلي. ويتأتى ذلك أيضاً من إمكانات الترتيب والتصنيف والتجميع الآلي السريع وفق مواصفات مختلفة (مثلا ترتيبا ألفبائيا وفق المصطلحات في اللغة ع أو ج، أو وفقا للتخصص العام أو الفرعي، أو المصدر، أو التشابه الشكلي… الخ).
- توفير الوقت والجهد والمال: حيث إن الباحث يستطيع بالكتابة على لوحة المفاتيح البحث عن مصطلح ما في ثوانٍ معدودات، وهو ما يساهم في تيسير الاطلاع عليها واسترجاعها ونشرها، بدلا من ساعات قد يقضيها في البحث في عدد كبير من المعاجم المطبوعة. كذلك يتم توفير الجهد والمال باشتراك عدد كبير من المستفيدين من البنك الواحد.
- التوثيق: لعل من الميزات الهامة لبنوك المصطلحات كونها قواعد معطيات (معلومات) كذلك. من ثم توفر لنا كثيراً من المعلومات التي لا نجدها في المعاجم التقليدية، مثل المعلومات الخاصة بمصدر المصطلح وتاريخ المصدر مما يساعد المستفيد في التعرف على درجة الموثوقية المصطلح وحداثته.
- بث الوعي المصطلحي في الوطن العربي
تدعو الحاجة إلى نشر الوعي المصطلحي بين الأساتذة والطلبة بتوفير المعاجم المتخصصة والنشرات والمجلات والدوريات المعنية بالمصطلح العلمي، ومتابعة الجامعات مدى التزام الأساتذة بتوظيف المصطلح الموحد في التدريس والبحوث والتأليف. وخدمة لهذه المساعي تبرز أهمية إقامة دورات للأساتذة الجامعيين في التخصصات المتجانسة على المستوى القطري والقومي، يتم التعريف بالأبحاث والمصطلحات وتشجيع الأساتذة على الانخراط في تلك الدورات والاسهام فيها فيساعد على تحقيق غاياتها فتصير الدورات منتديات علمية لتبادل الخبرات ويفضل أن يعقد المكتب (مكتب تنسيق التعريب) هذه الدورات.
- كفاءة مترجمي المصطلحات
يحتاج التخطيط المصطلحي الدقيق والسليم مجموعة من المترجمين والمصطلحيين الأكفاء الذين يقومون بوضع برنامج زمني معين لكل موضوع لساني نريد أن نترجمه. وهذا بالطبع يتم بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العربية والاسلامية. وينبغي أن يشرف على هذه الخطط لسانيون مختصون باللسانيات وفروعها النظرية والتطبيقية. وهذا التخطيط العلمي الواعي لعملية الترجمة سيمكننا من تأسيس علوم معرفية نافعة لمجتمعنا العربي إذا عرفنا كيف نستثمر هذه الترجمات في الثقافة العلمية العربية المعاصرة.
والواقع أننا في وقتنا الراهن نحتاج تكوين الكفاءات التي تقوم بالترجمة في المجالات العلمية واللغات المتخصصة، وبما أن تنمية الكفاءات تتم في البرامج التدريبية، وهذا غير متاح في معظم المعاهد والكليات العربية فيمكن أن تكسب أثناء ورشات العمل.
6-4 ضرورة وضع المعاجم المتخصصة الموحدة وحوسبتها
المعاجم الموحدة هي معاجم متخصصة لمصطلحات العلوم والفنون يُقصد منها توحيد المصطلحات المتعددة والمنتشرة بشكل فوضوي على الساحة العلمية والمعرفية العربية. ويعاني الباحثون والمترجمون العرب خصوصا من النقص الشديد في المعاجم المتخصصة باللغة العربية، فلو أنك تترجم نصوصًا متخصصة واردة حديثا في المؤلفات الورقية أو المحوسبة، لن تجد ما يمكن أن يسعفك سوى المعاجم الإنجليزية أو الفرنسية وموسوعة الويكيبيديا لكي تفهم معنى المصطلح الأجنبي، وعندما تبحث عن الترجمة العربية الملائمة لهذا المصطلح، تصطدم بمرادفاته أو غيابه.
والجدير بالذكر أن ثمّة مدرستان مصطلحيّتان يصعب على الباحث أن يتجاهل جهودهما الكبيرة عند الحديث عن ظاهرة توحيد المصطلح في المعاجم، كونها تشكّل عندنا نحن –العرب- أزمة حضاريّة، هما: مدرسةٌ مشرقيّةٌ يمثّلها مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، وأخرى مغربيّة يمثّلها مكتب تنسيق التعريب في الرّباط؛ إذْ صدر عن مكتب التنسيق (25) خمسة وعشرون معجمًا موحَّدًا، وعن المجمع (16) ستّة عشر معجمًا- يجزم بصحّةِ وجودهما وصدقِه، وبأنّ كلّ مؤسّسة منهما تعمل بمعزل عن الأخرى، وتشكّل مدرسة مستقلّة في دراسة المصطلح ونَقْله إلى العربيّة.
وثمّة معاجم أخرى صدرت بالتعاون مع مؤسسات واتحادات عربية وكلّها معاجم تهدف إلى التخلّص من ازدواجيّة المصطلح، ولكن ما فائدة أن تبقى هذه المصطلحات حبيسة الكتب بعيدا عن الاستخدام الموحّد من المحيط إلى الخليج؟ فالمصطلح تدبّ فيه الحياة ويغدو مألوفًا مع الممارسة وكثرة الاستعمال.
وبحكم أهمية ما تصدره المجامع اللغوية من معاجم متخصصة موحدة ودورها الفعال في حل أزمة المصطلح العربي، لابد من مواصلة العمل الحثيث في وضع هذا النوع من المعاجم في العلوم التقنية وخاصة الحاسوبية التي تشهد تطورا مصطلحيا مذهلا، وتقسيم مهام وضعها بين المجامع في المشرق والمغرب العربي حتى تلبي المعاجم الموحدة حاجة الباحث العربي في أوانها.
- تنسيق جهود الهيئات القائمة على وضع المصطلحات وترجمتها
إن المجامع اللغوية العربية، ومؤسسات التعريب، تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء التطور العلمي الذي تحاول اللغة العربية مواكبته، غير أنها لا تمتلك سلفا فرض المصطلحات والكتب المعربة على الجامعات والمؤلفين، ودور النشر، ويساعد على ضمور هذه السلطة عدم وجود تشريعات حكومية عربية لحماية اللغة العربية تطبق بصرامة وقوة، ومادامت الحال كذلك تبقى جهود المجامع ناقصة، إذ يحتاج توحيد المصطلحات الاحترام والتقيّد بما تتفق عليه الجماعة في وضع المصطلحات.
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة يجب التأكيد على ضرورة حشد الجهود في سبيل حل مسألة توحيد المصطلح العربي باعتباره «ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصل بهويّة هذه الأمة وإشاعة العلم الجديد بينها، ومن ثمّ يكون لها مكان خاصّ في هذا العالم الجاد المتطلّع إلى الجديد»[24]. وينبغي النظر إلى قضية توحيد المصطلح باعتبارها قضية قومية لا مناص من حسمها، حتى يستقر البحث ونستطيع تأسيس قاعدة متينة لتطوير معارفنا ولحاق قافلة التقدم العلمي والتكنلوجي التي تسير بخطى متسارعة وثابتة. وتتلخص أهم توصيات البحث في سبيل توحيد ترجمة المصطلح العربي في النقاط التالية:
1- أن تكون ترجمة المصطلح اللساني على أسس وضوابط علمية محددة، بحيث يكون وضع المقابل بمنهجية توافق قواعد اللغة العربية، إن المصطلح المولد ينبغي أن يكون مقبولا في بنيته الصوتية والصرفية وخصائصه التركيبية والدلالية.
2- تحديد أسباب اضطراب الترجمة اللسانية، وتعدد المصطلح من باحث لآخر على الرغم من انتماء هؤلاء إلى بيئة واحدة وعصر واحد، وتأسيس ورشات دائمة للترجمة وفق خطة واضحة المعامل تخضع لمؤسسة أو هيئة رسمية.
3- التعاون بين المترجمين والمصطلحيين ذوي الكفاءة والخبرة ومشاركة أهل الاختصاص في موضوع المصطلح، لتحقيق الترابط والاتصال بينهم تجنبا لاختلاف المنهجيات، بتبني منهجية واحدة ثابتة في ترجمته.
4- الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال الترجمة ووضع المصطلح والاستفادة منها مع التنسيق مع المجامع اللغوية والهيئات الدولية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO).
5- تحري الدقة في ترجمة المصطلح اللساني العريب حتى لا يكون المقابل متعددا لأن ذلك يكرس الازدواجية الدلالية في المصطلح العربي.
قائمة المصادر والمراجع
- العربية
- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تح. عبد السلام محمد هارون، الجزء الأول، دار جيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1996.
- ابن منظور، اللّسان، تح. عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف. (دت).
- ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، الجزء 3 ، (دت).
- إبراهيم أنيس وآخرون، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، (دت).
- إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1982.
- الأمير مصطفى الشهابي:
– المصطلحات العلمية وألفاظها العربية، مجلة المقتطف المجلد 84 الجزء 1، القاهرة 1934.
– المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، الطبعة الثانية، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1965.
- بن معمر بوخضرة، إشكالية معالجة المصطلح في الترجمة، مجلة مقاليد، العدد الأول جوان 2011، الجزائر.
- وليد محمد السراقبي، فوضى المصطلح اللساني، مجلة اللغة العربية، مجلد 83، الجزء 2، دمشق، 2008.
- مازن الوعر، مشكلات الترجمة في المصطلح العربي اللساني (PDF).
- محمد الديداوي:
– الترجمة والتواصل، دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2000.
- إشكالية وضع المصطلح المتخصص وتوحيده وتوصيله وتفهيمه وحوسبته، مكتب الأمم المتحدة، جونيف، 2008.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية، الرباط 1989.
- مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1994.
- محمد رشاد الحمزاوي، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها (الميدان العربي)، الطبعة الأولى، دار الغرب الاسلامي، 1986.
- عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، -ليبيا- تونس، 1984.
- عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، دار توبقال للنشر الطبعة الثالثة 1993.
- علي القاسمي، المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي، مجلة اللسان العربي، العدد 27، الرباط، 1986.
- روجرت بيل، الترجمة وعملياتها النظرية والتطبيق، ترجمة محي الدين حميدي، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض، 2001.
- الشريف الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1978.
ب- الأجنبية
- Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 1973.
[1] ابن منظور، اللّسان، تح. عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، مادة (ترج)، ص 426.
[2] مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، لبنان، باب الميم 1994، ص 73.
[3] إبراهيم أنيس وآخرون، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط2، القاهرة، (دت)، ص 83.
[4] J. Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 1973.P486.
[5] روجرت بيل، الترجمة وعملياتها النظرية والتطبيق، تر. د. محي الدين حميدي، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض،2001، ص42.
[6] المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية، الرباط 1989، ص 155.
[7] ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، ج3 ،دت، ص 303.
[8] الشريف الجرجاني، التعريفات، بيروت، لبنان، مكتبة لبنان، 1978 ،مادة صلح، ص 28.
[9] الأمير مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ط 2، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1965، ص 6.
[10] عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، دار توبقال للنشر الطبعة الثالثة 1993، ص 228.
[11] محمد الديداوي، الترجمة والتواصل، دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم، ط1، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2000.، ص 52.
[12] أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تح. عبد السلام محمد هارون، ج1، دار جيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1996، ص 75، وص79 (بتصرف).
[13] الأمير مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ط 2، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1965، ص 4، وص93 (بتصرف).
[14] الأمير مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية وألفاظها العربية، مجلة المقتطف مج 84 ج1، القاهرة 1934، ص 175.
[15] محمد الديداوي، إشكالية وضع المصطلح المتخصص وتوحيده وتوصيله وتفهيمه وحوسبته، مكتب الأمم المتحدة، جونيف، 2008، ص4.
[16] محمد رشاد الحمزاوي، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها (الميدان العربي)، ط1، دار الغرب الاسلامي، 1986 ص 53.
[17] الأمير مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص 93.
[18] وليد محمد السراقبي، فوضى المصطلح اللساني، مجلة اللغة العربية، مج 83، ج2، دمشق، 2008، ص 391.
[19] عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، -ليبيا- تونس، 1984، ص 55-56.
[20] بن معمر بوخضرة: إشكالية معالجة المصطلح في الترجمة، مجلة مقاليد، العدد الاول جوان 2011، الجزائر، ص 19.
[21] المرجع السابق، الصفحة نفسها.
[22] مازن الوعر، مشكلات الترجمة في المصطلح العربي اللساني (PDF)، ص 49.
[23] علي القاسمي، بنوك المصطلحات أسسها، وأنواعها، واستعمالاتها، مقال (PDF)، ص17.
[24] إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1982، ص111.