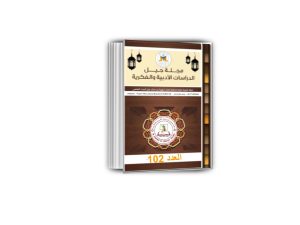إشكالية الصدق والكذب في الشّعر العربي بين الأخلاقي والفني
The problematic of honesty and lying in Arabic poetry between moral and artistic
خالد هلالي: باحث في التواصل، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
Khalid HiLALi : Researcher in Communication: University of Sidi Mohamed Ben Abdallah Fes, Morocco
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 51 الصفحة 85.
Abstract:
This study is an attempt to re-discuss the monetary phenomenon of “honesty and lying in ancient Arabic poetry”. According to a different view of previous studies, to some extent .
these studies are interested in collecting several opinions about truthfulness and lying , Did not exceed simple impressions such as (ugliness, quality ,honest poet…etc) . Without determining the point of view of each critic accurately of moral, technical level of this binary.
ملخص:
كثيرة هي الظواهر النقدية التي تمت معالجتها في كتب النقد العربي؛ كالسرقات الأدبية والمعارضات، واللفظ والمعنى، وعمود الشعر، والضرورات الشعرية…الخ. وهي ظواهر حاول نقاد الأدب التدقيق فيها واستخلاص ما يميّزها. لكن ما يلاحظ أنّ إشكالية الصدق والكذب لم يتم التعامل معها بنفس الصرامة النقدية التي عولجت بها تلك القضايا. وهذا راجع لعدة اعتبارات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي. فالتعقيدات التي طبعت تلك الظاهرة وصعوبة فك مغاليقها كانت سببا في هذا الاحتشام الذي نجده في الدراسات التي عنت بإشكاليتي الصدق والكذب. فالنقاد الذي دقّقوا في خصوصياتها وفق منهج عقلاني لا يتجاوزون رؤوس الأصابع، بل إن معظم الدراسات لا تتعدى وجهات نظر وانطباعات بسيطة في القبح والشناعة والجودة التي وسموا بها أبيات شعرية قديمة.
وهذه الدراسة هي محاولة متواضعة لإعادة النقاش في هذه الظاهرة النقدية، وفق رؤية اعتبرها مغايرة للمقاربات التي اكتفت بتجميع وجهات نظر متنوعة عن الصدق والكذب دون تفريعها وتحديد رأي كل ناقد بشكل دقيق فيما يخص المستوى الأخلاقي والفنّي والإيهامي لتلك الثنائية.
الكلمات المفاتيح: الصدق، الكذب، الأخلاقي، الفنّي، الإيهامي، الغلو، المبالغة، الإفراط، التناقض، الاستحالة.
توطئة:
مناقشة النقاد لإشكاليتي الصدق والكذب ظهرت في سياق نقدي وثقافي تزامن مع التطور الذي عرفه العصر العباسي في مجموعة من الجوانب، وهي أحد الظواهر النقدية الكثيرة التي تمّ التطرق إليها وإن بدرجات مختلفة؛ كالسرقات الأدبية، واللفظ والمعنى والمعارضات …الخ. فالتغيّرات الاجتماعية وكذا السياسية ومتطلبات المدنيّة الجديدة أرخت بظلالها على الإبداع الشعري وأضحى الشعراء يرصّون قولهم بمعاني أكثر جرأة وبعدا عن القصيدة الكلاسيكية، فكان طبيعيا أن تظهر أشعار بلون جديد إن لفظا أو معنى.
وقد استفزّت هذه الثنائية النقدية العديد من الدارسين من نقاد وفلاسفة وبلاغيين، وذلك لعدة اعتبارات متنوعة؛ لعل أهمّها محاولة تحصين المنجز الشعري بقواعد تُراعَى في العملية الإبداعية، وتبعد عنه الشناعة والقبح والعيوب. وكذلك الرغبة في تمتيع القول الشعري بميكانيزمات جديدة، وكذا محاولة تقريب الدلالة الشعرية إلى المتلقي في صورة تضمن التفاعل مع ما يصبو الشاعر إرساله.
ورغم أنّ معالجة النقاد لموضوع الصدق والكذب كان مبتور الأطراف في كثير من الأحيان؛ حيث اهتمّوا بتحديد معناه، ولم يتّخذوه مقياسا للأدب.[1] فإنّ ذلك لا يمنع من إظهار بعضا من جوانبه وارتباطاته مع مفاهيم أخرى، متحدّثا في الآن نفسه عن أهم التفريعات التي ارتآها النقاد والبلاغيون و الفلاسفة أو دافعوا عنها حجّة وبيانا. دون أن أغفل مظاهر الاختلاف بينهم في التمييز بين الصدق والكذب، إذ قال ” الأكثر منهم صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه له. […] وقال بعض الناس صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان أو خطأ، وكذبه عدم مطابقة حكمه له”.[2] فقاسوا في الصدق بين القول وامتثاله لمعطيات الواقع، وماثلوا في الكذب بين القول و عدم ملاءمته لما يحيط بالإنسان من أشياء ومعطيات، بل منهم من ربط كلّ ذلك باعتقاد وإيمان المتكلم بما يقوله، فقد يكون القول مخالفا لقناعات المخبِر، وإذ ذاك يسقط في شرك الكذب.
وتفاديا للغوص في خبايا هذه الإشكالية النقدية بدون هدف محدّد، ومن أجل وضع حدود للموضوع، ارتأيت أن أسيّج هذه الدراسة بحباك، حيث حصرت زاوية المعالجة في الجانب الفنّي والأخلاقي للصدق والكذب التي طبعت بعضا من جوانب التراث العربي القديم.
فالتطرق الى الصدق والكذب يرتبط أوّلا بالمعاني الشعرية، ومن جهة أخرى يقترن بالجودة الشعرية، ويدخل كذلك في إطار تقييم عمل الشعراء، بل هو في مرحلة أخرى قراءة لواقع الشعر العربي بناء على فهمهم للفلسفة اليونانية ونظرة كل من أفلاطون وأرسطو. كما يرتبط بكيفية التعاطي مع القصيدة، باعتبارها” كليّة لا تسعى للانسلاخ عن الواقع الذي أنتجها، بل هي تسعى إلى تجاوزه”.[3] وخرق قواعده وتخطّيها بقول مخيّل قد يجعل الكذب والامتناع والتناقض سمة تطبع ذلك الإبداع، مبتعدا فيه عن القول الصادق.
أوّلا: إشكالية الصدق في الشعر العربي القديم:
1 ـ الصدق الأخلاقي:
المقصود بهذا النوع من الصدق ذلك الشعر الذي يسعى إلى التعبير عن الوقائع بلغة صادقة لا تزييف فيها ولا تحريف للأشياء كما هي في حد ذاتها؛ وهذا يستدعي من الشاعر تنظيم قوله وفق معايير مضبوطة ومغايرة في الآن نفسه للكلام الشعري الذي يجنح فيه بعض الشعراء إلى الاتساع في القول وركوب الغلو والمبالغة ودخول غمار التناقض والاستحالة. فهو قول بتعبير القرطاجني مطابق ” للمعنى على ما وقع في الوجود”.[4] وقد ذهب مجموعة من النقاد والدراسين إلى التمييز بين الصدق الأخلاقي والآخر الفنّي. وهو تنويع يميّز بين الشعر الذي يحتكم فيه مناصروه إلى النظرة الدينية في تحديد خصوصياته، والمقياس هو عدم الخروج عن الضوابط الموضوعية التي تخصّ الغرض الشعري من مدح أو هجاء أو رثاء. وهو توجّه “يتّسق مع موقف القرآن الكريم والرسول في قبول ماكان منه أخلاقيا متمشيا مع تعاليم الدين، ورفض ما عداه “.[5]
ولعلّ أولى الإشارات النقدية التي حاولت تقييم بعضا من الأشعار الجاهلية، نجد التفاتة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يرسم حدود الصدق في تقييمه لمديح زهير بن أبي سلمى إذ كان ” لا يمدح الرجل إلا بما فيه “. [6] أي يمدحه بما يتمتّع به من سلوك وخصال ومعاملات حقيقية لا ممزوجة بالكذب والمبالغة والتهويل. وهي محاولة رسّخت لمنوال نقدي جديد يعتمد على التعبير الصادق في القول دون مواربة أو تحايل في المعنى. وهو منوال اعتمده العديد من النقاد في تحليلهم للنص الشعري؛ وإن بكيفية أكثر توسّعا وتخصيصا، ومن بينهم ابن طباطبا العلوي (322ه)، الذي ارتكز في انتصاره لمبدأ الصدق في الشعر إلى الأشعار الجاهلية والإسلامية، وما كانت تجنح إليه من قول الصدق” مديحاً وهجاء، وافتخاراً ووصفاً، وترغيباً وترهيباً […] وكان مجرى ما يريدونه منه مجرى القصص الحق، والمخاطبات بالصدق فيحابون بما يثابون، أو يثابون بما يحابون” .[7] والحالات الصادقة التي قد يوظّفها الشاعر في مدحه أو هجائه أو فخره ….الخ، يزداد تأثيرها في المتلقي إذا ” أيّدت بما يجذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلفة فيها، والتّصريح بما كان يكتم فيها، والاعتراف بالحق في جميعها”.[8] ومن شدّة نزوعه إلى الصدق، ضمّ عيار شعره قِسما سمّاه بـ: المثل الأخلاقية عند العرب وبناء المدح عليها، ومن بين ما وجده ساريا في أشعار العرب، نجد “الاستكثار من الصدق”.[9]
فقد وسم مفهومه للصدق بمعطى ديني أخلاقي، وهذا ما عابه جابر عصفور الذي يرى أنّ الصدق عن ذات النفس لا يعني المنحى الأخلاقي المنحصر دائما في قالب الحكمة. ولا يعني كذلك وضع الشعر في مرتبة هيّنة، خصوصا لو كان المنحى الحكمي الذي جاءت التجارب بصدقه غير واضح[10]. كما أن الصّدق الذي دعا إليه ابن طباطبا يضيف جابر عصفور، يقود إلى مأزق آخر؛ ذلك أنه يثبت مفهوم المحاكاة من زاويتين: الأولى خارجية تتصل بصدق الشعر في ذكر الأحداث والوقائع والأوصاف أمّا الزاوية الثانية الداخلية، فتتصل بصدق الشاعر عن ذات نفسه، بكشف المعاني المختلجة فيها؛ وهذا ما يغيّب الطابع التشكيلي لعمليّة الإبداع الشعري، إضافة إلى أنّه يجعل القصيدة محض محاكاة أو انعكاس آلي لعالم داخلي أو خارجي.[11] ومن مخاطر مقولة الصدق بهذا المفهوم أيضا، أنها تصرفنا عن الشعر إلى الشاعر؛ حيث يسعى الناقد إلى الكشف عن مدى التطابق بين القصيدة وصاحبها.[12] وهذا ما حدا بجابر عصفور إلى تجاوز مقولة التطابق في تفسير القول الشعري . [13]
واستمرت تلك النظرة التخصيصية لمفهوم الصدق من زاوية خلقيّة محضة من طرف لسان الدين ابن الخطيب، الذي ذهب إلى أنّ الكذب يتضاد و مبادئ الإسلام، فالمجيد من الشعراء في نظره من اهتم بـ” نصاعة اللفظ وقصَد الحق وقُرب المعنى وإيثار الجذاذ”.[14]
ونفس المقاربة الأخلاقية اعتمدها القاضي عياض في تقييمه لبعض الأشعار إذ لم “يتأخرّ عن إسقاط الأبيات الشعرية التي يأباها الخلق، وقد علّق مرّة على أحد هذه الأبيات، فقال: وبعد هذا بيت قبيح تركناه لفحشه ورفثه وإن كان بيت الأبيات الثلاثة في بابه”.[15]
ومن الأبيات التي يرى أن أصحابها خرجوا عن جادة القول، بيت المتنبي:
أنا في أمّة تداركها الله غريب كصالح في ثمود
معلّقا “فهذا البيت ونظراؤه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام من الشعر الذي نال فيه قائلوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك دون قصد”.[16]
فالنظرة التي حكمت أراء هؤلاء النقاد ارتكزت على معطى خلقي تماشيا مع مبادئ الإسلام وقواعده. وهي رؤى تنوعت بين لمحة ذوقية بسيطة اعتمدت على استحسان البيت الشعري الواحد أو رفضه؛ من قبيل أحسن بيت وأردأ بيت، دون تبرير ذلك الاستحسان او الاستهجان، إذ لم تخرج في عمومها عن الأحكام النقدية التي طبعت العصر الإسلامي وما تلاه. ونجد قراءة نقدية ثانية استقرائية لمجموعة من الأشعار القديمة، كصنيع ابن طباطبا؛ وهي عملية حاولت دراسة خصوصيات العديد من الأشعار على مستوى الشكل والمضمون.
2 ـ الصدق الفني:
هو الوجه الآخر للصّدق، فإذا كان الصدق الخُلقي قائم على معايير موضوعية تُراعي مبدا الإئتمان في وصف معطيات الواقع وتقريبها إلى المتلقي من مدح وفخر وهجاء، ما دام القياس في ذلك هو مراعاة الجانب الأخلاقي واستحضار المعطى الديني في كلّ عملية إبداعية. ففي الصدق الفني تبدو معطيات أخرى تنضاف إلى كل ذلك، وفق خصوصيات جديدة قد تتجاوز المطابقة الحرفية بين الواقع والمنجز الشعري إلى ركوب معاني أخرى متغايرة. حيث تجيء ” الصورة الشعرية معبّرة عن تجربة شعورية حقيقية تعبيرا صادقا، يحسّه القارئ من خلالها، فيتفاعل معها تفاعلا تامّا يساعدها في إحداث التخييل المناسب ذي الإثارة الوجدانية، الذي يعبّر بالصورة حدود عناصرها في الواقع العياني المرصود، و يمنحها قدرة على التوافق مع حركة النفس الشعورية”.[17] والمقصود بصدق التجربة هو أن يكون الأديب قد مرّ فعلاً ولو في عالم الخيال بموقفٍ أثار نفسه وحرّك وجدانه وألهب عاطفته ممّا يجعل نتاجه الفّني صدى لنفسه وصورة حقيقية لفكره. حيث يلاحظ اقتران عنصر الصدق؛ أي صدق الوجدان، أو الصدق الفني، بالتجربة الأدبية.[18] وحيث تظهر قدرات الشاعر على الإظهار الفنّي الملوّن بإيحائية الصور ودلالتها التي تسبح بخيال المتلقي لمعانقة آفاق تخييلية وجمالية فيها التأثير الصادق والصريح.
ومن أولى المحاولات التي تطرّقت إلى هذا الصنف من القول الشعري نجد الأمدي (ت370 ه)، حيث قدّم الصدق الفني على الكذب، وقد صرّح بذلك دون مواربة” لا والله ما أجوده إلا صدقه، إذا كان من يلخّصه هذا التلخيص ويورده هذا الإيراد على حقيقة الباب”.[19] بعد إيراده مجموعة من الأبيات الشعرية لكلّ من البحتري وأبي تمام تخصّ ألم الفراق وصعوبته وما يتركه في نفسية الإنسان.، فإعجاب الأمدي بجودة الأبيات وحسن التخلص الذي امتازت به، وكذا صدق معانيها، هو ما حدا به إلى الإقرار بأن أجود الشعر ما صدق معناه. وفي المقابل عاب بعض الابيات التي سخف لفظها وشانت معانيها. كقول أبي تمام:
ما حسرتي أن كدت أقضي وإنما حسرات نفسي أنني لم أفعل
حيث علّق قائلا “وهذا لفظ ومعنى في غاية الضعف والاختلال والرّداءة”.[20]
فهذا القول يعكس مدى عنايته بالألفاظ والمعاني سواء من حيث الجودة أو السخافة في تقييم الشعر والحكم عليه. كما يكشف سرّ تأييده لمبدأ الصدق الفنّي في الشعر، فكأنّه يريد أن يقول “أنّ أخير الشعر ما صدق معناه، وكذب أسلوبه”. [21]
المرزوقي (ت421هـ) وهو يتحدّث عن عمود الشعر، تطرّق إلى إشكاليتي الصدق والكذب، مبرزا تبرير كل فريق للاتجاه الذي دافع عنه، لكنه تبنّى رأيا وسطيّا، ساعيا إلى الموازنة بين طرفي هذه المعادلة النقدية الصدق والكذب، من خلال إقراره بتوجّه ثالث أسماه بالقصد في القول، مشيرا إلى أنّ” على الشاعر أن يبالغ فيما يصير به القول شعرا فقط ، فما استوفى أقسام البراعة والتجويد أو جلّها، من غير غلوّ في القول ولا إحالة في المعنى ، ولم يخرج الموصوف إلى أن لا يؤمَن بشيء من أوصافه، لظهور السّرف في آياته وشمول التزيّد لأقواله، كان بالإيثار والانتخاب أولى”. [22] فهو يوثر الصدق الفنّي الذي يجيد فيه الشاعر القول، ويضع قصيده موقعا وسطيا دون أن يدخله خانة الغلو ولا الإسراف في القول.
ولعلّ من المحاولات الجريئة التي انتصرت لمفهوم الصدق الفنّي، نجد صنيع عبد القاهر الجرجاني (ت471 ه)، فقد حاول أن يعرّف معنى الصدق؛ حيث رجّح أن يكون المراد به “
ما دلّ على حِكْمة يقبلها العقلُ، وأدبٍ يجب به الفضل، وموعظةٍ تُروِّض جماح الهوى وتبعث على التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في الأفعال، وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصال”.[23]
وهو إذكاء لمعنى العقل ورفع من قيمته باعتباره المتحكم في انتاج المعنى الشعري وتقييمه بالإضافة طبعا إلى عناصر أخرى كالخيال والتخييل والمحاكاة، فما كان “العقلُ ناصرَهُ، والتحقيقُ شاهدَه، فهو العزيز جانبه، المنيع مَنَاكبُه”. [24] كما أشار إلى أنّ المعاني العقلية المُعرقة في الصدق لا تحدّ من الطاقة الإيجابية التخييلية للصدق[25].
فهو صدق لا يلتجأ فيه إلى النقل الحرفي للواقع، بل يترك للشاعر حرية الإبداع والسفر بالخيال دون الخروج عن مقاييس العقل وضوابطه المتّزنة. بل التلطف والرفق في القول هي الرسالة التي حاول الجرجاني ترسيخها في أسرار بلاغته. وكأني به يريد أن يقول أنّ الشعر الصادق هو الشعر المخيّل الذي “يأتي على درجاتٍ”. [26] حيث يعزّز الشاعر قوله بأوصاف أخرى لإضفاء جوانب فنية وجمالية على نصه الشعري[27]. فما ميّز حديث الجرجاني عن ثنائية الصدق والكذب، هو أنّه لم يوغل في التطرق إلى مصطلحات الاستحالة العقلية، بل حدّها في الصدق الفنّي المبني على مقاييس العقل.
أمّا ابن رشد (520 – 595 هـ) فأقرّ ” أن الأقاويل الشعرية التي تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الشاعر، وهي التي تسمى أمثالا وقصصا، مثل ما في كتاب كليلة ودمنة، لكن الشاعر إنّما يتكلم في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود، لأن هذه هي التي يقصد الهرب عنها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها على ما قيل في فصول المحاكاة”.[28]
فقد حصر حدود الإبداع بالنسبة للشاعر في الأمور الموجودة أو التّي يمكن أن توجد، أمّا الأشياء التي لا يمكن للعقل أن يتقبّلها أو بالأحرى يتخيّلها فأخرجها من حسابات الشعر، لأنّ الكذب والاختراع في القول منسوب إلى القصص والأمثال؛ أي ما هو نثري. بل أضاف أنّ محاكاة الأفعال الممكنة تجعل” الإقناع فيها أكثر وقوعا، أعنى التصديق الشعري الذي يحرّك النفس إلى الطلب أو الهروب”. [29] فالقول الصّادق في نظره يؤثّر في المتلقي أكثر من غيره؛ وذلك بالإقبال عن أمر أو الهروب منه.
فقد امتازت رؤية حازم القرطاجني (ت 684 ه) لثنائية الصّدق والكذب، بشموليتها وبنيويتها؛ إذ حاول تفريع الصدق والكذب إلى تصنيفات، محاولا التعاطي مع مختلف الحالات التي يأتي فيها الصدق والكذب، بدءا من مستواه العادي البسيط والممكن إلى مستوى تجاوز الكذب الاختلاقي ومنه إلى الكذب الامتناعي الغير المحدود بضوابط ولا معايير. ورغم حسمه في كون الكلام المخيّل أسّ الشعر وجوهره، بغضّ النظر عن كون معناه صادقا أو كاذبا، وبالرغم من أنّه بسط القول في الذّرى التي تزِن النص الشعري من حسن تأليف، ومحاكاة وترابط بين المعاني، إضافة إلى اختيار الألفاظ المتوسطة التي تستسيغها الأذن، أو الاستعانة بحوشيها وساقطها لضرورة الوزن. كلّ ذلك لم يمنعه من اعتبار أنّ” المعاني التي تكون الأقاويل فيها صادقة أو مشتهرة، أفضل ما يستعمل في الشعر لكونها تحرّك النفوس إلى ما يراد منها تحريكا شديدا”.[30]
فمعظم الآراء التي خبرت خصوصيات الصدق الفنّي اهتمت بجوانب ذوقية ؛ وهي معطيات ارتكزت على مبدأ حسن التخلص في المعاني، ومراعاة مدى جودة الشعر في لفظه ومعناه؛ كالأمدي والمرزوقي . وهناك من اهتم إلى جانب ذلك بالمبادئ المؤسسة للقول الشعري من محاكاة وخيال وتخييل، وهي معطيات زكّت ضرورة امتثالها لمقاييس العقل، وهذا ما حكّمه كلا من الجرجاني وحازم القرطاجني وابن رشد، حيث نشتمّ أثر ومخلّفات القراءة اليونانية للشعر.
ثانيا: إشكالية الكذب في الشعر العربي القديم
أولا: الكذب الفنّي:
القول المتباين عن الواقع سواء في الشعر أو غيره من الفنون التعبيرية ، يرجع إلى فترات سبقت إشارة النقاد العرب إليه، فالكثير من “معارضة عدم صدق الأدب المتخيّل مدوّنة منذ القرن السادس قبل الميلاد، حين اشتكى صولون من أنّ الشعراء يخبرون بأكاذيب كثيرة”.[31] ونفس الشيء زكّاه قدامة بن جعفر عندما ردّ مقولة أعذب الشعر أكذبه إلى فلاسفة اليونان وهم يناقشون مواضيع الشعر وقضاياه [32] إلاّ أنّ هناك من عزاها إلى العصر الجاهلي. [33]
لكن ما يلاحظ أنّ معظم النقاد لم يعتبروا مطابقة الصدق للواقع مقياسا في تقدير الشعر، بل يبيحون له بالكذب، وأن يأتي من الأحكام بما لا يتّفق مع الحقيقة ولا يعنيهم إلاّ صواب المعنى.[34]
وقد رأى أرسطو أنّ الكذب في الشعر أكثر من الصدق، وذكر أنّ ذلك جائز في الصناعة الشعرية.[35] و هو رأي حفّزالفارابي ( 260 ـ 339 ه) للرّبط بين الكذب والشعر؛ وذلك أثناء حديثه عن الأقاويل أو القياسات، مشيرا إلى أنّ” الكاذبة بالكل لا محالة فهي الشعرية”.[36] مبعدا الأقاويل الصادقة من صفة الشعرية؛ وكأنّه أراد أن يقول أنّ “الشعراء كذّب بالمهنة”[37]، بمعنى آخر إنّهم يحترفون الكذب و يستطيعون التصرّف في المعنى بحسب الموقف والسياق.
أمّا ابن عبد ربه (246 ـ 328 ه)، فقد جعل أشعر الناس من يصوّر الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل بلطف معناه.[38] وكأنّه أراد التأكيد على أنّ أكاذيب الشعراء فيها جانب المكر والخداع لأنّها تحتمل الصدق.[39] وتحبيذ ابن عبد ربّه للكذب مرتكز على لطيفة المعنى وجماليته، واستساغته لأفهام المتلقين، فمن الكذب ما يظهر من معناه لكن لا يرقّ ويلين.
والمدخل الأساسي لفهم نظرة قدامة بن جعفر(275 ـ 337 ه) للكذب في الشعر، هو الغلو في القول الشعري بناء على ما استشفّه من الدراسات الشعرية لفلاسفة اليونان، وكذا ما استخرجه من الأشعار العربية القديمة. [40] معتبرا أنّ المراد بالغلو هو المبالغة، منكرا على من اعتبره خروجا عن الموجود والدخول في باب المعدوم. مشيرا إلى أنّ القصد منه وصول مرتبة التجويد في الوصف.[41] وهو كذلك ” تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه، وليس خارجاً عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له”.[42] فقد اعتبر الغلو واجهة شعرية تتيح للشاعر التوسّع في المعنى بغية إضفاء لمسة جمالية أخرى عليه، مادام أنّ الصدق في الشعر باب محدود المعاني، وتجاوزه إلى المبالغة وسيلة لاكتساب الشعر صفة الجودة. وهي رؤية تكشف أنّ الشعراء الذين انخرطوا في هذا الصنف من القول قد طوّروا من استعاراتهم” البيانية المتميزة إلى غلو من أجل المبالغة “. [43] وهو رأي لا يمكن اعتباره مقياسا، مادام هناك من الأشعار الصادقة المعنى التي لاقت استحسانا لجمالية ألفاظها وروعة وصدق معانيها.
أبو هلال العسكري ( ت 395 ه) في توصيفه لهذه الإشكالية النقدية، ابتدأ بتقسيم المعاني إلى المستقيم الحسن والمستقيم القبيح، والمستقيم الكذب، والمحال الذي اعتبره ممّا يفسد الكلام. [44] وهو تقسيم يبسط فيه الرأي عن خصوصية كلّ واحد منها، كما أنّه يشي أنّ الخروج إلى الكذب في الكلام قد يأتي في الشعر كما في الكلام العادي. متناولا خصوصية الشّعر وما بني عليه من صفات؛ مرشدا إلى أنّ أكثر الشّعر “قد بُنِيَ على الكَذِبِ والاستحالَةِ مِنَ الصفاتِ الممتنِعَةِ، والنُّعوتِ الخارِجَةِ عَنِ العادات، والألفاظ الكاذبةِ مِنْ قَذْفِ المُحصناتِ، وشَهادَةِ الزُّورِ وقَولِ البُهتان؛ لا سيَّما الشِّعرُ الجاهليُّ الذي هو أقوى الشِّعرِ وأفْحَلُه” [45] .
وقد زكّى غلبته للكذب في الشعر، بقولة لأحد الفلاسفة، عندما سئل أحدهم ” فُلانٌ يَكذِبُ في شِعرِه؛ فقالَ: يُرادُ مِنَ الشاعِرِ حُسنُ الكلامِ، والصِّدقُ يُراد مِنَ الأنبياء” [46] . وهو بذلك يميّز بين الصدق في القول الذي يخصّ الأنبياء، وبين حسن الكلام وجودته لفظا ومعنى التي يجب أن تسم الشّعر حتّى وإن كان كاذبا إذ لا” يُراد منه إلاّ حُسنُ اللَّفظِ وجَودَةُ المعنى؛ هذا هو الذي سوَّغ استعمال الكَذِبِ وغيرِه ممَّا جَرى ذِكْره فيه “.[47]
فالعسكري انتصر لمبدأ الكذب في الشعر؛ مميّزا فيه بين الاستحالة في الصفات، وما خرج عما ارتضته الجماعة من قوانين وأعراف يجيء بها الشاعر، وهي معايير استعملها الشعراء لتجويد صناعتهم الشعرية لفظا ومعنى. وهذا ما ينفرد به الشعر عن الخطب والرسائل، ما دام “له مواضع لا ينجع فيها غيره”.[48]
ابن سينا ( 370 ـ 427 ه ) اعتمد مبدأ المغايرة في القول لتبريره الكذب موحيا إلى ارتباط الكلام الذي يخرج عن العادة بالتخيّل الذي هو جوهر العمل الشعري الذي تنفعل له النفس “انفعالاً نفسانياً غير فكري، سواء كان المقول مصّقاً به أو غير مصدق به. فإن كونه مصدقاً به غير كونه مخيّلاً أو غير مخيِّل. فإنه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه؛ فإن قيل مرّة أخرى وعلى هيأة أخرى انفعلت النفس عنه طاعة للتخيّل لا للتصديق. فكثيرا ما يؤثّر الانفعال ولا يحدث تصديقا، وربما كان المتيقن كذبه مخيّلا”. [49] فهو يؤمن بقدرة الخيال على إثارة النّفس لتنفعل بمضامين القول الشعري دون أن يحدث بالضرورة تصديقا، خصوصا إذا تجاوز الشاعر حرفية الواقع وكسّر قوالبه المألوفة، وولج دائرة الكذب الفنّي. فقوة التخيّل أقوى من قوة التصديق، لأنّ التخيّل يثير التعجّب والالتذاذ، والتصديق هو قبول وإذعان أنّ ما قيل يتّصف به فعلا. [50] فابن سينا من المدافعين عن أهميّة تجاوز معطيات الواقع وكسر قوالب القول الصادق، فهذا الأخير ” إذا حرّف عن العادة وألحق به شيء تستأنس به النفس، فربّما أفاد التصديق والتخييل معا”[51].
وقد زكّى ابن رشيق ( 390 ـ 456 ه )،هذا الرأي، مشيرا إلى أنّ من فضائل الشعر أنّ الكذب ـ الذي اجتمع الناس على قبحه ـ حسن فيه”.[52] دون أن يشير إلى الجوانب المستحسنة في حكمه.
بالنسبة لابن الأَثيرِ (ت 630هـ) فقد تحدّث عن موقفه من الكذب في الشعر ضمن موضوع الصناعة المعنوية، ذاكرا معاني الاقتصاد والإفراط والتفريط ، باعتبارهما من أسس صناعة القول. إذ ميّز بين التفريط باعتباره تقصيرا وتصنيعا، بينما يؤتى بالاقتصاد في القول بحسب ما يتطلبه ويقتضيه السياق. في الوقت الذي اعتبر الإفراط إسرافا وتجاوزا للحدود المتعارف عليها. [53] وبينما استقبح الإتيان بالتفريط، أجاز استعمال الوجه الحسن من الإفراط. [54] وهو المفهوم الذي يعتبر الحد الأدنى والأقصى لفهم نظرة ابن الأثير للكذب. ولتوضيح ذلك نورد الفقرة التالية من كتابه المثل السائر حيث أظهر اختلاف النقاد حول توظيف الإفراط ” وأمَّا الإفراطُ، فقَدْ ذمَّهُ قَومٌ مِن أهلِ هَذِه الصِّناعَةِ وحَمِدَهُ آخرونَ، والمذْهَبُ عِندي استعْمالُه، فإنَّ أحْسَنَ الشِّعرِ أكْذَبُه، بَلْ أَصدَقُهُ أكذَبُه، لكنَّه تَتفاوَتُ دَرجاتُه، فَمِنه المُستحْسَن الذي عليه مَدارُ الاستعْمالِ”.[55] فقد ربط مفهومه للكذب باستعمال الإفراط الذي لا يبعد عن نطاق المستعذب منه حفاظا على فنيّة القصيد وجماليته.
ب ـ الكذب الإيهامي :
وهو ضرب من التأليف يحتمي فيه الشاعر بالإيهام والإغراق والتهويل في القول لإيصال رسالته، والذي يوقعنا في كمين معنى غير المراد منه. وهو أسلوب مردّه إلى إضمار المعنى الشعري بقول مغاير للحقيقة والواقع. وقد تمّت مناقشة هذا الموضوع وفق رؤى متباينة دفعت مجموعة من النّقاد إلى رفض هذا النوع، بل ذهب بعضهم إلى وصفه بالشّناعة والخساسة والقبح.
النّقاد القدامى وهم يناقشون الكذب الإيهامي وَصلُوه بمجموعة من المصطلحات من قبيل الغلو والمبالغة والامتناع والاستحالة والتناقض، وهي مفاهيم ستسعفنا لا محالة في اكتشاف الحدود المسموح بها لهذا الصنف من الكذب الذي يتجاوز درجات الممكن.
ومن الآراء التي حاولت مقاربة هذا الموضوع وفق رؤية ضيقة، نجد أحمد بن فارس (ت 395 ه) الذي حصر قول الشّعر في مجموعة من الشرائط؛ تتمثل في الإفراط والتعدّي والكذب. واعتبر أنّ الالتزام بمبدأ الصّدق يجعل قوله مخسولا ساقطا. [56] فالشاعر حسب رأيه بين “كذب وإضحاك”.[57] وهو بهذا يؤيّد مبدأ التزيّد في الكذب معتبرا أنّ الالتزام بالواقع يسقط من قيمة الشعر، دون أن يشرح سبب إعراضه عن مبدأ الصدق وغلبته للكذب المفرط والإيهامي.
فالإفراط أو الكذب الإفراطي أساسه الخرق و طريقه الغلو في” الصفة فيخرج بها عن حدّ الإمكان إلى الامتناع أو الاستحالة” [58] ، وعابه القرطاجني ( ت 684 ه) لركوبه معنى الاستحالة والامتناع .[59] وقد شانه قبل ذلك القاضي الجرجاني (322 – 392 ه) في حالة ما إذا تجاوز الحدود؛ إذ تتسع له الغاية ويدخل غمار الإحالة والإغراق. [60] بمعنى أنّه يقبله إذا احتفظ بمبدأ الوصف المقبول الذي لا يتجاوز الممكن. بينما أجاز قدامة بن جعفر الغلو مادام “تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه إلى مالا يجوز أن يقع له “.[61] وهو يتقاسم ـ أي الإفراط ـ مع مصطلح الغلو نفس الدلالة، كما أخبر بذلك ابن رشيق، إذ يربطه بمسميات أخرى تشاركه المعنى كـ ” الإغراق والإفراط”.[62] حيث رفض إقبال الشعراء عليه تحت مسمّى الفضيلة، واعتبر ذلك محالا وخروجا عن الحقيقة.[63]
واعتبر السجلماسي (ت 704هـ) بدوره الغلو مرادفا للإفراط [64] ، وأدرجه ضمن أقسام المبالغة، ووسمه بتصوير الأمور لا كما هي في حقيقتها، وإنّما يتخطّى الحقيقة إلى المحال والكذب المخترع بغية المبالغة في القول. [65] إضافة إلى الرغبة في ” بلوغ الغاية في النعت”.[66] وإظهاره للغاية من الغلو والإفراط بكون الشاعر يسعى إلى الوصول بمبدعه إلى المنتهى من النعت؛ هو في حدّ ذاته إقرار بالسّعة التي يمنحها الانخراط في هذا النوع من الوصف، والذي قد يجد فيه الشاعر ضالته في إدراك ما عجز عنه غيره من الشعراء.
فالغلو أو الإفراط أو المبالغة تختلف المسميات والمدلول واحد، هو تشكيل شعري مأربه تجويد الصناعة الشعرية، دون اكتراث العديد من الشعراء لما يلحق المعنى من تجاوز لحدود المعقول لما ارتضاه الذوق الشعري الجمعي. وهي معطيات قد تثقل النص الشعري بحمولة دلالية مغرقة في الكذب والاستحالة والامتناع، مادام للشعر حدود لا ينبغي تجاوزها ليحافظ على التواصل الفعّال بينه وبين المتلقي. فالإفراط والغلو قد يكون مقبولا ما سلم من الإيغال والتوعّر في القول الذي يدخل في باب الامتناع والاستحالة والتناقض، وهذا سبب إنكاره من طرف العديد من النّقاد.
والاستحالة والتناقض من العيوب التي تخلّ بالمعنى وتُبشعه، وهذا ما لامسه قدامة بن جعفر؛ معرّفا إياّها بأن يأتي الشاعر بالشيء فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة. ويظهر في إحدى الحالات الأربع الذي حدّده في المضاف والتضاد وطريق العدم والقنية والنفي والإثبات. واجتماعه عيب فاحش لا يصحّ وقوعه ولا تصوّره بسبب ما يحمله من تناقض. [67] وقد عرّف المعنى المتناقض أنّه ” لا يكون، ولا يمكن تصوره في الوهم “. [68] أي مما لا يمكن تخيله في الذهن، لما يحمله من تناقض.
وقد أورد بيتا شعريا لابن هرمة يوضّح فيه التناقض الذي وقع فيه: تراهُ إذا أبصرَ الضيفَ كلبهُ يكلمهُ من حبّه وهو أعجمُ حيث علّق قدامة على هذا البيت قائلا أنّ “الشاعر أقنى الكلب الكلام، في قوله: أنّه يكلّمه، ثم أعدمه إيّاه عند قوله: إنّه أعجم، من غير أن يزيد في القول ما يدل على أنّ ما ذكره إنّما أجراه على طريق الاستعارة”.[69]
ومن المفاهيم المشينة أيضا نجد الممتنع، وهو صورة أخرى للكذب الإيهامي؛ وهو مالا “يكون، ولكن يمكن تصوّره في الوهم.” [70]
كتجميع” يد أسد على رجل مثلا.” [71] مثال ذلك بيت أبي نواس: يا أمينَ الله عِشْ أبَداً … دُمْ عَلَى الأيامِ والزمنِ
معلّقا على ذلك بقوله “فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله: عش أبداً، أو دعا له، وكلا الأمرين، مما لا يجوز، مستقبح”. [72] معتبرا في ذات الآن أنّ الممتنع يقبح الإتيان به في الشعر، ولا يجوز وقوعه”. [73]ورفضه هو مفعول التشويش الذي قد يتولّد لدى القارئ، ممّا يقلّل من فهم واستيعاب المعنى الشعري. بل ذهب ابن البناء المراكشي أبعد من ذلك عندما قال أنّ ليس “للشاعِر أن يحاكيَ ويتخيَّل في الشيءِ ما ليس موجودًا أصلاً؛ لأنَّه إذا فَعَل ذلك لم يكُن محاكيًا، بل يكون مخترعًا، فيركب الكذب في قوله، فتبطُل المحاكاةُ لكذِبها، وهي موضوعُ الشِّعر”.[74]
نخلص إلى أن الغلو والإفراط من صوب والاستحالة والتناقض من نحو آخر، وكذا الامتناع؛ هي أحد الأوجه التي تؤطّر الكذب الإيهامي؛ باعتباره مُروقا عن الصناعة الشعرية كما ارتضاها الذوق النقدي القديم، ما دام هذا الصنف من الكذب ممّا يصعب على العقل الاقتناع به وكذلك يشوك عليه إدراكه وتخيّله، وهذا مكمن رفضه. ويمكن توضيح ذلك في الخطاطة التالية:
| الخروج بالمعنى من الإمكان والحقيقة |
| الاستحالة والامتناع |
| الكذب الإيهامي |
هو إلى
خاتمة:
الخلاصة التي يمكن أن أطمئن إليها، هي أن هذه الإشكالية معقّدة ولا يسع العمل الذي قمت به معالجة جوانبها الفنية والأخلاقية سواء من جانب الصدق أو الكذب، والتي تحتاج إلى تصفّح آخر بل مطالعات جديدة. وتبقى المقاربات التي أنمى بها النقاد والفلاسفة إشكاليتي الصدق والكذب انعكاس لمدى ما طبع النقد العربي من تطوّر، ومدى اختلاف وجهات نظرهم للتعاطي مع هذه الظاهرة النقدية؛ حيث اتسمت لدى البعض ببساطتها ونظرتها المحدودة في الانتصار إلى الصدق أو الكذب وما تفرّع عنهما من جوانب أخلاقية وجمالية وإيهامية.
فما يلاحظ أن جل القراءات قد تم تناولها أثناء حديثهم عن جانب المعاني، وما استحسنوه منها وكذا ما استقبحوه، فالحسن والقبح والجودة والرداءة هي النافذة التي أطلّ من خلالها النقاد على جانب الصدق والكذب في الشعر. كان هدفهم حماية النص الشعري من كل إخلال أو خروج عن الذوق الجمعي. وإن لم تلتزم في بعض جوانبها ـ أقصد قراءة النقاد ـ بالعمق والدقة في التعامل مع هذه الإشكالية.
ويبقى الصدق معطى شعري دافع عنه الكثير من النقاد، باعتباره انعكاسا حقيقيا لذات الشاعر وما يعتريها من تقلبات ومتغيرات. كما أن الكذب لا يشين الشعر ولا ينقص من قيمته إن راعى حدودا معيّنة من القول، ولم يتوغّل في الإفراط والغلو والمبالغة، التي تستحيل إلى تناقض وكلام محال لا يقتنع به العقل ولا يقبله.
المصادر والمراجع المعتمدة:
ـ أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق عمر فاروخ الدبّاغ. مكتبة دار المعارف، بيروت. ط 1، 1414 ه – 1993 م.
ـ ابن البناء المراكشي: الروض المريع في صناعة البديع، ، تحقيق رضوان بنشقرون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،د ط، 1985م.
ـ ابن بشر الأمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، سلسلة ذخائر العرب، عدد 25. تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط 4 ، د ت.
ـ ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط 5 ، 1401 ه / 1980 م.
ـ ابن طباطبا العلوي:عيار الشعر، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 2، 1426 ه / 2005 م.
ـ أبو محمَّد القاسم السجلماسيّ :المنزع البديع في تجنيس البديع”،حقَّقه علال الغازي، مكتبة المعارف، ط1، الرباط، 1401هـ/1980م.
ـ أبو هلال العسكرس: الصناعتين :الكتابة والشعر. تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم.دار إحياء الكتب العربية، ط 1، 1371 ه / 1952 م.
ـ أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د ط، 1996 م.
ـ أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق عمر فاروخ الدبّاغ.مكتبة دار المعارف، بيروت. ط 1، 1414 ه – 1993 م.
ـ أرسطو طاليس: فن الشعر، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمة عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، د ط، 1953 م.
ـ الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2003م/ 1424ه.
ـ الطاهر ابن عاشور: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق ياسر بن حامد المطيري.مكتبة دار المنهاج للتوزيع والنشر، الرياض.ط 1 ، 1431 ه.
ـ جابر عصفور: مفهوم الشعر، مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط 5، 1995م.
ـ جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي، ترجمة مبارك حنون، محمد الوالي، محمد أ,وراغ، دار توبقال للنشر، ط 2، 2008 م.
ـ جهاد المجالي: التجربة الشعرية بين الصدق الفنّي وصدق الواقع، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج 15 ، ع27 ، جمادي الثانية 1434 ه.
ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخواجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3 ، 1986م.
ــ ضياء الدين ابن الاثير:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي، يدوي طبانة.دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.د ط ، د ت.
ـ عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، د ط ، د ت .
ـ عبد الله شقور:القاضي عياض الأديب (الأدب المغربي في ظل المرابطين)، سلسلة رسائل جامعية 1، نشر دار الفكر المغربي، ط 1، ،1983 م.
ـ قُدامة بن جعفر :نقد الشّعر، تحقيق: مُحمَّد عبدالمنعم خَفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت. د ط ، د ت.
ـ ك. ك. روثن: قضايا في النقد الأدبي. ترجمة عبد الجبار المطلبي. دار الشؤون الثقافية العامة ،ط 1، 1989 م.
ـ لسان الدين بن الخطيب:” كتاب السِّحر والشِّعر”، حقَّقه المستشرق الإسباني ج.م كونتنته بيرير، راجعه ودققه: محمد سعيد إسبر، بدايات للطبع والنشر والتوزيع، ط1، جبلة، سورية، 2006م.
ـ مجيد عبد الحميد ناجي: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت لبنان. ط 1، 1984م .
ـ مصطفى الجوزو: نظريات الشعرعند العرب ( الجاهلية والعصور الإسلامية)، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 2، 1408 ه / 1988 م.
ـ نجوى صابر: النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان. ط 1، 1410 ه ـ 1990 م.
[1]ـ أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب بتصرف. ص: 425.
[2] ـ الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع، ص:25.
[3] ـ جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي، ، ص:6.
[4]ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء،. ص: 79.
[5] ـ نجوى صابر: النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، ص:26.
[6] ـ ابن رشيق : العمدة ، ج 1 ، ص: 80.
[7] ـ ابن طباطبا:عيار الشعر، ص:15.
[8]ـ ابن طباطبا:عيار الشعر، ص:22.
[9]ـ ابن طباطبا:عيار الشعر، ص:18.
[10]ـ جابر عصفور: مفهوم الشعر، بتصرف. ص:85.
[11]ـ نفسه.
[12]ـ نفسه، بتصرف. ص:86.
[13]ـ نفسه.
[14] ـ لسان الدين بن الخطيب: كتاب السِّحر والشِّعر”، ص:16.
[15] ـ عبد الله شقور:القاضي عياض الأديب (الأدب المغربي في ظل المرابطين)، ص:307.
[16] ـ عبد الله شقور:القاضي عياض الأديب (الأدب المغربي في ظل المرابطين)، ص:307.
[17] ـ مجيد عبد الحميد ناجي: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية،.ص :174.
[18] ـ جهاد المجالي: التجربة الشعرية بين الصدق الفنّي وصدق الواقع،بتصرف.ص:926.
[19] ـ الأمدي:الموازنة، 2/58.
[20] ـ نفسه، 2/56.
[21] ـ مصطفى الجوزو، ص: 162.
[22] ـ الطاهر ابن عاشور: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام،.ص: 38 .
[23] ـ أسرار البلاغة، ص:271.
[24] ـ نفسه ، ص:273
[25] ـ نفسه.
[26] ـ أسرار البلاغة، ص:267
[27] ـ أسرار البلاغة، ص:268
[28] ـ أرسطو طاليس: فن الشعر، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد. ص: 213
[29] ـ أرسطو طاليس: فن الشعر، ص: 214.
[30]ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء،. ص: 81 ـ 82 .
[31] ـ ك. ك. روثن: قضايا في النقد الأدبي. ص:343.
[32]ـ نقد الشعر، ص: 54.
[33]ـ أنظرمصطفى الجوزو: نظريات الشعرعند العرب،بتصرف. ص:149.
[34]ـ أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب، بتصرف. ص: 427
[35]ـ نفسه،بتصرف. ص: 440.
[36] ـ فن الشعر لأرسطو: ص: 151.
[37] ـ ك. ك. روثن: قضايا في النقد الأدبي. ص:343.
ـ مصطفى الجوزو: نظريات الشعرعند العرب،بتصرف. ص: 153.[38]
[39] ـ ك. ك. روثن: قضايا في النقد الأدبي. ص:345.
[40]ـ نقد الشعر، ص: 94.
[41]ـ نفسه.
[42]ـ نقد الشعر، ص: 202.
[43] ـ ك. ك. روثن: قضايا في النقد الأدبي. ص:345.
[44]ـ الصناعتين ص:70.
[45]ـ نفسه، ص: 136-137
[46]ـ نفسه، ص:137.
[47]ـ نفسه.
[48]ـ الصناعتين ص:136.
[49] ـ فن الشعر لأرسطو: ص:160 ـ 161.
[50] ـ نفسه، ص:162.
[51] ـ فن الشعر لأرسطو: ص:162.
ـ ابن رشيق: العمدة. ج1, ص: 22.[52]
[53] ـ المثل السائر، ص:178.
[54] ـ نفسه.
[55] ـ فن الشعر لأرسطو: ص:162.
[56] ـ أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. ص:266.
[57] ـ نفسه.
[58]ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 76.
[59]ـ نفسه، ص: 79.
[60]ـ العمدة، ج 2. ص :61.
[61] ـ نقد الشعر، ص:202
[62]ـ العمدة، ج 2. ص :60.
[63] ـ العمدة، ج 2. ص: 60 ـ 61.
[64] ـ المنزع البديع، ص: 273.
[65] ـ نفسه.
[66] ـ العمدة، ج 2. ص:62.
[67]ـ نقد الشعر، ص: 195 وما بعدها.
[68]ـ نقد الشعر، ص: 201.
[69]ـ نقد الشعر، ص: 199.
[70]ـ نقد الشعر، ص: 201.
[71]ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 76.
[72]ـ نقد الشعر، ص: 201 ـ 202.
[73]ـ نقد الشعر، ص: 202.
[74]ـ ابن البناء المراكشي: الروض المريع في صناعة البديع، ص:103.