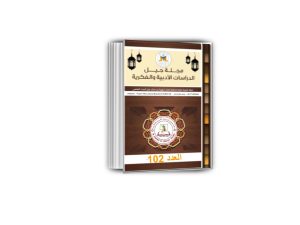الدلالة الصوتية والصرفية في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين
ديوان الضوء والأثر أنموذجاً
أ. حسين عمر دراوشة باحث ومحاضر غير متفرغ في علوم العربية بجامعة غزة- فلسطين
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 48 الصفحة 51.
الملخص:
يسعى البحث إلى دراسة الدلالة الصوتية والصرفية في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين، وذلك من خلال ديوان الضوء والأثر للشاعر علي عصافرة “شاعر الأسرى”، وتسليط الضوء على الدلالة الصوتية بالحديث عن طبيعة الأصوات وصفاتها التي استخدمها أهل المعتقلات في نصوص لغة خطابهم الشعري، وكذلك الكشف عن المقاطع الصوتية والموسيقى الشعرية، ومن ثم بيان الدلالة الصرفية بتوضيح طبيعة بنية الفعل والاسم والصيغ المستخدمة والزوائد وأسماء المشتقات وانعكاساتها على المعني في سياق نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين، مع ضرب نماذج وأمثلة من ديوان الضوء والأثر وتحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبعد ذلك الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصياته، وفهرس للمصادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية: (أدب المعتقلين، الدلالة الصوتية والصرفية، الخطاب الشعري، لغة النصوص).
Phonological and Phonetic Significance in the Language of Poetic Texts in Palestinian Prisoners
The Bureau of Light and Impact is a model
Abstract: The study seeks to study the significance of voice and morphology in the language of the texts of the poetry discourse of the Palestinian detainees, through the Office of Light and the impact of the poet Ali Asafra “Poet of prisoners”, and shed light on the significance of the voice talk about the nature of sounds and descriptions used by the people of detention in the texts of the language of their speech Poetry, as well as the disclosure of syllables and poetic music, and then the statement of morphological significance to clarify the nature of the structure of the verb and name and formulas used and appendices and names of derivatives and their implications on the meaning in the context of the texts of poetry discourse of Palestinian detainees, beating models and examples of Diwan of light and impact and analysis using the descriptive analytical approach, and then the conclusion and the results of the research and recommendations, and a catalog of sources and references.
Keywords: (the literature of detainees, voice and morphology, poetic discourse, .(textual language
المقدمة:تمثل اللغة الوسيلة التعبيرية الأولى عند الإنسان، وتشتد الحاجة إليها في ظل وجود ساحة للصراع والتحدي مع القوى الاستعمارية وأطماعها، فمُنيتْ فلسطين بالاحتلال الصهيوني البغيض، الذي زجّ بأحرار الشعب الفلسطيني في المعتقلات والزنازين ومسالخ التحقيق؛ لكسر شوكتهم ومصادرة عزيمتهم، ودفع شباب فلسطين زهرات أعمارهم في سبيل كنس المحتل وتحدي جبروته وصلفه، فمثّل المعتقل الفلسطيني في السجون الصهيونية شعلةً من النشاط، والجدية، والتحدي بنفس طويل للممارسات الاستفزازية، التي يقوم بها السجان الظالم، ويلاحظ أن أهل الإبداع في المعتقلات قد أنتجوا إبداعات أدبية ذات أجناس فنية مختلفة، ولكن هذه الإبداعات تعرضتْ للمصادرة والملاحقة كصاحبها؛ لأن العدو الغاصب يحاول جاهداً وأد الأفكار النضالية المجاهدة، وقتل تنقلات التجارب الحية للمقاومين الأبطال خلف القضبان.
وعمد الاحتلال إلى قمع التفكير والكتابة، وممارسة سياسة القوقعة والتجهيل، فلم يُدخلْ لهم الكتب المفيدة، فقام مبدعو المعتقلات بتهريب الكتابات الإبداعية عبر مناشير متقطعة يتم ضغطها فيما تُعرف بــِ”الكبسولة”، وعانى المعتقلون الأمرّين في سبيل إيصال كتاباتهم ورسائلهم للعالم الخارجي، ونجِح شعراء المعتقلات من إيصال رسائلهم عبر دوائر ضيقة وخاصة، لا يمكن الكشف عنها لحساسية سياق الولادة الإبداعية داخل الفضاء المغلق وبنيته الحالمة، فترك ذلك بصمات صوتية وبنيات صرفية لها دلالاتها في شعر المعتقلات الفلسطيني المعاصر؛ لذا يحاول البحث إلى استشرافها وقراءتها من خلال نماذج وتطبيقات من ديوان “الضوء والأثر” للمعتقل علي عصافرة الملقب بــِ”شاعر الأسرى”، فهذا الديوان يمثل تجربة شعرية أدبية واعية وُلِدَتْ في رحم معاناة المعتقلات وقسوتها وآهاتها وآلامها وشوقها وحنينها، وتسليط الضوء على الدلالة الصوتية في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين، وذلك من خلال الحديث عن الصوت المفرد ودلالاته في سياق الخطاب الشعري، وتحليل دلالة المقطع الصوتي في الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين، ومن ثم بيان الدلالة الصرفية خلال بنية الأفعال والأسماء التي تمثلها المشتقات، والحديث عن السوابق واللواحق التي تُزاد في بنية الكلمة، وتآلفها مع نسقيات الخطاب وتراكيبه في البُنى اللسانية المنجزة في نصوص أدب المعتقلات عند الفلسطينيين، ويُلاحظ الباحث أن التداخل بين المستوى الصوتي والصرفي يشكل بنية أساسية في النص والخطاب “فأصوات اللغة تتأثر بالصيغ، والصيغ تتأثر هي الأخرى بالأصوات، فالتغيرات الصرفية تقوم على عناصر صوتية، وليست الوحدات الصرفية إلا أصواتاً، والصوت والصيغة كلاهما يتأثر بالمعنى”([1])، ويبرز ذلك بصورة واضحة تفاعلات الروح الأدبية داخل الفضاء المغلق، ورؤيتها للحياة والواقع الذي تحياه، ففلسفة تحليل لغة الخطاب ومشكِّلاتها في شعر المعتقلين، تنطلق من تتبع ” مظهر خطابي معين للوقوف على درجة تكراره من أجل صياغة اطّراده، فهدفه هو الوصول إلى اطّرادات وليس إلى قواعد معيارية، باعتبار أنّ معطياته خاضعة للسياق الفيزيائي والاجتماعي وأغراض المتكلمين واستجابة المستمعين”([2])، فالاستقراء الجيد للنصوص المنجزة من وجهة نظر علم تحليل الخطاب أن يتبنى محلّل الخطاب ” المنهجية التقليدية للسانيات الوصفية محاولاً وصف الأشكال اللغوية التي ترد في معطياته دون إغفال المحيط الذي وردت فيه، فمحلّل الخطاب يحاول أن يكشف الاطّرادات في معطياته وأن يصنّفها”([3])، بمعنى أن البحث يحاول استكشاف طبيعة الدلالة الصوتية والصرفية باعتبارها مكون أساس في بنية نصوص الخطاب الشعري ومشكِّلاته عند المعتقلين الفلسطينيين، فاستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على الدلالة الصوتية والصرفية في نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وتقديم دراسة جادة لمكتبة اللغة والأدب العربي الفلسطيني؛ ليستفيد منها الباحثين والدارسين وأهل الاختصاص والجهات ذات العلاقة.
المبحث الأول: الدلالة الصوتية في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين- ديوان الضوء والأثر نموذجاً.
يتكون الكلام البشري من ” سلاسل صوتية يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً، فنحن لا نتكلم أصواتاً مفردة، وإنما كلمات وجملاً وفقرات”([4])، فيمثل الصوت أهم مشكِّلات النص، ويهتم مستوى الأصوات في التحليل الدلالي اللغوي بدراسة ” أصوات اللغة من ناحية بيعتها الصوتية مادة خاماً تدخل في تشكيل بنية لفظية، ويدرس وظيفة بعض الأصوات في الأبنية والتراكيب- والأخير مهم في الدلالة- ويدخل هذا تحتما يعرف بعلم وظائف الأصوات(phonology)، وهو دراسة وظيفية الصوت اللغوي في الكلام عن طريق زيادة في الكلمة مثل العناصر الصرفية ومن ناحية تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية وصفات كل مقطع أو عن ريق أدائه صوتياً، وما ينتج عن ذلك من نبر وتنغيم ووقفات وطبقة الصوت، وكل العناصر الصوتية التي تشارك في الدلالة وتؤثر في المتلقي”([5])، ويعد هذا المستوى ” أساسي من المستويات اللسانية التي تعمل على تلوين المعاني وتشكيل المباني”([6])، فيمثل اللَّبنة الرئيس في تشكيل النص وبناءه، ويُلاحظ أن اللغة تتألف” من الوحدات الصوتية مركبة في جذور وفي أبنية مختلفة”([7])؛ لذا تنطلق الدلالة الصوتية من تعبير الصوت في جوهره عن معاني ودلالات داخل نصوص لغة الخطاب الشعري، فيحمل سمات لها علاقة بظروف الإبداع والولادة الأدبية داخل المعتقلات الصهيونية، التي يعاني فيها المعتقلون ويلات العذاب وقسوة الآلام، ويُلاحظ أن الذات المبدعة المقيدة تبدع في انتقاء الألفاظ وتكوين المنطوقات في بينة نصوص الخطاب، فوظف الشعراء الأصوات الشديدة الانفجارية التي ترتبط بعقيدتهم الحرة؛ فيقول الشاعر([8]):
| ولى زمان تُستباح ديارنا | ويقيل في أفيائها الفجار | |
| هذا زمان المرهفات من القنا | والضامرات بعدها الإعصار |
وظف الشاعر الصوت المنفرد الذي يتسم بالشدة والانفجار والتكرار والقلقلة(ت- ب- ق-ج-د-ر-ه-ع)؛ مما يوحي إلى الحالة الشعورية التي يمر بها المبدع داخل أسوار المعتقلات، ومنح النص بنية متفاعلة لها مدلولاتها في سياق الخطاب الشعري وظروف إبداعه، فالإدراك السمعي الصحيح للأصوات، وهو “الإدراك الذي إذا تحقق مكّن السامعين من ميّز الأصوات اللغوية بعضها من بعض”([9])، واستخدم الشعراء الأصوات الموحية والمعبرة عن واقع المعتقلات وما فيها من آلام وعذابات، تلك المعتقلات، التي تزهق الآمال، وتقتل الأحلام عند الأحرار الأبرار؛ فيقول الشاعر عصافرة([10]):
يا أيها المعزول خلف الشمس طال الانتظار
مر الزمان ولا حِراك وفات في العمر القطار
مر الرفاق وخلفوك فريسة تحت الجدار
يقتات قلبك والشباب يستبد ولا فرار
قد شد حولك فكه شد المعاصم بالسوار
عبر الشاعر عن حال المعتقلات وآلامها وضيق آفاقها وترامي الزفرات النفسية فيها من خلال الاعتماد على الأصوات الصفيرية التنفيسية(س، ش) التي تعبر عن ذات الشاعر وما يدور في مخيلته، والارتكاز على الأصوات الجانبية التكرارية(ل، ر، ن) للتعبير عن المعاناة المتكررة التي تجثم على صدور الأحرار في زنازين الظلم وسجون القهر.
ووظف الشعراءُ في المعتقلات الصوائت الطويلة للمد، التي توفر مساحة واسعة للنفس الشعري الذي يكتنز في ثناياه كثير من المعاني والدلالات، التي تنقل معاناة المعتقلين وآلامهم وآمالهم؛ علاوةً على أن “الصوت الأسهل يميل إلى أن يكون أشيع، وكلما كان نطقه أصعب، قلّ شيوعه في معظم الحالات”([11])، فصوائت المد؛ فيقول الشاعر رثاء إخوته الشهداء([12]):
| وشجا فؤادي أن صحبي ودعوا | تحت الثرى والعين شوقاً غصّت |
تكررت الألف في البيت السابق خمس مرات وفي هذا دلالة على ما في النفس من كمد وحزن وألم على فراق رفاق الدرب؛ حيثُ تعد بيئة المعتقلات الصهيونية ملتقى للأحرار، واستطاعوا بفكرهم النيّر تحويل المعتقلات لمنابر من نور ترسم خُطى المجد؛ فهم لم يعدموا الوسيلة في ظل قهر السجان وجبروته، ونلمس كل ذلك من بنية نصوصهم وإنتاجيات خطاباتها في ظل سياقات مختلفة.
ووظف الشعراء المعتقلون في لغة نصوص خطابهم الشعري الترديد الصوتي داخل بنية الكلمات الشاعرة، التي تجسد روح الإبداع؛ فيقول الشاعر([13]):
| ما أسكر الروح كالذكرى أرددها | كأن شط الصبا لاحت سواقيه |
جاء الترديد الصوتي في توظيف صوت الدال في الفعل (أرددها) في سياق الافتخار بمجد الأمة وعزها ورفعتها، وتشت حدة الترديد الصوتي مع الحروف المشددة؛ فيقول الشاعر([14]):
| صحب تفرقنا البطون وحسبنا | نسباً حماسُ وصنعةُ الأمجاد | |
| نجلو به صخب الحياة وهمَّها | ونجدّد الأرواح في الأجساد |
الترديد الصوتي في (نجدّد) يعبر في نفس الشاعر وما يمثل مشاعره وأحاسيسه وما يعمل به فكره في رؤيته للحياة والواقع من داخل الفضاء المغلق، واعتمد شعراء المعتقلات على ترديد الألفاظ في لغة بنية نصوص الخطاب الشعري، فيما يتعلق بواقع المعتقلات، وما يتعرض له الأحرار من مضايقات وممارسات عدوانية؛ فقال الشاعر في قصيدة له بعنوان “الورقاء”([15]):
| ورقاء في نفسي الجريحة حيرة | من فعل حر للنجوم ربيب | |
| ورقاء([16]) ماذا تفعلين بمحبس | صحراء لون رملها التعذيب |
ردد الشاعر لفظة(ورقاء) التي تدلل الحمامة التي تعد دال سيميائي يوحي بتشوق المعتقلين للحرية والانعتاق من براثن السجون وأقبيتها، فتوظيف مادة الصوت الخام الأولى للغة يمثل بؤرة ارتكازية في تكوين دلالات نصوص الخطاب في شعر المعتقلات، ويحمل في طياته سمات ومعادلات نصية يودع فيها أهل المعتقلات ما تجيش به نفوسهم، ويرسمون من خلال رؤيتهم للواقع والحياة نظراً لخبرتهم النضالية في مجابهة المحتل وأعوانه؛ مما يضمن حيوية النص وفاعليته عند جمهور المتلقين.
ويختار المبدع المقاطع الصوتية التي توافق حالته الشعورية والوجدانية، وهذه المقاطع تسهم في تشكيل الإيقاع الشعري، الذي يعد لازمة من لوازم النص في الخطاب الشعري، وتُؤثر المقاطع الصوتية في تحديد الدلالة التي يريد المبدع المعتقل إيصالها، فوصف الشاعر ثورات الأحرار في البلدان العربية؛ فيقول في قصيدة بعنوان “صباح النصر”([17]):
صباح النصر يا مصر
صباح النيل منتشيا
ص با ح لن ن ص ر يا
ص ح ص ح ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح ص ح ص ح ح
مص ر ص با ح
ص ح ص ص ح ص ح ص ح ح ص ح
لن ني ل من ت ش يا
ص ح ص ص ح ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح ص ح ح
بلغ عدد المقاطع (20) مقطعاً في هذين السطرين الشعريين، بلغ عدد المقاطع القصيرة (11) مقطعاً وعدد المقاطع الطويلة المقفلة (4) مقطعاً، وعدد المقاطع الصوتية الطويلة (5) مقاطع، فالمقطع القصير أكثر المقاطع وروداً؛ لتعبيرها عن مدى قوة الفرحة بالنصر ببيان مقتضب والافتخار به بأصوات ثورية انفجارية وتكرارية ومهموسة وصفيرية؛ لأنها هي المميز لعملية الهمس في الطبيعة([18])، فتكونت التفعيلة من ألفاظ متساوية في السطرين السابقين؛ مما شكل إيقاعاً موسيقاً يتمثل من ” مجموعة المقاطع الصوتية لكل (تفعيلة) أي أن القصيدة تتألف من أشطر مختلفة الطول تتكرر فيها تفعيلة واحدة متشابهة من أول القصيدة إلى آخرها”([19])، ويرتبط الإيقاع الموسيقي في نصوص شعر المعتقلات بالجرس الصوتي للألفاظ المستخدمة في أبنية نصوص الخطاب ومشكِّلاتها؛ مما يضفي على النص حيوية تأويلية يستنتجها المتلقي؛ لأن الموسيقى ” تدرك بواسطة الأذن دون بقية الحواس، فالأذن هي سبيل تسلل الموسيقا إلى النفس”([20])، وتمُيز الشعر عن النثر إلى الشكل العروضي الذي يلتزمه الشعر العربي من توالي مقاطع الكلام على طريقة خاصةٍ؛ حيثُ يتكون من كميات نغمية تتكرر عدة مرات؛ لتؤدي الإيقاع الموسيقي الذي هو أهم خصائص الشعر([21]).
تقوم القافية مع الوزن بوضع إطار معين للشعر، وللقافية” دور كبير في تحديد بنية البيت من حيث التركيب والإيقاع معاً”([22])، ويُلاحظ تردد القوافي وتكرارها على نظام خاص وشروط محددة تفصلها كتب العروض، وكأنما تصنع القافية وقفة موسيقية في نهاية البيت، يبدأ بعدها التفاعل في البيت الذي يأتي بعد ذلك، مكوناً إيقاعاً موسيقياً يمتد دلالته من المعاني، التي تجيش بها نفس الأسير داخل معتقله، وكل وزن يكتب خصائصه داخل التجربة الشعورية في هذا الفضاء المغلق، وهذا يعني أن الشاعر يصوغ في الوزن الواحد أكثر من غرض دلالي، ينبو عما في النفس؛ لأن الشعر “شيء تجيش به صدورنا، فتقذفه على ألسنتنا”([23])، فركز شعراء المعتقلات على بنية الروي في قوافيهم، فهو” الحرف الذي تُبنى عليه القافية”([24])، الذي يعد من العناصر الصوتية المركزية في بنية موسيقا النصوص الشعرية، ومن أهم الحروف التي وردتْ روياً في قصائده(التاء- الدال- الراء- الحاء- النون) وجمعيها أصوات شديدة انفجارية وتكرارية وأشباه صوائت تتميز بوضوح نبراتها وسهولة نطقها، وتتسم بانتظامها وتكرارها على مستوى القصيدة؛ مما يمنح النص جرساً موسيقياً يتسرب إلى عمق النفس البشرية؛ ليعبر عن حال المعتقلين ووصف واقعهم المؤلم، وتعكس مواقفهم تجاه القضايا والأحداث والوقائع، ومن أمثلتها قول الشاعر ([25]):
| داوِ الجراحَ وأيقظ الأفراحا | واترك عدوك في الدما سياحا | |
| داوِ الجراحَ فقد أيسنا بُرأها | طول العناء يورث الأتراحا |
وردت الألفاظ (سياحا، الأتراحا) بقافية مطلقة “كانت موصولة، والوصل حرف اللين الناشئ عن إشباع حركة الروي”([26])؛ مما أنتج بنية موسيقية للنص الشعري، لقد أشبعت الحركة بدفقات نطقية تعبر عن الحالة الشعورية، التي يحياها أهل المعتقلات وما يحملونه من مشاعر ثورية ترسم درب الحرية والاستقلال أمام الأحرار في الساحات والميادين، وتعبر هذه القافية عن النفس الثوري العميق عند الأسرى، والتي توحي بها الألفاظ والتراكيب، فلغة نصوص الخطاب في شعر المعتقلين تمتاز بالشعرية أي أنها أداة للتواصل، ونقل الأفكار والعواصف، ووعاء لحفظ التجارب والذكريات، وهي أبنية صوتية تحمل معاني ودلالات محددة، تصبح شاعرية إذا تغيرت معانيها ودلالاتها، وبالتالي تتحول إلى شكل أدبي أكثر بعداً عن لغة الواقع أو اللغة المادية، واللغة الشرقية كما يُعرفَها العقاد، هي اللغة التي: ” بُنِيَتْ على الشعرِ في أصولهِ الفنيةِ والموسيقيةِ، فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات، لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولم يكن منه كلام الشعراء” ([27])، هذا مجمل ما حملته البنية الصوتية من دلالات لها عمقها النفسي في ذوات المبدعين داخل المعتقلات الصهيوينة.
المبحث الثالث: الدلالة الصرفية في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين – ديوان الضوء والأثر نموذجاً.
تتكون النصوص في الخطاب الشعري من مجموعة من الأبنية، التي تشكل جوهر المادة التعبيرية التي تتآلف مع السياق الأدبي؛ لتحمل في تشكِّيلاتِها مدلولات نصية في شعر المعتقلين الفلسطينيين، ويدرس المستوى الصرفي في التركيبة اللغوية للنصوص “صيغ الكلمات من حيث بناؤها والتغيرات التي تطرأ عليها من نقص أو زيادة وأثر ذلك في المعنى”([28])، ويبحث الصرف في ” الوحدات الصرفية كالسوابق واللواحق، ويعرض الصرف كذلك للصيغ اللغوية فيه ويصنفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفها، كأن يقسمها إلى أجناس الفعل والاسم والأداة، أو ينظر إليها من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع إلى غير ذلك من كل ما يتصل بالصيغ المفردة”([29])، وبرز في العصر الحديث عند أهل اللغة أن الصرف ” يعنى بالصيغ كما يعنى بالتغييرات فيها سواء كانت عن طريق السوابق أو اللواحق، أو التغيرات الداخلية فيها، التي تؤدي المعنى الأساسي للكلمة، وتعرف الوحدة الصرفية بأنها أصغر وحدة ذات معنى ومنه المورفيم الحر المتصل أو المقيد”([30])، وترتكز الدلالة الصرفية على الصيغ ومعانيها، فصيغة (صادق) تدل على الذي يصدق مرة أو مرتين وهي اسم فاعل، بينما صيغة (صدوق) تدل على من يصدق كثيراً وهي صيغة مبالغة على وزن(فعول)، فهذه الإضافات والتغييرات في بنية الكلمة ” تشارك في الدلالة ويتأثر المعنى باختلافها ومقدار الزيادة في الكلمة”([31])، اعتمد شعراء المعتقلات على توظيف الأفعال بمختلف أبنيتها، التي تحمل دلالات أدبية في نصوص الخطاب الشعري وسياقاته في الفضاء المغلق، الذي يبلور رؤية الأحرار وأحلامهم التي تراودهم بالحرية والانعتاق من سدفة براثن السجون وأقبية زنازين القهر، فركن عصافرة إلى استخدام أفعال فيها حركة ونشاط وذات منحنى دلالي متنوع، تنسجم مع مضمون القصيدة، وطبيعة الولادة الأدبية داخل المعتقلات؛ مثل: (نال- قال- فهم- قم-شتم-طاب- كسر- فاض-جاد-نال-صار- رمى)، ومن ذلك قوله:
| وفررت من حُرقٍ تذيب حشاشتي | وتركتني والهمُّ حشو وسادي |
وظف الشاعر صيغة الفعل الثلاثي الماضي والمضارع؛ ليدلل على قسوة الألم داخل السجون، وشدة العذابات التي يحياها أهل المعتقلات في حضرة الشوق والحنين والألم والوجع، واستخدم الشاعر صيغة الفعل الثلاثي المضعف(مُدّ- شُدّ)، ومنه قول الشاعر([32]):
| مدّ السنا ليشُدَّ أفئدة الورى | عن هوة الإنكار والإلحاد |
استخدم أدباء المعتقلات الفعل المضعف؛ ليعبر عن حالة العنفوان النفسي والاندفاع نحو نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الأماني والأحلام، لقد أوجب الجمهور ضمَّ فاء الفعل الثلاثي المضعف، وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد([33])، وهذا فيه دلالة على القوة والأمر بشده، وكثيرة هي الأفعال المضعفة في ثنايا شعر المعتقلين، التي تدلل على مدى صدق الأبطال وبسالتهم في الثورة على العدو والنيل منه، فالزيادة في ” المبنى الصرفي للفعل، بدخول حروف الزيادة عليه، أضافت إلى دلالته دلالات فرعية أخرى، فمزيد الثلاثي بحرف يأتي بثلاثة أوزان(أفعل، فعّل، فاعل)، ولكل زيادة دلالة جديدة، علاوةً على دلالة الفعل على الحدث والزمن”([34])، ومن الأفعال التي استخدمها عصافرة الأفعال الثلاثية المزيدة صيغة(فَعّل) وتكون بزيادة حرف من جنس عينه أي تضعيفه([35])، وقد وردتْ للدلالة على التكثير والمبالغة، ومن أمثلة هذه الصيغة قول الشاعر([36]):
| ثقّف يراعك هُزّتِ الأوتار | وتحرّرت من سكرها الأشعار |
وظف الشاعر صيغة(ثقّف، هُزّت، تحرّرت) التي تحوي في طياتها دلالة على التدريب والاستزادة من كل شيء، وكذلك النبر الصوتي الناتج عن الحرف المضعف فيه دلالة على القوة وشحذ الههم لملاقاة العدو في ساحات النزال كافةً، وتوحي بالتكرار والمبالغة في حياكة الحدث وإدارة الموقف الحاسم الذي يرسم طريق النصر والتمكين بعيداً عن الأشعار والإبداعات المقيدة بالهوى والثمالة.
ووظف الشاعر صيغة (فعلّ) التي تحوي في فحواها دلالات من وحي المعتقلات، فيقول([37]):
| ولىّ المداد وحلّ دمع المقلة | وجرت على خدي بقايا المهجة |
يصور الشاعر حالته الثورية التي تنتاب شعوره فالمداد قد ذهب وحل بدلاً منه المقلة، وفي هذا دلالة على صدق المشاعر الثورية والوطنية في شعر الأسرى حتى أنّ ألفاظهم تنبو عن ذلك، وكذلك استخدم الشاعر صيغة(أفعَل) ثلاثي مزيد بحرف تأتي للتعدية، وقد جاءتْ للدلالة على أن الأسير يريد الحرية، ومن ذلك قول الشاعر([38]):
| أما من موعد للصبح إنّي | أتوق لبقعة فيها الضياءُ |
ومن الأفعال التي استخدمها الشاعر ثلاثية المزيدة بحرفين صيغة (تفعّل) فهي مزيدة بالتاء وتضعيف العين (تقدّم)، دلالة على القوة والشجاعة في المواجهة، ومن ذلك قول الشاعر([39]):
| وأبي تقدّم يوم حمحمت الرّحي | فوج الكتائب هازئاً بالهجد |
يمنح استخدام صيغ الفعل المزيدة أبنية نصوص الخطاب الشعري مزيداً من المعاني والدلالات التي تمثل واقع المعتقلين وحياتهم في السجون الصهيونية، فكل “زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى”([40])، كما أن الأفعال فيها معانٍ ثوريةٍ كامنةٍ طوعها أهل المعتقلات في أشعارهم، فهو شعر ثوار ثورة من أجل الحرية والاستقلال، وطرد المحتل وكنسه عن ثرى فلسطين الطاهرة.
ووظف أدباء المعتقلات في أشعارهم الصيغ الفعلية المركبة، التي تتآلف فيها الحروف مع صيغ الأفعال لتبلغ المقصود وتوصل رسائل لغة نصوص الخطاب المنجز، وشكَّلت هذه النسقيات التركيبية سمات دلالية متفاعلة مع الحدث الأدبي والمعاني الإبداعية، التي يَروم المعتقل إلى إيصالها والإفصاح عنها، ومن ذلك استخدم الشاعر (قد) التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع، ويُلاحظ أن الشاعر اعتمد إلى تركيبها مع الفعل الماضي؛ مثل: (قد نزلت- قد ملأ- قد فقد- فلقد خلت- قد أجلبوها- قد كنتُ- قد أقسموا- قد عزمت- قد شد- قد نسيت- قد كابد- قد مضى)؛ لأنها تفيد التحقيق والتأكيد للقضايا والدلالات التي يريد أهل المعتقلات التأكيد عليها؛ لأنها من الثوابت في معتقداتهم وسجلهم الجهادي؛ فيقول الشاعر واصفاً بسالة المجاهدين([41]):
| أشراف قوم لا يُضام نزيلهم | وإذا استحثوا خيلهم لم تبهتِ | |
| قد أجلبوها حرة أنسابها | جابوا بها أنف الصعاب فذلت | |
| وأبر من حمل اللواء فوارس | بهم إذا عز الفداء تفدت | |
| خاضوا المنايا لا تمل نعالهم | دوس العداة ولا لهيب العركة | |
| قد أقسموا أن لا تغل لهم يد | ذوداً عن الحرم الأسير فبرت |
وظف الشاعر قد مع الفعل الماضي (أجبلوها، أقسموا)؛ ليؤكد على قوة شكيمة الأحرار وإيمانهم المطلق بنهج الثورة والجهاد ضد الطغاة المعتدين وأعوانهم، كل ذلك يدلل على مدى قوة الشكيمة التي تختزنها نفوس المبدعين من المعتقلين خلف قضبان السجون، وتحمل زفرات شعرية وشعورية نابعة من حب الوطن وترتبط بالبعد القومي والتاريخي لأمجاد العرب والمسلمين، وقال الشاعر في رثاء إخوة الدم من الأحرار([42]):
| رغب الخلود بصحبة فاختارهم | ولقد أجاد بذا اصطفاء الصحبة |
استخدم الشاعر (قد) مع الفعل الماضي للتأكيد على رابط الإخوة في طريق الجهاد والمقاومة، وتنكب سبيل ذات الشوكة من أجل نصرة المستضعفين ورفع الظلم عن أبناء الأمة.
ووظف مبدعو المعتقلات (لم) مع الفعل المضارع التي تفيد نفي حدث المضارع وتحويله إلى الزمن الماضي([43])، وهذا التحول يكون في الفضاء المغلق للمعتقلات بما يشي بحالة الرفض والتمرد على الطغاة الظالمين ومن والاهم؛ مما يشحن النص دلالياً،” فانتقال المبدع بين الأزمنة داخل النص هو بعث للحركة وموت للركود، وهو مقابلة وصراع بين أزمنة وأحداث، وبالتالي يظل العمل الفني قلقاً نتيجة هذا الانتقال المحسوب بين الأزمنة، فالزمن في بنية النص لليس زمن صيغة فقط بل يتحول كثيراً إلى دلالات يفرزها السياق النصي”([44])، ومن التراكيب الواردة في ديوان عصافرة (لم يثنه- لم تبلغ- لم تشبع- لم تنطق- لم يعد- لم تذق-لم يركع)، ومثال ذلك قول الشاعر([45]):
| وأين اللذائذ إن لم يكن | قراع الخطوب ودفع العداء |
نفى الشاعر التمتع بملذات الدنيا ونعيمها، وحول جل اهتمامه لمنازلة الأعداء ومواجهة المصائب والملمات ودفع العدوان عن بني شعبه وأمته، فجاء الفعل المضارع(يكن) منفياً يدلل على ثبات المعتقلين وصمودهم أمام موجات المحن والآهات والآلام، وقال الشاعر([46]):
| وأبي تقدم يوم حمحمت الرحى | فوج الكتائب هازئاً بالهجد | |
| وأضاف طراد العداة مكرماً | وفداهم بالنفس فدي الأمجد | |
| لم يثنه عن عزمه حب الضنى | والإبنُ مجبنةٌ لغير محمد |
يصور الشاعر الهمة العالية التي يستمدها من والده الذي أنشأه على درب الشهادة والجهاد، تلك الطريق التي رسمها الشهداء بدمائهم وأشلائهم، واستخدم (لم) مع الفعل المضارع(يثنه) للدلالة على الاستمرار والصمود في المعتقلات والساحات في وجه صلف المحتل وأعوانه، وقال([47]):
| لم يعد في القلب إلا وجده | وكلوم لم تذق طعم الشفاء |
ووظف الشاعر (لم) مع الفعل المضارع(يعد، تذق) ليدلل على مدى المعاناة الإنسانية التي يحياها أهل المعتقلات وما يكتنف ذلك من مآسٍ وآهات يمارسها المحتل الغاصب على أبناء الشعب الفلسطيني.
واستخدم شعراء المعتقلات حرف النفي(لا) مع الفعل المضارع التي تحمل معنى النهي، ومن أمثلته قول الشاعر([48]):
| أصخر أنت لا يعروك وجد | وقد فقد الفطيم أبا فناحا | |
| أصخر أنت لا يبكيك طفل | كسير القلب قد فقد الجناحا |
يصور الشاعر مدى بشاعة الصورة في حرب غزة فيقول للمخاطب لا يهز وجدانك ومشاعرك ما ترى، لا تبكي تأثراً ولا تهتز مشاعرك من الأطفال الذين قطعوا أشلاء وإرباً من طائرات الحقد والكراهية، وقال([49]):
| لا زلت أنعم بالربيع بقربه | حتى أهل خريف دهر أجرد |
وظف الشاعر حرف النفي مع الفعل (زلت)، التي تنفي الركون والابتعاد، وتؤكد قوة الروابط والثبات على النهج الصحيح، وتدخل (لا) على الاسم لنفيه؛ ومن أمثلة ذلك قول الشاعر([50]):
| أحياةٌ بنت ثلاثة لا رجعةً | فيهن لا أسفٌ على الأوهام |
يخاطب الشاعر نفسه في الأسر وذلك عندما بلغ ثلاثين عاماً، فالحياة تمضي فنفى عنها الرجوع، وكل ذلك يصدر عن عقيدة راسخة وإيمان قوي ثابت في القلب لا تحركه الأنواءـ، فينفي الأسف على هذه الحياة أو البكاء على هذا العمر، ولعمري هذه الروح الثورية والنفس الوثابة والمشتاقة للحاق بركب الثوار والمجاهدين الأبرار، ومن أمثلة ذلك أيضاً، قوله:(لا فرار – لا حِراك- لا ريح – لا ضياء) ([51])، وهذا يدل على مدى ظلم السجان وقسوته وجبروته في تعامله مع المعتقلين في السجون؛ حيثُ القيود والسلاسل والشباك والقضبان الحديدية، فلا فرار ولا حراك؛ لثقل القيد وضيق المكان داخل غرف الاعتقال والزنازين، وكذلك لا ريح ولا ضياء سواد حالك وظلام دامس.
استخدم شعراء المعتقلات المشتقات، التي تعد وصفاً لها سماتها الدلالة على مستوى أبنيتها وتآلفها مع سياق نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين، فارتكز مبدعو المعتقلات على بنية اسم الفاعل الذي هو الصفة الدالة على فاعل([52])، ولمن وقع منه الفعل، أو تعلق به([53])؛ للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحَدَث([54])؛ ومن أمثلة ذلك استخدام الشاعر:( ماجد- مبيت- الفتّان- متقدِم – الشادي – الساقي- الغاصبين- شامخ- جاثم-خائف)، واستخدم اسم المفعول الذي يدل على الحدث ومفعوله([55])، ويستخدم لمن وقع عليه فعل الفاعل([56])، ومن أمثلته في شعر عصافرة (منبع- المعزول- معقود- المقدَّم)، واستعمل صيغ المبالغة (خلّاق- عوّار- مقدام- كسير- سبّاق- حمّال- سيّال-خيّال)؛ حيثُ تدل على المبالغة والكثرة في معنى الفعل الثلاثي الأصلي([57])، واستخدم الصفة المشبهة التي ليست من الصفات الجارية وإنما هي مشبهة بها في أنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع نحو كريم وحسن وصعب، وهي تدل على معنى ثابت([58])، ومن الأمثلة عليها في شعر عصافرة(سَمْحُ الخليقة- عَذب الكلمات- عقيد القوم- بَسْطَ الكريم- صخب الحياة-خفض الجناح- عَجِل المنون)، هي ومن أمثلة استخدامه المشتقات قوله([59]):
| الفخر معقود لآل محمد | والعز مرتهن لهم في المولد | |
| عين العصافرة الكرام وعقدهم | وبهم أصابت كل شأوٍ مُحْصَدِ | |
| إذا سراة الناس أجفت وانكفت | وسلت مكارمها بلُسنِ رُقَّدِ | |
| فأبيُّ سبّاق لكل فضيلة | وأبيُّ ورّاد المكارم باليد |
وظف عصافرة المشتقات في أبياته السابقة، فكلمة (معقود) اسم مفعول مشتق من الفعل الثلاثي (عُقِدَ) يدل على أن الفخر موجود وواقع في آل العصافرة الذين يعتز بهم الشاعر المعتقل داخل سجنه، وهذا يمثل حالة الشوق والحنين عند أدباء المعتقلات في ظل قلة المناصرين وغيابهم، ووظف الشاعر كلمة (مُحْصَد) على وزن(مُفْعَل) اسم مفعول من غير الثلاثي يكون كاسم فاعله، ولكن بفتح ما قبل آخره([60]) كما ورد في هذا المثال، وهذا يدل على تحقق الحصاد ووصف المحصود، الذي تم جنيه من معالي الأمور ومراتبها، ووظف الشاعر صيغة المبالغة في كلمتي (سبّاق، ورّاد) على وزن (فعّال) الذي يفيد التكثير؛ مما يدلل على روح الثورة والشجاعة والإقدام في ميادين البذل والعطاء عند أبناء الشعب الفلسطيني، لم يكن أهل المعتقلات ظاهرة عابرة أو لمحة دالة إنما يعبرون عن القيم والثوابت التي يؤمن بها الإنسان الفلسطيني الحر، ويذود عنها مهما كلّف الأمر من ثمن، فوهب أهل المعتقلات أرواحهم ودمائهم وأجسادهم من أجل الفوز برضوان الله، وتحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير أمام قوات الاحتلال الصهيوني وصلف الاستكبار الاستعماري العالمي، فجاءتْ الدلالة الصوتية والصرفية معبرة عن تكوينات الخطاب اللغوي في شعر المعتقلات، توحي بدرجة البيان والمقصدية والشعرية المختزلة في الأصوات والأبنية وتشكِّيلاتها، التي تتصل اتصالاً مباشراً برؤية المعتقلين من داخل الفضاء المغلق لسجون الظلم.
النتائج والتوصيات
توصل البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:
أولاً- النتائج.
- اعتمد شعراء المعتقلات على تشكِّيلات من الأصوات التي تحمل الشدة والانفجار والقلقة للتعبير عن موقفهم الرافض لظلم الاحتلال وجبروته؛ مما يضمن شعرية لغة نصوص الخطاب الشعري.
- وظّف شعراء المعتقلات بوتيرة عالية الأصوات المهموسة والرخوة في حديثهم عن الشوق والحنين والأمل المنشود بتحقيق الحرية والاستقلال؛ مما مَنَحَ بنية النصوص حيويةً دلاليةً.
- اختار شعراءُ المعتقلاتِ حروف المد والمقاطع الصوتية الطويلة، التي حملتْ جزءاً من معاناتهم وآهاتهم وآلامهم وآمالهم التي يصبون إليها، والتي تتمثل في الانعتاق من الواقع المرير داخل أقبية الزنازين ومسالخ التحقيق وعتمة السجون وظلامها الدامس.
- استخدم شعراء المعتقلات بنية الفعل بأنواعه كافةً؛ للدلالة على حالة العنفوان الثوري واستمرار المعاناة داخل السجون، والارتكاز على بنية الاسم في استعراض الثوابت والقيم والمبادئ، التي دفعوا زهرات أعمارهم من أجلها.
- جاءتْ زيادات الأبنية تعبر عن معانِ تتعلق بحياة الشعراء في السجون، ورؤيتهم في كيفية الخلاصِ من هذا الظلم والعدوان، ورسم طريق الحرية والاستقلال لأبناء الشعب الفلسطيني.
- استعمل شعراءُ المعتقلاتِ أسماء المشتقات بدرجة كبيرةٍ؛ لأنها تصف أحوالهم التي تكون ثابتة ومتغيرة، نظراً للممارسات الوحشية اليت يقترفها السجان الصهيوني.
- تتسم دلالات الأصوات بمنحى متصاعد يحمل وتيرةً ذاتْ نفسٍ شعري عميق، يعبر عمّا يجيش به صدور المعتقلين.
- تميّزتْ الدلالة الصرفية في شحن النص وضمان فاعلية في تثبت القيم والمبادئ والتعبير عن الأحداث والوقائع ومجرياتها داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
ثانياً- التوصيات.
- ضرورة الكشف عن المكون الصوتي ومتعلقاته في لغة نصوص الخطاب الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين.
- بيان معالم الأبنية التي تجمع الأصوات لتشكل البناء الذي يندرج تحت التراكيب في لغة نصوص الخطاب الشعري؛ لأن جزئيات النص لها دلالاتها في التشكيل الكلي.
- يجب نشر أدب المعتقلين على الساحة المحلية والعالمية، وطباعته بشكل جيد.
فهرس المصادر والمراجع
- أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة: أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا 1973م.
- الأصوات اللغوية، محمد الخولي، دار الفلاح، الكويت 1990م.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري(ت761هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، القاهرة.
- الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، مصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان، العراق 1970م.
- بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب (ت 1422هـ)، مكتبة الخانجي، ط3، القاهرة 1415هـ-1995م .
- البناء العروضي للقصيدة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، ط1، القاهرة 1990م.
- البيان والتبيين ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـــ)، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون (ت 1408هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
- التحرير الأدبي، حسين علي محمد حسين (ت 1431هـ)، مكتبة العبيكان، ط5، الرياض2004م.
- التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة راسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر للجامعات، ط1، القاهرة 2005م.
- التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت 2004م.
- جماليات التلقي وإعادة إنتاج الدلالة(دراسة في لسانية النص الأدبي)، محمد الدسوقي، دار العلم والإيمان، ط1، القاهرة 2007م.
- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، لمحمد بن علي الصبان الشافعي (ت 1206هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت 1997م.
- دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار المعارف، القاهرة 1973م.
- دليل الطالبين لكلام النحويين، مرعي الكرمي(ت1033ه)، إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، الكويت 2009م.
- ديوان الضوء والأثر، علي محمد عصافرة، رابطة الأدباء والكتاب الفلسطينيين،ط1، غزة 2012م.
- شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي (ت1351هـ)، تحقيق: نصر الله عبد الرحمن نصر الله، مكتبة الرشد، الرياض.
- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد الأزهري (ت905هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت 2000م .
- العربية وعلم اللغة الحديث، محمد داود، دار غريب، القاهرة 2001م.
- علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، فريد حيدر عوض، مكتبة الآداب، ط1، القاهرة 2005م.
- علم اللغة، حاتم الضامن، مطابع التعليم العالي، العراق 1989م.
- العوامل الصوتية في توجيه الصيغ المورفولوجية الحدثية وتلوينها، سعاد بسناسي، رسالة دكتوراه، جامعة السانيا وهران، الجزائر 2006م.
- فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، خلدون أبو الهيجاء، عالم الكتب الحديث، ط1، إربد 2006م.
- القافية في العروض والأدب، حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، القاهرة 2001م.
- القوانين الصوتية في بناء الكلمة، فوزي الشايب، عالم الكتب الحديث، 1، إربد 2004م.
- لسانيات النص (مدخل إلى انسجام النص)، محمد خطابي، المركب الثقافي العربي، ط1، بيروت 1991م.
- اللغة الشاعرة – مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية، عباس العقاد، دار غريب للطباعة، القاهرة.
- المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان ناشرون، ط2، بيروت 1984م.
- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة ، مصر.
- المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم الزمخشري(ت538هـ)، علي بو ملحم، مكتبة الهلال، ط1،بيروت 1993م.
- النحو المصفى، محمد عيد، مكتبة الشباب، القاهرة.
- النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، على الجارم ومصطفى أمين، الدار المصرية السعودية، القاهرة.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق : عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة .
[1])) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص15.
[2])) لسانيات النص (مدخل إلى انسجام النص)، ص49.
[3])) المرجع السابق.
[4])) أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ص15.
[5])) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص13.
[6])) العوامل الصوتية في توجيه الصيغ المورفولوجية الحدثية وتلوينها، ص50.
[7])) علم اللغة، ص57.
[8])) ديوان الضوء والأثر، ص44.
[9])) فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، ص237.
[10])) ديوان الضوء والأثر، ص32-33.
[11])) الأصوات اللغوية، ص145؛ 155.
[12])) ديوان الضوء والأثر، ص7.
[13])) ديوان الضوء والأثر، ص61.
[14])) ديوان الضوء والأثر، ص17.
[15])) ديوان الضوء والأثر، ص76.
[16])) الورقاء: الحمامة. انظر: المعجم الوسيط، ج2/ص1026.
[17])) ديوان الضوء والأثر، ص71.
[18])) بحوث ومقالات في اللغة، ص78.
[19])) الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، ص4.
[20])) البناء العروضي للقصيدة العربية، ص17.
[21])) التحرير الأدبي، ص49.
[22])) البناء العروضي للقصيدة العربية، ص165.
[23])) البيان والتبيين، ج3/ص274.
[24])) القافية في العروض والأدب، ص5.
[25])) ديوان الضوء والأثر ص42.
[26])) المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص284.
[27])) اللغة الشاعرة، ص11.
[28])) العربية وعلم اللغة الحديث، ص106.
[29])) دراسات في علم اللغة، ص12.
[30])) أسس علم اللغة، ص44.
[31])) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة راسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص13-14.
[32])) ديوان الضوء والأثر، ص17.
[33])) أوضح المسالك، ج2/ص136 وشرح التصريح، ج1/ص439 وهمع الهوامع، ج3/ص315 وشذا العرف، ص41.
[34])) علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، ص35.
[35])) التطبيق الصرفي، ص30.
[36])) ديوان الضوء والأثر، ص43.
[37])) ديوان الضوء والأثر، ص7.
[38])) ديوان الضوء والأثر، ص48.
[39])) ديوان الضوء والأثر، ص19.
[40])) بحوث ومقالات في اللغة، ص21- 22.
[41])) ديوان الضوء والأثر، ص7 -8.
[42])) ديوان الضوء والأثر، ص8.
[43])) انظر: دليل الطالبين لكلام النحويين، ص29.
[44])) جماليات التلقي وإعادة إنتاج الدلالة(دراسة في لسانية النص الأدبي)، ص69-70.
[45])) ديوان الضوء والأثر، ص12.
[46])) ديوان الضوء والأثر، ص19.
[47])) ديوان الضوء والأثر، ص6.
[48])) ديوان الضوء والأثر، ص10.
[49])) ديوان الضوء والأثر، ص19.
[50])) ديوان الضوء والأثر، ص41.
[51])) ديوان الضوء والأثر، ص18.
[52])) حاشية الصبان، ج2/ص442 والنحو المصفى، ص65.
[53])) شذا العرف، ص61.
[54])) شذا العرف، ص62.
[55])) شرح التصريح، ج2/ص22.
[56])) شذا العرف، ص 63 والنحو الواضح، ج1/ص328.
[57])) أوضح المسالك، ج3/ص184.
[58])) المفصل في صنعة الإعراب، ص293 وشذا العرف، ص63.
[59])) ديوان الضوء والأثر، ص39.
[60])) شذا العرف، ص63.