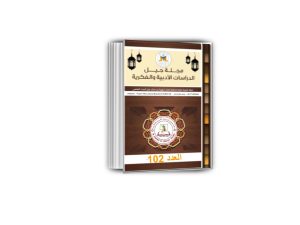الشعر بين الواقع والخيال
العربي قنديل ـ باحث بمختبر الدراسات المقارنة- جامعة محمد الخامس/ الرباط
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 36 الصفحة 61.
حديث التقديمتكشف ثنائية الواقع والخيال تصورا خاصا لعـــلاقة الأدب عامة والشعر بخاصة بالواقع. والقول بربط الشعر بالواقع لا يعني أن يتقيد الشاعر بالوصف الحرفي لما يراه وإلا كان ذلك ضربا من السذاجة، ووقوعا في الواقعية الحرفية والتقريرية، وابتعادا عن روح الشعر. ولعل سبب ربطنا بين ثنائية الواقع والخيال في مكونات النص الشعري يعود إلى خصوصية هذه الأخيرة، إذ يصعب اختزالها في مجرد “تقطيع وجودي “Découpage existentiel” إلى خيال وواقع. وذلك راجع للتداخل الحاصل على مستوى المنجز النصي في ما له مرجعية في الواقع و ما لا يمتلك هذه المرجعية، فيظل بحاجة إلى اجتهاد المتلقي في ربطه بطرق ملتوية بالمرجع الواقعي. السؤال المطروح إذن هو: هل نحن مطالبون بربط المكونات النصية بمرجعية واقعية تحيل إلى خارج النص؟ أم بمرجعية داخلية تحيل إلى النص نفسه وتحقق صدقه الفني؟
I – التصورات النقدية القديمة
- ابن رشيق القيرواني ومفهوم “الغلو”
لقد سبق لثنائية الواقع والخيال في الشعر أن تنوولت قديما من قبل الفلاسفة والنقاد، لكن بمفاهيم مختلفة كثنائية: الصدق/الكذب، والاعتدال/الغلو، والزيف/الحقيقة، والصحة/الخطأ، والنموذج/ المحاكاة. إلا أن طريقة التناول اختلفت من باحث إلى آخر حسب اختلاف المرجعيات التي ارتكز عليها كل واحد منهم.
وقبل أن نخوض في البحث عن جذور ثنائية الواقع والخيال، نورد مثالا على استراتيجيتنا في مقاربة الموضوع من خلال ما جاء به إدريس الناقوري في مصطلحه النقدي، إذ يقول: »والممتع الذي يذكره قدامة قد لا يكون غير الغلو الذي يجوزه مادام ليس خارجا عن طباع الشيء ولا مستحيلا، وما الغلو إلا القدرة على التخييل”[1] فقد ربط بين المصطلح القديم ( الغلو) والآخر الحديث (التخييل)، لأن الأول هو نتيجة ومحصلة للثاني.
وإذا كان إدريس الناقوري قد أقام حوارا مع “قدامة بن جعفر” في مصطلحه النقدي، فسنحاول كذلك إقامة الحوار نفسه مع كل من “ابن رشيق القيرواني” و”عبد القاهر الجرجاني” و”حازم القرطاجني”، للتوقف عند طبيعة هذه العلاقة.
إن استقصاءنا لتجليات هذه الثنائية في كتاب العمدة “لابن رشيق القيرواني”، يكشف لنا عن كونه يفرد بابا خاصا يطلق عليه “باب الغلو” يقول فيه: “وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل، وثبت فيه الشاهد من كتاب الله تعالى”. وإذا كان الكلام عنده يكون صحيحا اذا ثبتت حجته فإننا نجده قد قرن الغلو بالخروج عن الحق في إيراده لقوله تعالى: “يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الحق”[2].
فإذا كــان الشاعر الحق عند “ابن رشيق” هــو من يطابق شعره الحقيقة أو الـــواقع، ومن ثم يكتسب صفة الصحة، فإن الغلو خروج عن هذا النهج، و هو ما لا يتحقق في الشعر إلا بالصور التخييلية. ولعل ما يجب الانتباه إليه في هذا الموضع هو الخلفية الفكرية الموجهة لابن رشيق القيرواني، ألا وهي الخلفية الدينية التي ترسخ قيمة الصدق وترفض الكذب ولو كان مزاحا. ولعل موقف صاحب “العمدة” يبدو واضحا من خلال النعت الذي أضفاه على المنادين بالحقيقة في الشعر بأنهم حــذاق، إذ يقــول:” وقد قال الحذاق: خير الكلام الحقائق، فإن لم يكن فما قاربها وناسبها”[3].
وإذا كان ذلك كذلك، فإن مصطلح “الغلو” كما ورد عند ابن رشيق يعتبر صفة قدحية تنبه الشعراء إلى ضرورة الحد من شطحات الخيال، والتزام الصدق واحترام صلة الشعر بالمنطق والواقع، وأن تكون وظيفة الخيال مساهمة في التعبير عن الواقع. إلا أن الغلو في الشعر لا يعني دائما الإفراط في التجريد على مستوى التخييل، فحديث بشار بن برد عن نحول جسمه بسب عذاب الحب، حتى أدى ذلك إلى أن يَتَمَنْطَقَ بخاتمه، ليس فيه تجريد، ولكن فيه ابتعاد– قائم على ما هو محسوس– عن المنطق وخروج إلى المحال. حيث يقول:
“قَدْ كَانَ لِي فِي مَا مَضَى خَاتَمٌ وَالأْنَ لوْ شِئْتُ تَمَنْطَقْتُ بهِ”
ولعل هذا هو ما يقصده القدامى في قولهم بـ”الغلو”، فليس الغلو هو التخييل بقدر ما هو أحد تجلياته.
- عبد القاهر الجرجاني وثنائية الصدق والكذب
إذا كان ابن رشيق قد ركز على مفهوم “الغلو” من منطلق ديني أخلاقي فإن الجرجاني سينظر في عــلاقة الشعر بالحقيقة نظرة الحكم أو القاضي الذي يعرض آراء الطرفين وحججهما. إذ يقسم المعاني إلى قسمين: قسم عقلي؛ وهو الذي يتصف بالصحة ويتطابق مع الحقائق التي لا شك ولا جدال فيها، حيث عرف الجرجاني المعنى العقلي قائلا: “معنى صريح محض يشهد له العقل بالصحة، ويعطيه من نفسه أكرم النسبة، ويتفق العقلاء على الأخذ به، والحكم بموجبه، في كل جيل وأمة …”[4].
وإذا كان هذا النوع من الشعر ينزع نحو المعاني الصحيحة، فإن المجال الأمثل لهذه المعاني هو الدين. فكما عـاد ابن رشيق إلى الإسلام لتبرير الـــدعوة إلى الصحـة والصدق، فكذلك هو الشأن بالنسبة للجرجاني الذي يربط ما جاء من هذا القسم العقلي بالمعاني الــــواردة فــي السنة النبويـــة والقـــرآن الكـــريم، إذ يورد مقتبسا من السنة النبوية ما يلي: “كلكـــم لآدم وآدم مـــن تراب”[5]. وقـد أورد هذا المعنى ذاتـــه باعتباره من المعاني الصادقة والصحيحة عند “محمد بن الربيع الموصلي” في قوله:
“النٌاسُ فِي صُورَةِ التَّشْبِيهِ أَﮐَْفَاءُ
أَبُوهُمُ آدَمً وَ الأُمُّ حَوَّاء”[6].
أما القسم الآخر، فهو القسم التخيلي؛ وهو “الذي لا يمكن أن يقال إنه صادق، وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي، وهو مفتن المذاهب، كثير الممالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبا و لا يحاط به تقسيما وتبويبا”[7].
على هذا الأساس، نلاحظ أن الجرجاني يرى في التخييل ذلك الفعل الذي لا يمكن الحكم عليه صدقا أو كذبا لأنه خارج معيار الحكم. ذلك انه ينفلت من التقسيم المرجعي والحكم القيمي. ولعل أبرز تعبير عن تذمر الشعراء من مطالبتهم باحترام المنطق قول “البحتري”:
كَلفْتُمُونَا حُدُودَ مَنْطِقِكُمْ وَالشِّعْرُ يُزْرِي بِنُطْقِهِ عَجَبُهْ
وَمَا كَانَ دُو الْقُرُوحِ تَلْهَجُ بالـَــــــــــــــــــمَنْطِقِ مَا نَوْعُهُ وَمَا سَبَبُهْ
وَالشِّعْرُ لَمْحٌ تَكْفِي إِشَارَتُهُ وَلَيْسَ بالْهَدْرِ طُوِّلَتْ خُطْبُهْ
إن القائلين بـ”صدق الشعر” يوجهون الشعراء بالنتيجة إلى البحث عن المعنى البسيط والصريح الذي لا يستعصي على العقل ولا يربك الفكر. وفي المقابل، يمجون أي شعر لا يجود بمعناه إلا بعد طول مماطلة. وهذا ما عبر عنه الجرجاني بقوله: “فمن قال: “خيره أصدقه« كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق الصحيح اعتماد ما يجري من العقل على أصل صحيح، أحب إليه وآثر عنده”[8].
أما القائلون بجمالية الشعر الكاذب فميالون إلى شعر الصنعة، لأنه يفتح آفاقا رحبة للتعبير أمام الشاعر، من جهة، ويبقى المجال مفتوحا أمام القارئ لاستقصاء معاني النص انطلاقا من تأويلات ثرة من جهة أخرى. وهو ما عبر عنه “الجرجاني” قائلا: “ومــن قال »أكذبه«[يعني الشعر] ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها، وتنشر شعاعها، ويتسع ميدانها، وتتفرع أفنانها، حيث يعتمد الاتساع والتخيل، ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل”[9].
وعليه، يكون منهج الجرجاني في الحكم هو عرض الرايين المختلفين بل المتعارضين، ليحتكم الى معيار ديني في تغليب كفة المنادين بالواقعية، والى معيار الفن في تدعيم كفة القائلين بالتخييل.
3 – حازم القرطاجني ومفهوم “التخييل”
لقد عرض “حازم القرطاجني” لمفهوم “التخييل” أثناء مقارنته بين “الأقاويل الشعرية” و”الأقاويل الخطابية”. وفي هذا الصدد خص الأقاويل الشعرية بالقول: “فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب بل من حيث هو كلام مخيل“[10].
من خلا ما تقدم، نستشف أن القرطاجني قد جاء بتصور مهم لحل قضية الصدق والكذب فـــي النص الشعري. فالعبرة عنده لا تكــون بصدق الأقاويل ولا بكذبها، بل الأهم هو أن الخطاب الشعري ككل يقوم على مفهوم التخييل ما دام “الشيء قد يخيل على ما هو عليه وقد يخيل على غير ما هو عليه”[11].
وبذلك يكون القرطاجني قد فتح آفاق الإبداع الشعري لتشمل الكائن والممكن وغير الممكن، مما يخلص الشعر من تلك النظرة الضيقة التي تنزع إلى النفعية في استخلاص المضامين الشعرية بشكل مباشر دون مكابدة لرحلة المشاق أثناء عملية محاورة النص واستجلاء معانيه، لأن الأخذ بتلك النظرة سيوقع الشعر في دائرة النثر أو يقربه منها.
وإذا كان القرطاجني قد طرح مفهوم “التخييل” كحل يتعالى على ثنائية “الصدق والكذب”، فإنه لم يقحمه في الشعر جزافا دون برهنة أو استدلال، بل عمل على تبرير ما ذهب إليه، منطلقا من مراعاة طرفي التواصل الأدبي: الشاعر/ القارئ، أو المنشد/ السامع، أو المرسل/ المرسل إليه. إذ إن المتحكم في قصدية الشاعر هو “اليقين”. وبالتالي، يتوخى تحقيق “التصديق” عند الطرف الآخر وهـــو المرسل إليه. وعلى عكس ذلك، فما هو حاصل في الخطابة هو أن ما يتحكم في مرسلها هو “تقوية الظن”، مما يجعل الخطيب ينزع إلى الإقناع ما أمكنه ذلك لحصول التصديق لدى السامع. أما الشعر فيتحدث عن “يقين” يتواطأ عليه الشاعر والمتلقي، سواء أكان الشاعر صادقا أم كاذبا لأنه يقين مخيل.
فضلا على ذلك، فإن للتخيل دورا كبيرا في التأثير في المتلقي، وذلك مدعاة استحسانه. وفي ذلك يقول القرطاجني: “ويحسن موقع التخييل في النفس أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب فيقوي بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام[12] .
غير أن القرطاجني لم يعط التخيل مفهوما مفتوحا بشكل مطلق، بل وضع له ضوابط لا يحسن بل لا يجب عليه تجاوزها. ولتوضيح ذلك يقول:” ولا يخلو الشيء المقصود مدحه أو ذمه من أن يوصف بما يكون فيه واجبا أو ممكنا أو ممتعا أو مستحيلا. والوصف بالمستحيل أفحش ما يمكن أن يقع فيه جاهل أو غالط في هذه الصناعة. والممتنع قد يقع في الكلام إلا أن ذلك لا يستساغ إلا على جهة من المجاز”[13].
لكن الممتنع والمستحيل كما ورد عند القرطاجني قد يلتبسان، فهـــو يمثل للممتنع بأن ننسب عضـــو حيوان إلــى حيوان، ويمثل للمستحيل بأن نصف الشيء بأنه صاعد نازل في الآن نفسه. وإذا كان الخيال الشعري يضم كلا من الممتنع والمستحيل فـالقرطاجني يحد من طاقة الخيال عندما لا يقبل الممتنع إلا على مضض، ويرفض المستحيل رفضا قاطعا، وهو مـا توضحه الألفاظ التي استعملها فـــي هــذا الصدد: »أفحش«، »جاهل»، «غالط«.
وإذا كانت التصورات النقدية القديمة قد وجهت اهتماماتها إلى مقاربة موضوع الشعر بشكل يجمع بين النظري والتطبيقي، أي بين ملامسة مفاهيم مثل: الصدق/ الكذب/ الغلو/ التخييل/ المبالغة/ التشبيه، مع إرفاق هذا التناول بأمثلة لتعيين مواقع تمظهر تلك المفاهيم، سواء عند ابن رشيق القيـــرواني، أو عند عبد القــاهر الجــرجانـــــي، أو عند حـــازم القرطاجني، فإن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا الفرق الهام الذي يميز القرطاجني الذي يمكن أن نطلق على مقاربته– مع بعض الاحتراس– نعت “المقاربة التخييلية”، لأنه كان أكثر النقاد القدماء استفاضة في الحديث عن مفهوم التخييل الأدبي، إن في جانبه النظري أو التطبيقي، مادامت مقومات منهجه تنبني في التقليد النقدي الحديث على توافر دعامتين أساسيتين هما: خلفية نظرية وتطبيقات نصية وإواليات اشتغال.
لقد توفرت هذه الشروط في عمل “القرطاجني”. إذ تطرق في الجانب النظري الذي تقع فيه أغلب الثنائيات النقدية في النقد القديم: الصدق / الكذب، الزيف/ الحقيقة، الطبع/ الصنعة، كما قدم بديلا يتجلى في الجانب التخييلي لبعض المقاطع الشعرية، معتمدا في ذلك على خلفيات دينية وأدبية ووقائع تاريخية.
كما أردف القرطاجني كل فكرة نظرية بشواهد من القرآن الكريم أو من الشعر العربي، ثم حللها نصيا وفقا لمنظوره التخييلي. وبذلك، تشكلت لديه معالم مقاربة شاملة لمفهوم التخييل.
وإذا كام ذلك كذلك، فمــا موقف الشعرية الحديثة والمعاصرة من “الممتع” و”المستحيل” المرفوضين من قبل القرطاجني؟ ومـا تصورها لمفهومي الخيال والواقع في اشتغالهما داخل النص الشعري بصفة خاصة؟
II- التصورات النقدية الحديثة
سنحاول في هذا المحور التوليف بين مجمــــوعتين مـــن الطروح النظرية التي قدمها بعض النقاد سواء في الغرب أم عند العرب. وداخل هذا المبحث نفسه، سنحاول التمييز بين نظرة تجعل التخييل وساطة بين الواقع والخيال، وأخرى تنصبه وسيطا بين الأنا والواقع.
- التخييل.. وساطة بين الواقع والخيال
إن التطرق إلى ثنائية الواقع/ الخيال ليحيلنا إلى مذهبين أدبيين كبيرين في تاريخ المذاهب الأدبية. حيث يؤمن الأول بضرورة الالتزام بالواقع التزاما “حرفيا”، فيما يعول الثاني على الخيال بشكل مفرط يقربه من شطحات “التفكيكية”.
واستعمال مصطلح “الحرفية” و “التفكيكية” بين مزدوجتين، إنما هو للتحفظ من إطلاق حكم قيمة على هذين المذهبين، ولإبراز الفـرق بين المذهب الــــــواقعي و المذاهب السريالية والدادية… من جهة، وبين ما يمثله الطرح، هدف بحثنا هذا، وهو مفهوم التخييل من جهة أخرى.
كما أن استعمال لفظة “الحرفية” يدل على أن محاولة كيفما كانت درجة توقها إلى الانفصال عن الواقع لا يمكنها أن تحقق ذلك، لأنه يمثل ضربا من المستحيل. فحتى فكرة الانفصال عن الواقع تمثل في حد ذاتها موقفا معبرا عن هذا الواقع المراد الانفصال عنه. كمــــا أن لفظة “الواقعية” تشير إلى أن المقاربة الواقعية (الحرفية) قد تنزع إلى وصف أو تفسير الظواهر الواقعية بشكل جاف ينفي الإبداعية الفنية والخيالية عن العمل الأدبي.
إن أهم خصائص الأدب الواقعي هي نقل الواقع بدقة متناهية. وفي هذا الإطار، يقول تودروف: “فعلى القارئ وهو يقرأ الأعمال الواقعية، أن يكون لديه انطباع بأنه بصدد خطاب لا قاعدة له غير قاعدة نسخ الواقع بدقة. وجعلنا على صلة مباشرة بالعالم كما هو”[14]. فاستعمال تودروف لكلمة “نسخ” له بالغ الدلالة على هدف هذا المذهب الأدبي، أي إنتاج نسخة طبق الأصل من الواقع.
وقد سار بعض الشعراء العرب على نهج المذهب الواقعي إلى درجة أن بعضهم قد حمل الواقعية أكثر مما تحتمل، حتى أدى ذلك إلى فقدان الجانب الفني والأدبي لصالح تقصي الوقائع الاجتماعية بشكل مباشر وتقريري. وهو ما تكرر في مذاهب و مدارس أدبية أخرى، حتى ألفينا الرومانسية الثورية في منشئها وقد أصبحت رومانسية انهزامية استسلامية عند الكثيرين ممن استهواهم شكلها التعبيري، دونما عميق اهتمام بغاياتها التعبيرية و خلفياتها الفكرية. ولعل هذا ما أدى إلى القول بان “ولكن معظم هذا الشعر- وخاصة في المرحلة الأولى– جاء من الناحيــة الفنية ضعيفا ومباشرا. وهذا يعني أن الواقعية لـــم تفهم على وجهها الصحيح عند شعرائنا، بــل فهمت على أن هذا الحديث المباشر عن الواقع، أي عن الحــركات السياسة والاجتماعية، ومن ثم وجدنا نقادا واقعيين إلى جانب شعراء واقعين في مستوى هذا الفهم الضيق الذي أفرز عدة دواوين شعرية كتبت بلغة مباشرة وواضحة”[15].
إن هذا الخلط الذي وقع فيه بعض النقاد والشعراء العرب، هو نفس الخلط الذي وقع فيه الكتاب الغربيون، منطلقين في ذلك من كتابي “الشعرية ” لأرسطو، واللاوكون (Laocoon) لكاتبه “ليسنك”. إذ إن الأول لا يرى في الأدب إلا محاكاة للواقع. في الوقت الذي يرفض فيه الكتاب الثاني أن يكون الأدب مقتصرا على عملية نسخ ومحاكاة بشكل ميكانيكي.
وإذا كان أنصار الكتاب الثاني “Laocoon” لا يرضون بهذا النسخ الآلي للواقع فإنهم يطرحون بديلا لذلك يمكن تمثل ملامحه عند “تودروف” الذي انطلق من أن الأدباء لا يحاكون الواقع في جميع الأحوال ، بل قد يحاكون كذلك أشياء لا وجود لها في الواقع كبعض الكائنات أو الأفعال، ليصل إلى أن “الأدب تخيل ، وذلكم هو تعريفه البنيوي الأول”[16].
غير أن ما ذهب إليه تودروف لم يكن سوى تذكير بما توصل إليه “فريجي”. وبهذا الخصوص، يقول تودروف: “فقد سبق لأوائل علماء المنطق المحدثين (ومنهم فريجي مثلا) أن لاحظوا أن النص الأدبي لا يخضع لمعيار الحقيقة، وأنه ليس بصحيح أو مغلوط ، لكنه تخيلي على وجه الدقة. وذلك ما أضحى اليوم حيزا مشتركا.”[17].
وإذا كان “فريجي” من المناطقة الأولين الذي تأثروا بأرسطو في كتابه “فن الشعر” الذي أعلى فيه من قدر الشعر ، ودافع عن المبالغة في الشعر، لأن الشاعر لا يصور ما هو كائن فقط ،بل يصور ما ينبغي أن يكون أيضا. وبذلك اعتبر مفهوم “الخيال” كبديل عن الارتباط بالواقع أو كانفلات من ثنائية “الصحة والخطأ” ، فإن هناك الكثير من الفلاسفة والنقاد ،المتأثرين بالمنطق كذلك، قد سبقوه في الوصول إلى ذلك. ولعل من أبرزهم : ابن سينا، وابن رشد، والقرطاجني…
وإذا كان هؤلاء الأعلام المتقدمون قد جعلوا للشعر منفذا يهرب عبره من قبضة الواقع، فإن نظرتهم تلك كانت مجملة .إذ اهتموا بإبراز الخطـــوط العريضة والعامـــة في عملية التخييل، من قبيل تحويل الأشياء الواقعية إلى أخرى تبدو منفصلة عن الواقع. لكن كيف لهذه العملية أن تحصل إجرائيا أثناء الإنجاز النصي؟
للإجابة عن هذا السؤال سنستقصي مجموعة من الآراء التي نستهلها برأي علي آيت أوشن في ذهابه إلى أن “التخييل ليس تصورا للواقع كما هو ، فذلك شأن الإدراك الحسي، ولكنه تصور لما يمكنه أن يكون أو لما سوف يكون، فالشاعر في عملية التخييل يستعين بالذاكرة ، فهي التي تزوده بالصور الذهنية لأشياء واقعية، ولكنه يركب منها أشياء لا وجود لها في الواقع”[18]. وهو بذلك يشرح تصور الفلاسفة: ابن سينا والفاربي وابن رشد للتخييل، وبطريقة غير مباشرة كان يشرح تصور أرسطو المشار إليه سلفا.
وفي الإطار نفسه، نلفي الناقدة “يمنى العيد” تتجه إلى المتلقي قصد تفعيل العملية التخييلية إجرائيا. فالأدب– حسب الناقدة– لا يستعمل الكلمات قصد إبراز علاقة المطابقة بينها وبين مرجعها الواقعي، بل إن ذلك لا يكون إلا في مرحلة أولى، وسرعان ما يكتشف المتلقي أن استعمالها كـــان لتكثيف حمولـة إيجابية تؤشر على أفكـــار أخرى. إذ إننا “نلاحظ أن لهذه الموجودات أسماء هي الكلمات التي تطابقها. غير أنه بالإمكان أن نحرف هذه الكلمات أو أن نزيحها عن مستواها المطابق، عن طريق استعماله رمزيا. وهذا يعني أننا نحول الكلمة إلى علامة”[19].
- التخييل.. وساطة بين الواقع والأنا
إذا كان مفهوم “الانعكاس” الآلي يتخذ من نسخ الــواقع ومطابقته مطابقة حرفية قـــاعدة أساسية له، فإن الانعكاس سيعرف نوعا من التطور على يد غولدمان الذي رأى في الانعكاس الآلي قدرا كبيرا من الميكانيكية التي تسلب العمل الأدبي أدبيته. وهكذا قسم مقاربته إلى مستويين: مستوى دراسة بنية العمل الأدبي بوصفه ينتمي إلى جزء من البنية الثقافية التي لها خصوصيتها ، ومستوى إدراج هذه البنية ضمن بنية أكبر وأوسع هي البنية الثقافية والفكرية التي هي- في النهاية- تعبير عن الوعي الكائن والوعي الممكن للطبقة التي ينتمي إليها الكاتب. بهذه المقاربة خلص غولدمان مفهوم الانعكاس من سوء الفهم الذي عرّضه للمكانيكية.
يجد هذا الطرح الغولدماني صداه عند محمد بنيس الذي يرى أن: “الانعكاس، كما يوضحه غولدمان غير مباشر، لأن العمل الأدبي هو الصورة الذاتية للعالم الواقعي، ولذلك فإن تطبيق المقولة الماركسية بطريقة ميكانيكية لا يساعدنا على فهم العلاقة الموجودة بين ما هو موضوعي، في الواقع، وما هو خيالي في النص الأدبي”[20].
فالمقصود بالصورة الذاتية للعالم الواقعي هو رفض التصور الذي لا يرى في العمل الأدبي إلا نسخة مطابقة للأصل الذي هو الواقع، بغض النظر عن ذاتية الأديب. في حين أن التصور الجديد سيعيد الاعتبار للأديب ولذاتيته في صياغة العمل الأدبي.
وفي إطار المواقف المنتصرة لمكانة العنصر الذاتي داخل العمل الواقعي كما هو الشأن بالنسبة “لغولدمان” ينجد أنه ” كلما كـان هناك التحـــام بين العنصر النضالي والعنصر الشخصي مع توفر الأمانة والصدق في التعبير كان ذلك تعبيرا عن خصوبة العمل وارتوائه من أحضان الحياة”[21].
فالعنصر النضالي يؤشر على الحضور القوي للجانب الواقعي عند “عادل بنمنصر” إضافـة إلى عنصر “الصدق في التعبير” .وهذا الصدق لا يعني الصدق في نقل الحقائق الواقعية كما هي، بل هو صدق مرتبط بالأديب، يجعله ملتصقا بقضيته، ومطبوعا في صياغته، ومؤمنا بتجربته وشرف رسالته. لكن كل هذه الجوانب تبقى في أمس الحاجة إلى “العنصر الشخصي” الذي يدعمها ويعينها، قصد الوصول إلى النهل الصحيح من “أحضان الحياة”. ومنه، إلى الانصهار تلقائيا في حركة التطور الإيجابي للتاريخ وللحضارة البشرية ككل.
إن تشبعنا بهذه العناصر فسنجد أنفسنا لا نستغرب الجمع بين الواقعية الفنية ومختلف الأشكال التعبيرية: الرمز، الصورة، الأسطورة وغيرها. فكلها تشكل وسائل للخلق الفني في الشعر.
لقد سبق أن تطرقنا إلى ضرورة النهل من الواقع المعيش مع بعض الباحثين”باعتباره عنصرا أساسيا في تشكيل العمل الأدبي. وهــو ما سنجد له سندا عند “كريستوف كودويل” تحت اسم “تقديم بيان ما حول الــواقع”، إذ يقول: “والآن، وبالطريقة نفسها فإن الشعر– أو الفن الأدبي عمومـا– حين يرغب في “أن يرمز” إلــــى الانا الاجتماعية، أي يرغب فــــي نقل المواقف الفعالة بطريقة منظمة، فإنه لازال مضطرا إلى تقديم بيان ما حول الواقع. العواطف والانفعالات لا نجدها في الحياة الفعلية إلا ملتحمة بأجزاء من الواقع”[22].
انطلاقا من قول “كودويل”، نستنتج أن هناك اتحادا قويا بين الواقع والعواطف والانفعالات، على اعتبـار أن الشعر يسعى إلـى التعبير عن “الأنا الاجتماعية “. فما دامت تلك الأحاسيس شعرية فإنها مشاعر اجتماعية يصل إليها المبدع حينما يذيب مشاعره وقضاياه في مشاعر وقضايا مجتمعه. وبالتالي تتحقق عملية التواصل بين المبدع والمتلقين ما داموا يقاسمونه التجربة نفسها.
وبناء عليه، فإن المبدع حين يقصد- مــن خلال عمله الأدبي- نقل موقفه الخاص فإنه يتعين عليه الالتجاء إلى العالم الواقعي. غير أن ذلك يجب أن يتم بعيدا عن المحاكاة الساذجة لهذا العالم الخارجي، أي من خلال إعادة إنتاج هذا الواقع وفق منظور خاص، متوسلا في ذلك بالانتقاء من الأنساق الأدبية والاجتماعية والتاريخية التي تحيل إلى خارجيات النص.
وإذا كنا قد أشرنا فيما سبق إلى العلاقة بين الواقع و”أنا” المبدع، فإنه لمن الضروري ،كذلك، الإشارة إلى العلاقة القوية التي تربط “أنا” المتلقي بالواقع عبر وساطة النص الأدبي. وفي هذا الإطار، يجب أن نميز بين المعنى: وهو الإحالة البسيطة الأحادية لكل لفظة ( المعنى المعجمي) أو تركيب، والدلالة: وهي الإحالة العميقة المتعددة التي تؤشر عليها لفظة أو تركيب ما؛ أي أن علينا التمييز بين ” المعنى” و”معنى المعنى” باصطلاح “الجرجاني”. وبعبارة أخرى، علينا التمييز بين ” المرجع ” أو المشار إليه” باعتباره الشيء أو الفكرة كما هي في الواقع، وبين “الإحالة” أو المقابل النفسي للشيء، على اعتبار أنها تلك العملية الذهنية التي تتوخى التعرف على المرجع، حسب كل من ” أوجدن” “ورتشاردز”، أو”دلالة المطابقة ” و”دلالة الإيحاء” كما يرى” جون كوهن” في قوله: “وسنستعمل لأجل تسمية نمطي المعنى هذين، مصطلحين ملائمين هما: دلالة المطابقة ودلالة الإيحاء. ينبغي أن يفهم بوضوح، أن لدلالة المطابقة ولدلالة الإيحاء نفس المرجع ولا تتعارضان إلا على المستوى النفسي. فدلالة المطابقة تشير إلى الاستجابة العقلية ودلالة الإيحاء تشير
إلى الاستجابة العاطفية مصوغتين في عبارتين مختلفتين عن نفس الشيء”[23].
ولعل النص الشعري يميل في توجهه العام إلى “دلالة الإيحاء”، لأنها مقوم أساسي من مقومات شعريته القائمة على الخيال. فعبر تفاعل الخيال مع نفسية المتلقي يتوصل إلى إدراك ما وراء الخيال من مرجعيات وأفكار ودلالات، وليس بالضرورة أن تكون هذه المرجعيات متحققة ووحيدة، بل يمكن أن تتعدد بتعدد المتلقين أنفسهم. وبذلك تتحقق العلاقة التفاعلية بين الواقع والخيال من جهة و”أنا” المتلقي من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، “فالإحالات المرجعية” المتضمنة في نص ما لا تطابق الواقع بحرفيته، بل تعلن عن نفسها كما لو كانت إحالة واقعية محض، في حين أن دلالاتها الرمزية هي سبب إيرادها في الأصل. وعليه، تبقى مهمة إيراد هذه العلاقات الترميزية موكولة إلى المتلقي الإيجابي وطاقته التأويلية المرتبطة “بدرجة الكشف الذاتي” لديه. وبذلك نصبح أمام نصين اثنين لا نص واحد، إذ “كما أن الشاعر «يقــــرأ» الواقع (ويقــــرأ الــــذات والمجتمــــع والذاكـــرة والإيديولوجيا ) ويكتب، فإن القارئ – وهو «يقرأ» نص الشاعر – يكتب نصه الخاص عندما يقرأ”[24].
وعن وظيفة الخيال، يذهب “ريتشاردز” إلى أن الشاعر يروم استثارة القارئ بالصور الخيالية التي تناظر ما يكمن في نفسيته، لأن الصور الخيالية وحدها غير قادرة على ملامسة الواقع، ولذلك يجب على الشاعر أن يحرك كوامن نفسية القارئ[25].
توصلنا “أهمية التخييل” أو “الـوهم الجميل” إلى أنـه باستطاعته أن يجعل القــارئ يغض الطرف عن الحقائق الواقعية نتيجة تأثره بالجمال التخييلي، ويحرك الفاعلية الوجدانية على حساب الصرامة المنطقية.
كما يتضح الفرق بين الواقعي والخيالي بشكل كبير عند المقارنة بين عمل عالم النفس- مثلا- الذي يقتصر دوره على الإخبار ووصف الإحساس الذي يعالجه باعتباره حقيقة علمية، وبين الشاعر الذي يقيم عبر أحاسيسه حقائق مستقلة بنفسها تتعالى على الحقائق العلمية. وبذلك، يكون “الشرط الوحيد لتحول «الفكرة» إلى «قصيدة» هو ذاته الشرط الذي يجب أن يتحقق في العاطفة أو الواقعة. وهو ألا نعالج هذه أو تلك الظاهرة معالجة محايدة؛ فالشاعر المفكر يأتي شعره ثمرة التزاوج بين قلبه وعقله”[26].
نستنتج أن هناك تداخلا بين الواقع والخيال، وتزاوجا بين العقل والوجدان، وهذا التداخل بين أطراف مختلفة هو الذي يخول لنا إطلاق اسم “الخلق الفني” على العملية الإبداعية. وهو ما أكده “حسين مروة ” بقوله: “من هنا يبدو، جليا، أن عملية الخلق الفني- في مفهوم« الواقعية الجديدة»- ليست عملا عقليا محضا، وليست عملا سياسيا أو اجتماعيا خالصا… وإنما هي عمل يشارك فيه العقل (الوعي) والوجدان والخيال جميعا. إن للوجدان والخيال فيه نصيبا لا يمكن الاستغناء عنه…”[27].
ومنه، نتلمس أهمية الواقع بوصفه القـاعدة التي تربط المتن الشعري “بأنا” المبدع أولا، ثم بـ”ـأنا” المتلقي ثانيا. وهو ما نروم من خلاله استقصاء راي ناقد/ شاعر، وهو “عبد الله راجع”، لنعرف تصوره لعلاقة الشعر بالواقع. إذ يقــول في هـــذا الصدد: “إن علاقة أي متن شعري بالواقع إنما هي علاقة فعلية.. ومعنى ذلك أنه لا وجود لمتن شعري يمكن فصله عن واقعه”[28]. بل إن العملية التخييلية بكل ما تتوسل به من أدوات ووسائل تصبح شهادة على حقبة زمنية واقعية أو تصويرا لشريحة اجتماعية كائنة فعلا فــي المجتمع أو منـاهضة لثقـــافة اجتمـــاعية كرست في واقع المبدع المعيش. لأن واقع المبدعين” هو الذي أدى إلى أن تصبح الصورة والرمز والأسطورة تجليات حقيقية لمكابدات المبدع المغربي”[29].
حديث الختم
نخلص، من خلال هذا الاستقراء النقدي لمدونات قديمة وأخرى حديث، إلى أن ثنائية الواقع والخيال لا ينبغي لها أن تؤمن بمعياري الصحة والخطأ في تطابقهما كحكمين مع الواقع المرجعي. ذلك أن الأدب العجائبي يبقي على خيط رابط له مع مرجعات الواقع، كما أن السيرة الذاتية يشوبها شيء من تجليات التخييل في اللغة أو الوضعيات أو غيرها. ومنه، تكون ثنائيتنا خارج معيار الحكم المرجعي الخارجي، وأقرب إلى معيار الحكم الداخلي الذي يبحث في تماسك النص وصدقه الفني في اطار فاعلية إبداعية تميز الإبداع والإيحاء عن الفكر المجرد
الببليوغرافيا:
–ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج2، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ط 5. دار الجيل، بيروت، 4199.
–ادريس الناقوري، المصطلح المقدي في الشعر: دراسة لغوية تاريخية نقدية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1982.
–بارت، هامون، واط، رفاتير، الأدب والواقع، (مؤلف جماعي)، ترجمة: ع .الجليل الأزدي ومحمد معتصم، مطبعة تنمل للطباعة والنشر، ط 1، 1992.
–بشير القمري، “شعرية النص الشعري الجديد بالمغرب”، مجلة الثقافة المغربية، ع7، يونيو، 1992.
–تودروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ترجمة عبود كاسوحة، سلسلة الدراسات الأدبية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2002.
–جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 1، 1986.
–حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ترجمة محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1981.
–حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1987.
–عادل بنمنصر، “الواقعية في الشعر”، مجلة كلية الآدب، الجديدة، العدد5، 2000.
–عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط 1، 1991.
–عبد الله راجع، القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1 ، 1988.
–على آيت اوشن، التخيل الشعري في الفلسفة الإسلامية، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط 1، 2004.
–كريستوف كودويل، الوهم والواقع – دراسات في منابع الشعر، ترجمة: توفيق الأسدي، دار الفاربي، بيروت، ط 1، 1982.
–محمد بد العزيز الموافي، “جدالية والفلسفة”، علامات في النقد، مجلد 15 ، الجزء 57، 2005.
–محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب– مقاربة بنيوية تكوينية–، دار العودة، بيروت، ط 1، 1979.
–يمنى العيد، في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، منشورات الأفاق الجديدة،، بيروت، ط 3، 1985.
[1] ادريس الناقوري، المصطلح المقدي في الشعر: دراسة لغوية تاريخية نقدية، ص: 360.
[2] ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص: 63.
[3] نفسه، ص: 60.
[4] عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص: 260.
[5] نفسه، ص: 264.
[6] نفسه، ص: 265.
[7] نفسه، ص: 267.
[8] عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق، ص: 271.
[9] نفسه، ص: 272.
[10] حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 63.
[11] حازم القرطاجني، مرجع سابق، ص: 62.
[12] المرجع السابق، ص: 90.
[13] نفسه، ص: 62.
[14] نقلا عن: بارت، هامون، واط، رفاتير، الأدب والواقع، ص: 5.
[15] عادل بنمنصر، “الواقعية في الشعر”، ص: 58.
[16] تودروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ص: 8.
[17] نفسه، ص: 8.
[18] على آيت اوشن، التخيل الشعري في الفلسفة الإسلامية، ص: 148-149.
[19] يمنى العيد، في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، ص: 65.
[20] محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، ص:339-340.
[21] عادل بنمنصر، مرجع سابق، ص: 61.
[22] كريستوف كودويل، الوهم والواقع، ص.16.
[23] جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص: 196.
[24] بشير القمري، “شعرية النص الشعري الجديد بالمغرب”، ص: 43.
[25] نقلا عن : محمد بد العزيز الموافي، “جدالية والفلسفة”، ص: 63.
[26] محمد عبد العزيز الموافي، مرجع سابق، ص: 72.
[27] حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص: 182
[28] عبد الله راجع، القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد، ص: 147.
[29] نفسه، ص: 154.