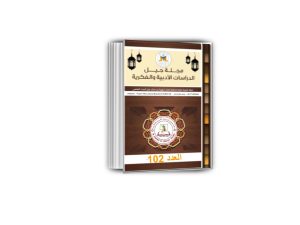الاهتمام بخصائص المتعلمين وحاجاتهم في بناء المحتوى التعليمي مطلب لتحقيق الجودة
دراسة تطبيقية في كتب اللغة العربية للطورين الأول والثاني من التعليم المتوسط
Taking into account the characteristics and interests of learners in building educational content is a requirement for quality Applied study in Arabic books for the first and second phase of intermediate education
| د. عائشة بن السايح dr.aichabensayahجامعة ورقلة L’université Ouargla | د. إسماعيل سيبوكر dr.ismailsiboukeurجامعة ورقلة L’université Ouargla |
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 70 الصفحة 75.
ملــــــــخص:
لاشك أن للمتعلم دورا هاما في التعليم فهو أحد أهم عناصر العملية التعليمية التعلمية، ومن هنا فقد سعت هذه الدراسة لإبراز دور المتعلم في بناء المحتوى التعليمي، وتحديدا في اختيار مكوناته، وقد فصلنا الحديث عن المحتوى من حيث مفهومه، وطرق اختياره، والوسائل المعتمدة في ذلك، ومعايير الجودة فيه خصوصا ما تعلق منها بالمتعلم وطبقت تلك المعايير المتعلقة بالمتعلم على نصوص في كتب اللغة العربية للسنوات؛ الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، لتصل إلى نتائج أهمها: أن مراعاة خصائص المتعلمين وحاجاتهم تتحكم في جودة المحتوى، وكذلك تهتم كتب الجيل الثاني من الإصلاح التربوي بخصائص المتعلمين وذلك من خلال النصوص التي قمنا بتحليلها.
الكلمات المفتاحية: خصائص المتعلمين- اهتمامات- بناء المحتوى- جودة-كتب اللغة العربية- تعليم متوسط
Summary:
The learning process is one of the most important elements of the learning process: Teacher, content and learning, and this study sought to highlight the role of the learner in building educational content, specifically in selecting its components, and we have articulated the discourse on content in terms of its concept and methods of selection. The methods adopted and the standards of quality in this regard, in particular those relating to the learner, have been applied to texts in the Arabic books for the years; the first, second and third of the intermediate education, to the most important results: Considering learners’ characteristics and needs controls the quality of content, and second-generation textbooks of educational reform also address learners’ characteristics through texts we have analyzed.
Keywords: Learners’ Characteristics – Interests – Content Building – Quality – Arabic Language Books – Medium Education
- مقدمة:
يختلف المحتوى التعليمي في بنائه بحسب الفئات العمرية، فلا شك أن محتوى يقدم لأطفال في المدرسة الابتدائية يختلف اختلافا نوعيا عن محتوى يقدم على مستوى المدرسة المتوسطة والثانوية، وهو في الابتدائية يختلف في الصف الأول عن الصف الخامس، وذلك وفق معايير كثيرة؛ منها القدرات المعرفية، والبيئة اللغوية، والمواد الأخرى المصاحبة وهكذا . وعليه فالمتعلم له دور أساسي في تصميم المحتوى التعليمي أيا كان نوعه، لغوي أو غير لغوي، ولا شك أن المحتوى الذي يحقق النجاح والجودة هو ذاك المحتوى المعدّ بدقة، والمناسب لفئة المتعلمين التي وجه إليها سواء كانوا كبارا، أم صغ، ومن هذا المنطلق سعت هذه الدراسة لإبراز دور المتعلمين في إعداد المحتوى التعليمي طارحة التساؤل التالي: فيما تتمثل خصائص المتعلمين وما علاقتها بجودة المحتوى التعليمي؟
وللإجابة عن هذا السؤال سار البحث وفق خطوات ثلاث أولها الحديث عن بناء المحتوى التعليمي بدءا بمفهوم المحتوى، ثم طرائق اختياره، ثم مراحل اختياره، ثم وسائل اختياره، وبعد الحديث عن المحتوى تمّ تفصيل الحديث عن معايير اختياره بالتركيز على المعيار المتعلق بالمتعلمين، وبعد ذلك تمّ عرض جوانب من نصوص كتب اللغة العربية للطور الأول والثاني[1] من التعليم المتوسط تعكس الاهتمام بخصائص المتعلمين وحاجاتهم، وهو ما يبين الجودة، كل ذلك بانتهاج المنهج الوصفي التحليلي، ليختم البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج المتوصَّل إليها.
- بناء المحتوى التعليمي:
تعدّ عملية اختيار المحتوى أهم الخطوات في بناء المحتوى التعليمي، ويجدر بنا قبل تفصيل الحديث عنها أن نتطرق إلى مفهوم هذا المحتوى.
1.2 تعريف المحتوى التعليمي:
المحتوى هو العنصر الأساس في عناصر المنهج التعليمي المتمثلة في؛ الأهداف، طرائق التدريس، أساليب التدريس، أساليب التقويم، وقد وردت له تعريفات منها أنه “مجموع الحقائق والقيم الثابتة والمعارف والمهارات والخبرات الإنسانية المتغيرة بتغير الزمان والمكان وحاجات الناس[…] والمنظّم بشكل علمي ومهني بحيث يحتكّ المتعلم به ويتفاعل معه، من أجل تحقيق الأهداف التربوية “[2].
يتّضح من خلال التعريف أن المحتوى كمّ من التعلّمات التي يتعرض لها المتعلم، ويتفاعل معها لبلوغ أهداف محددة، ويُشترط في هذه المحتوى أن يكون منظما، ومختارا وفق طرق مضبوطة، ومراحل محددة، وأساليب متنوعة
2.2 طرائق اختيار المحتـوى :
يرى علي أحمد مدكور أنّ اختيار المحتوى يتمّ بطرائق ثلاث[3] هي:
- الطريقة الأولى : هي التي تعتمد على تحديد حاجات الدارسين ومشكلاتهم، والمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم وأعمالهم، وبناء على ذلك يتم اختيار المحتوى الذي يحقق هذه الحاجات للدارسين، ويساعدهم على تحقيق ذواتهم وفق فطرة الله فيهم ذكورا وإناثا .
- الطريقة الثانية : هي التي تهتم بتحديد مطالب المادة التعليمية كاللغة والرياضيات … الخ أكثر من اهتمامها بحاجات الدارسين، فالترتيب المنطقي للمواد الدراسية وكل المعارف والمعلومات والتطورات التي حدثت للمادة الدراسية يجب أن يكون متضمّنا في محتوى المنهج، هذه الطريقة غالبا ما ترفع قيمة المادة الدراسية والمعرفة والمعلومات على قيمة الإنسان المتعلم، وحاجاته ومشكلاته و مطالبه.
- الطريقة الثالثـة : هي طريقة اختيار محتوى المنهج عن طريق الخبراء في كل مجال من مجالات المعرفة، فهؤلاء يستخدمون خبراتهم الطويلة في اختيار محتوى المنهج كل في مجال تخصصه .
والجمع بين هذه الطرائق التي تختلف في تركيزها على المتعلم، والمحتوى، والخبير عند اختيار المحتوى يحقق التوازن، ويجعل المحتوى أجود، وأنجع.
3.2 مراحل اختيار المحتوى :
تتم عملية اختيار المحتوى عبر ثلاث مراحل رئيسية متشابكة ومترابطة تتمثل في[4]:
أولا: مرحلة اختيار الموضوعات الرئيسية: وهي الخطوة الأولى في عملية اختيار محتوى المنهج، و يجب فيها أن تترابط، وتتناسب هذه الموضوعات مع الأهداف، كما يجب أن تكون الموضوعات المختارة تمثل عينة مترابطة تظهر فيها طبيعة المحتوى والأبعاد التي ينبغي أن يدرسها المتعلم على أن يكون حجم هذه الموضوعات وما تتضمنه من أبعاد يناسب الوقت المخصّص لها في العملية التعليمية.
ثانيا: مرحلة اختيار الأفكار الأساسية التي تحتويها الموضوعات الرئيسية: وهذه الأفكار تُعدُّ الأساسيات المكوّنة للمادة، وعليه يجب أن تتضمن المعلومات الضرورية التي يجب أن يعرفها المتعلم حتى يُلمّ بالمادة إلماماً كاملاً، ويجب أن تكون هذه الأفكار خاضعة قابلة والتعديل في المواقف التعليمية.
ثالثا: مرحلة اختيار المادة الخاصة بالأفكار الرئيسية : ويتم ذلك عن طريق وضع العيّنة المناسبة من المادة لكل فكرة رئيسية، والعينة الموضوعة للمادة يجب تعبر بصدق عن الفكرة الأصلية وترتبط بها ارتباطا منطقيا.
بعد الحديث عن المراحل والطرائق المتّبعة في اختيار المحتوى، ينبغي الحديث عن الوسائل المعتمدة في هذا الاختيار.
4.2 وسائل اختيار المحتوى :
توجد وسائل كثيرة يتمّ بوساطتها اختيار محتوى المنهج أبرزها:
1.4.2 رأي الخبـــــــــير : الخبير هو المتخصّص في مجال معين ولديه الخبرة والدراية الكاملة والكافية بهذا المجال، ورأي الخبراء وسيلة من وسائل اختيار محتوى المنهج، استخدمت لفترة طويلة وعلى نطاق واسع في مختلف مراحل التعليم، وتركز هذه الطريقة على أخذ رأي الخبراء، وتوجيهاتهم فيما يجب أن يعلّم، ويعد أساتذة الجامعات في مقدمة الخبراء كل في مجال تخصصه[5].
2.4.2″استطلاع الرأي: يؤخذ رأي المهتمين بعملية التعليم، وعلى رأسهم المعلمون فيما يتم اختياره من موضوعات المحتوى، على أساس أن المعلم هو أكثر الأفراد احتكاكا بكل من المادة التعليمية والمتعلم، ومن ثم يجب أخذ رأيه لما له من أهمية كبيرة في تحديد أهمية الموضوعات ومناسبتها للمتعلمين وقابليتها للتطبيق، وعادة ما يتم ذلك عن طريق الاستفتاءات والمقابلات الشخصية وعقد المؤتمرات وحلقات المناقشات …”[6]
3.4.2 المسح : “المسح وسيلة هامة من وسائل اختيار محتوى المنهج، فمثلاً مسح البحوث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال معين تساعد على اختيار المحتوى المناسب للتلاميذ في هذا المجال وأيضا مثل مسح ميول التلاميذ في القراءة، كشف عن أنواع الكتب والصحف والمجلات التي لها جاذبية أكثر بالنسبة للتلاميذ، ومسح المصادر الطبيعية والظواهر الطبيعية في البيئة يحدد بدرجة كبيرة محتوى منهج التاريخ”[7]، وهكذا بالنسبة لباقي المواد الدراسية .
وكذلك “مسح الاخطاء الشائعة في الاستخدام اللغوي من مقررات اللغة العربية يساعد في اختيار المحتوى المناسب[8]“،
4.4.2 التحلــــــــيل: استخدم التحليل في البداية في ميدان التربية المهنية وكان استخدامه عبارة عن ملاحظة الأنشطة والمهارات التي يقوم بها المشهود له بكفاءة في مهنة معينة بِعدِّ أداء هؤلاء دقيق، ومتقن في هذه المهنة، وذلك لاكتشاف أنواع الإجراءات والعمليات وتواتر حدوثها ثم تقويمها وتبويبها ومن ثم تستخدم هذه المعلومات أساسا لاختيار مواد المقرر مثل: يمكن أن نجري تحليلاً لمواقف الحديث الشفهي في حياة الكبار حتى يمكن تحديد مجالات تعليم لغة الكلام، وبذلك ننظّم وظيفة اللغة ونضع برنامجا جيدا لتنمية الطلاب وإتقان مهاراتهم اللغوية وذلك بدلاً من التخطيط الذي يسير عليه معلمو اللغات في تعليم التعبير الشفهي،[9] .
بعد الانتهاء من عرض الوسائل الأربع لاختيار المحتوى، استوقفتنا حقيقةٌ لاحظها بعض الباحثين في مجال بناء المناهج، وهي أنّ أغلب المناهج العربية يتمّ اختيار محتوياتها التعليمية ” في ضوء آراء الخبراء فقط، وهذا يمثل خطورة كبيرة في بناء المناهج، إذا كيف يتم بناء المناهج باستخدام وسيلة واحدة رغم وجود تغيرات أضعفت منتج العملية التعليمية وأثرت في جودتها مما أثار الشكوى المستمرة من المناهج “[10]، وعليه فجودة المحتوى تتوقف على تنويع وسائل بنائه.
3 معايير الجودة في اختيار المحتوى التعليمي:
معلوم أن لكل إنجاز أسسا أو معايير ليتم العمل على أكمل وجه وليحقق المنجز نجاحا ملحوظا دون أخطا، ومحتوى المنهج هو أحد أهمّ المنجزات في العملية التعليمية وحتى لا يكون هذا المحتوى “وما يشتمل عليه من خبرات اختيارا عشوائيا بلا ضوابط، الأمر الذي يؤثر كثيرا في نوعية المحتوى المختار وتنظيمه، كان لابد من وضع معايير يتم الاختيار في ضوئها حتى يكون اختيارا عمليا سليما غير خاضع لأهواء مخططي وواضعي المنهج أو أي مؤثرات أخرى”[11] وعليه فمعايير اختيار المحتوى هي الأسس التي يبنى عليها وتحدد مدى جودته وصلاحيته.
تتعدد معايير اختيار محتوى المنهج وتتداخل فيما بينها، ولكن يمكن تحديد معايير يرى الباحثون[12] في مجال التعليم وإعداد المناهج التعليمية على أنها أساسية في الاختيار وهي:
_ أن يتم اختيار المحتوى الذي يحقق الأهداف ويرتبط بها.
_ أن يكون المحتوى ذا أهمية.
_ أن يكون المحتوى صادقا وذا مشروعية
_ أن يحقق المحتوى التوازن بين الشمول والعمق.
_ أن يرتبط المحتوى بتراث المجتمع ومشكلاته المعاصرة.
_ أن يراعي المحتوى التنوع.
_ أن يتناسب المحتوى مع الوقت المخصّص له.
_ أن يراعي المحتوى خصائص المتعلمين واهتماماتهم.
والملاحظ أن بعض هذه المعايير متعلق باختيار المحتوى، وبعضها متعلق بتنظيمه، ويمكن الحديث عنها بشيء من التفصيل في ما يلي:
1.3 أن يتم اختيار المحتوى الذي يحقق الأهداف ويرتبط بها: إن لكل منهج تعليمي أهدافا محددة يسعى لتحقيقها من خلال العملية التعليمية التي تتكون من عناصر ثلاثة: المعلم، والمتعلم، والمادة الدراسية؛ أي المحتوى، وعليه فالمحتوى التعليمي هو ” أحد الوسائل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف ولكي يقوم المحتوى بهذا الدور ويسهم إسهاما فعالاً يجب أن يكون ترجمة صادقة للأهداف ومرتبط بها، ولتوضيح ذلك يجب أن تكون الموضوعات التي يتكون منها المحتوى وما تشتمل عليه من معارف وأنشطة تعد تعبيرا صادقا عن أهداف المنهج وأيضا يجب عند اختيار المادة الدراسية التركيز على العناصر والأفكار والمفاهيم التي تكون أكثر ارتباطا بهذه الأهداف وتسهم في تحقيقها بفاعلية ” [13].
2.3 أن يكون المحتوى ذا أهمية : وهذا يعني أن يكون المحتوى له قيمة بالنسبة للمتعلم والمجتمع حيث يفي بحاجات المتعلم ويسهم في حل مشكلات المجتمع ويعمل على تطوير الحياة به بما يحقق رخاء المجتمع وتقدمه وهنا يجب أن نشير إلى واقع ما يتمّ تعلّمه الآن بمدارسنا، حيث يوجد العديد من جوانب المحتوى التي لا تحقق هذا المعيار، فمعظم الخريجين في كثير من الكليات يُصدمون عندما يواجهون الحياة فما درسوه لا صلة له بواقع الحياة العملية ولا يواكب تطورات العصر وليس له واقع تطبيقي، كما أن أهمية المحتوى تتوقف أيضا على مواكبة التطور العلمي التكنولوجي الحاصل بشرط أنْ لا يخلّ هذا التطور بقيمنا الدينية الثابتة[14].
3.3 مشروعية المحتوى وصدقه : يقصد بالصّدق صحة ما يُقدّم للمتعلم، أمّا بمشروعية المحتوى، فيقصد بها اتفاق ما يتضمنه من معارف وخبرات مع العقيدة الدينية الإسلامية وهي عقيدة المجتمع العربي كله واتفاقها مع تقاليد المجتمع واتجاهاته وقيمه التي يؤمن بها، ويسعى إلى تأكيدها لدى أبنائه من النّاشئة[15] .
4.3 أن يحقق المحتوى التوازن بين الشمول والعمق:
المقصود بالشمول أن تغطي المادة المختارة جميع الجوانب والأفكار الرئيسية وتعطي فكرة واضحة عن المادة ونظامها، أما العمق فيعني تناول أساسيات المادة مثل المبادئ والمفاهيم والأفكار الأساسية وكذلك تطبيقاتها بشيء من التفصيل الذي يلزم لفهمها فهما كاملا، ويربطها بغيرها من المبادئ والمفاهيم والأفكار، ويمكن تطبيقها في مواقف جديدة، والمطلوب من مخططي وواضعي المحتوى أنْ يحققوا التوازن بين الشمول والعمق بحيث يكون اختيار المادة الممثلة للأفكار الأساسية والعناصر(الشمول) بناء على مدى احتوائها على أساسيات المادة وبالتالي قابليتها للتطبيق في المواقف المتنوعة ( العمق) [16] .
5.3 أن يرتبط المحتوى بتراث المجتمع ومشكلاته المعاصرة:
يجب أن يعبّر محتوى المنهج عن هوية المجتمع وثقافته لأن الهدف الأساس من عملية التربية إعداد أجيال للحياة في هذا المجتمع، والمجتمع المعاصر إنما هو حصيلة تطور خلّف تراثا من المعرفة والفكر والعادات والتقاليد، والقيم لابد من ربط المتعلمين في مراحل التعليم بها حتى يشعروا بالانتماء الحقيقي لهذا المجتمع، ويرتبط الماضي بالحاضر في أذهانهم، ومشكلات الحياة المعاصرة لابد أن تراعى في اختيار المحتوى عن طريق تبصير المتعلمين بهذه المشكلات، وأسبابها، وأبعادها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، ودفعهم إلى البحث والدراسة لمحاولة الإسهام في اقتراح حلول لهذه المشكلات[17].
6.3 أن يراعي المحتوى التنوع:
يجب أن تتنوع المجالات المعرفية والخبرات، وألوان النشاط المقدمة ضمن المحتوى، وهذا التنوع _فضلا عن أنه ضرورة لمراعاة الفروق الفردية _أمر ضروري ليشمل المحتوى كل جوانب التعلم: المعرفي، والانفعالي، والمهاري، مع مراعاة التوازن بين هذه الجوانب الثلاثة، ويرتبط بتنوع المحتوى أن يراعي اختلاف البيئات المحلية، وعناصر الثقافة المحلية في كل منها، فلا شك أن بيئة الريف تختلف عن بيئة الحضر وهذه وتلك تختلفان عن البيئة الصحراوية، وبيئة الوجه البحري تختلف عن بيئة الوجه القبلي، والبيئة الصناعية تختلف عن البيئة الزراعية، فلا بدّ أن يتنوع المحتوى ليراعي احتياجات كل بيئة وعناصر الثقافة السائدة فيها[18]
7.3 أن يراعي المحتوى الوقت المخصص له: إنّ مراعاة عنصر الزّمن المتاح للدراسة معيار ضروري يجب أن يؤخذ في الحسبان عند اختيار المحتوى حتى يأخذ كل موضوع حقه في الدراسة، ويحقق الهدف من الاختيار، وحتى لا يزدحم المحتوى بالموضوعات التي لا يتسع العام الدراسي لدراستها، فتصبح حشوا لا معنى له بالنسبة للمتعلم، أو تقل موضوعات المحتوى عن الحد المطلوب فينتهي الطلاب من دراستها في وقت قليل من العام الدراسي ، ثم يملون من كثرة التكرار، والمراجعة ، ويقتضي معيار مراعاة الوقت عند اختيار المحتوى أن يؤخذ في الحسبان الوقت اللازم لدراسة كل موضوع يقع عليه الاختيار[19]. فإن اختيار محتوى المقرّر يجب أن يؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.
8.3 أن يراعي المحتوى خصائص المتعلمين واهتماماتهم :
وهذا من أهم المعايير؛ فالمتعلم اليوم يوليه مصممو محتويات المناهج التعليمية أهمية كبيرة، ومن خصائصه التي لابد من مراعاتها في إعداد المحتوى اختلاف المستوى؛ فمحتوى مقدم لمتعلم في السنة ألثانية من التعليم الابتدائي مثلا يختلف عن محتوى مقدم لآخر في السنة الثانية من التعليم المتوسط، ومنها أيضا الفروق الفردية؛ فالمتعلمون يختلفون المستوى التعليمي الواحد من حيث قدراتهم، واستعداداتهم، إذ تجد بعضهم يمتلك قدرات عالية، والبعض يمتلك قدرات متوسطة، وأحيانا ضعيفة، ومن الخصائص أيضا ميولاته واهتماماته التي تميزهم، ويشتركون فيها في كل مستوى، أو مرحلة تعليمية.
- 1- مستوى المتعلمين :يعدّ المتعلم محور العملية التعليمية وإنه أحد العوامل الأساسية التي تؤثر تأثيرا مباشرا في بناء المناهج الدراسية بصفة عامة وفي اختيار وتنظيم المحتوى بصفة خاصة؛ بمعنى أنّنا لا يمكن أن نقدم للمتعلم أية فكرة أو نطالبه بالقيام بأي عمل دون الأخذ في الاعتبار مرحلة النّمو التي يمرّ بها، ومراعاة قدراته واستعداداته وخصائص نموه في كافة الجوانب الجسمية والعقلية، والنّمو لدى المتعلم في أي مرحلة من مراحل حياته الدراسية يتميز بخاصتين أساسيتين: أولهما: أنّه يتمّ في صورة متكاملة أي أنّ النّمو دفعة واحدة في جميع الجوانب ويؤثر بعضه على بعض فحينما ينمو الفرد جسميا ينمو حركيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ولغويا، وهذه الجوانب الثلاثة تتبادل التأثير فيما بينها، ثانيهما: أن النمو يتأثر بعاملين اثنين هما: النّضج وهو يعني الزيادة التي تطرأ على الكائن الحي من خلال تفاعلات داخل الجسم، والتعلم الذي يتم في المحيط الثقافي الذي يحيط بالفرد في البيت و المدرسة والمؤسسات الاجتماعية[20].
وعليه فالمحتوى الجيد هو الذي تكون عناصره المختارة مناسبة لمستوى نمو المتعلمين، كما أنّ وعي القائمين على وضع المحتوى بخصائص نمو المتعلمين في كل مرحلة على حدة يساعدهم على إحداث الملاءمة بين المحتوى المقدّم وما يضمه من مفاهيم ومصطلحات، وحقائق علمية، وقوانين، ومبادئ، ونظريات وتنظيم لكل ذلك وصياغة لغوية تناسب المستوى الدراسي لهم، ومن جانب نمو المتعلمين واهتماماتهم وخصائص نموّهم قواعد لتوجيه وتكييف المنهج الدراسي، ومعايير لاختيار خبرات محتوى المنهج، فعلى سبيل المثال يتميز النمو الجسمي عند متعلمي المرحلة الابتدائية بالهدوء النِّسبي من حيث الطّول وملامح الوجه، كما يتأثّر بالعوامل الصّحية والاجتماعية والاقتصادية، ومن المشاكل الصحية التي يمر بها متعلمو هذه المرحلة نقص التغذية وتأخر النمو الجسمي، وعدم اختيار الطعام الجيد وكل هذه المشكلات تؤثر في التحصيل الدراسي والتوافق المدرسي وتعوق فرص التعلم[21].
ومما سبق يمكن لمعدي محتويات مرحلة التعليم الابتدائي أن يهتموا في اختيارهم للمحتوى بما يلي[22]:
_ بيان المفاهيم التي تعمل على تحديد نشاط المتعلمين وتقوية حيويتهم، وحثهم على الاهتمام بالنظافة والمظهر .
_ تكوين عادات العناية بالجسم والمحافظة عليه سليماً من الأمراض .
_ توجيه المتعلمين إلى الالتزام بالآداب السّامية في المأكل والمشرب والملبس وعند النوم ودخول الحمام .
_ حث المتعلمين على ممارسة الرياضة البدنية التي تعمل على المحافظة على أجسامهم وهكذا يمكن للمحتوى مراعاة جوانب النمو الأخرى بهذه الطريقة.
- 2- ميول المتعلّمــين واهتماماتهم: عند اختيار المحتوى يجب أن تُعْطى ميول المتعلمين واهتماماتهم أهمية كبيرة، واختيار ما تناسب معها من موضوعات، لأن ميول المتعلمين يمثل في العملية التعليمية أهدافا ووسائل، فهي أهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال العملية التعليمية، ووسائل تستخدم لتحقيق أهداف أخرى، لأنّ ما يميل إليه الفرد يحدد بدرجة كبيرة ما يفعله، ويهتم به، كما للميول دور كبير في توجيه سلوك الفرد، وهذا يعدّ دافعا قويا يمكن استخدامه والتركيز عليه لإثراء العملية التعليمية وتحقيق نتائج جيدة وفعالة، لذا فإن إغفال المحتوى لميول المتعلمين يعد خسارة كبيرة للعملية التعليمية[23]
ج – الفروق الفردية بين المتعلمين:
إنّ محتوى المنهج الدراسي موجه إلى متعلمين يختلفون من حيث القدرات والحاجات، والاستعدادات رغم وجودهم في مستوى دراسي واحد، وفي سن واحد تقريبا، لذلك يجب أن يشتمل محتوى المنهج على موضوعات متنوعة ومجالات متعددة في محاولة لمواجهة الفروق الفردية بين هؤلاء المتعلمين قدر الإمكان بحيث يستطيع كل متعلم أن يجد لنفسه في هذه الموضوعات وتلك المجالات ما يناسب حاجاته واستعداداته وقدراته، ويستطيع من خلال ذلك تحقيق قدر معين من النجاح يبعث فيه الثقة بالنفس وبقدراته، فقد أثبتت كثير من الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال أنّ كلّ متعلم مهما كانت قدراته واستعداداته يجب أنْ يشعر بالنّجاح، وأنّ النجاح في أداء عمل ما مهما كان بسيطا يدفع إلى مزيد من النجاح[24].
4- مراعاة خصائص المتعلمين واهتماماتهم في نصوص من كتب اللغة العربية للطور الأول والثاني من التعليم المتوسط – الجيل الثاني-
بيانات الكتب:
* كتابي في اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم المتوسط”
– من إعداد: _ محفوظ كحال[ مفتش التربية الوطنية، مادة اللغة العربية]
محمد بومشاط [ أستاذ التعليم المتوسط، مادة اللغة العربية]
– تنسيق وإشراف: _ محفوظ كحال
– التصميم الفني والغلاف: _ محمد زهير قروني [ماستير في مهن الكتاب والنشر]
– الـــــــتركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب: _ صبرينة جعيد / محمد زهير قروني.
– منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات: _ موفم، الجزائر، طبعة 2016م.والطبعة الجديدة 2017م
– عدد الصفـــــــــــــــــحات:170.
* اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم المتوسط.
من إعداد: _ كمال هيشور [مفتشّ الترّبيةّ الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابــهـــا]
_ ميلود غرمول [مفتش الترّبيةّ الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابـهــا]
_أحمد بوضياف [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم الثـــاّنــوي]
_رضوان بوريجي [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم الثاّنوي]
_أحمد سعيد مغزي[ أستاذ بالتعّلــــــيم العالــــي]
_عزوز زرقان [أستاذ بالتعّليــــــــــم العــــــــالي]
_نورالدين قلاتي [مفتشّ التعليم المتوسط للغّــــــة العربيــــةّ]
_الطاّهر لعمش [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم المتوسط]
المراجعة العلمية: _أحمد سعيد مغزي[أستاذ بالتعّليم العالي]
المراجعة اللغّوية: _عبد الرحمان عزوق[مفتش الترّبية الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابها (سابقا)
تنسيق و إشراف: _ ميلود غرمول[مفتش الترّبيةّ الوطنيةّ للغةّ العربيةّ وآدابها]
منشورات: _ أوراس، السداسي الأول – الجزائر ط 2017م.
عدد الصفحات : 176 .
* اللغة العربية، السنة الثالثة من التعليم المتوسط.
إعداد: _ كمال هيشور [مفتشّ الترّبيةّ الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابهــا]
_ ميلود غرمول [مفتش الترّبيةّ الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابـهــا]
_أحمد بوضياف [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم الثـــاّنــــوي]
_رضوان بوريجي [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم الثاّنوي]
_أحمد سعيد مغزي[ أستاذ بالتعّلـــيم العالــــي]
_عزوز زرقان [أستاذ بالتعّليـــم العــــالي]
_نورالدين قلاتي [مفتشّ التعليم المتوسط للغّــــــة العربيـــــــةّ]
_الطاّهر لعمش [أستاذ مكونّ للغّة العربيةّ بالتعليم المتوســــط]
المراجعة العلمية: _أحمد سعيد مغزي [أستاذ بالتعّليم العالي]
المراجعة اللغّوية: _عبد الرحمان عزوق [مفتش الترّبية الوطنيةّ للغّة العربيةّ وآدابها )سابقا(]
تنسيق و إشراف: _ ميلود غرمول [مفتش الترّبيةّ الوطنيةّ للغةّ العربيةّ وآدابها]
التصميم الفني والتركيب: _ نعيمة بن تواتي.
منشورات: _ أوراس، السداسي الأول – الجزائر 2017م.
عدد الصفحات:175.
1.4 المرحلة المتوسطة وخصائص المتعلمين فيها:
- المرحلة المتوسطة
تتميز مرحلة التعليم المتوسط عن غيرها من المراحل بإعداد المتعلم لمتابعة دراسته الثانوية بعد تحكّمه في أساليب التواصل باللغة العربية، فهي بمثابة البوابة التي توصِل المتعلم إلى المرحلة الثانوية، وكونها كذلك يستدعي من المتعلم التسلح بالعلم والتمكن من ناصية اللغة، لأنه سيبدأ في مرحلة التعليم الثانوي بالتّخصّص في المجال أو الشُّعبة التي اختارها. والمرحلة المتوسطة ” تأتي في إطار عمر زمني يبدأ من الناحية الفرضية، مع أوائل السنة الثالثة عشرة للطلاب[ وفي الجزائر مع أوائل السنة الحادية عشرة]، وينتهي مع أوائل السنة السادسة عشرة، وهي بهذا تقع بين مرحلة الطفولة المتأخرة، ومطلع المراهقة الباكرة “[25].
تُقسّم المرحلة المتوسطة في التعليم الجزائري إلى ثلاثة أطوار؛ الطور الأول، وتمثله السنة الأولى، الطور الثاني، وتمثله السنة الثانية + السنة الثالثة، الطور الثالث، وتمثله السنة الرابعة.
- خصائص نمو المتعلمين في المرحلة المتوسطة: يتميز المتعلمون في المرحلة المتوسطة بخصائص جسمية، وعقلية، وانفعالية، واجتماعية، ولغوية تميزهم عن غيرهم من المتعلمين في المراحل الدراسية المختلفة، وتتمثل هذه الخصائص في:[26]
*الخصائص الجسمية:
في هذه المرحلة يسرع النمو، وتتلاحق التغيرات، ويظهر التمايز واضحا بين التكوين الجسمي للمتعلم والتكوين الجسمي للمتعلمة، ويتّجه كل إلى الغاية التي خلق لها..وكثيرا ما تستطيل العظام، وتسبق في نموها النمو العضلي؛ بما يؤدي إلى اختلال التآزر الحركي للنّاشئ.
*الخصائص العقلية:
يمضي الذكاء في طريقه، ويتذبذب مقياسه ويضطّرب مع البلوغ، ويميل نحو التناقص، وعلى النحو نفسه تميل القدرة على التذكر والحفظ، ولكن ذلك ليس بالدرجة التي تؤثر تأثيرا واضحا في المسار اللغوي، وتزداد قدرة المتعلم على التفكير المجرد، وعلى فهم الرموز والاستجابة لها، وعلى معالجتها بنفسه، ويستطيع أن يدرك الفروق في المكانة الاجتماعية، كما يصبح حكمه على النواحي الجمالية والفكاهية، ونواحي القبح طبقا لمعايير الجماعة، فلا يكون حكمه على أساس حبه أو كرهه هو فقط. ويزداد النشاط العقلي للمتعلم، مما يساعده على التنظير، والنّقد، والتحليل، والتأليف.
*الخصائص الانفعالية:
يميل المتعلم إلى البطولة والمغامرة، والجرأة، والغلبة والقهر، بينما تميل المتعلمة إلى النوع العاطفي من البطولة، وتعتزّ بتفوق المرأة، وتشدها بطولات الفتيات من أترابها، ويتحول كل من الفتى والفتاة شيئا فشيئا إلى النواحي التي تتصل بالمستقبل.
وقد “أجريت دراسات على ميول المتعلمين دلّت على أن الذكور يميلون إلى قراءة الموضوعات التي تدور حول الآلات الميكانيكية، والهوايات العملية، والاختراعات الحديثة ولا سيما في سنّ الرّابعة عشر، أمّا الإناث فيملن إلى القصص العاطفية، ثمّ يتطوّر بهنّ النّمو إلى غيرها من النواحي التي تتّصل بحياتهنّ”[27].
*الخصائص الاجتماعية:
تتسع علاقات المتعلمين، ويزدادون احساسا بالمجتمع، وتفاعلا معه، وتصحب ذلك ملامح العمل من أجل تحقيق الذات وتأكيد الشخصية، والتعلّق بالتفوّق، والصراع من أجله. ويتدرب من خلال الجماعات على العمل الجماعي والتعاون وتحمّل المسؤولية.
*الخصائص اللغوية:
وأما من الناحية اللغوية فتزداد ثروة المتعلمين من الألفاظ والتراكيب، وتتأثر هذه الثروة في نوعيتها والقدرة على استخدامها بعامل النّضج، والتعلّم طوال المرحلة المتوسطة.
هذه هي أهم خصائص المتعلمين التي يجب أن تُستثمر في إعداد المناهج الدراسية للغة العربية وغيرها من المواد التعليمية لتحقيق الجودة في التعليم .
4.2 – استثمار خصائص المتعلمين في النصوص التعليمية:
إنّ من أهم الأمور التي يهتمّ بها الطفل و يحتاجها؛ المحبة، واللعب والصداقة والتعاون، والتّعارف[28] وممارسة الرياضة، ومعرفة عادات وتقاليد مجتمعه، واكتساب المهارات المختلفة، ومسايرة التطور العلمي والتكنولوجي وغيرها، من الحاجات، وانطلاقا من حاجات المتعلم يتم اختيار المحتوى التعليمي الذي سيتعلمه، شريطة أن تتناسب هذه الحاجات، سواء كانت عاطفية، أو اجتماعية، أو علمية، أو مهارية وغيرها مع خصائص المتعلمين واهتماماتهم، وذلك لتحقيق الجودة.
وقد توصّلنا من خلال تحليلنا لنصوص مختلفة في كتب اللغة العربية لسنوات الطور الأول والثاني من التعليم المتوسط أنّ هذه النصوص تعبر عن الحاجات الأساسية للمتعلمين، ومن أمثلة ذلك:
أ- في كتاب السنة الأولى: عبر نصّ “ابنتي” لإبراهيم المازني في الصفحة 12 عن حاجة الأطفال إلى عَطْف ومحبّة آبائهم، وعبّر كذلك نص “فداء الجزائر” لحنفي بن عيسى في الصفحة 40 عن البطولة والشجاعة؛ فقد جسّد “مخلوف” دور المجاهد البطل، المدافع عن وطنه، وهذا ما يثير إعجاب المتعلّم؛ إذ يميل في هذه المرحلة العمرية إلى البطولة والمغامرة، والجرأة، والغلبة والقهر، بينما تُعْجب المتعلّمة بتفوّق المرأة، وشجاعتها، وهذا ما جسّدته شخصية “زُهور” في ذات النّص؛ إذ قامت بدور المرأة الشجاعة والمضحّية في سبيل وطنها. ويعبّر كذلك نصّ” الفيس بوك” في الصفحة 96 عن ما يثيرُ اعجاب المتعلّم.
ومن أمثلة النّصوص التي تعبّر عن الحاجات الاجتماعية نصّ “في كوخ العجوز رحمة” في الصفحة 20، ونصّ “فرانز فانون” في الصفحة 56، ونصّ “فداء الجزائر”، فهذه النّصوص تعبّر عن التّعاون، فالمتعلّمون يميلون في هذه المرحلة إلى مساعدة الآخرين.
أمّا الحاجات العلمية فقد مثلها نصّ” الكتاب الإلكتروني” في الصفحة 92، ونصّ” الفيس بوك” اللذان يعبّران عن حاجة المتعلّم إلى مسايرة التطوّر التكنولوجي، إلاّ أنّ ما يؤخذ على النّصوص هو عدم الاهتمام بالحاجات المهارية من لعب ورياضة…؛ فاللعب، وممارسة الرياضة من الأساسيات التي يحتاجها المتعلم في هذه المرحلة.
ب- في كتاب السنة الثانية : لقد عبّرت النّصوص عن الحاجات الأساسية في تكوين المتعلمين؛ وأبرزها الحاجات العاطفية، ومما يعبّر عنها نصّ “سهرة عائلية ” في الصفحة 12 إذ يعبّر عن حاجة المتعلّم إلى الشّعور بالدّفء الأسري، وتماسك أفراد الأسرة. وكذلك نصّ “أرض الوطن” في الصفحة 32 ونصّ “الوطن الحبيب” في الصفحة 42 اللذان يعكسان تعلّق الإنسان بوطنه، وحبّه له. ومما يعبّر عن عاطفة الإعجاب نصّ “يا جميلة” في الصفحة 52 إذ أعطى صورة عن المرأة الجزائرية البطلة المكافحة.
أمّا الحاجات العلمية فمما يعبّر عنها نصّ “الضّوء العجيب” في الصفحة 102 الذي يبيّن أهمّية الاختراع والاكتشاف في حياة النّاس؛ إذ بفضل اكتشاف “كاشف العظام ” يمكن إيجاد العلاج ، وتحسين صحّة الإنسان.
ومما يمثّل الحاجات الاجتماعية نصّ “نشيد العيد” في الصفحة 117 الذي يذكّر بمناسبة اجتماعية يَسْعد فيها المتعلّم، وهي الأعياد.
ج/في كتاب السنة الثالثة :
لاحظنا أنّ النّصوص عبّرت عن الحاجات العاطفية؛ ومنها مثلا نصّ” ولي التّلميذ” في الصفحة ، الذي يصوّر قدر محبّة الآباء لأبنائهم، وهذا ما يحتاجه المتعلّم، وكذلك نصّ “أخي الإنسان” في الصفحة الذي يدعو إلى التآخي والمحبّة.
أمّا الحاجات العلمية فمما يمثّلها نصّ “الصّحافة الإلكترونية” في الصفحة ، ونصّ “الإدارة الإلكترونية” في الصفحة ، ونص “دواء السّرطان” في الصفحة ، فهذه النّصوص تعبّر عن فضل العلم، وأهمّية مسايرة التّطور العلمي.
أمّا الحاجات الاجتماعية فمما يعبّر عنها نصّ “درهم السّل” في الصفحة ، ونصّ “الهلال الأحمر الجزائري” في الصفحة ، ونصّ “أسْعِفوه” في الصفحة ، فهذه النّصوص تعبّر عن فضل التّعاون، وتدعوا إليه، وهذا ما نجده له استعدادا عند المتعلّم.
ومما يعكس مراعاة الكتب الثلاثة لخصائص المتعلمين، مراعاة الخصائص اللغوية؛ فقد رأينا سابقا أن من الخصائص اللغوية للتعلم في المرحلة المتوسطة زيادة الثروة اللغوية مقارنة بالمرحلة الابتدائية، وهذه الخاصية قد راعتها كتب اللغة العربية في المرحلة المتوسطة من خلال تكليف المتعلمين بكتابة نصوص متنوعة الأحجام، والأنماط بينما في المرحلة الابتدائية التي يتميز فيها المتعلمون بقلة الثروة اللغوية خصوصا السنوات الأولى يُكلَّف المتعلمون بكتابة كلمات وجمل فقط. والأمثلة الآتية تؤكّد ما سبق[29]:
- جاء في كتاب اللغة العربية في السنة الأولى من التعليم المتوسط في حصة التعبير الكتابي :
- جاء في كتاب السنة الثانية من التعليم المتوسط في حصة التعبير الكتابي:
- جاء في كتاب السنة الثالثة من التعليم المتوسط في حصة التعبير الكتابي:
وتشير المطلوبات التعبيرية فيما سبق إلى أنّ المتعلم في المرحلة المتوسطة يمتلك رصيدا لغويا أكبر، بينما تشير الوضعيات الآتية إلى أن المتعلم لا يمتلك من الرصيد اللغوي إلا القليل، فلا يُطلَب منه ما فوق طاقته، فهو حديث عهد بالتعلم، ولم يتعلم إلا القليل من اللغة[30]:
- جاء في كتاب اللغة العربية في السنة الأولى من التعليم الابتدائي في حصة التعبير الشفهي:
- جاء في كتاب السنة الثانية من التعليم الابتدائي في حصة التعبير الكتابي:
- جاء في كتاب السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في حصة التعبير الكتابي:
وختاما يمكن القول أن ما سبق يعكس مدى حرص معدّي الكتاب المدرسي على الأساسيات التي يحتاجها المتعلم لما لها من أهمية فهي تُرغّبه وتمكنه من قراءة النّصوص، والتفاعل معها، كما تُسْهِم بشكل فعّال تكوينه ليصبح متعلما ناجحا، ومواطنا صالحا. ونجمل أهم النتائج المتوصّل إليها في الآتي:
– لكي يحقق المحتوى التعليمي الجودة المطلوبة يجب أن يخضع من حيث الاختيار والتنظيم إلى معايير وضوابط عديدة، ومتنوعة، أهمها: مراعاة خصائص المتعلمين.
-تنويع طرائق ووسائل اختيار المحتوى سبيل لإتقانه وجودته.
-تهتم كتب الجيل الثاني من الإصلاح التربوي بالمتعلم وخصائصه وذلك من خلال النصوص التي قمنا بتحليلها، أي نصوص من السنوات؛ الأولى، والثانية، والثالثة، من التعليم المتوسط، وهو ما يعكس الجودة .
-أبرز حاجات المتعلمين التي راعتها الكتب السابقة تتمثل في الحاجات العاطفية، والحاجات الاجتماعية، والحاجات العلمي، وهي حاجات تتناسب مع خصائص المتعلمين في المرحلة المتوسطة.
قائمة المصادر والمراجع:
- أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس المنهج، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة دمنهور، مصر، دط، 2015م.
- وجيه إبراهيم محمود، التعلّم؛ أسسه، ونظرياته وتطبيقاته، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط1976.
- وزارة التربية الوطنية، كتابي في اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم المتوسط، موفم للنشر، ط2017م.
- وزارة التربية الوطنية، كتاب اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم المتوسط، أوراس للنشر، ط2، 2017م
- وزارة التربية الوطنية، كتاب اللغة العربية، السنة الثالثة من التعليم المتوسط، أوراس للنشر، ط2017م
- وزارة التربية الوطنية ، كتاب اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
- وزارة التربية الوطنية كتاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي.
- وزارة التربية الوطنية كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي .
- الوكيل حلمي والمفتي وحمد أمين، أسس بناء المناهج وتنظيماتها، دار المسيرة، الأردن، ط1، 2005م/ 1426هـ.
- مدكور علي أحمد، نظريات المناهج التربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1427هـ/2006م.
- سعادات محمد حسن، المناهج التربوية نظرياتها _مفهومها_ أسسها_ عناصرها_ تخطيطها_ تقويمها، دار الحامد، عمان، الأردن، ط1، 2009.
- فؤاد محمد موسى المناهج، مفهومها أساسها عناصرها تنظيماتها، جامعة المنصورة، دط _ دت.
- صابر سليم محمـد وآخرون، بناء المناهج وتخطيطها، دار الفكر، عمان، ط 1، 1426ه/ 2006م.
- أبو العز عادل أحمد سلامة، تخطيط المناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق، دار ديبونو، عمان، الأردن، ط1، سنة 2005م.
- الخليفة حسن الجعفر، المناهج، أسسها وعناصرها و تنظيماتها، مكتبة الرشد، الرياض، ط12، 1433هـ.
- ظافر محمد إسماعيل ، والحمادي يوسف ، التدريس في اللغة العربية، دار المريخ، الرياض، ط1984م..
- فؤاد البهي السّيد، الأسس النّفسيّة للنّمو، دار الفكر العربي، مصر، ط1، 1956م.
[1] أي السنوات؛ الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط.
[2] علي أحمد مدكور، نظريات المناهج التربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1427هـ/2006م، ص:339.
[3] علي أحمد مدكور، نظريات المناهج التربوية، ص 340 .
[4] ينظر: محمد حسن سعادات، المناهج التربوية نظرياتها _مفهومها_أسسها_عناصرها_تخطيطها_تقويمها، دار الحامد، عمان، الأردن، ط1، 2009، ص: 144_145.
[5] ينظر: فؤاد محمد موسى المناهج، مفهومها أساسها عناصرها تنظيماتها، جامعة المنصورة، دط_ دت، ص 284.
[6] نفسه، ص:285.
[7] ينظر: محمـد صابر سليم وآخرون، بناء المناهج وتخطيطها، دار الفكر، عمان، ط 1، 1426ه/ 2006م. ص: 160.
[8] عادل أبو العز أحمد سلامة، تخطيط المناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق، دار ديبونو، عمان، الأردن، ط1، سنة 2005م، ص: 90.
[9] ينظر: عادل أبو العز أحمد سلامة، تخطيط المناهج وتنظيمها ، ص:89.
[10] محمـد صابر سليم وآخرون، بناء المناهج وتخطيطها، ص: 161.
[11] نفسه، ص: نفسها
[12] من هؤلاء الباحثين : فؤاد محمد موسى، في كتابه: المناهج مفهومها، أساسها تنظيمها عناصرها. محمـد صابر سليم ويحي عطية وفايز مراد و يسرى عفيفي وحسن شحاته، ومحسن فراج في كتابهم: بناء المناهج وتخطيطها. حيدر عبد الكريم محسن الزهيري، في كتابه: المناهج وطرائق التدريس المعاصرة. حلمي الوكيل ومحمد أمين المفتي، في كتابهما: أسس بناء المناهج وتنظيماتها. سعدون محمود الساموك وهدى علي جواد الشمري، في كتابهما: مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها. سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، في كتابها: المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل. الخليفة حسن الجعفر في كتابه: المناهج، أسسها وعناصرها و تنظيماتها. جودت أحمد سعادة وعبد الله محمد إبراهيم، في كتابهما: تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها. عبد السلام يوسف الجعافرة، في كتابه: المناهج، أسسها وتنظيماتها. عبد الرحمان الهاشمي ومحسن علي عطية، في كتابهما: تحليل محتوى مناهج اللغة العربية. عادل أبو العز أحمد سلامة، في كتابه: تخطيط المناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق…
[13] أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس المنهج، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة دمنهور، مصر، دط، 2015م.ص: 161.
[14] ينظر: نفسه، ص: 280.
[15] ينظر: أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس المنهج، ص 114 .
[16] ينظر: حلمي الوكيل ومحمد أمين المفتي، أسس بناء المناهج وتنظيماتها، دار المسيرة، الأردن، ط1، 2005م/ 1426هـ.ص: 138.
[17] ينظر: أعضاء هيئة التدريس، فلسفة أسس المنهج ، ص:115.
[18] ينظر: أعضاء هيئة التدريس، فلسفة أسس المنهج ، ص:116.
[19] نفسه، ص: نفسها.
[20] ينظر: الخليفة حسن الجعفر، المناهج، أسسها وعناصرها و تنظيماتها، مكتبة الرشد، الرياض، ط12، 1433هـ.ص 79.
[21] ينظر: نفسه، ص:نفسها.
[22] نفسه، ص: 80.
[23] ينظر: محمد صابر سليم وآخرون، بناء المناهج وتخطيطها، ص 162.
[24] ينظر : المرجع نفسه، ص: 163.
[25] محمد إسماعيل ظافر، ويوسف الحمادي، التدريس في اللغة العربية، دار المريخ، الرياض، ط1984م. ص: 77.
[26] ينظر: المرجع السابق، ص: 78_79.
[27] فؤاد البهي السّيد، الأسس النّفسيّة للنّمو، دار الفكر العربي، مصر، ط1، 1956م، ص:221 .
[28] ينظر: إبراهيم وجيه محمود، التعلّم؛ أسسه، ونظرياته وتطبيقاته، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط1976.ص:67_79.
[29] وزارة التربية الوطنية ، كتاب اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم المتوسط، ص:40 ، وكتاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم المتوسط ص: 15، وكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ص: 15.
[30] وزارة التربية الوطنية ، كتاب اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ص: 43 ، وكتاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي ص: 12 ، وكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي ص: 22.