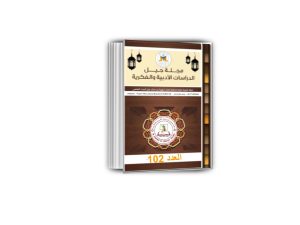قيود اللفظ الفصيح في تصور البلاغيين العرب بين بنياته الصوت صرفية ومؤثراته الخارجية
د. مجيد الخلطي ـ جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، المغرب.
The Restrictions of the Eloquent Utterance as Perceived by Arab Rhetoricals Between its Phono-Morphological Structures and its Extrinsic Influences
*Majid Kholti ـ University Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fes, Morocco.
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 50 الصفحة 69.
Abstract
This study seeks to unveil the properties of the eloquent utterance and the reason behind the neglect of some of the Arab publications. It equally reveals the discrepancy in the attitudes of the old Arab rhetoricals towards the existing dissonance between the sound utterances and the requisites for its concordance, which makes it undesirable and shunned by the speaker or appealing and aspired for.
I demonstrated the impact of the phonological, morphological, pragmatic and aesthetic restrictions that were put in place by these rhetoricals on the eloquent utterance both in its spread and usage. I also proved that sounds’ proximity or remoteness are not valid criteria because some close sound utterances are appreciable while some remote sound utterances are unappealing.
This study did not overlook their disagreement over the influential factors in the utterance eloquence: Is it the sounds structure or remoteness and closeness? Or Pronunciation? Or listening? Or composition? I concluded that all these extrinsic factors overlap with one another to constitute a wholistic context which turns into the real influential element in the eloquence of the utterance and the expansion of its usage zone. I also found that previous explications were not scientific enough and tended more towards subjectivity.
ملخصتهدف هذه الدراسة إلى إبراز خصائص اللفظ الفصيح وسبب إهـمـال بعض التأليفات العربية. وتكشف كذلك عن تباين مواقف البلاغيين العرب القدماء من التنافر الحاصل بين أصوات اللفظ وشروط انسجامها، مما يجعله مستكرها يعدل عنه المتكلم، أو مستحسنا يقبل عليه.
وقد بينت أثر القيود الصوتية والصرفية والتداولية والذوقية التي وضعها هؤلاء البلاغيون للفظ الفصيح في شيوعه وتداوله، وأن قيدي تقارب الأصوات وتباعدها ليسا معيارين سليمين، لأن بعض الألفاظ متقاربة الأصوات مستحسنة، وبعضها متباعدة الأصوات مستقبحة.
ولم تغفل اختلافهم في العنصر المؤثر في فصاحة اللفظ أهو بنية الأصوات أم تباعدها وقربها؟ أم النطق؟ أم السمع؟ أم النظم؟ وخلصت إلى أن هذه العناصر الخارجية تتضافر فيما بينها فتشكل سياقا شموليا يكون هو المؤثر الفعلي في فصاحة اللفظ واتساع دائرة استعماله، وأن تفسيرات اللفظ الفصيح لم ترق إلى التحليل العلمي الدقيق، وطغى عليها المنحى التأثري.
الكلمات المفاتيح
اللفظ الفصيح، البلاغيون العرب، تأليف الأصوات، الألفاظ متقاربة الأصوات، الألفاظ متباعدة الأصوات، القيود، العنصر المؤثر.
مدخل:
عني اللغويون العرب القدماء بمبحث الأصوات وأولوه أهمية خاصة؛ إذ درسوها دراسة مستفيضة، وحددوا مخارجها وصفاتها، وبينوا تأثيرها في النطق، وعلى مدلول الكلمة.
وعلى الرغم من أنهم الأوائل الذين تحدثوا عن هذا المبحث، إلا أن الجاحظ كانت له الريادة في نقل تنظيراتهم إلى المجال التطبيقي في الدرس البلاغي، وأضحى مبحثا رئيسا فيه. ويؤكد ذلك قول عبد الحكيم راضي: «وإذا كان مبحث الأصوات والحديث عن مخارج الحروف وسلامتها وقوتها، واختلافها وتوافقها قد بدأ في مؤلفات اللغويين، وبالذات عند الخليل بن أحمد، فقد كان للجاحظ فضل انتقال هذا المبحث ـ من منطلق تطبيقي ـ إلى مؤلفات البلاغيين، فلم يستمر وقفا على المؤلفات اللغوية المعنية ببحث الصوت بعيدا عن التفكير في استعماله، أو ـ بعبارة أدق ـ بعيدا عن قيمته، وإنما غدا الحديث فيها مبحثا أساسيا في كثير من كتب البلاغة وعدد من المؤلفات التي تعرضت لقضية الإعجاز القرآني»[1].
لقد درس البلاغيون مكونات الألفاظ الصوتية وكيفية تأليفها، ومدى تآلفها أو تنافرها، وخفتها في النطق أو ثقلها على اللسان، ومن ثم انتهوا إلى ضبط مواصفات اللفظ الفصيح، وصياغة القيود التي تحقق له شروط الفصاحة. وشرعوا في دراستها وتحليلها بشكل مستفيض. ولا تختلف كثيرا قيود اللفظ الفصيح عندهم عن قيود تأليف اللفظ عند النحويين. فإلى أي مدى كانت هذه القيود معيارا لتحديد مفهوم اللفظ الفصيح، وقبول المولّد واستحسانه أو رفضه والنفور منه؟
1ـ تصور البلاغيين القدماء لمفهوم الفصاحة
الفصاحة لغة هي البيان والظهور [2]. أما اصطلاحا فالملاحظ في المصنفات العربية أنها لا تقتصر على الكلمة بمفردها، وإنما تتعداها لتشمل الكلام، والمتكلم؛ إذ تقع وصفًا لهذه العناصر كلها[3].
ويرى أبو هلال العسكري (ت: نحو 395هـ) «أن الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ؛ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى، والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى»[4].
ويتبنى ابن سنان الخفاجي (ت: 466هـ)، التصور نفسه؛ إذ يرى: «أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني»[5].
ويذكر ابن الأثير (ت: 673هـ) أن اكتفاء البلاغيين فـي تعـريفاتهـم للفصاحـة بالوقـوف عـنـد الـدلالـة اللـغـويـة لا يجـلّـي مفـهـومـهـا؛ لأن: «غاية ما يقال في هذا الباب: إن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي، يقال: أفصح الصبح، إذا ظهر، ثم إنهم يقفون عند ذلك، ولا يكشفون عن السر فيه. وبهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة»[6]. ولذلك يرى أن اعتبار اللفظ الفصيح هو الظاهر البين من غير تفصيل يصاحبه اعتراضات ثلاثة واردة: «أحدها: أنه إذا لم يكن ظاهرا بينا لم يكن فصيحا، ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحا.
الوجه الآخر: أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلك بالنسب والإضافات إلى الأشخاص، فإن اللفظ قد يكون ظاهرا لزيد، ولا يكون ظاهرا لعمرو فهو إذا فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا، وليس كذلك، بل الفصيح هو فصيح عند الجميع، لا خلاف فيه بحال من الأحوال، لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختص به خلاف.
الوجه الآخر: أنه إذا جيء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع، وهو مع ذلك ظاهر بين، ينبغي أن يكون فصيحاً وليس كذلك لأن الفصاحة وصف حسن اللفظ، ولا وصف قبح»[7].
ويفـرق ابن الأثير بين الفصاحة والبلاغـة[8]. ويـرى[9] أن اللفظة الـواحـدة يطلـق عليهـا اسم الفصاحة، لوجود وصف المختص فيها، وهو الحسن، ولا يطلق عليها اسم البلاغة لعدم وجود الوصف فيها؛ لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاما.
ويرى أيضا[10] أن البلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، وهي أخص من الفصاحة، ولذلك فكل كلام بليغ يوصف بالفصاحة، ولا تتحقق البلاغة لكل كلام فصيح.
لكن صلاح الدين الصفدي (ت: 764هـ) يختلف معه، ويذكر كما يشير إلى ذلك محمد سلام زغلول أن هناك فرقا دقيقا بين المفهومين لم يتنبه إليه ابن الأثير: «والذي أقوله إنما هو أن بين البلاغة والفصاحة عموما من وجه وخصوصا من وجه، وبيان ذلك، أما عموم البلاغة فلأنها تتناول الكلام الفصيح أعني الحسن البين، وغير الفصيح، أعني الغريب الوحشي، وعموم الفصاحة فلأنها تتناول الألفاظ العذبة الحسنة مفردة ومركبة، أما خصوص البلاغة فلأنها لا تتناول إلا الألفاظ المركبة فقط فثبت أن بين البلاغة والفصاحة عموما من وجه وخصوصا من وجه، ومثل هذا لا يبينه ابن الأثير»[11].
ويستند ابن الأثير في الفصاحة إلى حاسة السمع، فهي المرجع في حسن اللفظ وقبحه، «فما استلذه السمع منه هو الحسن، وما كرهه فهو القبيح، والحسن هو الموصوف بالفصاحة، والقبيح غير موصوف بفصاحة، لأنه ضدها لمكان قبحه»[12]. ويمثل للصنف الحسن بكلمتي “دِيمَة، ومُزْنَة”، وللصنف القبيح بلفظ “بُعاق”.
فإلى أي مدى يمكن أن تكون ملكة السمع هي الفيصل في تحديد اللفظ الفصيح؟ أو ليست الأذن مجرد قناة توصل الملفوظ إلى الدماغ البشري وتجعله يتفاعل مع المعجم المخزن فيه فيثير دلالات تنعكـس على النفس فتتأثر بذلك الملفـوظ، وتتفاعـل معـه إمـا إيجـابا وإما سلبا؟ أو ليس هذا ما عبّر عنه البعض بالذوق؟!
ويرى حازم القرطاجني (ت: 684هـ) في المنهاج أن من شروط فصاحة الكلمة وقيودها التأليفية: «أن تكون الكلمة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها»[13].
ويقول عبد القاهر الجرجاني (ت: 471هـ)، في سياق حديثه عن الفصاحة: «فلو كانت الكلمة إذا حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجـاورة لهـا في النظم، لما اختلف بهـا الحال، ولكانت إما أن تحسن أبـدا، أو لا تحسن»[14].
ويـرى أيضا أنه لا تفاضل في الدلالة بين اللفظتين: «هل يتصور أن يكون بين اللفظتين/ تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به، حتى يقال إن (رجلا) أدل على معناه من (فرس) على ما سمي به»[15].
ويؤكد في موضع آخر اللاتفاضل للألفاظ من حيث هي ألفاظ مجردة: «ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر»[16].
الملاحظ من التعريفات المقدمة هو أن مفهوم الفصاحة يختلف عن مفهوم البلاغة، وأن فصاحة الكلمة لا ترجع إلى مادتها التي تشكل بنيتها، وإنما إلى عنصر خارجي يحدده ابن سنان في “بنية أصوات الكلمة وكيفية تكوينها ونطقها”، وابن الأثير في “السمع” الذي يفاضل بين حسن اللفظة وقبحها. ويتحدد أيضا عند حازم القرطاجني في “السمع”؛ لأنه هو المراد من حجم المادة المنطوقة (التوسط في الحروف) والزمن الذي يستغرقه النطق، بينما ينحصر عند الجرجاني في “النظم”؛ إذ هو الفيصل في إضفاء صفة الحسن أو القبح على الكلمة.
وعلى الرغم من أن فصاحة اللفظ لا تخرج عن نطاق المتكلم والسامع، إلا أن هناك تباينا بين هؤلاء البلاغيين في العنصر المؤثر فيها أهو بنية الأصوات أم النطق؟ أم السمع؟ أم النظم؟
ويبدو أن هذه العناصر الخارجية تتضافر فيما بينها فتشكل سياقا شموليا يكون هو المؤثر الفعلي في فصاحة الكلمة، فتحظى بالاستحسان ويُقبل عليها، أو تُنعت بالاستثقال ويُنفر منها.
2ـ تصور البلاغيين القدماء لتأليف الأصوات
لا يحيـد ابن سنان الخفـاجـي[17] في تحديد سبب إهـمـال بعض التأليفات عـن عـلماء اللغة المتقدمين أمثال: الخليل بن أحمد (ت: 175هـ)، وابن دريد (ت: 361هـ)، وابن فارس (ت: 395هـ)، وابن جني (ت: 392هـ)، الذين أجمعوا على كون الاستثقال الناتج عن تقارب مخارج الأصوات هو السبب الرئيس للإهمال. يقول: «ووقوع المهمل من هذه اللغة، على ما قدمته لك، في الأكثر من اطراح الأبنية التي يصعب النطق بها لضرب من التقارب في الحروف، فلا يكاد يجيء في كلام العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة؛ لحزونة[18] ذلك على ألسنتهم وثقله»[19].
ويذكر السيـوطـي (ت: 911هـ)[20] أن الخـفـاجـي يذهب إلـى أن هناك ألفـاظـا مشكـلـة مـن أصوات متقـاربـة المـخـارج مثل: شَجَـرٌ، وجَيْشٌ، وفَـمٌ، ولا تنافـر فيها، وكذلك المتباعـدة منهـا، المفرطة في بعدها مثل: عَلِمَ وبَعُـدَ، بل اعتبر تباعد مخارج الحروف شرطا للفصاحة[21].
والحقيقة أن هذا التعريف لا يرد سبب التنافر إلى مخرج الصوت ذاته، ويضمر عاملا آخر مؤثرا في ذلك يكشف عنه في محاولته تفسير إهمال لفظة وذيوع أخرى على لسان متكلمي العربية، معتبرا مسألة التنافر تنحصر في سببين: الأول يتمثل فـي كيفية تأليف أصوات اللفظ التي تراعي تباعد مخارج الأصوات، والثاني يتمثل في العامل النفسي الذي يجعل المرء يميل إلى تفضيل كلمة على أخرى تبعا لذوقه.
وفـي هـذا السيـاق يـقـول ابن سنان الخفاجي: «والثانــي أن تـجـد لـتـألـيـف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرها وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنا يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه ومثاله في الحروف ــ ع ذ ب ــ فإن السامع يجد لقولهم العَذيب اسم موضع وعذيبة اسم امرأة، وعذب وعذاب وعذب وعذبات ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في التأليف وليس سبب ذلك بعد الحروف في المخارج فقط ولكنه تأليف مخصوص مع البعد ولو قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال لضرب من التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير […]، وقد يكون هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاق فيحسن أيضا»[22].
ويبدو أن الخفاجي حاول تعليل شيوع لفظة دون سواها بإضافة خاصية ضمنية تتمثل في تأليف الأصوات على وجه مخصوص من خلال تحليل لفظة “عذب” وكيفية تأليف أصواتها على هذا الترتيب الذي يمنحها حسنا وجمالية.
فإلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التفسير صحيحا؟ وما سبب عدم استحسان تغيير ترتيب حروف “عذب” أهو التداول الذي أشاع اللفظة على الألسنة أم العامل النفسي المتمثل في التعود على سماع هذه الكلمة على هذا الترتيب الأصواتي حتى أضحى من العسير خرقه كي لا تنفر منه النفس أم السياق الذي ترد فيه هذه اللفظة في اللسان العربي، وهو الذي أثر على الذوق وعمل على تشكيله؟
على الرغم من تداخل هذه المسوغات التي تبدو مجتمعة تعزز مقبولية اللفظة، إلا أننا نرجح الترتيب الأصواتي في إشاعة اللفظة[23] ليس لأن خرقه يفسد حسن اللفظة ـ كما يرى الخفاجي ـ ولكن لأنها وردت مرتبة[24] من حيث قرب مخارجها من الحلق، ولا يتم الرجوع عند نطقها إلى مخرج متقدم حتى لا يكون تقطع لامتداد الصوت وانسيابه، مما يمنحها خفة في النطق ووقعا حسنا في النفس.
أما ابن الأثـيـر[25] ـ في سياق حديثه عن تباعد مخارج الأصوات ـ فيقول في معرض تعليقه على كلام ابن سنان: «أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه، لأن الواضع قسمها في وضعه ثلاثة أقسام: ثلاثيا، ورباعيا، وخماسيا، والثلاثي من الألفاظ هو الأكثر، ولا يوجد ما يكره استعماله إلا الشاذ النادر، وأما الرباعي فإنه وسط بين الثلاثي والخماسي في الكثرة عدداً واستعمالاً، وأما الخماسي فإنه الأقل، ولا يوجد فيه ما يستعمل إلا الشاذ النادر، وعلى هذا التقدير فإن أكثر اللغة مستعمل على غير مكروه»[26].
ويذهب[27] إلى أن أكثر اللغة مستعمل على غير مكروه، وأن كثيرا من الحروف المستكرهة أسقطها الواضع أثناء تأليف الكلمات؛ فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين، ولا بين الجيم والقاف، ولا بين اللام والراء، ولا بين الزاء والسين. ويؤكد أن «كل هذا دليل على عنايته بتأليف متباعد المخارج، دون المتقارب»[28].
يتبين من كلام ابن الأثير أن استحسان الكلمة يقتضي تباعد مخارج صوامتها. وفي موقفه هذا لم يضف جديدا إلى ما قاله المتقدمون عليه؛ لكونه يرجع أسباب إهمال الألفاظ إلى تقارب المخارج الذي يتولد عنه ثقل نطق الأصوات من طرف المتكلم، واستقباحها من طرف المتلقي واستكراهها. وفي مقابل ذلك يستحسن هذا المتكلم الكلمات متباعدة المخارج؛ لخفتها في النطق، ووقعها الحسن[29] على سمع المتلقي.
لكن استحسان ابن الأثير للكلمة عنده لا يرتبط بعدد مكوناتها الصوتية، ولذلك خالف[30] ابن سنان في كون طول الكلمة معيارا لقبحها مستندا في رأيه إلى ألفاظ في القرآن الكريم التي وردت طويلة، ومع ذلك عدت من الألفاظ الحسنة كقوله تعالى في سورة البقرة، الآية 137: “فسيكفيكهم الله”، وقوله أيضا في سورة النور، الآية 55: “ليستخلفنّهم في الأرض”؛ لأن الطول فيهما ليس أصلا، لكنه خلص إلى أن الطول الناجم عن كثرة الحروف الأصول قبيح، ولا يحسن إلا في الثلاثي وبعض الرباعي، ولا يكاد يوجد منه شيء حسن في الخماسي، وعلى هذا الأساس استقبح كلمة “جَحْمَرش” و”صَهْصَلق”؛ لأنهما مـن الخماسي المجرد.
ويرى أن الاستحسان والاستقباح رهينان بحاسة السمع. وفي ذلك يقول: «وإنما شّذ عنه الأصل في ذلك، وهو أن الحسن من الألفاظ يكون متباعد المخارج، فحسن الألفاظ إذن ليس معلوما من تباعد المخارج، وإنما علم قبل العلم بتباعدها، وكلُّ هذا راجع إلى حاسة السمع، فإذا استحسنت لفظا أو استقبحته وجد ما تستحسنه متباعد المخارج وما تستقبحه متقارب المخارج، واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار المخارج لا بعده»[31].
لكنه يذهب إلى أن العربي نطق الألفاظ على غير علم برتبتها في مخارجها. ويستدل على ذلك من خلال جواب المخاطب الفوري عند استجوابه عن كون اللفظة حسنة أو قبيحة دون علمه بتباعد مخارجها، وإلا لصح ما ذهب إليه ابن سنان في اعتبار حسن الألفاظ رهين بتباعد مخارجها.
ونشاطر ابن الأثير رأيه؛ لأنه من غير المنطقي استحضار العربي تقارب وتباعد أصوات اللفظ لحظة نطقه حتى يتم تأليفه ومنحه صفة الاستحسان أو الاستقباح، وإنما هذه الصفة نعت بها لا حقا بعد تداوله وسماعه. وأنه بعد استقراء وتقعيد المتن اللغوي علم بذلك، واتضح له أن الألفاظ متباعدة المخارج مستحسنة، ومتقاربة المخارج مستقبحة.
ويؤكد في موضع آخر عدم مراعاة المتكلم تباعد وتقارب الأصوات عند تأليف اللفظ لإضفاء صفة الاستحسان أو الاستقباح عليه، ويعتبر حاسة السمع هي الفيصل في قبول اللفظ أو النفور منه: «لو أراد الناظم أو الناظر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ وهـل هي متباعدة أو متقاربـة لطال الخطب في ذلك وعسر، ولما كان الشاعر ينظم قصيدا ولا الكاتب ينشئ كتابا إلا في مدة طويلة تمضي عليها أيام وليال ذوات عدد كثير، ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك، فإن حاسة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح ما يقبح»[32].
إن موقف ابن الأثير الذي يتبنى طرح المتقدمين عليه فيما يخص حسن تأليف الأصوات يتأرجح بين تباعد مخارجها وحاسة السمع. وهوما يحيل على عدم اقتناعه بالتعليل الأول ومحاولته سنده بحاسة السمع، خاصة أمام وجود ألفاظ مستقبحة رغم تباعد مخـارجهـا مثل بُعاق[33]، علِـم، ملَعَ، وألفاظ مستحسنة مع تقارب مخارجهـا مثل: شجَرٌ، جيْشٌ، فـمٌ. والراجح أنه يحيل من خلال تركيزه على حاسة السمع على التداول؛ ذلك أن السمع قناة توصل الملفوظ بخصائصه الصوتية إلى النفس فتألفه وتعتاد عليه، وبكثرة الاستعمال قد تستحسنه.
وعرض القزويني لتنافر أصوات الألفاظ، وما يترتب عنها من ثقل في النطق واستكراه الأسماع لها؛ مما يعرضها إلى الإقصاء من دائرة الكلام الفصيح. يقول: «أما فصاحة المفرد، فهي خلوصه من تنافر الحروف، والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان، وعسر النطق بها، كما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته؛ فقال: تركتها ترعى الهعخع[34]. ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر[35] في قول امرئ القيس»[36].
يتضح من اللفظتين اللتين استدل بهما القزويني على التنافر أنه ليس نوعا واحدا ثابتا، بل هو درجات تتفاوت فيها الألفاظ تبعا لنوعية الأصوات التي تؤلفها، ولكنه يظل ثقيلا على اللسان مستكرها، يمجه السماع والذوق العربي.
ويعرض بهاء الدين السبكي (ت: 773هـ) في عروس الأفراح تصور المتقدمين عن تنافر الحروف كما يورد السيوطي: «قالوا: التنافر يكون إما لتباعد الحروف جدا، أو لتقاربها، فإنها كالطفرة والمشي في القيد»[37].
ويرى أن التنافر الحاصل من تباعد الحروف البين أو تقاربها، هو نفسه الحاصل من المثلين لشدة تقاربهما والضدين لشدة تباعدهما، وإن كان تنافر المتباعدين عنده أخف. يقول: «ويشبه استواء تقارب الحروف وتباعدها في تحصيل التنافر استواء المثلين اللذين همـا في غاية الوفاق، والضديـن اللذيـن همـا فـي غايـة الخلاف، فـي كون كل من الضدين والمثلين لا يجتمع مع الآخر، فلا يجتمع المثلان؛ لشدة تقاربهما، ولا الضدان لشدة تباعدهما، وحيث دار الحال بين الحروف المتباعدة والمتقاربة، فالمتباعدة أخف»[38].
ويرى الدسوقي محمد بن عرفة[39] (ت: 1230هـ) أن سبب الثقل فيها راجع إلى توسط الشين المهموسة الرخوة بين التاء المهموسة الشديدة وبين الزاي المجهورة، وأن التنافر ليس مرده قرب المخارج، وإنما ثقل الكلمة في السمع لاختلاف صفات أصوات تأليفها.
3ـ موقف بعض البلاغيين المحدثين من تصور البلاغيين القدماء للتنافر الصوتي
إذا كان البلاغيون والنقاد القدماء يسوقون كلمة “مُسْتَشْزِرات” في وصف امرئ القيس شعر محبوبته؛ للاستدلال على تنافر حروفها، ويكادون يتفقون على أن مصدر صعوبتها يكمن في اجتماع حروف خاصة هي (السين والشين والزاي) «وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء – وهي مهموسة شديدة – والزاي وهي مجهورة»[40]، فإن هناك من المحدثين من يخالفهم الرأي، ومنهم مصطفى إبراهيم عبدالله [41] الذي يعتبر كـلمة مستشزرات فصيحة، ومجسدة للمعنى المراد. ويذهب إلى أن التنافر فيها لازم لزوما فنيا؛ لأنه يعكس الصورة التي يريد الشاعر رسمها لخصلات شعر المحبوبة الكثيفة، وينسجم معها؛ ذلك أن كلمة استشزر فيها زيادة في المبنى تحيل إلى زيادة في المعنى. وقد وردت بمعنى انفتل[42] التي تدل على مدى تداخل خصلات الشعر واختلاف أوضاعها. ويسمي ذلك بالسياق السببي.
وهذا التفسير له ما يعضده لغويا وبلاغيا؛ لأن الغاية التعبيرية التواصلية تقتضي اعتماد الشكل اللساني الذي يحتضن المدلول مع استيفاء المعنى. ويؤكده قول الطاهر بن عاشور: «لأن حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلُفه فيه غيره، مقدَّم على مراعاة خفَّة لفظه»[43].
ومن الألفاظ التي يستثقلها اللسان “اثّاقلتم” في قوله تعالى في سورة التوبة، الآية 38: (يا أَيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم)، لكن ذلك لا يخرجها من الفصاحة؛ لأنها تصور حقيقة المتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله. يقول سيد قطب: «ولو أنك قلت: تثاقلتم لخفَّ الجرس، ولضاع الأثَر المنشود، ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقلَّ برسمها»[44]. وقد عرض لذلك موضحا البعد الدلالي المعبر لهذا التأليف الصوتي الذي يحصر “اثَّاقلتم” في الألفاظ التي يستثقلها اللسان. ولكن ما كان لهذا اللفظ أن يحققه لولا هذا التأليف.
ويعلل أبو موسى تنافر لفظ “الهعخع” بقوله: «وهذه كلمة ثقيلة لا يستطاب دورانها على الألسنة، إلا أن يكون شجراً كريهاً مرا، لا يطاق طعمه، كأنه هذه الكلمة التي لا يطاق النطق بها»[45]. وقد يكون ما ذهب إليه أبو موسى، في كون ثقل هذه الكلمة راجع إلى دلالتها الحقيقية التي لا تطاق، مقبولا، إلا أنه لا يقدم تفسيرا مقنعا لسبب تنافر أصوات الكلمة.
ولعل التفسيرات التي قدمها اللغويون والبلاغيون القدماء والمحدثون فيما يخص تنافر أصوات اللفظ وفصاحته والمتأرجحة بين تقارب المخارج وتباعدها، وثقلها على السمع وخفتها، والذوق ترجع إلى السياق التركيبي والزمني الذي يرد فيه هذا اللفظ والحالة النفسية للمتلقي عندئذ، وما قد يصاحبها من تفاعل أو عدمه مع هذا اللفظ، مما يترتب عنه إما انجذاب النفـس إلى ذلك اللفظ والإقبال عليه واستحسانه، أو الإعراض عنه والنفور منه، واستثقاله. ولذلك ظلت هذه التفسيرات تأثرية انفعالية؛ لأن التعليلات التي قدمت في شأنها غير علمية؛ لاتستند إلى معايير دقيقة أو عقلية منطقية. وفي ذلك يقـول تمام حسـان: «والانعكاسات النفسية فيما أرى كالقيم الطبيعية لا تخضـع للمقاييس الموضوعية ولا للعبارات المعيارية، ومن ثَمَّ كان من الصعب على المتأخرين من دارسي المعاني أن يستثمروا إشارات المتقدمين، ويبنوا عليها النظريات، ولاسيّما أن الدراسات النفسية لم تكن في ذلك الوقت شيئاً مذكوراً، إذ لم تكن تعدو أن تكون جزءاً من الميتافزيقا في معسكر الفلاسفة أو من التجارب الفردية في مضارب المتصوفة»[46].
4ـ قيود اللفظ عند البلاغيين القدماء
أثار مفهوم اللفظ الفصيح جدلا واسعا بين البلاغيين، وتباينت تحليلاتهم في شأنه. فمنهم من رد الفصاحة إلى التأليفات الصوتية، ومنهم من ربطها بالبنية الصرفية، ومنهم أرجعها إلى الذوق السليم، ومنهم من عزاها إلى التداول. فما مدى صحة طروحاتهم؟ وما حدودها في ذيوع اللفظ وفصاحته؟
4ـ1ـ قيود اللفظ الصوتية
أسفرت دراسة البلاغيين لأصوات اللفظ الفصيح عن تصنيفها إلى صنفين: الأصوات المستحسنة والأصوات المستقبحة. واعتمدوا هذا التصنيف في الحكم على فصاحة اللفظ.
والأصوات المستحسنة عند العلوي[47] (ت: 745هـ) هي الشفوية “الباء، والفاء، والميم، والواو”. والذلق “الراء، واللام، والنون”. ويرجع سبب استحسان الشفوية في بناء الألفاظ إلى كونها أخف الأحرف موقعا، وألذها سماعا، وأسلسها جريا على الألسنة. ويرجع استحسان حروف الذلاقة إلى مخرجها من طرف اللسان وكثرة استعمالها في الكلام، وتلطيف الأبنية، وتحسين سماعها.
أما الأصوات المستقبحة وعلى الخصوص في الأشعار؛ فقـد حصرها ابن الأثير في: ث، ذ، خ، ش، ص، ط، ظ، غ. يقـول: «واعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يجتنبا ما يضيق به مجال الكلام في بعض الحروف الباقية مندوحة عن استعمال ما لا يحسن من هذه الأحرف المشار إليها، والناظم في ذلك أشد ملامة؛ لأنه يتعرض لأن ينظم قصيدة ذات أبيات متعددة فيأتي في أكثرها بالبشع الكريه الذي يمجه السمع لعدم استعماله، كما فعل أبو تمام في قصيدته الثائية التي مطلعها:
قف بالطلول الدارسات عُلاثا
وكما فعل أبو الطيب المتنبي في قصيدته الشينية التي مطلعها:
مبيتي من دمشق على فراش
وكما فعل ابن هانئ المغربي في قصيدته الخائية التي مطلعها:
سرى وجناح الليل أقتم أفتخ»[48].
ويرى ابن الأثير[49] أن القصائد المقصدة لا تصاغ من هذه الحروف وإن صيغت ورد أكثرها بشعا، وهي متفاوتة في الكراهة وأشدها الخاء، والصاد، والظاء، والغين، أما الثاء، والذال، والشين، والطاء، فإن الأمر فيهن أقرب حالا.
وخلص البلاغيون من استقرائهم للمتن العربي إلى أن اللفظ الفصيح يقتضي سهولة نطقه، وحسن وقعه الصوتي في الأسماع، ووضعوا لذلك العديد من القيود الصوتية؛ منها مخرج الصوت، وقربه أو بعده من الصوت الذي يليه، وطبيعة الأصوات المشكلة لمقاطع الكلمة، وأيضا نوعية المقطع الصوتي من حيث الطول والقصر والتوسط، وعـدد مقـاطـع الكـلمـة. واخـتـزلـوا تلك القـيـود فيما يترتب عنهـا مـن صعـوبـة نطـق بعـض الأصوات، مما نتج عنه إهمال بعض التأليفات.
وقد عرض لهذه الظاهرة مجموعة من البلاغيين؛ فابن الأثير يتفق مع ابن سنان في سبب الإهمال وينسبه إلى الاستثقال. وحازم القرطاجني يرى أن قيود تأليف الكلمات تقتضي التوسط بين قلة الحروف وكثرتها، وهو ماعبر عنه ابن سنان بالاعتدال في عدد الحروف. والقزويني أشار إلى التنافر الصوتي الذي يؤدي إلى الثقل على اللسان وعسر النطق. وبهاء الدين السبكي يرى أن تباعد مخارج الحروف أخف من التقارب.
4ـ2ـ قيود اللفظ الصرفية
لقد اشترط البلاغيون في اللفظ الفصيح عدم مخالفته القياس الصرفي[50]. وقد أورد السيوطي[51] في سياق حديثه عن هذا القيد البلاغي قول بهاء الدين السبكي في معرض رده على الخطيبي (ت: 745هـ) في شرح التلخيص في شأن لفظة سُرُر: «إن عَنَى بالدليل ورود السماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغوي، لا الفصاحة: وإن عنى دليلا يُصيِّره فصيحا، وإن كان مخالفا للقياس، فلا دليل في سرر على الفصاحة إلا وروده في القرآن؛ فينبغي حينئذ أن يقال: إن مخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة حيث لم يقع في القرآن الكريم»[52].
ومن خلال هذا القول يتضح تصور بهاء الدين السبكي (ت: 773هـ) للفظ المخالف القياس الصرفي[53]، والمتمثل في كونه فصيحا إذا كثر استعماله وورد في القرآن الكريم. ومن تجليات مخالفة القياس كما يشير إلى ذلك ابن سنان الخفاجي[54] الاستعاضة عن جمع التكسير بالجمع الصحيح.
«قال الطرماح: وأكره أن يعيب على قومي *** هجاي الأرذلين ذوي الحنات
فجمع إحنة على غير الجمع الصحيح، لأنها إحنة وإحن، ولا يقال حنات».
وأيضا فك إدغام الحرفين في الحالات التي يجب فيها كما يشير إليه (المراغي[55] في «قول أبي النجم بن قدامة من رجاز الإسلام:
الـحـمـد لله العلـي الأجلَلْ *** أنـت مليـك النـاس ربـا فاقبل»
وفي نفس السياق يقول ابن سنان الخفاجي[56]:
«ومنه أيضا إظهار التضعيف[57] في الكلمة مثل قول الشاعر: هو قعنب بن أم صاحب:
مهلا أعاذل قد جربت مـن خلقي *** أني أجود لأقوام وأن “ضننوا”»
ومنه أيضا جمع صيغة فاعِل على فواعل كما يذكر المراغي: «كجمع ناكس على نواكس بمعنى مطأطئي الرؤوس في قول الفرزدق:
وإذا الرجال رأوا يريد رؤيتهم *** خُضْع الرقاب نواكس الأبصار
مع أن فواعل إنما تقاس في وصف لمؤنث عاقل لا لمذكر كما هنا»[58].
وبالإضافة إلى ذلك تنوين الممنوع من الصرف، ومنع التنوين مما ينصرف، ومدّ المقصور[59]. يقول ابن سنان:
«وأما صرف ما لا ينصرف كقول حسان بن ثابت:
وجبريلٌ أمين الله فينا *** وروح القدس ليس له كِفاءُ
ومنع الصرف مما ينصرف كما أنشدوا قول العباس بن مرداس:
وما كان حصن ولا حابس *** يفوقان مرداسَ في مجمع
وكما قال البحتري:
هزج الصهيل كأن في نغماته *** نبرات معبدَ في الثقيل الأول
فمنعا الصرف عن مرداس ومعبد. وقصر الممدود كقول الآخر:
والقارح العدا وكل طمرة *** ما إن تنـال يـد الطـويـل قـذالـهـا
ومد المقصور على ما روى بعضهم:
سيغنيني الذي أغناك عني *** فلا فــقـر يـدوم ولا عـــنـــاء»[60]
يتضح من القيود الصرفية التي سنها البلاغيون لمعيرة اللفظ الفصيح أن هناك خرقا لها. وعلى الرغم من ذلك يظل هذا اللفظ منتميا لدائرة الفصيح. والسند في ذلك حضور اللفظ في النص القرآني، وكثرة استعماله بين متكلمي العربية.
4ـ3ـ قيود اللفظ بين نفسية المتلقي وذوقه
رغم القيود الصوتية والصرفية التي أقرها البلاغيون في اللفظ الفصيح إلا أنهم اعتبروا الذوق السليم هو معياره الأساس؛ ذلك أن المتلقي عند سماعه الألفاظ تتحرك مشاعره. ويتفاعل ذوقه المكتسب في الجماعة التي ينتسب إليها مع نفسيته فيستجيب للمسموع ويشعر بخفته عليه، ويرتاح له أو ينفر منه لوحشيته، وغلظته، وثقل وقعه عليه فيعرض عنه.
ويولي ابن الأثير مكانة رفيعة للذوق في انتقاد الأعمال الأدبية ؛ إذ يقول: «واعلم أيها الناظر في كتابي أن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم»[61].
ويذهب ابن خلدون إلى أن مدار البلاغة على الذوق، حيث يقول: «اعلم أن لفظة “الذوق” يتداولها المعتنون بفنون البيان، ومعناها حصول ملكة البـــلاغة للســان»[62]. ويضيف[63] أن علماء البيان استعاروا لملكة البلاغة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق.
إن الذوق يمكن صاحبه من إدراك مواطن الجمال والخلل في الكلام، والانجذاب إليه أو النفور منه دون حاجة إلى معرفة قوانينه. ولذلك يرى[64] أن الذوق لا يحصل للأعاجم الداخلين في اللسان العربي المضطرين إلى النطق به، لقصور حظهم في هذه الملكة.
وعلى أساس الذوق قد يتم خرق قيود اللفظ التأليفية وتجاوز معياريتها فيتم الحكم للفظ بالحسن على الرغم من تقارب حروفه مثل: جيش، شجر، فـم، أو بتنافر أصواته على الرغم من تباعد حروفه مثل: بُعـاق، مَـلـع، عَلِم.
4ـ4ـ قـيـود اللفظ التداولـيـة
إذا كان “الذوق السليم” الذي يستند فيه العربي إلى فطرته هو المعيار الأساس في تقبل اللفظ، فإن التداول هو المعيار الثاني الذي يسمح للفظ بالشيوع والانتشار بين الجماعة اللسانية.
ويبين ابـن النفيس (ت: 687هـ) أثـر التـداول فـي إكساب الكـلمـة فصاحتـهـا، ذلك أن تغيير بنيتها الصرفية، ونقلها مـن استعمال إلـى آخـر يجعلـهـا مستحـسـنـة بعـد أن كانت مستقبحة. يقـول “الطريـق إلى الفصاحـة” حسب السيـوطـي[65]: «قـد تنقل الكلمـة مـن صيغة لأخرى، أو مـن وزن إلى آخر، أو من مُضِيّ إلى استقبال وبالعكس، فتحسن بعد أن كانت قبيحة وبالعكس؛ فمن ذلك خَوَّدَ بمعنى أسرع قبيحة، فإذا جُعِلت اسما “خَوْداً، وهي المرأة الناعمة قل قبحها، وكذلك دَعْ تقبُح بصيغة الماضي؛ لأنه لا يُستَعمل وَدَع إلا قليلا، ويحسُن فعلَ أمر أو فعلا مضارعا. ولفظ اللُّبّ بمعنى العقل يقبح مفردا، ولا يقبح مجموعا، كقوله تعالى: (لأولي الألباب)[66] […]، وكذلك الأرجاء تحسن مجموعة كقوله تعالى: (والملك على أرجائها)[67]. ولا تحسن مفردا إلا مضافة، نحو رجا البئر[68] […]، ومما يحسن مفردا ويقبح مجموعا المصادر كلها، وكذلك بقعة وبقاع، وإنما يحسن جمعها مضافا مثل بقاع الأرض».
إن ابن النفيس يربط فصاحة الكلمة بالتداول والسياقات التي يوردها فيها المتكلم من خلال العمليات التحويلية التي يخضعها لها أثناء استعمالاتها حسب ما يفرضه المقام. وهـو في هذا الطرح لا يختلف عما تذهب إليه النظريات اللسانية الحديثة التي تعتبر كفاية المتكلم اللسانية عنصرا رئيسا ومهما في عمليات التواصل.
ولا يقل رأي القزويني (ت: 739هـ) في مفهوم الفصاحة أهمية عن رأي ابن النفيس؛ إذ اعتبر الاستعمال علامة الكلمة الفصيحة والمحك الحقيقي لنعتها بهذه الصفة. يقـول: «ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا، أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها»[69]. ولعل في هذا التعريف إدراك قل نظيره عند المنظرين لمفهوم الفصاحة، ويتمثل في شرط تداول اللفظ واستعمال العرب له بكثرة.
ولا يختلف تصور السيوطي لمفهوم الفصاحة عن تصور القزويني لها؛ ففي سياق تفسيره لكلام ثعلب عن الفصاحة يرجع معيار الفصاحة إلى كثرة تداول اللفظ بين العرب، وتناقله على ألسنة العرب قائلا: «والمفهوم من كلام ثعلب أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها»[70].
ويحيل كلام السيوطي والقزويني على أن هناك ألفاظا تتوفر فيها شروط الفصاحة، ولكنها محصورة في المعجم العربي لا تتداول. وفي مقابل ذلك هناك ألفاظ تخرق شروط الفصاحة ومع ذلك يكتب لها الشيوع والانتشار على ألسنة العرب بفضل ترويج المتكلم لهـا؛ حيث يجعلها تتجلى فـي نماذج تركيبية تكتسب مـن خلالهـا قيمتها الفصاحية والدلالية والتداولية، ولو بعد حين.
ولذلك عَـدّ النقاد العرب اللفظ غير الظاهر المعنى وغير المألوف الاستعمال عند العرب الأقحاح غريبا؛ إذ المعنى عندهم هو القصد والغاية. وعناية العرب بألفاظهم إنما هو عناية بمعانيها، وتحسين ألفاظهم وإظهارها في صورة تستجيب فيها للقيود التأليفية هو خدمة منهم للمعاني. وفي ذلك يقول ابن الأثير: «واعلم أن في تقابل المعاني بابا عجيب الأمر، يحتاج إلى فضل تأمل، وزيادة نظر، وهو يختص بالفواصل من الكلام المنثور، وبالأعجاز من الأبيات الشعرية»[71].
5ـ رتب الفصاحة عند البلاغيين القدماء
لقـد انتهت عناية البلاغيين باللفـظ الفصيح إلى اقتراح تصنيف لـه فـي سلـم الرتب تبعا لتأليفاته الصوتية، وخصوصياته التداولية. وقـد تباينت تحديداتهم لـه ودرجات تصنيفه عندهـم.
يقول السيوطي: «رتب الفصيح متفاوتة؛ ففيها فصيح وأفصح؛ ونظير ذلك في علوم الحديث تفاوت رتب الصحيح؛ ففيها صحيح وأصح»[72].
ووفق هذه المعايير سار البلاغيون يميزون بين الألفاظ؛ فيحببون في بعضها، وينفرون من البعض الآخر. ومن ذلك قول صاحب الجمهرة: «البُرُّ أفصح من قولهم القمح والحنطة. وأنصبه المرض أعلى من نَصَبَهُ. وغلب غَلَبا أفصح من غَلْبا. واللُّغوب أفصح من اللَّغْب»[73].
ويذكر السيوطي: مثالا آخر لرتب الفصاحة؛ إذ يقـول: «وفي ديوان الأدب: الحِبر: العالم، وهو بالكسر أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال، والفعل يجمع على فُعول. ويقال: هذا مَـلْك يميني، وهو أفصح من الكسر»[74].
ويورد في نفس السياق قول ابن خالويه (ت: 370ه) في شرح الفصيح: «قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك»[75].
وقد فاضل السبكي في عروس الأفراح حسب السيوطي[76]، بين الألفاظ من حيث فصاحتها، وحدد تراكيب الكلمة الثلاثية من حيث مخارجها في اثني عشر تركيبا. وجعل أفضلها وأكثرها استعمالا ما انحدر فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى.
ورغم محاولته ضبط اللفظ الفصيح اعتمادا على خفة النطق وثقله، والانتقال في نطق الأصوات من مخرج إلى آخر وتحديد رتبه، إلا أنه في تفسيراته لم يعالج هذه الظاهرة اللغوية في شموليتها، وظلت محاولته عملية وصفية.
6ـ خاتمة
لقد اتضح من التحليل أن اللغويين العرب القدماء كانوا سباقين إلى دراسة بنية الكلمة الصوتية، لكن البلاغيين أولوها عناية خاصة، وشكلت مبحثا رئيسا في مصنفاتهم تجاوزوا فيه طروحات اللغويين الصوت صرفية إلى دراسة مفهوم الفصاحة، ومواصفات اللفظ والكلام الفصيحين.
وإذا كانت مكونات اللفظ الصوتية هي المنطلق الرئيس للبلاغيين العرب القدماء في ذلك، فإن تصوراتهم للعنصر الخارجي المؤثر في فصاحة الوحدة المعجمية اتسمت بالتباين والتعارض أحيانا، مما كان له تأثير بيّن في استعمالها أو إهمالها، وإفراز قيود أضحت معيارا لا محيد عنه للفظ الفصيح، تمثلت في:
ـ قيود صوتية تراعي أساسا عـدم تنافر أصوات اللفظ وسهولة نطقه، وحسن وقعه الصوتي فـي الأسماع.
ـ قيـود صرفـيـة تقتضي عـدم مخالفـة القـيـاس الصرفـي الذي يحدده النسق العربي.
ـ قيود ترتبط بذوق المتلقي الذي يتفاعل مع المسموع ويرتاح لـه أو ينفر منه.
ـ قيود تداولية هي سند اللفـظ في شيـوعه وانتشاره.
وعلى الرغم من محاولاتهم الإقناع بأثر هذه القيود في تحديد الألفاظ التي يستحسنها المتكلم ويقبل عليها في استعمالاته اللغوية، والألفاظ التي ينفر منها ويهملها، إلا أن تفسيراتهم اصطدمت ببعض الحالات التي تخرق تلك القيود. ومما يؤكد ذلك شيوع ألفاظ عديدة في المتن العربي شعرا ونثرا لا تتوفر فيها شروط الفصاحة، وانحسار أخرى فصيحة لتصبح من المهمل، ومحصورة في المعاجم العربية. وهذا يحيل على كون القوانين اللغوية المعيارية لا تصمد دائما أمام الجماعة اللسانية التي هي مصدر اللغة؛ إذ فيها تعرف هذه اللغة تطورات وتخضع قوانينها لتعديلات تجعلها ملائمة للنسق اللغوي الجديد.
ولم تقتصر العناية بالتنافر الصوتي واللفظ الفصيح على البلاغيين القدماء فحسب، وإنما امتدت إلى بعض المحدثين الذين لم يستسيغوا تفسيراتهم وتعليلاتهم، مما دفعهم إلى انتقادها، والتأكيد على أن الغاية التعبيرية تقتضي اعتماد اللفظ الذي يحتضن المدلول مع استيفاء المعنى، حتى وإن اجتمعت فيه تلك الأصوات التي تبدو في ظاهرها متنافرة، بينما هي في بعدها الدلالي ليست كذلك.
وعموما تبقى الجهود التي بذلها البلاغيون العرب القدماء في تحديد اللفظ الفصيح وقيوده أثرت الدرس البلاغي، وفرضت انتقاء اللفظ المتداول، والارتقاء بالكلام العربي، ومنحه جمالية ظلت ترصعه. ولكن ذلك لا يمنعنا من القول بأن تفسيراتهم بقيت في شموليتها وصفية بعيدة عن التحليل العلمي الدقيق، وطغى عليها المنحى التأثري؛ لأن اللفظ الفصيح أكبر من أن يستجيب لتلك القيود التي وضعوها له، باعتباره وحدة معجمية مشكلة من أصوات، وتحكمها ضوابط صرفية، وعناصر خارجية متداخلة فيما بينها؛ تتمثل في المتكلم والسامع، والتركيب، وهي مجتمعة تشكل سياقا شموليا هو المؤثر الفعلي في تصورنا في عملية إنتاج اللفظ وفصاحته.
المراجع المعتمدة
ـ القرآن الكريم برواية ورش.
ـ إبراهيم، عبد الله مصطفى، نظرية السياق السببي في المعجم العربي، مؤسسة اليمامة، الرياض، السنة 2005م.
ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعـر، الموقع على الإنترنيت: http://www.al-mostafa.com
ـ أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية 1952م.
ـ تمام، حسان، الأصول، دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1401هـ ـ 1981م.
ـ الجرجاني، الشريف، التعريفات، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمية، الطبعة الأولى 1306هـ..
ـ الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1402هـ 1989م.
ـ ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، اعتنى به هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1428هـ ـ 2007م.
ـ الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ج1، مطبعة الهادي، بيروت، 1989م.
ـ راضي، عبد الحكيم، الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ، مكتبة الآداب ـ القاهرة، الطبعة الثالثة 2006م.
ـ زغلول، سلام محمد، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2002م.
ـ ابن سنان، الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ت).
ـ السيوطي، جلال الدين، المزهرفي علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد عبد الرحيم. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى (1425هـ 1426هـ) ـ 2005م.
ـ ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
ـ العسكري، أبو هلال ، كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر، الموقع على الإنترنيت: http://www.al-mostafa.com
ـ العلوي، الحسيني الطالب، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي: المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الأولى 1423هـ 2002م.
ـ القرطاجني، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، التاريخ الدار العربية للكتاب، تونس، الطبعة الثالثة 2008م.
ـ القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ ـ 2003م.
ـ قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، الطبعة الشرعية السادسة عشرة 1423هـ ـ 2002م.
ـ المراغي، أحمد مصطفى، علوم البلاغة، المكتبة المحمودية التجارية، الطبعة الخامسة، (د ت).
ـ ابن منظور، لسان العرب، طبعة صادر، الطبعة الثالثة 1414هـ ـ 1994م.
ـ أبو موسى، محمد محمد، خصائص التراكيب، الناشر مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة 1416هـ ـ 1996م.
[1]ـ الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ ، (ص ص: 102 ـ 101).
[3]ـ ينظر على سبيل التمثيل: القزويني (ت: 739ه)، الإيضاح في علوم البلاغة، (ص ص 13ـ 19). والشريف الجرجاني (ت: 816ه)، التعريفات، ص 72.
(يذهبان إلى أن الفصاحة في اللفظ خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القِياس، وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات مع فصاحتها، وفي المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فَصِيح).
[4]ـ كتاب الصناعتين، ص: 7.
[5]ـ سر الفصاحة، ص: 29.
[6]ـ المثل السائر، ص: 38.
[9]ـ المثل السائر، ص: 41.
[10]ـ المرجع نفسه، ص: 40.
[11]ـ تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص: 24.
[12]ـ المثل السائر، ص: 39.
[13]ـ عن السيوطي، المزهر، ج1، ص: 199.
[14]ـ دلائل الإعجاز، ص: 48.
[15]ـ المرجع نفسه، ص: 44.
[16]ـ المرجع نفسه، ص: 46.
[26]ـ سر الفصاحة، ص: 32.
[31]ـ المرجع نفسه، ص:87.
[32]ـ المرجع نفسه، ص:87.
[47]ـ الطراز، ج1، ص: 58.
[48]ـ المثل السائر،ج1، ص ص: 181 ـ 182.
[49]ـ المرجع نفسه، ص ص: 181 ـ 182.
[50]ـ المراد بمخالفة القياس “كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب”.
[51]ـ يورد السيوطي قول الخطيبي في “شرح التلخيص” في أن مخالفة القياس لدليل لا تخرج اللفظ من الفصاحة كما في سُرُر، وأن قياس سرير هو أن يجمع على أفعلة وفُعْلان، مثل أرغفة ورُغفان. المزهر، ص: 158.
[52] ـ المرجع نفسه، ص: 158.
[53]ـ ذكر السيوطي (المزهر، ص: 158) أن الخطيبي ذهب إلى أن اللفظ المخالف للقياس الصرفي يعد فصيحا إذا كثر استعماله وورد في القرآن الكريم.
[55]ـ علوم البلاغة، ص: 19.
[56]ـ المرجع نفسه، ص:41.
[58]ـ علوم البلاغة، ص: 19.
[60]ـ سر الفصاحة، ص: 41.
[61]ـ المثل السائر: 3.
[62]ـ المقدمة، ص: 599.
[63]ـ المرجع نفسه، ص: 600.
[64]ـ المرجع نفسه، ص: 599.
[65]ـ المزهر، ص: 165ـ 166.
[66]ـ سورة آل عمران، الآية 190، وسورة يوسف، الآية 111.
[67]ـ سورة الحاقة، الآية 17.
[68]ـ رجا البئر: الناحية من البئر.
[69]ـ الإيضاح، ص: 15.
[70]ـ المزهر، ص: 156.
[71]ـ المثل السائر، ص: 417.
[72]ـ المزهر، ص: 174.