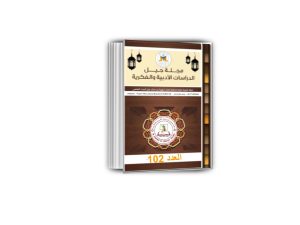جدلية السرقات والتناص: العقد أنموذجا
Dialectical of thefts and the Intetextuality : the al-akked a modle
د/ فريدة مقلاتي جامعة خنشلة – الجزائر-
Dr/Meguellati farida- University, of Abbes Laghrour Khenchela – Algeria
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 50 الصفحة 117.
الملخص:
يتميز النص الإبداعي بالانفتاح وتعدد المعاني؛ لأنه لم ينشأ من فراغ، بل هو نسيج من نصوص أخرى تنتمي إلى ثقافة متعددة تشربها النص بطريقة معينة، وبذلك فكل نص هو امتصاص، وتحويل، وإعادة لعدد من النصوص الأخرى، وهذا يعني أن النص ليس تشكيلا مغلقا أو نهائيا، بل يتضمن نصوصا سابقة، وبذلك فقد تأسس على قاعدة التفاعل مع غيره من النصوص، وهذا ما أقر به النقاد المعاصرون، ولكن الشعراء والنقاد القدماء بدورهم قد تفطنوا إلى وجود نصوص سابقة على النص المنجز، وتجلى ذلك من خلال طرحهم لقضية السرقات، وإن كانت نظرتهم إلى هذه القضية نظرة جزئية، وبذلك فقد استخدموا مصطلح السرقة للدلالة على هذا التفاعل، ربما هذا يعود لخفاء وتستر العملية – سرِقَ الشَّيْءُ: خَفِيَ ، بَقِيَ مُسْتَتِراً- ولكنهم استخدموا أيضا مصطلحات أخرى للدلالة على هذا التفاعل منها العقد (نظم المنثور).
الكلمات المفتاحية: العقد (نظم المنثور)، التناص، السرقة، التفاعل، النقاد المعاصرون، النقاد القدماء.
Abstract
Creative text is characterized by openness and multiple meanings, because it is not created in a void. It is a text from other texts that belong to a different culture that the text absorbed it in some way, so that each text is an absorption, conversion, and repetition of a number of other texts. This means that the text is not a closed or final formation, but it was established on the base of interaction with other texts. It is what contemporary critics have acknowledged, but the poets and ancient critics in turn have noticed, as the existence of earlier texts on the text accomplished, and this was manifested through the introduction of the issue of thefts, and since that their view of this issue was partial, so they used the term theft. This is probably due to the hiding and concealment of the process – the object was stolen: hidden, remained unseen- but they also used other terms to denote this interaction, including the al-akked, that is the versification of the prosaic, which reflects the process of interaction between the prose and verse clearly.
key words: the al-akked -Intetextuality, robbery, interaction, contemporary critics, ancient critics.
توطئة:أقر بعض النقاد المعاصرين أن قضية التفاعل بين النصوص قد وعاها الشعراء والنقاد منذ القديم، وقد عمدوا إلى إبراز مواطن التفاعل، ومظاهر التشابه باعتبار أن المعنى يمكن أداؤه بأشكال تعبيرية متباينة إلا أن وَقْع المصطلح الذي استخدموه على السمع جعل بعضهم يستخدم مصطلحات أخرى للدلالة على هذا التفاعل والتعالق، وتجاوزا لمصطلح السرقة المنفر، ومن هذه المصطلحات نجد مصطلح ” العقد”، إذ هناك من يرى أن الشعر رسائل معقودة، والرسائل شعر محلول، وقد عده القدماء من أَجَلِّ السرقات حسب تعبيرهم، وهو أيضا من المصطلحات التي أدخلها النقاد المعاصرون ضمن التفاعلية النصية، وبذلك فهذه الدراسة ستنطلق من مجموعة من التساؤلات منها : ما هو العقد؟ وكيف نظر إليه النقاد القدماء؟ وهل يمكن لهذا الأسلوب هضم النصوص وتذويبها وتوظيفها في نص جديد؟ وما مدى وعي الشعراء القدماء أثناء قراءتهم للنص الغائب واستدعائه في نصوصهم الجديدة بواسطة هذه التقنية؟
1– العقد: هو مصطلح بلاغي نقدي، وقد ورد في المعجم المفصل في علوم البلاغة أن« العقد ضد الحل؛ لأن العقد نظم المنثور، والحل نثر المنظوم»([1])، وذكر “ابن حجة الحموي” ( 837هـ) في كتابه “خزانة الأدب وغاية الأرب” أن « العقد ضد الحل؛ لأن ” العقد” نظم المنثور، و”الحل” نثر المنظوم، ومن شرائط العقد أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعر، ومتى أخذ بعض معنى المنقول دون لفظه كان ذلك نوعا من أنواع السرقات، ولا يسمى عقدا إلا إذا أخذ الناظم المنثور برمته، وإن غير منه طريقا من الطرق التي قدمناها كان المتبقي منه أكثر من المغير بحيث يعرف من البقية صورة الجميع»([2]) .
بيَّن “الحموي” أن الشاعر إذا أخذ اللفظ كله أو معظمه، فيزيد فيه أو ينقص ليستقيم له الوزن الشعري، فهذا يعد سرقة، أما إذا أخذ المنثور برمته، أو كان المتبقي أكثر من المغير فهذا يعد عقدا؛ أي الناظم يحافظ على صورة المقصدية الأصلية للكلام المنثور، وهذا يعني أن الناظم إذا أخذ المنثور معنى ولفظا؛ أي بما يناسب القصد الذي يسعى إلى تحقيقه وعمل على حسن تأليفه وجودة تركيبه، وكمال حليته فإنه بذلك يحقق إضافة جديدة إلى نصه؛ أي يحقق تفاعلية نصية بطريقة جلية مع غيره من النصوص، وهذا ما أقر به “جيرار جنيت” عندما تحدث عن البيونصية.
وهذا يعني أن العقد هو أخذ المنثور، ونظمه لذلك قيل أن« …الشعرُ رسائل معقودة والرسائل شعر محلول»([3])، وعرفه أيضا “عبد الغني النابلسي” في كتابه “نفحات الأزهار في نسمات الأسحار” بقوله:«هو أن يؤخذ المنثور من قرآن أو حديث أو حكمة أو غير ذلك، بجملة لفظه أو بمعظمه، فيزيد الناظم فيه أو ينقص ليدخل في وزن الشعر، فالنثر الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد على أي طريق كان إذ لا دخل فيه للاقتباس، وإن كان قرآنا أو حديثا فإنما يكون عقدا إذا غُيِّر تغييرا كثيرا لا يتحمل مثله في الاقتباس، أو لم يغير تغييرا كثيرا ولكن أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث وحينئذ لا يكون على طريق الاقتباس»([4]). نعاين من خلال هذا التعريف أن عبد “الغني النابلسي” لم يعده نوعا من أنواع السرقة، كما فرق بين الاقتباس والعقد، حيث بيّن أن النثر الذي قصد الناظم عقده إن كان في غير القرآن والحديث فهو عقد، أما إذا كان المنثور المأخوذ قرآنا أو حديثا فهو اقتباس، وليس عقدا، إلا إذا أدخل الناظم تغييرا كبيرا على النثر المأخوذ من القرآن والحديث، وأشار إلى ذلك فهذا لا يكون على طريق الاقتباس.
ونستشف مما سبق أن الشاعر إذا أخذ المعنى المنقول دون لفظه كان ذلك نوعا من أنواع السرقات، أما إذا أخذه لفظا ومعنى فذلك هو العقد، أي القارئ عندما يقرأ النص يشعر بالعلاقة التي تربط النص الجديد برؤى ومكونات أخرى لها السمات الرئيسة نفسها، فالعلاقة تكون واضحة بين النص، والنص المعقود، ونلاحظ أيضا أنهم أخرجوا العقد من باب السرقة ولكن بشروط، وإن خالف الشاعر هذه الشروط، فعقده ينضوي تحت باب السرقات، باستثناء عبد الغني النابلسي الذي لم يدخله تحت هذا الباب سواء زاد الناظم في الكلام المعقود أو أنقص ليدخله في وزن الشعر.
2- تجليات المصطلح عند النقاد القدماء:
ورد هذا المصطلح عند العديد من النقاد حيث طرحوه أثناء حديثهم عن قضية السرقات، ومن بينهم “الحاتمي” (388هـ) الذي أورده في كتابه “حلية المحاضرة” (نظم المنثور)، حيث يقول:« …ومن الشعراء المطبوعين طائفة تخفي السرق، وتلبسه اعتمادا على منثور الكلام دون منظومه، واستراقا للألفاظ الموجزة، والفقر الشريفة، والمواعظ الواقعة، والخطب البارعة»([5]) ونلاحظ أن الحاتمي قد عده آلية لإخفاء السرق، كما عده سمة للمطبوعين، وهذا الخفاء يقابله قارئ متميز وعارف، حتى يدرك هذا العقد، وبخاصة إذا صدر عن شاعر مطبوع غير متكلف، كما ذكر أنواع المنثور الذي قد يعمد الناظم إلى عقده، ولكنه على الرغم من نعته لهذا النمط بالسرق، إلا أنه في بعض النماذج يستخدم بعض المصطلحات التي توحي باستساغه لهذا التفاعل بين النصوص، ويتجلى ذلك من خلال تعليقه على بعض نماذج “نظم المنثور” نحو قوله: « ومن بديع التشبيه قول العباس بن الأحنف:
أُحْرَمُ منكم بِما أقول وقد *** نال به العاشقون مَنْ عَشِقُوا
حتى كأني ذُبـالةٌ نُصِبَتْ *** تُضِئُ للنـاس وهي تحترق
وإنما انتظم به قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه” أنا لكم ذبالة تضئ وتحترق”»([6]) . نعاين من خلال تعليقه أنه معجب بهذا المعنى الذي جاء به” العباس بن الأحنف” فعبر عن إعجابه بقوله:”بديع التشبيه” فامتصاص هذه الفكرة معنى ولفظا، وصياغة نص جديد يدل على طبع وحذق الشاعر الذي حقق له التميز والتفرد، وقد اعترف بهذا التميز الرياشي عندما سمع هذين البيتين، فقال:« والله لو لم يقل من الشعر إلا هذين البيتين لكفيا»([7]) ، فهذا المعنى الذي عقده الأحنف منبثق عن نص آخر .
كما استحسن أيضا نظم “صالح بن عبد القدوس” لقول أرسطاطاليس، حيث يقول:« يقال أنه لما مات الاسكندر نَدَبَهُ أرسطاطاليس فقال” طال ما كان هذا الشخص واعظا بليغا، وما وعظ بكلامه موعظة قط أبلغ من موعظته بسكوته” فنظم هذا المعنى صالح بن عبد القدوس وبسط لفظه، فقال وأحسن:
وَيُنَادُونَه وقَـدْ صُمّ عَنهـم *** ثـُمَّ قـالوا: وللنساءِ نحيب
مَا الذي عَاقَ أن تَردّ جوابا *** أَيَّهُـا المِقْـوَلُ الألـد اللبيبُ
إن تَكن لا تطيقُ رجع جواب *** فيها قدْ نــَرَى وأنت مطيبُ
ذُو عِظاتٍ وما وعظْتَ بشَيء *** مثلَ وعظ السُكوت إذ لا تُجِيبُ»([8])
نعاين من خلال هذا التعليق أن “الحاتمي” أشار إلى هذا الأخذ الذي تم على مستوى اللفظ والمعنى، وقد استحسنه، وذلك لقدرة الشاعر على نظم هذا المعنى وبسط لفظه، وكأن هذا الأمر لا يتأتى إلا للحاذق والمطبوع، والذي يحتاج في المقابل إلى متلق مزود بالثقافة لتحقيق عملية التواصل.
وقد أشار “أبو هلال العسكري”(395هـ) إلى هذا المصطلح، وذلك من خلال حديثه عن أسباب إخفاء السَّرَق، وذلك بقوله:« والحاذق يخفي دبيبه إلى المعنى يأخذه في سُترة فيَحكم له بالسبق إليه أكثر من يمر به، وأحد أسباب إخفاء السرق أن يأخذ المعنى من نظم فيُورده في نثر، أو من نثر فيورده في نظم… إلا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرِّر، والكامل المقدم…»([9]). نعاين من هذا النص أن أبا هلال أيضا عدّ “نظم المحلول” سببا من أسباب إخفاء السرق، علما أن هذا الإخفاء لا يتقنه -حسب تصوره- إلا الناظم المبرز والكامل والمقدم؛ أي هناك علاقة تربط بين النص اللاحق والسابق دون أن يشير المبدع إلى ذلك، وبذلك فهذا التفاعل لا يتمكن منه إلا الناظم الحاذق العارف بأحوال النظم، وكيفية امتصاص نص سابق وتذويبه في نص لاحق، وهذا ما يجعل عملية استشفاف النصوص المذوبة والمتعالقة في نص ما عملية معقدة؛ لأن هذه العملية تتم بطريقة محبوكة تدل على حذق ومهارة الصنعة فيه، وبذلك فهي تحتاج إلى قارئ مطلع ليمسك بأطرافها ويرجعها إلى مظانها التي استقيت منها.([10])
بل وبيّن أن نظم المحلول أسهل من ابتدائه؛ لأن المعاني إذا نظمت – حسب تصوره- منثورة حاضرة بين يديك يمكن أن تنْقص منها شيئا فينتظم، أما إذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعاني غائبة عنك عندئذ تحتاج إلى فكر يحضرها([11])، وقد أدخل هذا النمط في حسن الأخذ الذي خصه بالباب السادس، والذي قسمه إلى فصلين، الأول: في حسن الأخذ، والثاني: في قبح الأخذ.
وقد أشار أيضا إلى استحالة استغناء الناظم عن تناول المعاني السابقة، وذلك بقوله:« … ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن … يزيدوا في حسن تأليفها، وجودة تركيبها … »([12]). نلاحظ أن أبا هلال يعترف بقضية التفاعل بين النص السابق واللاحق، بل لا يمكن أن يستغني القائل عما سبقه من المعاني المتجلية في النص إلا أنه يشترط دائما قضية الإجادة، والتفوق في عملية النظم .
وقد أشار ابن رشيق (456هـ) بدوره إلى “نظم المنثور” وعده من أجل السرقات، بل وقال:«فما جرى هذا المجرى لم يكن على سارقه جناح عند الحذاق…»([13]) إذن قد عد العقد بابا من السرقات، ولكن المفارقة تكمن في قوله:” أجل السرقات”. كما قال:«اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سبق إليه جهل»([14])، إذن هو أقر بضرورة تفاعل الشاعر مع المعاني السابقة، ولكن باعتدال؛ أي ضرورة الإبداع والاختراع حتى يحقق التميز والتفرد، وربما استخدم هذا المصطلح “السرقة”؛ لأن معناه الخفاء والتستر، ومادام هذا المعنى يذوب في ثنايا النص الجديد، ولا يظهر إلا للحاذق المتمرس أطلقوا عليه هذا المصطلح على الرغم من أن السمع لا يستسيغه، فهو مرتبط بخُلق سيء.
وقد تحدث الحميدي (ت 488هـ ) بدوره عن الأخذ، وعدَّه من أساليب المبدع الحذق الفطن، وبخاصة إذا انتقل المبدع بالمعنى من موضوع إلى آخر، نحو تمثل المنثور وصرفه منظوما، والعكس([15])، فهو إذن أشار إلى العقد (تمثل المنثور وصرفه منظوما). وهو لا يرى عيبا في تمثُّل المعاني، وإعادة بنائها بناءً فنيًّا جديدًا، والتمثل لا يتأتى للمبدع إلا إذا توفرت فيه بعض الشروط، وقد حددها بقوله:« أن يضرب في النحو بنصيب، ولا أقل حتى لا يقع في اللحن، ويبعد صور لفظه عن قباحة الخطأ، وأن يعرف لغة العرب، ويقف ما أمكنه من نوادر البلغاء قبله، وصفاتهم للأمور، وتصرفاتهم في المعاني، وكذا توسعهم في الألفاظ؛ لأن ذلك يقويه على إيراد المعاني وتصريف الألفاظ، وهذا يجعله إذا امتثل أمكنه باتساعه في اللغة، ومعرفته بوجوه الكلام، ووقوفه على حقائق المعاني أن يصور ما امتثله في صورة يوحي بها أنه ابتدع، ولم يمتثل، ولم يتعذر عليه أن يصور المعنى الواحد، والمثل الوارد في صور كثيرة مختلفة الألفاظ »([16]).
نلاحظ أن الحميدي أشار إلى ثقافة المبدع ودورها في تحقيق هذا العقد، ولهذا عده من الحذق، ولا يراه عيبا، بل يمكن للمبدع إذا امتلك طبعا قويا أن يحقق التميز والتفرد، وذلك بإعادة تشكيل بنية نصية جديدة ترقى من الاقتداء، والامتثال إلى حدود الاختراع.
وقد ذكره أيضا ابن أيوب البطليوسي (494هـ) في كتابه ” شرح الأشعار الستة الجاهلية”، فالعقد(نظم المنثور) عنده هو أخذ معنى الأقوال المنثورة، ونظمها شعرا، وذلك بإخراجها في صياغة فنية راقية، ومثّل لها بقول امرئ القيس:
قولا لِدودانَ عبيـدَ العَصا *** ما غَرَّكُمْ بالأَسَــدِ الباسِــلِ
فهذا المعنى حسب رأيه مأخوذ من المثل : ” العبدُ يُقِرَعُ بِالعَصَـا”.([17]) ويتجلى هذا أيضا في قول ابن مقبل في صفة القدح، إذ قال:« إذا امتحنه ممتحنٌ غدا يقدحُ ناراً قبل الإفاضة به ثقة بفوزه، وأول من نطق بهذا امرؤ القيس بقوله:
إِذَا مَا رَكِبْنَا قَالَ ولدان أهلنا *** تعالوْا إلى أن يأتي الصيدُ نحطبِ »([18]).
وقد طرح ابن السراج قضية “نظم المنثور، ونثر المنظوم” في كتابه “جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب([19])، وأقر بدوره أنها من أجل السرقات، وبذلك فهو يلتقي أيضا بهذا الرأي مع العديد من نقاد المشرق والمغرب، ومثل لهذا النمط بقول« نادِب الإسكندر: ” حَرَّكنَا المَلكُ بسُكُونِهِ”، فأخذه أبو العتاهية، فقال:
قَدْ لَعَمْري حَكَيْتَ لي غُصَصَ المَوْ *** تِ وَحَرَكَّتْنِي لَهَا وَسَكَنْتــا»([20]).
وقد أشار ابن “خيرة المواعيني” أيضا إلى هذا النمط ونعته بـ “سرقة الشعر من النثر” وقد أورد كثيرا مما يسمى في نظم المنثور (العقد)، ومن ذلك إشارته إلى أخذ المتنبي من أرسطوطاليس حكيم العجم فنظمه أحسن نظم.([21]) وقد مثل لها أيضا بقول الماوردي:
يَا فَاخِرًا للسَّفاهِ بِالسَّـلَفِ *** وَتَــارِكًا لِلْـعَــلَاءِ وَالشـَّرَفِ
آباءُ أَجْسَـادِنَا هُـمُ سَبَبٌ *** لأنْ جُعِلْنـَا عَوَارِضَ التَّــلَفِ
مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ كَانَ خَيْرَ أَبٍ *** ذَاك أَبُو الرُّوحِ لا أبــو النُّـطَفِ
فهذه الأبيات تدخل -حسب تصوره- في إطار نظم المنثــور؛ لأنها مأخوذة من قول الإسكندر حينما« قيل له ما بال تعظيمك لمعلمك أشد من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي سبب حياتي الفانية، ومعلمي سبب حياتي الباقية »([22])، ونعاين مما سبق أن جل النقاد في القرنين الرابع والخامس الهجريين قد أشاروا إلى الدلالة العامة لهذا المصطلح، والشاعر حتى وإن أخذ اللفظ والمعنى معا فهذا الأسلوب الذي يدخل في إطار نظم المحلول (العقد) فقد عدوه نمطا من أنماط السرقة، على الرغم من أن بعض النقاد لا يرون عيبا في تمثُّل المعاني، وإعادة بنائها بناءً فنيا جديدا؛ لأن هذا يحقق التميز والتفرد للمبدع، ولكن في القرن السادس الهجري نجد “أسامة بن منقذ” (584هـ) قد استخدم مصطلح “العقد” في كتابه ” البديع في نقد الشعر”، وعرفه بقوله:«…هو أن يأخذ لفظا منثورا فينظمه…مثل قول الرشيد: ولو جمد الخمر لكان ذهبا، أو ذاب الذهب لكان خمرا فنظمه غيره فقال:
وَزَنَّا لها ذهبا جامـدا *** لكـالتْ لنا ذهبـا سائلاً…
وقال عبد الله بن الزبير لما قُتل مصعبٌ أخوه: إن التسليم والسلوةَ لحزماءِ الرجال، وإن الهلع والجزع لِرَبَّات الحِجَالِ، عقده أبو تمام فقال:
خُلقنا رجالاً للتجلًّدِ والأَسَى *** وتلكَ الغوانِي للبُكا والمَآتِمِ»([23]).
وغيرها من الأمثلة التي أوردها، وحاول من خلالها توضيح عملية العقد (نظم المنثور)، دون أن يدخله في باب السرقات، كما أنه خلال تعليقاته لم يستخدم ملفوظ السرقة قط، بل كان يذكر النص المنثور، ثم يقول وعقده الشاعر بقوله.
كما قدم “ابن أبي الأصبع” (ت 654هـ) تعريفا اصطلاحيا للعقد في كتابه ” تحرير التحبير”، حيث يقول:« هو ضد الحل؛ لأنه عقد النثر شعرا، ومن شرائطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه فيزيد فيه أو ينقص منه أو يحرف بعض كلماته ليدخل به في وزن من أوزان الشعر …ولا يسمى عقد إلا إذا أخذ المنثور برمته، وإن غير منه بطريق من الطـرق…كان المُبَقى منـه أكثر من المغيَّر بحيث يعرفُ من البقية صورة الجميع »([24]) فالعقد عنده هو أخذ الشاعر المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه، وأن يبقى ما يدل على صورة المعنى.
وأورد هذا المصطلح أيضا “الخطيب القزويني” (739هـ) في كتابه” الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع”، حيث عرفه بقوله: « هو أَنْ يُنْظَمَ نَثْرٌ لاَ عَلَى طرِيقِ الاقْتِبَاسِ»([25])؛ كقول أبي العتاهية:([26]) مَا بَالُ منْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ***وَجِيْفَةٌ آخِرُهُ يَفْخَرُ
يرى القزويني أنه عقد قول علي رضي الله عنه: وَمَا لابْـــنِ آدَمَ وَالفَخْرَ، وَإنما أَوَّلُه نطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِيْفَةٌ.([27] ). كما أورد أمثلة عن عقد القرآن، والحديث، والأمثال، وأقوال بعض الحكماء .
وهذا ما أقر به أيضا “سعد الدين التفتازاني” (792هـ) بقوله:« [العقد فهو أن ينظم النثر]قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس، وقد عرفت الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه…»([28]). أي لابد من التغيير الكبير حتى يدخل في العقد لا في الاقتباس، وألف “السيوطي” (911هـ)بدوره كتـابا وسمه بـ “الأزدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار “، وصرح بأنه جمع فيه الأشعار التي عُقد فيها شيء من الأحاديث والآثار، وله فوائد: منها الاستدلال به على شهرة الحديث وصحته في الصدر الأول، ومنها الاستشهاد به في فن البديع: في أنواع العقد والاقتباس والانسجا.([29])، ومن الأمثلة التي أوردها قوله:«…حدثنا يزيد بن زريع، قال: رأيت أبا نواس عند روح ابن القاسم، فتحدث روح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال يزيد: فقال أبو نواس: أنت لا تأنس بي،
وسأجعل هذا الحديث منظوما بشعر. قلت: فإن قلت ذلك فجئني به، فجاءني فأنشدني:
يَا قلب رِفقاً أَجَدا مِنْكَ ذا الكلــف *** ومن كلفت به جافَ كمَا تَصفُ
وَكانَ في الحق أن يَهْوَاكَ مُجتهدا *** بذاك خبر منـا الغابر السلـف
إنَّ القــلوبَ لأجنــادٌ مجندةٌ *** لله في الأرض بالأهـواء تعترفُ
فمـا تناكر منها فهــو مختلف *** وما تعارفَ مِنْهَا فَهُوَ مُؤْتَلِفُ ».([30])
نعاين أن أبا نواس امتص النص الغائب المنثور وعقده؛ أي حوله إلى نص شعري، مع المحافظة على معنى النص الغائب، وعلى ألفاظه.
ونلاحظ أنه مع بداية القرن السادس اتخذ هذا المصطلح منحى آخر، حيث نظر إليه النقاد والبلاغيون نظرة إيجابية أخرجته باب السرقات، بل هناك من وسم كتبه بهذا المصطلح، وقد اتضح لنا من خلال هذا الطرح أن الشاعر قد يعمد إلى استخدام بعض الآليات التي تمكنه من إقامة علاقات تفاعلية مع نصوص أخرى، وفي الوقت نفسه تبعده عن مذمة السرقة، وتمكنه من التفاعل الإيجابي مع نماذجه الفنية السابقة عبر تحقيق الاختلاف المبدع معها([31]).
كما نستشف مما سبق أن الناقد القديم قد كان على وعي ودراية بحقيقة التفاعل بين النصوص، أو أخذ اللاحق عن السابق، وبذلك ينفي وجود نص مستقل بذاته، وبمعزل عن غيره من النصوص، وإن كان طرحهم لهذه القضية يختلف عن طرح النقاد المعاصرين، فكل ناقد عالجها حسب ظروف عصره.
ومهما كان فإن هذا الفهم يعكس مدى وعيهم بحقيقة التداخل والتساوق داخل النص الواحد، لذا عملوا على تجلية مكنوناته الداخلية وإبراز طبيعة هذا التفاعل، حتى وإن تتبعوا مصدر هذا المعنى المذوب في النص الجديد، فهذا إنما يدل على رغبتهم في معرفة مدى توفيقه -المعنى- في موضعه الجديد الذي وضع فيه، ومدى نجاح الشاعر واستفادته منه في صياغة نص جديد يعبر عن معان وأفكار تناسب عصره([32])، وإن كانوا في تلك الحقبة اهتموا بالتفاعل الخاص الجزئي بين النصوص، ولم يهتموا بالتفاعل العام الكلي بينها، أي التفاعل النصي بأنواعه وأشكاله مثل ما نعرفه اليوم من مناص، وتناص، وميتانص([33])وبذلك فهمهم يلتقي، ولو جزئيا مع طبيعة التناص الأدبي من حيث هو « تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة، شعرا أو نثرا مع النص الأصلي. بحيث تكون منسجمة ومتسقة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يقدمها أو يعلنها المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويتحدث عنها»([34]).
وقد أشار ابن سلام الجمحي (232هـ) إلى مفهوم التداخل بين النصوص حينما تحدث عن الدربة؛ أي الخبرة وضرورتها في حياة المبدع، ويعني بذلك أن المبدع بعد إطلاعه وقراءاته، أو سماعه لنصوص عدة، واستيعابها ينتقل إلى مرحلة إبداع نصوص جديدة نتيجة للدربة التي ملكها طيلة فترة تحصيله وتعايشه مع النصوص الأخرى.([35]) وقد تجلى مثلا هذا في استئذان “أبي نواس” لخلف الأحمر في نظم الشعر فطلب منه أن يحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة، فلما حفظهـا أمره بنسيانها، وبعد نسيانها قال له: الآن اُنظم الشعر.([36]).
وهذا ما ذكره أيضا ابن رشيق في كتابه ” قراضة الذهب” بقوله:« يمر الشعر بمسمعي الشاعر لغيره فيدور في رأسه أو يأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديما…»([37])، وقد حدد “ابن خلدون” بدوره نوعية المحفوظ بقوله:«وعلى قدر جودة المحفوظ …وكثرته…تكون جودة الملَكَةِ الحاصلةِ عنه للحافظ…وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال بعده…فبارتقاء المحفوظ … ترتقي الملكة الحاصلة؛ لأن الطبع ينسج على منوالها وتنمو قوى الملكة بتغذيتها …»([38])، كما أشار إلى ضرورة نسيان ذلك المحفوظ وطمس رسومه الحرفية الظاهرة.([39])
وهذا يعني أن مخزون الشاعر له أهمية كبرى في عملية التفاعل، وهذا ما أشار إليه أيضا بعض النقاد المعاصرين نحو “رولان بارت” (Roland Barthes)حينما بيّن أن التناص يمتحُ من مخزونين اثنين أحدهما مخزون المؤلف الثقافي الذي يبدع النص([40])، وهذا يدل على أن الكتابة لا تأتي طفرة واحدة، بل لابد من مخزون ثقافي، ومعرفي يستغله المبدع في صياغة نصوص جديدة حسب السياق الذي يريده، ونسيان المحفوظ قد طرحه نقاد الغرب مثل “رولان بارت” وسماه “تضمينات من غير تنصيص”، وعليه فحفظ النصوص ثم نسيانها هي أساس فكرة التناصية عند هؤلاء فهي تلازم كل مبدع، وهذا يعني أن المخزون من النصوص المقروءة أو المحفوظة المنسية هو الذي يتحكم غالبا في صنعة النص المكتوب، وبهذا فإن فكرة التناص قد وردت عند النقاد القدماء وتجلت في مظهرين: الأول وهو أن النصوص تتوالد من بعضها البعض، والثاني: التكرار وهو إعادة نماذج ونصوص أصلية وتكرارها من طرف الشعراء والكتاب.([41])
وعليه فعملية ” العقد”؛ أي نظم المنثور عند الشاعر تتم بطريقة واعية يعني أن الشاعر قد يقصد إليها قصدا للاستفادة من النص المنثور المحفوظ أو المقروء، وبخاصة أن بعض النقاد قد عدوه آلية لإخفاء الأخذ، وبينوا أن هذا النمط لا يتقنه إلا المطبوع الحاذق، فيعتمد على مخزونه من النصوص المقروءة والمحفوظة، ويعيد عقدها بما يتناسب والمقصدية التي يسعى إلى تحقيقها من خلال نصه الجديد؛ أي أنه يصور ما امتثله في صورة فنية توحي بالابتداع، وقد عمد الشعراء القدماء إلى تفعيل هذه الآلية لبعث نصوص جديدة فهذا محمود الوراق سمع قول القاسم بن محمد ” أبونا آدم أخرج من الجنة بذنب واحد ” فعقده بقوله:([42])
تَصِلُ الذنوبَ إلى الذنوبِ وترتجي*** دركَ الجنانِ بها وفوز العابد
ونسيتَ أنَّ الله أخـرج آدمـا *** منها إلى الدنيا بذنب واحد
قد سمع الشاعر قول “القاسم بن محمد” وعمد مباشرة إلى عقده، ولكن بعد أن حدد المعنى الذي يريد، والوزن فأخرجه نظما صحيحا، وبذلك فقد امتص القول معنى ولفظا، وحضر النص حضورا مباشرا في قول هذا الشاعر، وهذا ما أقر به بعض نقاد الغرب وبخاصة جيرار جنيت (G. Genette،) الذي اهتم بالنص من رؤية تعاليه النصي: أيّ معرفة كل ما يجعله في علاقة خفية أو جلية مع غيره من النصوص.([43])وعليه فالحضور المباشر لنص من النصوص في نص آخر يدخل في إطار البيونصية (التناص)، وبخاصة أن “جيرار” ذكر خمسة أنماط للتعددية النصية([44])، وكل نمط بين فيه طبيعة العلاقة التي تربط النص بنص آخر. ومن الشعراء الذين استعانوا بهذه الآلية لنظم الشعر المعري، وقد تجلى “العقد” في بعض أشعاره منها قوله:([45])
لَعِبَتَ بسحرنَا والشِّعْرُ سِحرٌ *** فَتُبْنَا منه توبَتَنا النَّصُوحا
فقد ورد معنى الشاعر متآلفا ومتطابقا لفظا ومعنى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «… وإن من البيان لسحرا»([46])، وعليه فالشاعر قد استثمر النص الشريف ليجسد المعنى الذي أراده.
وقول المعري أيضا:([47]) رَوِّح ذَبيحكَ لا تُعْجِلْهُ مِيتَتَهُ*** فَتَاْخذَ النَّحْضَ منهُ وهوَ يَخْتَلجُ
نستشف من هذا القول أن الشاعر قد استند إلى نص الحديث النبوي الشريف ممثلا بقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحدَّ أحدكم شفرته، فليُرح ذبيحته»([48]). إن الشاعر تفاعل لفظا ومعنى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فملفوظات النص الشعري (روح، ذبيحك)، تتعالق وتتآلف مع ملفوظات حديث الرسول (ليرح، ذبيحته)، ونلاحظ أن الشاعر استخدم ملفوظ “رَوّح” ليدل به على معاني الراحة والرحمة، وغيرها من النصوص الشعرية عند المعري التي تجلت فيها آلية العقد لصياغة نص جديد منفتح، انطلاقا من النص الغائب، وعقد ابن الرومي أيضا قول عبد الملك ( إن كان الحقد لقاء الخير والشر فهما باقيان في صدري فإنه خزانة تحفظ ما استودعت من خير وشر)([49]) بقوله:([50])
لئن كنت في حفظي لما أنا مودعٌ *** من الخير والشر انتحيتُ على عرضِي
لما عبتني إلا بما ليـس عائبي *** وكم جاهل يُزْرِي على خلق محض
وما الحقدُ إلا توأم الشكر في الفتى***وبعضُ السجايـا ينتسبنَ إلى بعـــض
فحيث ترى حقداً عـلى إساءة *** فثمَّ لها شُكــرا على حَسنِ القـرض
استطاع ابن الرومي أن يستوعب مضمون ودلالة قول “عبد الملك” وأن يوظفها في نصه توظيفا فنيا، وهذا ينم عن توظيفه لآلية العقد، التي تعمل على امتصاص النص النثري وتحويله إلى نص شعري جديد ذي أبعاد دلالية وتعبيرية، فهو قد عكس من خلال نصه الجديد طبيعة النفس البشرية، فالشر والخير عند ابن الرومي، لصيقان بالإنسان، ولكن يبقى الخير هو الجوهر في صدر الإنسان، أما الشر فهو العرض .
وقد تجلت هذه الآلية عند الشعراء القدماء بشكل كبير، فلا يخلو شعر شاعر من العقد، وهذا يعني أن الشاعر قد عمد إلى توظيف هذه الآلية توظيفا إبداعيا، وبخاصة أن النقاد القدماء يصرون على ضرورة اختلاف النص اللاحق عن النص السابق، فهذا الاختلاف شرط لتحقيق الإبداع؛ لذلك نجد النقاد دائما يقترحون بعض الآليات على الشعراء لتمكنهم من التفاعل الإيجابي مع النصوص الممتصة والمذابة في نصوصهم ليتمكنوا بذلك من تحقيق الاختلاف والمغايرة.([51])
وعليه قد أدخل النقاد القدماء في بداية الأمر مصطلح العقد في باب السرقات، ولكن السرقات الجليلة حسب تصورهم، ولكن مع مرور الوقت هناك من أخرج العقد من باب السرقات نحو: أسامة بن منقذ، والقزويني والسيوطي وغيرهم، وهذا يعني أن النقاد القدماء قد أقروا بقضية التفاعل بين النصوص، وعملوا على تحديد بعض الآليات لامتصاصها، وتذويبها لخلق نص جديد، ولكن نظرتهم تبقى جزئية، على الرغم من فهمهم لخصوصية الظاهرة النصية.
أما بالنسبة للنقاد المعاصرين الذين اهتموا بموضوع السرقات في القديم نجد “مصطفى هدارة” الذي لم يكن له في دراسة هذا النوع ” العقد” من جهد سوى الإشارة إليه أثناء تتبعه للمؤلفات، والنقاد الذين درسوا قضية السرقات في مصنفاتهم، أما “صبري حافظ” الذي يعد رائد الدارسات العربية الحديثة في “التناص”، ويعد أول من تبنى مشروعا عربيا للتناص منبثقا من النقد العربي القديم وإنجازات علم البديع([52]) فإنه لم يدرج “العقد” ضمن المصطلحات العديدة التي ذكرها في مقاله المنشور في مجلة “ألف”، وقد ذكره كل من “بدوي طبانة” في “معجم اللغة العربية”([53])، و”أحمد مطلوب” في “معجم المصطلحات البلاغية وتطورها”([54]) ونجد “نهلة فيصل الأحمد” التي أخرجت “العقد” من باب السرقات إلى التناصية، حيث قسمت المصطلحات التي عرفت عند النقاد القدماء إلى قسمين، قسم المصطلحات التي لا تنتمي إلى عملية التفاعل النصي، وقسم المصطلحات التي تنتمي إلى عملية التفاعل النصي.([55]) وبذلك فالعقد مصطلح يدل على امتصاص النص الغائب، وتحويله إلى نص شعري يخدم مقصدية المبدع، ولكن دائما بطريقة فنية توحي بالإبداع، وهذا يدل على التفاعل النصي، وهو بذلك يلتقي مع مصطلح التناص الذي يعني بدوره التفاعل بين النصوص.
الخاتمة:
– يعد العقد صورة مطابقة في كثير من جوانبها مع البيونصية وفق النظريات الحديثة التي أقرت بعلاقة النص الخفية أو الجلية مع غيره من النصوص.
– نظر النقاد القدماء إلى العقد نظرة غير متوازنة فأحيانا يصفونه بالسرقة، وأحيانا أخرى يدخلونه ضمن السرقات الجليلة فهذه المفارقة توحي بالاضطراب الذي كان يشوب مفهومهم لهذا المصطلح بخاصة في القرنين الرابع والخامس الهجريين.
– عده النقاد القدماء آلية لإخفاء السرق، علما أن هذا الإخفاء لا يتقنه حسب تصورهم إلا الناظم المبرز والكامل والمقدم؛ أي أن هذا التفاعل لا يتمكن منه إلا الناظم الحاذق العارف بأحوال النظم، وكيفية امتصاص نص سابق وتذويبه في نص لاحق.
– إخراج مصطلح “العقد” من باب السرقات في القرن السادس عند كل أسامة بن منقذ، والقزويني، والسيوطي، وغيرهم، وهذا يعني أن النقاد القدماء قد أقروا بقضية التفاعل بين النصوص، وعملوا على تحديد بعض الآليات لامتصاصها، وتذويبها لخلق نص جديد، ولكن نظرتهم تبقى جزئية رغم ما قد يظهر في جانبها الجمالي من فهم دقيق وعميق لخصوصية الظاهرة النصية.
– التقاء النقاد القدماء والمعاصرين في قضية مخزون المؤلف الثقافي الذي يبدع النص، فهذا المخزون حسب تصورهم يستغله المبدع في صياغة نصوص جديدة حسب السياق الذي يريده، فحفظ النصوص ثم نسيانها هي أساس فكرة التناصية عند نقاد الغرب فهي تلازم كل مبدع، وهي الفكرة نفسها عند النقاد القدماء الذين أقروا بتوالد النصوص من بعضها البعض.
– تجلي هذه الآلية – العقد- عند الشعراء القدماء بشكل كبير، فلا يخلو شعر شاعر منها، وقد وظفها الشاعر توظيفا إبداعيا، وبخاصة أن النقاد القدماء يصرون على ضرورة اختلاف النص اللاحق عن النص السابق، فهذا الاختلاف شرط لتحقيق الإبداع.
– تتجلى براعة الشعراء في توظيف النص المنثور في نصوصهم الشعرية توظيفا فنيا واضحا للقارئ للتعبير عما يجيش في صدورهم من معان مختلفة ومواقف متعددة، فعقد المنثور والتقاطع معه في نص شعري جديد دلالة واضحة على براعة الشعراء وتمكنهم من هذه الآلية.
إذن يجب الاعتراف أن العقد يدخل في إطار التفاعل النصي، وبخاصة أن النقاد القدماء قد بينوا- من خلال متابعتهم لعملية تداول المعاني بين الشعراء – أن النص اللاحق بإمكانه أن يحمل في ثناياه رماد نصوص سابقة، ولكن المبدع يعيده، ويحوله إلى نصوص مناسبة للسياق الذي يريده.
* البيبليوغرافيا:
1- إبراهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحديث،ط1، إربد، 2011م.
2- أحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية: (رؤيا) لهاشم غرابية، وقصيدة (راية القلب) لإبراهيم نصر الله، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع،ط2، عمان- الأردن: 2000م.
3 – أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، مراجعة إبراهيم مصطفى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، دط، القاهرة، 1960م.
4- ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي. دط،دت.
5 -.الأصفهاني (أبو الفرج)، الأغاني،ج8، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، ط2،بيروت، دت..
6- إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة والبديع والبيان والمعاني، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت- لبنان، 1996م.
7- ابن أيوب البطليوسي (أبو بكر)، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج1-2، تحقيق ناصيف سليمان عواد، مراجعة لطفي التومي، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، ط1، بيروت، 2008م.
8- بدوي طبانة، معجم اللغة العربية، دار المنارة، ودار الرفاعي للنشر والتوزيع، ط3،جدة- الرياض: 1988.
9- الحُمَيْدِي (محمد بن أبي نصر فتوح) ، تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل، طبع بالتصوير عن مخطوطة أحمد الثالث، مكتبة طوب قابو سراى استنابول.
10-جنيت جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال، ط2، المغرب، 1986م.
11- الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن المظفر) حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج1، تحقيق جعفر الكتاني، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، سلسلة كتب التراث (82)، 1979م.
12- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه إبراهيم شمس
الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1،بيروت – لبنان، 2003م.
13- ابن خيرة المواعيني، ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب، تحقيق وتقديم مصطفى الحيا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1988-1989م.
14- ابن السراج (محمد بن عبد الملك الشنتريني الأندلسي)، جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ، ج 2،تحقيق محمد حسن قزقزان منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دط، دمشق: 2008م.
15- ابن رشيق(أبو علي الحسن)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه وفهرسه صلاح الدين الهواري، وهدى عودة، ج2، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، دط، بيروت- لبنان: 2002م .
16- ابن الرومي، الديوان،ج2، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط3،بيروت- لبنان: 2002.
17- سعيد سلام، التناص التراثي: الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، ط1، اربد- الأردن: 2010م.
18- سعيد يقطين، ” الرواية والتراث السردي”، المركز الثقافي العربي، ط1الرباط – المغرب: 1992م.
19- ابن السيد البطليوسي، شروح سقط الزند، تحقيق مصطفى السقا، وآخرون، إشراف طه حسين الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، 1986م.
20- السيوطي (جلال الدين)، الازدهار في ما عقد الشعراء من الأحاديث والآثار، تحقيق علي حسين البواب، منشورات المكتب الإسلامي، دط، بيروت:1991م.
-21عزت العطار، المتشابه في نظم النثر وحل الشعر، المطبعة العربية، دط، مصر: 1927م.
22- عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: دراسة نظرية تطبيقية، إفريقيا الشرق، دط، المغرب، 2007م.
23- عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك”، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1998م.
24- أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات، ج1، تحقيق سيدة حامد وآخرون، إشراف مراجعة حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، دت.
25 – عبد الغني النابلسي، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار: شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية، عالم الكتب، ومكتبة المتنبي، دط، بيروت- القاهرة، دت.
26- محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز العربي الثقافي، ط2، بيروت، 1990م.
27- ابن منظور المصري، أخبار أبي نواس: تاريخه، نوادره، شعره، مجونه، السفر الأول،شرحه وضبطه محمد عبد الرسول إبراهيم، وعني بنشره عباس الشربيني، دار الكتب المصرية، دط، 1924م.
28- نهلة فيصل الأحمد، التفاعل النصي: التناصية، النظرية، والمنهج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط1، القاهرة، 2010م.
29- أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل)، الصناعتين : الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ط1،صيدا-بيروت: 2006م.
30- يوسف بكار، في النقد الأدبي: جدليات ومرجعيات، عالم الكتب الحديث، ط1، إربد- الأردن: 2014م.
[1] – إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة والبديع والبيان والمعاني، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت- لبنان: 1996م، ص 603.
[2] – ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، ج4، دراسة وتحقيق كوكب دياب، دار صادر، ط2، بيروت، لبنان، 2005م، ص 421.
[3]-ابن طباطبا ، عيار الشعر، تحقيق عباس عبد الستار، مراجعة نعيم زوزو، دار الكتب العلمية ،ط1، بيروت، لبنان: 1982م. ص 81.
[4] – عبد الغني النابلسي، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار: شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية، عالم الكتب، ومكتبة المتنبي، دط، بيروت- القاهرة، دت، ، ص 324.
[5] – الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن المظفر) ، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج1، تحقيق جعفر الكتاني، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية،سلسلة كتب التراث (82)، 1979م، ص 92
[6] – الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن المظفر) ، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج1ـ، ص 92
[7] – الأصفهاني (أبو الفرج)، الأغاني،ج8، تحقيق سمير جابر، دار الفكر ،ط2، بيروت، دت، ص 386.
[8] – الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن المظفر) ، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج1، ص 93.
[9] – أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل)، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ط1، صيدا- بيروت: 2006م، ص 178.
[10] – ينظر، محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز العربي الثقافي، ط2، بيروت، 1990م، ص 105.
[11] – ينظر، أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل)،الصناعتين : الكتابة والشعر، ص 194-195.
[12]– المصدر نفسه، ص 177.
[13] – ابن رشيق ( أبو علي الحسن)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه وفهرسه صلاح الدين الهواري، وهدى عودة، ج2، دار مكتبة الهلال للطباعة والنش، دط، بيروت- لبنان: 2002م ص 438.
[14] – المصدر نفسه، ص 422.
[15]– الحُمَيْدِي (محمد بن أبي نصر فتوح) ،” تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل”، طبع بالتصوير عن مخطوطة أحمد الثالث، مكتبة طوب قابو سراى استنابول، ص 15.
[16]– المصدر نفسه، ص 14.
[17]– عاصم بن أيوب البطليوسي، (أبو بكر)، شرح الأشعار الستة الجاهلية”، ج1، تحقيق ناصيف سليمان عواد، مراجعة لطفي التومي، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، ط1، بيروت: 2008م، ص 178-179.
[18]– المصدر نفسه، ج2، 421.
[19]– ابن السراج (محمد بن عبد الملك الشنتريني الأندلسي)، جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب، ج 2، تحقيق محمد حسن قزقزان، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، دط، 2008م، ص750 – 760.
[20]– المصدر نفسه ، ص 761.
[21]– ابن خيرة المواعيني، ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب ، تحقيق وتقديم مصطفى الحيا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط: 1988-1989، ص 32.
[22]– ابن خيرة المواعيني، ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب، ص 77.
[23] – أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، مراجعة إبراهيم مصطفى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، دط، القاهرة : 1960م، ص 259.
[24] – ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، دط،دت، ص 441.
[25] – الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت – لبنان: 2003م، ص 318.
[26] – أبو العتاهية، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، دط، بيروت، 1986م، ص 187.
[27] – ينظر، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع، ص 319.
[28] – سعد الدين التفتازاني، المطول، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت- لبنان، 2013م، ص 728.
[29] – ينظر، السيوطي (جلال الدين)، الازدهار في ما عقد الشعراء من الأحاديث والآثار، تحقيق علي حسين البواب، منشورات المكتب الإسلامي دط، بيروت، 1991م، ص2.
[30] – السيوطي (جلال الدين)، الازدهار في ما عقد الشعراء من الأحاديث والآثار، ص 2.
[31] – ينظر، عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: دراسة نظرية تطبيقية، إفريقيا الشرق، دط، المغرب، 2007م، ص 43.
[32] – ينظر، سعيد سلام، التناص التراثي: الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، ط1، اربد- الأردن، 2010م،ص 87.
[33] – ينظر، سعيد سلام، التناص التراثي: الرواية الجزائرية أنموذجا، ص 44.
[34] – أحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية: (رؤيا) لهاشم غرابية، وقصيدة (راية القلب) لإبراهيم نصر الله، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، ط2، عمان- الأردن، 2000م، ص50.
[35] – ينظر، سعيد سلام، التناص التراثي، ص 83.
[36] – ينظر، ابن منظور المصري، أخبار أبي نواس: تاريخه، نوادره، شعره، مجونه، السفر الأول،شرحه وضبطه محمد عبد الرسول إبراهيم، وعني بنشره عباس الشربيني، دار الكتب المصرية، دط، 1924م، ص 266-267.
[37] – ابن رشيق القيرواني (أبو علي الحسن)، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقيق منيف موسى، دار الفكر اللبناني، ط 1، بيروت، 1991م، ص 78.
[38] – ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد)، مقدمة، تحقيق شرح وفهرسة سعيد محمود عقيل، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، بيروت- القاهرة- تونس، 2005م، ص 484-485.
[39] – ينظر، المصدر نفسه، ص 481.
[40] – ينظر، إبراهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحديث ط1،إربد: 2011م، ص 16.
[41] – ينظر، سعيد سلام، التناص التراثي، ص 85.
[42] – الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن المظفر) ، حلية المحاضرة، ج1، ص 93.
[43] – ينظر، جنيت جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال،ط2، المغرب1986م: ص 90
[44] – المتمثلة في: التناص: Intertextualité – المناص: Paratexte- الميتانصية: Métatextualité- النص اللاحق: Hypertexte- معمارية النص: Architextualité.(ينظر، سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص- السياق، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت: 1989م، ص 96.)
[45] – ابن السيد البطليوسي، (أبو محمد ) شروح سقط الزند، تحقيق مصطفى السقا، وآخرون، إشراف طه حسين الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، 1986م، ص 276..
[46] – صحيح مسلم، دار الرشيد، الجزائر، رقم الحديث 869، ص 393.
[47] – أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات، ج1، تحقيق سيدة حامد وآخرون، إشراف مراجعة حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، دت، ص 309.
[48] – صحيح مسلم، ، رقم الحديث 1955، ص 993.
[49] – ينظر، عزت العطار، المتشابه في نظم النثر وحل الشعر، المطبعة العربية، دط، مصر، 1927م، ص 40.
[50] – ابن الرومي، الديوان،ج2، شرح احمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت- لبنان، 2002م، ص 270.
[51] – ينظر، عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: دراسة نظرية تطبيقية، ص 47-48.
[52] – ينظر، يوسف بكار، في النقد الأدبي: جدليات ومرجعيات، عالم الكتب الحديث، ط1، إربد- الأردن، 2014م: ص 75
[53] – ينظر، بدوي طبانة، معجم اللغة العربية، دار المنارة، ودار الرفاعي للنشر والتوزيع، ط3، جدة- الرياض، 1988م: ص 433.
[54] – ينظر، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج3- د-و، مطبعة المجمع العلمي العراقي، دط، 1987م، ص 84-85-86.
[55] – ينظر، نهلة فيصل الأحمد، التفاعل النصي: التناصية، النظرية، والمنهج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط1، القاهرة: 2010م، ص 236.