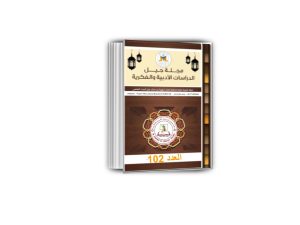تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم دراسة نصيَّة
The Reception of Holy Quran by Rasulullah: A Study in Text Linguistics
|
الأستاذ المساعد/ د.محمد عبدالرحمن إبراهيم كلية اللغات والإدارة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا Mohamed Abdelrahman Ibrahim Youssef, Languages and Management, International Islamic University Malaysia. |
الأستاذ المساعد/ د. نجية حسين التّهامي كلية معارف الوحي، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا Njea Husean Atohame, Islamic Revealed Knowledge And human sciences, International Islamic University Malaysia |
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 69 الصفحة 109.
ملخص البحثيتناول هذا البحث تلقي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضي الله عنهم للقرآن الكريم؛ للوقوف على الآليات المستخدمة في عملية التلقي. وقد تبنَّى الباحثان المنهجين الوصفيّ والتحليليّ، وقد توصلا لعدة نتائج، منها: يجب أن تنأى دراسة النص القرآني عن الشطط الناتج عن تطبيق مقولات غربية لا تراعي قدسية آي الذكر الحكيم، وتنزله منزلة أي نص أدبي أو غير ذلك. ولا مانع من الاستئناس بالنظريات اللغوية التي لا تتعارض مع هذا المبدأ.ومن الآليات التي عوَّل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار رضي الله عنهم عند تلقي النص القرآني : مراعاة السياق، والتأويل المحلي، والتغريض، والتضام، والتناص.
الكلمات المفتاحية: نظرية التلقّي، النص، القرآن، السياق، التأويل المحليّ، الغرض الإنجازي.Abstract
This study deals with the Holy Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his righteous companions, may God be pleased with them, received the Holy Qur’an To find out the mechanisms used in the receiving process. The two researchers have adopted the descriptive and analytical approaches, and have reached several conclusions, including: The study of the Qur’anic text must distance itself from the exaggeration resulting from the application of Western sayings that do not take into account the sanctity of the Holy Quran, and give it the status of any literary text or otherwise. There is no objection to adopting linguistic theories that do not contradict this principle. Among the mechanisms that the Messenger, may God’s prayers and peace be upon him and his pure companions, may God be pleased with them, relied upon when receiving the Qur’an text: consideration of context, local interpretation, prejudice, solidarity, andintertextuality
Key words: the reception theory, text, Quran, context, local interpretation, achievement.
مقدمة حظي القرآن الكريم – على مرّ السنين – بدراسات ثرَّة لا حصر لها، تناولته من زوايا كثيرة، تنهل من معينه، دون أن تنقضي عجائبه، وتنفد أسرارُه؛ فالقرآن معجزة لا تُدانيها معجزة من جميع النواحي: لغةً، وتشريعاً، وتوجيهاً، وهدايةً. وقد وقع اختيار الباحث على موضوع تلقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم للقرآن؛ للوقوف على الآليات التي اعتمدوا عليها عند تلقي القرآن الكريم. يقوم هذا البحث على تمهيد، تعقبه ثلاثة مباحث: يقف المبحث الأول بين يدي ثلاثة مصطلحات تعد ركائز لهذا البحث، وهي: القرآن، والنص، والتلقي. ويتناول المبحث الثاني أهم العوامل الملابِسة للتلقي. ويستجلي المبحث الثالث بعض الآليات التي عوَّل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم عند تلقي الوحي، وتلك الآليات تشكل الجانب التداولي للخطاب القرآنيّ، بالمفهوم العام لهذا المصطلح. يعوِّل هذا البحث على المنهجين الوصفيّ والتحليليّ، وذلك بجمع مادة البحث من مظانّها، ثم استقراء المظهر العملي للتلقي وغاياته؛ تمهيداً للانطلاق نحو هدفنا الأسمى المتمثل في بيان الاستراتيجيات التي اتُبعت إبّان عملية التلقي، مع الاستعانة- أحياناً- بما يوضح الدلالات المعجمية للألفاظ، فضلاً عن الاستهداء بمقولة أحد عناصر الاتساق Cohesion المتمثلة في التضام ،Collocation، بالإضافة إلى الآليات التي تعين على تلقي النص، ممثلةً في المعرفة الخلفية Background Knowledge، والتأويل المحلي Local interpretation ، والتغريضMatisation، والسياق Context، والتناص Intertextuality المبحث الأول: بين يديّ المصطلح أولاً:القرآن ثمة تعريفات كثيرة رامَتْ الوقوف على هذا المصطلح، ومن ذلك ما ذكره ” الشافعيّ أنه قال: القرآن اسم على غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز، لم يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب الله مثل: التوراة والإنجيل”[1]. وقد رفض الزرقاني هذا الرأي ذاهباً إلى أن لفظ القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى:﴿ إنَّ علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ ( القيامة: 17-18). ثم نُقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً لكلام الله المعجز المنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم – من باب إطلاق المصدر على مفعوله. وقد خلص الزرقاني إلى أنّ القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم – المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته[2]. بيْد أن قول الزرقاني- في نظر الباحثيْن- هو الأرجح؛ لأن الواقع اللغوي يصدقه من حيث ورود المصدر (قرآن) في آي الذكر الحكيم. ثانياً: النص جاء في القاموس المحيط “( نَصَّ) الحديث إليه: رفعه. وناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير. والشيء: حركه. ومنه: فلان ينص أنفه غضباً. وهو نصاص الأنف. والمتاع: جعل بعضه فوق بعض. وفلاناً: استقصى مسألته عن الشيء. والعروس: أقعدها على المِنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه، فانتصبت. والشيء: أظهره… والنص: الإسناد إلى الرئيس الأكبر…”[3]. ويلاحظ -هنا- أن المعاني السالفة الذكر تفسر جوانب مختلفة من النص. فرفع الحديث وإسناده إلى قائله، إشارة إلى الباث، وما جاء وصفاً لسيْر الناقة، يوضح الجهد الذي يبذله المبدع في عملية الإبداع، وما يفيد ترتيب المتاع يومئ للتابع الخطي للنص الذي يأخذ في النهاية صورة أسطر متتابعة. وما ذكر عن العروس وجلوسها في مكان عالٍ يشير إلى تداول النص وسيرورته بين المتلقين. ثالثاً: التلقي بالرجوع إلى الأصل اللغوي لهذا المصطلح يُلحظ أنّ الفعل “( لَقِيَهُ) يلقاه… لقاءً ولقايةً ولِقياً ولقياناً ولقيانةً ولُقياناً ولِقٍيّا ولُقية… استقبله وصادفه ورآه… وتلقى الشيء بمعنى لقيه…”[4]. وجاء في المعجم الوسيط”( تلقت) المرأة: حبلت. فهي مُتلقٍ ( بلا هاء). وــالشيء: لقيه. وقال: تلقى فلاناً. وــ الشيء منه: أخذ منه. ويقال: تلقى العلم عن فلان”[5]. وعليه، فإن المعاني السابقة تدور حول الاستقبال، والتلقي يعني استقبال النص، وهو الأمر الذي يسلك فيه المتلقي طريقين: القراءة أو الاستماع. ولا شك في أن المتلقي يشغل حيزاً كبيراً من ذهن الباث ووجدانه عندما تنقدح شرارة إبداعه، وحتى يتبلور ذلك الإبداع في صورته الأخيرة المنتمية إلى جنس ما من الأجناس الأدبية، فنرى ” إن ملازمة المتلقي لوعي المبدع هو الذي جعل الدارسين يقوِّمون البلاغة والبيان انطلاقاً من قدرة الخطاب على بلوغ مآربه عند ذلك المتلقي، فكان البيان على حد تعبير الرماني الذي أورده ابن رشيق هو ( الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس…) أما البلاغة فتقوم من أصل معناها على إرادة المتكلم إيصال معنى من المعاني أو فكر من الأفكار إلى الشخص المقصود بالكلام حسب كيفيات معينة تتحدد بنوع العلاقة القائمة بين الدال والمدلول”[6]. فالعلاقة- إذن- بين الباث والمتلقي قارّة في العقل والوجدان، وتلك علاقة لا تنفصم عراها. ولقد اشتط بعض النقاد في تقدير العلاقة بين مبدع النص والمتلقي، فأعلى من شأن المتلقي، وكتب شهادة وفاة للمرسل، فقد ذهب ( ريكور) إلى أنّ قراءة كتابٍ ما تعني أنّ كاتبه قد مات مسبقاً. وأن الكتاب قد تم طبعه بعد وفاته. وبالفعل، عندما يموت الكاتب، فإن العلاقة مع الكتاب تصبح كاملة وسليمة أيضاً. وإذا لم يعد بإمكان الكاتب أن يجيب، فلن يبقى له سوى أن يقرأ كتابه وقد استهجن عدنان على رضا مقولة ( ريكور) موضحاً أنَّ المؤلف –في الإسلام- مسؤول عن كلمته حياً وميتاً[7]. وما ذهب إليه الناقد على صواب، يقول الله تعالى: ( ما يلفظ من قولٍ إلا لديهِ رقيبٌ عتيدٌ) ( سورة ق : 18)، وموطن الشاهد -هنا- في عموم المعنى، والكلام إنتاجاً وتلقياً – في الإسلام- تحكمه ضوابط كثيرة، منها: الدين، والعرف، والمنطق، والإفادة. ولا يجوز للمسلم أن يدور في فلك كل ما يصدر عن الفكر الغربي من مقولات نقدية ونظريات لغوية، بل يجب تبنَّي ما يتناغم مع عقيدتنا السمحة. من الملاحظ أن المنطلق النقدي لريكور ومن ذهب مذهبه مثل رولان بارت يكمن في جعل النص وحده محور الاهتمام، فيكون الغوص في أعماقه للوقوف على جمالياته، ومظاهره الأسلوبية، وقطع كل الوشائج التي تربطه بمنشئه. وهذا الموقف النقدي رد فعل للمذاهب الأدبية التي سلطت الضوء على حياة الأديب مثل المذهب الطبيعي. ومن ثم فقد ثارت عليه مذاهب أخرى كمذهب الجمالية ( الفن للفن) حيث ذهب أنصاره إلى أن دراسة شخصية الأديب والتعرف على تفاصيل حياته لا يسمن ولا يغني من جوع، لكونه يمس حيثيات النص الأدبي ومحيطه الخارجي، بينما نحن نود أن نتعرف على جماليات النص ذاته”ا[8]، والرأي أن التوسط في الأمر هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك بالتعويل على حياة الأديب إذا كان ذلك يضوئ النص، ويسهم في فك رموزه على نحو فاعل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المرسل لم ينتهِ دوره بوضع لمساته الأخيرة على ما أبدع، فعلاقته بالنص والمتلقي موصولة، وروحه تسري دوماً في أوصال النص، ولعل المتلقي يستشعر هذه المعاني وهو يمعن النظر في أي نص لأحد المبدعين العظام مثل: المتنبي ،والجاحظ، وغيرهما. إن التلقي عملية مركبة، تحيطها عناصر السياق الذي يهيئ فهماً صحيحاً لها، علاوة على أن المتلقي الفاعل يسلك طريقاً إبداعياً عندما يتفيّأ ظلال النص، ويستروح نسماته. وقد أوضح فطوم أن الظاهرة الجمالية تُسبر أغوارها بما يمتلكه المتلقي من حساسية ومستقبلات ذوقية ينتج عنها استثارة انفعالاته الجمالية عند استقبال النص، وتدفعه نحو الغوص في أعماقه من خلال مَلَكة الوعي ومرجعياته الثقافية وغيرها[9].ومن الجدير بالذكر أن نظرية التلقي تجعل النص بنية من بنيات العمل الأدبي نفسه؛ ليصبح الفهم هو عملية بناء المعنى وإنتاجه، وليس الكشف عنه أو الانتهاء إليه. فلم يعد النص بنية محايثة مكتفية بذاتها؛ أي أن شروط تفسيرها تكمن في داخلها فقط، وذلك على النحو الوارد لدى البنيويين[10]. وتتحقق مهمة المتلقي في بناء المعنى من خلال المرور بالمرحلتين الآتيتين: الإدراك المباشر: وذلك بالنظر في الهيكل الخارجي للنص ومعطياته اللغوية والأسلوبية. الاستذهان: ويتحقق بملء الفجوات النصية، ومحاولة استجلاء كل ما غمض، في محاولة للمشاركة الفاعلة في صنع المعنى[11].ويستخدم النص- حسب آيزر- جملة من المعايير والمواضعات، على نحو يُفصح عن معناه. وجملة هذه المعايير والمواضعات أطلق عليها آيزر ” السجل النصيّ “، وهي كامنة في تلافيفه، ومتعالقة بالمسرح اللغوي الملابِس لإنتاج النص، ومعهود الخطاب لدى الجماعة اللغوية. ويشتمل النص على آليتين، هما: – الانتقاء: حيث ينقل النص الواقع بطريقة مضمرة دون التخلي عن مرجعيته الأصلية المشتركة بينه وبين القارئ. – التشويه: وذلك بأن يعوِّل النص على التشويه مشكِّلاً فضاءً متنوعاً من الأنساق الدلالية المستندة إلى أرضية واقعية، لكن بمفهوم جديد يجسد معاني متحولة، تُقدَّم برؤى مختلفة[12]. وهكذا، لا ينفصل المبدع عن واقعه، حيث يمتح من معينه، ويمتص رحيقه ليقدم منه رؤية معبرة أصدق تعبير عن مكنون ذاته. المبحث الثاني: مُلابَسات عملية التلقي ثمة عوامل تحفُّ بعملية التلقي وحيثياتها، وسنعرض في ما يلي طائفة من أهم هذه العوامل: أولاً:العامل النفسيّ من الجليّ أن العامل النفسي يعد من أبرز العوامل الملابسة للتلقي، ولقد” عني الخطاب العربي- شعراً وخطابةً ونثراً فنياً- بالمتلقي، هادفاً إلى تحقيق المعنى الأدبي، مستنداً إلى عدد من إجراءات التعبير داخل النص أو من خلال وضع رؤية نظرية لعملية التلقي، ومستعيناً بالعامل النفسي الذي هو عامل حاسم في إحداث التفاعل بين أطراف التخاطب، وفي النصوص العربية الرفيعة، ما يوضح حجم العناية بالمستقبل ومستواها[13]. وبناءً على ذلك العامل فإن العامل النفسي له خطره في توجيه عملية التلقي، ولا يتحقق الهدف من الاتصال إلا بإدراك المرسل لعناصر المسرح اللغوي، الذي يتضمنه بداهة ويشتمل المتلقي والمكان وما فيه من أشياء وموضوعات ومن فيه من أناس لهم علاقة بموضوع الحديث علاوة على الزمان وفترته المعينة من التاريخ[14]. فالمرسل عليه أن يستهل خطابه بما تنشرح له صدور المتلقين، ويدغدغ عواطفهم، ويثير مشاعرهم، ويسموا بها. ومن هنا عاب النقاد على المتنبي أن يفتتح أمدوحته لكافور بقوله: كفى بك الموت أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا فهذا يُخالف ما يندرج تحت ما يُعرف لدى البلاغيين بحسن الابتداء، فالممدوح- هنا-بانتظار ما يسبغه عليه الشاعر من فضائل، وما ينعته به من عظيم الصفات، وحميد الأفعال. فإذا به يسلك مسلكاً آخر مخيباً لأفق توقعات هذا الممدوح. ويمكن إجمال العوامل التي تحدث الأثر النفسي المرغوب في المتلقي على النحو الآتي: النظم الرائع للمعاني، والشواهد على ذلك كثيرة منها، طريقة تلقي عمر بن الخطاب للنص القرآني للوهلة الأولى حين تلقى آيات سورة” طه” وتجاوبت نفسه مع ما يتسم به النظم القرآني من انسجام صوتي بديع علاوة على”القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، وهاتان نهايتان لا يستطيع أحد من الكتاب الجمع بينهما…”[15]. وتحفل مظانّ البحث بكثير من الشواهد على فاعلية هذا العامل في نفس المتلقي. تلبية حاجات المتلقي، بالحديث- مثلاً- عما يشغله، على النحو الذي يُعَدُّ به الخطاب السياسي الناجح الذي يتناغم مع نبض الجماهير. انسجام الخطاب، وذلك بأن توضع الكلمات في مواضعها الصحيحة، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي سمع رجلاً يتلو آية هكذا “( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا، نكالاً من الله والله غفورٌ رحيم) فقال له الأعرابي: أخطأتَ. قال كيف؟! قال: إن المغفرة والرحمة لا تناسبان قطع يد السارق. فتذكر الرجل الآية وقال﴿والله عزيز حكيم﴾ ( سورة المائدة: 38)، فقال الأعرابي: نعم، بعزته أخذها، وبحكمته قطعها”[16]. فسليقة الأعرابي اللغوية ومعهود الخطاب لديه أوقفاه على فحوى الآية الكريمة. ثانياً: العامل العقدي ويتجلى ذلك في تلقي النص مِنْ منطلق عقدي، يستجمع فيه المتلقي قواه لتفسير معطيات هذا النص في ضوء معتقداته، وذلك على النحو الذي نجده عند المعتزلة والشيعة والمرجئة والأشاعرة وغيرهم. فالفلاسفة- على سبيل المثال-” جعلوا القرآن تابعاً لما اعتقدوه من صحة كل ما جاء به أرسطو، فتكلفوا تأويل آياته المحكمات، في البعث والنشور، والجنة والنار، وفي النبوة والوحي، وفي خلق السماوات والأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهي القضايا الأساسية الثلاث، التي كفرهم بها الغزالي في كتابه الشهير” تهافت الفلاسفة” لمصادمتها لمحكمات القرآن، وقواطع الإسلام، وأشار إليها في كتابه” المنقذ من الضلال”[17]. وينضاف إلى ذلك ما ذهب إليه المعتزلة من تقديم المعقول على المنقول، ونفي الصفات، والوقوع في فتنة خلق القرآن، ، مما تحفل به تصانيفهم، ومنها- على سبيل المثال- “الكشاف” للزمخشريّ. ثالثاً: العامل الاجتماعي من نافلة القول إن الإنسان ابن بيئته، يتأثر بها، ويؤثر فيها، يحمل همومها بين جنبيه، تملك آمالها عليه أقطار نفسه. لذلك كان للبعد الاجتماعي خطره في عملية تلقي النص. فانطلاقاً مِنْ رؤية واعية لأحوال المجتمع، وحرصاً منه على تماسك الأسرة، تلقى ابن تيمية الآيات التي تناولت قضية الطلاق بمفهوم خالف فيه الأئمة الأربعة فقد” رفض رأي الأئمة الأربعة في إمضاء طلاق البدعة، فكانت هذه جراءة هو لها أهل، لأنه فعلاً لا معنى إطلاقاً لأن تكون الأسرة ألعوبة في يد طائش، وكأن البيت ورق لعب…”[18] ولا يَعْزُب عن بالنا تلقي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لسهم المؤلفة قلوبهم، حين امتنع عن أدائه، بعد أن بزّ الإسلام وقويت شوكته. رابعاً: العامل الحضاري النص تتفاوت قراءته من عصر إلى عصر، فلكل عصر ظروفه، ولكل عصر رجالات لديهم من الآليات ما يفجِّرون بها طاقات تمهد لهم سُبُلاً متجددة لفهم أقرب إلى روح العصر. ومن ذلك تلقي النص القرآني في ضوء آخر الحقائق العلمية، ويشير إلى ذلك أحد الباحثين بقوله:” وأنا أفعل ذلك كثيراً، فأنا أود زاداً لقلبي عن طريق عقلي في كثير من الأحيان، فأقف مثلاً عند قوله تعالى: ﴿وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ ( الحج: 5). نعم، يقرأها المسلم في القرون الأولى الهجرية فيشعر بأن الأرض الظامئة تهتز طرباً وسعادة إذ يأتيها غيثها فتدب فيها الحياة. وهو تفسير جميل يقدم لنا صورة فنية… جمالية رائعة، ولكن رجلاً مثلي يشتغل بالعلوم والهندسة يبحث عن الإعجاز المكنون في هذه الصياغة الربانية فيوفقه الله إليه”[19]. ولا يخفى على أحد ما ترفدنا به نتائج البحوث من حقائق تتناغم مع ما ورد في تلافيف القرآن. وهذا ما يمثله التلقي الحضاري للنص الكريم. المبحث الثالث: تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم للنص القرآني أ- الجانب العملي للتلقي- بدء التلقي
- ختام التلقي
- الربط بين السور بمراعاة أسباب النزول ( القول الأول لابن عباس…إلخ).
- المعنى اللغوي. ( القول الثاني لابن عباس).
- الوقوف عند دلالات الألفاظ، وهي- هنا- واضحة، لا داعي للرجوع إلى مظانها للكشف عنها.
- التغريضMatisation” يعرف براون ويول الثيمة بأنها نقطة بداية قول ما. ولما كان الخطاب ينتظم على شكل متتاليات من الجمل، بناءً على أن يبدأ به المتكلم أو الكاتب سيؤثر في تأويل ما يليه. وهكذا. فإن عنواناً ما سيؤثر في تأويل النص الذي يليه… وإن شئنا التوضيح قلنا إن في الخطاب مركز جذب يؤسسه من طلقه، وتحوم حوله بقية أجزائه”[40]. فالآية مفتتحها قوله تعالى:﴿ إذا حاء نصر الله والفتح﴾ ( سورة النصر:1) وهذا القول يهيمن على سائر الآيات، إذا تتمثل فيه الحد الأول الذي يحدد الأجل الذي أعلمه الله تعالى لنبيه- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم، فإن هذا يستتبع دخول الناس في دين الله أفواجاً وهو الحد الثاني، وما ينبغي أن يوضح ما يجب أن يفعله النبي – صلى الله عليه وسلم- استعداداً للقاء ربه.
- استدعاء الرسول – صلى الله عليه وسلم- المباشر لمعرفته الخلفية حيث ربطها بدلالات الألفاظ والتغريض وفطن إلى فحوى الخطاب.
- يجب أن تنأى دراسة النص القرآني الشطط الناتج عن تطبيق مقولات غربية لا تراعي قدسية آي الذكر الحكيم، وتنزله منزلة أي نص أدبي أو غير ذلك. ولا مانع من الاستئناس بالنظريات اللغوية التي لا تتعارض مع هذا المبدأ.
- تدور معاني التلقي حول استقبال النص استماعاً وقراءةً.
- المؤلف – في الإسلام – مسؤول عن كلمته، ولا مكان – فيما يراه البحثان- للقول بموت المؤلف كما زعم البنيويون.
- لم يعد النص بنية مُحايثة مكتفية بذاتها، بل إنه بحاجة ملحة لاستجلاء مسرحه اللغوي.
- علاقة الباث بالمتلقي لا تنفصم عراها، فالمتلقي قارُّ في عقل الباث.
- ثمة عوامل كثيرة مصاحبة لعملية التلقي، منها: العوامل النفسية، والعقدية، والاجتماعية، والحضارية.
- من الآليات التي عوَّل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم – عند تلقي النص القرآني- : مراعاة السياق، والتأويل المحلي، والتغريض، والتضام، والتناص.
- إبراهيم الأبياري، تأريخ القرآن ( بيروت: دار الشروق، د. ط.، 1964م.
- إبراهيم أنيس ( وآخرون ) المعجم الوسيط (القاهرة: دار المعارف، د.ط، د. ت).
- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،ج1، بيروت: دار الفكر، د. ط.، لا ت
- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الرياض: دار عالم الكتب، ط2،1997م.
- أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن حسن الرازي، كتاب فضائل القرآن وتلاوته، تح:
- عامر حسن بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1994م.
- أحمد عفيفي، نحو النص- اتجاه جديد في الدرس النحويالقاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ط1، 2001م.
- بشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات ( الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 20012001).
- بطرس البستاني، محيط المحيط، بيروت: مكتبة لبنان،د. ط.، 1983م.
- جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، بيروت: المكتبة العصرية، د. ط.، 1988م.
- سيد دسوقي، تأملات في التفسير الحضاري للقرآن الكريم، القاهرة: دار نهضة مصر، د. ط.، 1998م).
- صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، بيروت: دار العلم للملايين، ط24، 2000م.
- الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على يطرقة المصباح المنير وأساس البلاغة( بيروت: دار الفكر، ط3، 1970م.
- عبد الحميد بو زوينة، نظرية الأدب في ضوء الإسلام، عمان: دار البشير للنشر والتوزيع، ط1، 1411هـ- 1990م).
- عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان( بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ- 2000م.
- عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن، القاهرة: نهضة مصر، ط3، 2007 .
- عبد القهار داوود العاني، دراسات في علوم القرآن، كوالالمبور: مركز الأبحاث، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ط1، 2001م.
- عدنان علي رضا النحوي، الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام، الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع، ط1، 1419هـ).
- كاظم السباعي، القرآن كتاب حياة( بيروت: مؤسسة الوفاء، ط1، 1404هـ- 1984م.
- كمال بشر، دراسات في علم المعنى- السيمانتيك ( د.م.: د.ن.، د.ط. 1985م
- محمد بن أبي بكر الرازي، ترتيب مختار الصحاح، تح: شهاب الدين أبي عمر( بيروت: دار الفكر، د. ط.، 1414هـ- 1992م.
- محمد حسن عبد العزيز، المصاحبة في التعبير اللغوي، القاهرة: دار الفكر العربي، د. ط.،1990م.
- محمد خطابي، لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب( بيروت: المركز الثقافي العربي، ط1، 1991م.
- محمد زكي الدين محمد أبو القاسم، جامع البيان لما اتفق عليه الشيخان( الغردقة: دار الصفوة، ط1، 1999م.
- محمد عبد العظيم، معاني النص الشعري- طرق الإنتاج وسبل الاستقطار، في منشورات كلية الآداب بمنوبة، تونس، 1992م.
- محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط.، 1996م).
- محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن،هيرندن- فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1411هـ-1991م).
- محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 1999م.
- محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص( بيروت: المركز الثقافي العربي، ط3، 1993.
- محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي (القاهرة: ط1، 1996).
- مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي ( دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د.ط، 2013)
- يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن ، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1999م).
- حسين بوفناز، تحليل الخطاب في ضوء الدرس اللساني المعاصر: الخطاب النبوي أنموذجاً، مجلة لغة-كلام، المجلد 6، العدد3، الجزائر، 2020.
- شيخ عبد الرزاق، السجل النصي والاستراتيجية النصية من المرجعي إلى التخييليّ في رواية ” سيرة المنتهى” لواسيني الأعرج، مداخلة الملتقى الوطني لتحليل الخطاب، شبكة المعلومات (dspace.univ.msila.dz ).